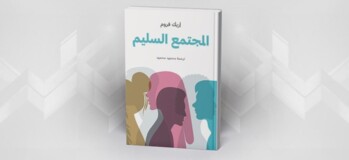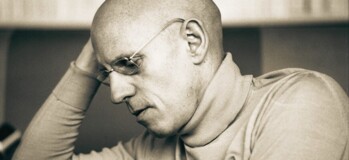العلاقة بين الموت والمقاومة في الخبرة الإسلامية: قراءة في كتاب خاطرات الأفغاني
فئة : قراءات في كتب
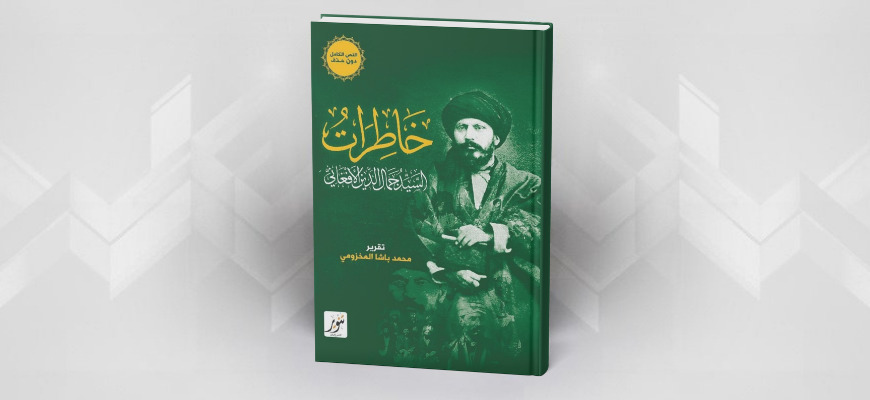
العلاقة بين الموت والمقاومة في الخبرة الإسلامية:
قراءة في كتاب خاطرات الأفغاني
مقدمة وتمهيد:
يعد جمال الدين الأفغاني أحد الأعمدة الأساسية - إن لم يكن الأساسي - في الفكر الإسلامي النهضوي في القرن التاسع عشر، وكان لفكره العديد من الأبعاد الإصلاحية والثورية، لا سيما الوحدة الإسلامية ومحاربة الاستبداد، وقد خرج من مدرسته الفكرية العديد من المفكرين والعلماء والسياسيين الذين كان لهم عظيم الأثر في القرن العشرين، وقد شكلوا تيارات سياسية وفكرية مختلفة، بل وحتى متناقضة بالرغم من كونهم تعلموا تتلمذوا في المدرسة الأفغانية.
كان جمال الدين الأفغاني معنيًا بشكل أساسي بالمشكلة الحضارية الشرقية التي وصلت لذروتها مع المسألة الشرقية ،وتقهقر الدولة العثمانية وخضوع العديد من البلدان الإسلامية للاستعمار الأوروبي، وهو ما جعله يطرح تساؤلات حول تأخر الشرق، وخصوصا البلدان الإسلامية منه، وخضوعها بهذا الشكل المُهين لأمم أجنبية كانت تخشى جانبها من فترة ليست بعيدة من التاريخ؛ ذلك ما جعل سؤال المقاومة حاضرا وبشدة في فكر الأفغاني؛ أي التساؤل حول عدم مقاومة الأمم الإسلامية المُستعمَرة لتعدو مستقلة.
لكن هل يمكننا أن نطرح تساؤلات حول دور الموت كمفهوم في رؤية الأفغاني لهذه المقاومة الاستعمارية التحررية؛ أي بعبارة أخرى، هل كان لمفهوم الموت دور أساسي في فكر الأفغاني التحرري؟ غرض هذه التساؤلات هو تقديم قراءة جديدة للأفغاني من خلال الكشف عن دور مفهوم الموت في البناء المفاهيمي الخاص به، ووظيفته في رؤية الأفغاني للمقاومة، لا سيما مقاومة الاستعمار. وأهمية هذه القراءة أنها تعمل على حل مشكل نظري معقد في الواقع السياسي، ألا وهي مقاومة سياسات الموت، بالإضافة إلى فائدتها القصوى في إرساء معالم خصوصية مقاومة سياسات الموت في الخبرة الإسلامية.
في الواقع، لم يُقدم الأفغاني نظرية متكاملة في العلاقة بين الموت والمقاومة، لكنه ترك شذرات نظرية متفرقة عالجت هذا الموضوع. لذا، يمكن أن نحاول استجماع هذه الشذرات لنكوّن منها إطارا نظريًّا، يساعدنا على فهم حدود العلاقة بين الموت والمقاومة من منظور تابع للخبرة الإسلامية؛ وذلك تحديدا في الكتاب الذي نُشر بعد 43 عاما من وفاته، وهو كتاب "خاطرات الأفغاني"، هذا الكتاب الذي جمعه ونشره محمد باشا المخزومي عام 1931، وهو الذي كان مرافقا للأفغاني في آخر سنوات حياته في إسطنبول، يكتب ما يناقشه السيد في مسائل الشرق، وما يلقيه على مريديه في مجالس العلم، وما يجول في وجدانه من أفكار.
وأهمية هذا الكتاب أنه كتب عن السيد أفكاره في مرحلة عمرية قد نضج فيها فكره النضوج الذي يُفضي إلى تساقط الثمرة؛ أي كانت أفكاره في هذه المرحلة هي التجربة الخام لمسيرة حافلة بالتجول في بلدان الشرق والغرب، مسيرة مثيرة للشعوب ومُناهضة للحكومات والحكام، فالخاطرات الواردة في الكتاب قد دُونت عن السيد الأفغاني في الفترة من 1892 حتى 1897؛ أي الخمس سنوات الأخيرة من حياته. لذا؛ يمكن أن نحاول أن نقرأ هذا النص بطريقة نستجمع من خلالها هذه الشذرات التي تفرقت عبر حوالي 45خاطرة، لنكوّن منها إطارا نظريًّا، يساعدنا على فهم حدود العلاقة بين الموت والمقاومة من منظور تابع للخبرة الإسلامية عبر فكر جمال الدين الأفغاني.
تشريح النفس الإنسانية وتوضيح العلاقة بين الجبن والموت وحدود السلطة:
يبدأ جمال الدين الأفغاني من النفس الإنسانية، فهو يرى أن الجبن الذي يعد أحد الصفات الذميمة، هو منبع أغلب المفاسد والشرور التي تجعل الإنسان يرتكب العديد من المُوبقات المُذلة. فالإنسان يصمت عن قول الحق بسبب الجبن، ولا يقدم على مناصرته؛ لأنه يعلم التكلفة. ولا يقاوم الإنسان السلطة حينما تنحرف بسبب الجبن أيضا. ويُرجع الأفغاني الجبن في أصوله العميقة إلى الخوف من الموت.([1])
وعلى الرغم من أن الموت هو مآل أنطولوجي، إلا أن الإنسان بسبب الوهم يتصور أن الجبن سيحميه من الموت، لكن الموت عند الأفغاني لا يقتصر على الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، بل هذا الانتقال هو أعلى درجات الموت. يمكن أن يكون الموت في هذا الفهم هو حالة معيشية ذليلة وغير كريمة، لا يتحقق فيها الإنسان كإنسان، بل يكون ما هو أدنى منه بسبب قبوله بأوضاع غير إنسانية. هذا ما يوضحه الأفغاني عندما يقول إن: "الناس في الموت خوف الموت وفي الذل خوف الذل".([2])
يرى الأفغاني أن الإنسان يمكنه أن يتحرر من هذه الصفة التي تمكّن السلطة منه؛ أي الجبن، من خلال الإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر. هذا الإيمان الذي يجعل الإنسان يعتقد أن جميع مجريات الأمور بيد الله، ومن ثمة يُقدم على اقتحام المخاطر والمهالك ولا يخاف الموت الذي يعتبر أحد المقدرات الإلهية في سبيل إعلاء الحق ودفع العدوان. وهذا الاعتقاد هو الذي يهون على الجبلة الإنسانية الحريصة على الحياة خوض المصارع. فيوضح الأفغاني العلاقة بين الإيمان بالقضاء والقدر والمقاومة والموت بقوله: "الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد من شناعة الجبر، يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام الهالك ... كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته".([3])
المقاومة والموت والحرية:
أهم ما يجعل الإنسان حرًّا أو مستعبدًا هو مدى نزوعه إلى ترقب السلطة وقابليته لمقاومتها، وكل سلطة في طبيعتها الميل نحو الاستبداد ما دامت لم تجد من يقف لها بالمرصاد بالمراقبة والمحاسبة كما يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد".([4]) لذلك، لا يمكن أبدا أن تمنح السلطة الاستعمارية رعاياها الاستقلال ولا الحرية. فهاتان الصفتان تأتيان وفقا للأفغاني بالمقاومة المستميتة التي تصل تكلفتها إلى حد فقدان حيوات من هم لا يقبلون أن يرضخوا للعسف والطغيان.([5])
وهذا القول ينطبق بالأخص على الأقوام المستعمرة، حيث يُلاحظ الأفغاني أنه: "لا حياة لقوم لا يستقبلون الموت في سبيل الاستقلال بثغر باسم".([6]) فالمسألة لا تتعلق فقط بتصالح الإنسان مع الموت في سبيل استقلال وطنه، بل بالإيمان العميق النابع من رسوخ الاعتقاد أن هذا المسلك هو خير المسالك، وطلب الموت فيها من أنعم المطالب المبتغاة أشرف الغايات. هذا ما يجعل الإنسان يحتقر الحياة الناقصة لشروط الحياة؛ أي الحرية والعيش الكريم، وينتفض لمقاومة الظلم.
لكن هل يستطيع كل الأفراد فعل ما يطلبه الأفغاني؟ خاصة وأن ذلك يتطلب أُناسا على درجة عالية من الوعي والتضحية. فلهذا يدعو الأفغاني إلى ضرورة تربية جيل "بعلم صحيح وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان الأول على الأجساد والأرواح وهو الدين"،([7]) وهذا الجيل بعدما يتربى على فهم صحيح الدين وما فيه من معان لمقاومة الظلم وموقفه من الموت، سيخلق أفراد لديهم من الخيال السياسي ما يجعلهم لا يتأخرون لحظة عن التضحية بأرواحهم في سبيل حياة الوطن؛ لأنهم تحرروا من قيود الجبن والتقاعس التي ترجع إلى الخوف من الموت كما حدد الأفغاني؛ أي بمعنى آخر هذه التربية ستخلق أفراد لديهم أنطولوجيا سياسية تحررية مقاومة، تتم عبر تقنيات الذات كما يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.([8])
في تأمله للظاهرة الاستعمارية، توصل الأفغاني إلى أن أي استقلال مرهونا بقدرة الأمة على الأخذ بأسباب القوة والمقاومة والاتحاد؛ أي يكونون كما وصفهم هو: "قوم حرب يطاحنون الموت"، فهم لا يتأخرون عن بذل التضحيات والصمود والصبر أمام القتل والتدمير، وهذا الصبر واستمرار المقاومة هما بالأساس رهنا للإجابة عن سؤال الموت؛ لأن الإنسان إذا لم تكن لديه رؤية واضحة لما بعد الموت، وهو شحيحا بوجوده بالأساس، في الأغلب الأعم لن يُقدم على تعريض روحه للهلاك.([9]) وهذه المقاومة المستمرة هي التي تُفكك المنظومة الاستعمارية؛ لأنها تكبدها باستمرار تكلفة باهظة لا يمكن تحملها. كما أنها تجعل المُستعمِر يًدرك أنه لا يمكنه "إفناء أمة بأسرها تتفق وتستبسل وتطلب الموت في سبيل استقلالها" كما يقول الأفغاني.
يُقيم الأفغاني مقارنة بين السعادة والشهادة كأوجه لحب الموت الذي يُعتبر مُخلصا لحالة الذل والهوان، حيث إن الإنسان المُقاوم تُعاد رسم العلاقة بين الحياة والموت في ذهنه على أساس السعادة الدنيوية التي ترى الحرية أهم مُتطلباتها، وحينما تغيب هذه الحرية وما يتبع غيابها من عيش ذليل، حب الموت سيدفع هذا المقاوم إلى محاولة تغيير الواقع البائس؛ لأنه مستعد لنيل الشهادة في سبيل هذه المحاولة التي لو نجحت؛ ستُحقق السعادة بتوفير الحرية. ولهذا، تحديد العلاقة مع الموت في الخبرة الإسلامية هو ما يجعل الإنسان المُقاوم يفلت من زمام السلطة، وبالأخص السلطة الحديثة التي تُأسس سيادتها ذاتها على إدارة الحياة والموت في المجتمعات الحديثة كما يقول منظرو السياسة الحيوية الذي كان أبرزهم ميشيل فوكو.([10])
وبما أن المنظومة الكولونيالية تُقيم سلطتها على الأراضي المُستعمَرة بواسطة العنف بشكل أساسي كما يجادل الفيلسوف الفرنسي فرانتز فانون،([11]) فإن الإنسان المُستعمَر عبر رؤيته المعرفية للموت، سيستطيع دائما المقاومة وفقا لرؤية الأفغاني؛ لأن أقصى مراحل العنف الكولونيالي الذي هو فرض الموت، لن يجعل المُقاوم يتراجع.
ينظر الأفغاني للإبادة التي هي في جوهرها فرض الموت على مجموعة من البشر، والتي تعدّ مفهومًا مركزيًّا في حقل السياسة الحيوية وكذلك في الدراسات الاستعمارية، نظرة تحليلية، فهو يرى أن الإبادة تنبثق من المُغالاة في التعصب الديني أو التعصب القومي، مما يجعل قوم ما يُبيدون قوم أو أقوام أخرى بدعوى الاعتقاد بالأفضلية التي يمكن أن تستند إلى ديباجات دينية أو عرقية. فهذه الاعتقادات تجعل القوم المتعصبون يرون من يخالفهم كمثل "الحيوانات السائمة والهمل الراعية وليس من نوع الإنسان"،([12]) مما يجعل إبادة هؤلاء المختلفين أمرًا لا يُكلف الضمير شيئًا؛ لأن عملية نزع الأنسنة عن الآخر قد تمت مسبقا بالفعل. وهنا نلاحظ أن الموت كمفهوم عند الأفغاني لم يكن حاضرا فقط في طيات المقاومة، بل قد نظر له أيضا كأداة للسلطة والقوة في العلاقات الاستعمارية، وجاء بنظرة لا تقل فهما لما جاء به منظرو السياسة الحيوية بعده بأكثر من نصف قرن.
ختاما:
وفقا لهذه القراءة؛ تتضح وظيفة الموت في استقلال الأمم المُستعمرَة في المنظومة الفكرية للأفغاني، فقد حدد الأفغاني للموت وظيفة تحررية عبر الرؤية المعرفية الإسلامية التي لديها تصورات غنية عن الاستشهاد، فإذا كانت السلطة الاستعمارية ستُمارِس سيادتها عبر القتل؛ فالإنسان الذي سينشأ عبر إعادة تثوير مفهوم الموت، سيُحطم سيادة السلطة الاستعمارية عبر رؤيته الابستمولوجية للموت، وستستمر المقاومة حتى تدرك السلطة الاستعمارية أنها لا يمكنها "إفناء أمة بأسرها تتفق وتستبسل وتطلب الموت في سبيل استقلالها". ومن ثم، لن يكون أمامها سوى أن تُرغم على التسليم بالاستقلال الذي يدور على الأمم المجاورة أيضا بفضل بسالة الأمم التي استقلت كما يقول فانون.
[1] جمال الدين الأفغاني، "خاطرات الأفغاني"، تقرير: محمد باشا المخزومي، (القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2002)، ص 219.
[2] المصدر السابق، ص 120، 220
[3] المصدر السابق، ص 295، 297
[4] عبد الرحمن الكواكبي، "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، (يورك، مؤسسة هنداوي، 2017)، ص 16
[5] خاطرات الأفغاني" مصدر سبق ذكره، ص 83
[6] المصدر السابق، ص 33
[7] المصدر السابق، ص120
[8] راجع: ميشيل فوكو، "المقالات الإيرانية"، ترجمة: عومرية سلطاني، (القاهرة، تنوير للنشر والإعلام، 2020).
[9] "خاطرات الأفغاني"، مصدر سبق ذكره، ص 218، 230
[10] راجع فصل (حق الموت والسلطة على الحياة) في:
ميشيل فوكو، "تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة"، ترجمة: سلمان حرفوش، (بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 2017).
[11] راجع فصل (في العنف) في:
فرانتز فانون، "معذبو الأرض"، ترجمة: سامي الدروبي وجمال الأتاسي، (القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، 2014).
[12]“ خاطرات الأفغاني"، مصدر سبق ذكره، ص 308