الفيلسوف الفرنسي بول ريكور: من فالانس إلى نانتير
فئة : حوارات
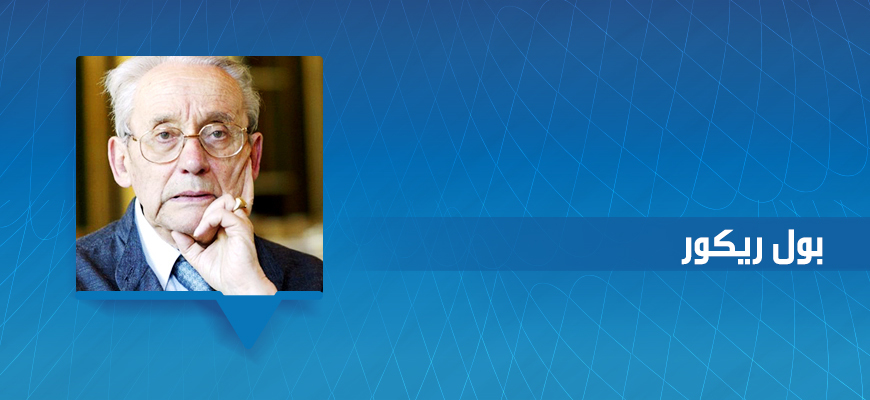
حاوره: فرانسوا أزوفي، ومارك دولوني
ترجمة: حسن العمراني
بول ريكور، أنت قبل كل شيء رجل كتابة، ومع ذلك، وافقت بصدر رحب على مبدأ إجراء سلسلة من الحوارات. نريد أن نعرف ماذا يُمثِّل هذا بالنسبة إليك؟
بول ريكور: أوَدُّ أن أقول في البدء، إنّي أخشى كثيراً هذا النوع من الممارسة اللغوية؛ وذلك لأني بالفعل رجل كتابة بقدر ما أنا رجل أهتم بالصورة النهائية للكتابة (التشطيب)، لذلك تجدني عادة أحترز من الارتجال، ومع ذلك قبلت دعوتكما لسببين:
أمّا الأول فلأنكما تنتميان إلى جيل يضمّ أَعَزَّ أصدقائي، جيل تفصله المسافة ذاتها عن الشيخوخة التي أتقدم فيها بخطى حثيثة، وعن الشباب الذين لم أعد أخالطهم قطّ عبر آلية التواجه التي يتيحها التدريس. تتواجدان في وسط معترك الحياة، وتضمنان لي قُرباً ومواكبة، بل وأستمتع بجواركما بنعمة الصداقة، ولم أكن لأقبل الدخول في هذا النوع من العلاقة بالكلام لو كان المُحاور طرفاً آخر غيركما.
والسبب الثاني يرتبط بطبيعة الحوارات ذاتها. فأنا راغب في توريط نفسي، مرة واحدة في حياتي، في ما يتيحه الحوار، أي في ذلك الكلام الأقل خضوعاً للرقابة. تكلمت للحظة عن التشطيب، وهو نوع من الرقابة الذاتية. يُضاف إلى ذلك أنّي احتفظت دوماً لنفسي ببعض الأسرار. المستوى الذي سنقف عنده سيكون، بحق، في منتصف الطريق بين الرقابة الذاتية والبوح؛ وهي طريقة بفضلها أسمح بتسرب ما كنت سأشطبه في حال وجودي وحيداً مع الورقة البيضاء، وهو على وجه الدقة ما لن أكتبه. إنّنا هنا بين القول والكتابة، أمام جنس يتيح لنا مزيداً من الحرية، لأنّ شطآناً من الكلام يمكن أن تترك، إن لم نقل في حالتها الخام، فعلى الأقل في حال تفتقها وتلقائيتها، بينما يكون مصير الأخرى هو، على العكس من ذلك، إعادة الكتابة. وهذا يمنح القارئ تشكيلة متنوعة من مستويات الكلام والكتابة.
هذه الحرية، بل وهذه الجرأة التي يتضمنها هذا الأسلوب، سوف تتيحان لي الحديث بشكل خاطف عن تيمات لم يسبق لي أن كتبت فيها، لأنّ الفكر فيها لم يَرقَ إلى مستوى الصياغة التي أحرص على توفرها في كتاباتي. ينطبق هذا القول أساساً على تأملاتي في التجربة الجمالية. ربما هذا هو الامتياز الذي يكون لكلام يخضع لرقابة أقل، والقارئ سيحكم على ذلك بنفسه.
ما أريد قوله أيضاً، تبعاً لترتيب الأفكار ذاته، هو أنّنا سنلعب بصورة تناوبية، على الجانب المتعلق بالشتات، ولكن على جملة من عمليات التقريب التي لم أقم بإنجازها. أفكر على سبيل المثال في المجالين الديني والفلسفي اللذين قمت بالفصل بينهما بقوة، وذلك لأسباب كنت أجتهد دوماً في تبريرها، غير أنّي في هذا الحوار الذي أشعر فيه بحرية أكبر، سأركز أكثر على المشاكل التي تطرحها تداخلات ما هو ديني بما هو فلسفي وتشابكاتهما. أستطيع عبر الكتابة أن أفصل بين هذين المجالين، بقصدية أكبر وبصورة مفكر فيها أكثر، في حين سيكون في مقدوري، ضمن هذه الحوارات التي ستدور بيننا، حيث سيتكلم الإنسان أكثر من المؤلف أو إن شئت قل سيتكلم الإنسان أكثر في الكاتب، أن أحافظ بصورة أقل شرعية على هذا النوع من الفصام المراقب الذي يؤطر على الدوام نظامي الفكري؛ فيتغلب نظام الحياة على نظام الفكر.
مجمل القول إنّك ستغامر بإقامة نوع من التمفصل، أكثر قرباً مما كان عليه الأمر في كتاباتك، بين القطبين اللذين يتشكل منهما عنوان هذا الكتاب: الانتقاد والاعتقاد.
بول ريكور: ما أريد قوله، من الآن فصاعداً، هو أنّ الانتقاد لن يوضع في جانب ويوضع الاعتقاد في جانب آخر؛ إذ سأحرص، ضمن الحقول التي سَنَعْبُرها أو نلامسها، على بيان كيف أنّ هناك مزيجاً دقيقاً بين الاعتقاد والانتقاد، وإن بدرجات مختلفة.
لقد خصصت أعمالاً كثيرة وهامة لموضوعة الذاتية، كما يحمل آخر كتاب لك عنوان: "العينية بوصفها آخر". بيد أنّنا لا نعرف عنك، وعن حياتك، وعن تكوينك الفكري، إلا الشيء القليل. هل لك أن تحدثنا عن الوسط الذي أمضيت فيه طفولتك الأولى؟
بول ريكور: ولدت سنة 1913، في "فالانس" (valence)، حيث كان والدي يعمل مدرساً للغة الإنجليزية. الحدث الأبرز في طفولتي تمثل في أنّي كنت ربيب الأمّة، أي ابن واحد من ضحايا الحرب العالمية الأولى، وهو بدوره كان أرمل، لبضعة شهور، قبل أن يُقتل في شتنبر 1915 في معركة "المارن" (bataille de la marne).
أحتفظ بذكرى لا أدري تماماً هل هي حقاً ذكرى أم أنّها تشكلت انطلاقًا مما رُوي لي؟ إنّ تاريخ 11 سبتمبر 1918 لم يكن بالنسبة إلى أسرتي يوم نصر وفرح. أعتقد بأنّني أتذكر مجيء قطارات تحمل جنوداً مبتهجين يملؤون الدنيا صياحاً وهتافاً، فيما كان الجو المُخَيِّم في منزلنا هو جو الحداد. والسبب أنّنا لم نكن نعلم علم اليقين بوفاة والدي، فحينئذ لم نكن قد تلقينا إلا خبراً يفيد اختفاءه، ولم يُعثر على جثمانه إلا بعد انصرام وقت طويل، بالضبط سنة 1932، لمّا قام أحدهم بحرث أحد الحقول، فتَمَّ التعرف عليه بفضل شارته العسكرية. انتهت الحرب بموت والدي، ولهذا لا تقترن عندي نهايتها بذكرى سارة توقف فيها الاقتتال، ولا حتى بذكرى إحراز نصر مظفر.
لديَّ صورة له أُخذت أثناء إجازته في مطلع عام 1915 أَظهرُ فيها أنا وأختي جالسين على ركبتيه. منذ ذلك الحين لم تتحرك تلك الصورة؛ أما أنا فقد كبرت في السن، وشيئاً فشيئاً تعودت على فكرة أب أصغر مني بكثير، فيما كانت فكرتي عنه في البداية هي لرجل بلا عمر. كان عليَّ أَن أُدمجه كصورة لشاب تجاوزته في الحياة. وما زلت إلى اليوم لا أستطيع ترتيب العلاقة مع هذه الصورة التي توقفت لتعكس صورة هذا الشاب إلى الأبد، وهذا ما أشعر به أيضاً أمام النّصب التذكارية التي تقام للموتى، أمام ذلك الأثر الذي كتبت عليه عبارة "إلى أبنائنا"، متسائلاً: من هم هؤلاء الأبناء؟ والغريب أنّ النّصْب يتحدث عن طفل هو أبي، إلى طفل آخر يتقدم باستمرار نحو الشيخوخة. وبالمناسبة فقد فرغت للتو من قراءة تأمل مماثل عند "كامو" (Camus) في كتابه الإنسان الأول.
للعلاقة التي تربطني بصورة أبي أهمية بالغة؛ وذلك بسبب القلب الذي تعرضت له في ما بعد؛ إذ تم التوسل بصورته لتربيتي بطريقة أستهجنها إلى الآن. كانوا يُكرِّرون على مسامعي باستمرار: "لو أنّ أباك رآك". مطلوب مني الامتثال لنظرة غائبة، هي فضلاً عن ذلك نظرة بطل. والحال أنّي تأثرت، لمّا كان عمري يتراوح بين الحادية عشرة والثانية عشرة، بِرَجل هو في الواقع مالك المنزل الذي كنا نقطن فيه، وقد كان كاثوليكيًا مُحبّاً للسلام مؤيداً للتوجه الذي اختطه "مارك سانيي" (Marc Sangnier) ـ غَيَّر نظرتي كُلِّياً حينما "برهن" لي أنّ فرنسا كانت خلال الحرب العالمية الطرف المعتدي، وأنّ استمرار العدوان بعد "فردون" (Verdun) كان عبارة عن فضيحة، وأنّ معاهدة فرساي شكلت وصمة عار دفعت ثمنها أوروبا بأكملها. وقد كنت أرى الصعود الهتلري ضمن هذا المنظور. ظلت هذه الصورة قوية في ذهني، ولم أتخلَّ تماماً عن كون فرنسا تتحمل قسطاً من المسؤولية في ما وقع. من هنا، صرتُ أرى أنّ أبي مات من أجل لا شيء، وعندما توقفت صورته عن لعب دور الرقيب الأخلاقي، أصبح لزاماً عليَّ أن أدخل في نوع من السجال مع هذه النظرة الجديدة للحرب ولأبي.
ماذا حدث بعد وفاة والدك؟
بول ريكور: تَكَفل جدي وجدتي، من جهة الأب، بأمر تربيتنا أنا وأختي، فأقمنا بـمدينة "رين" (Rennes)، حيث كان جدي وكيلاً مفوضاً بالخزينة العامة. وهكذا انقطعت صلتي بجزء مهم من عائلتي، من جهة الأم أساساً، المتواجدة في منطقة "لاسفوا" (La savoi) و"جنيف" (Geneve). تنضاف إلى وضعيتي يتيمًا وربيبًا للأمة (Pupille de la nation) وضعيتي كشخص انحجب عنه جزء من عائلته. وبسرعة وجدت نفسي أمام الجَدّ والجَدّة فحسب، صحيح أنّه كانت لي عمة غير متزوجة تقوم برعايتنا، إلا أنّها خضعت بدورها لسلطة الجَدَّين التي استمرت حتى وفاة جدتي، وعمري آنذاك لم يتجاوز أربع عشرة سنة.
لا شك أنّ هذه البنية الجنيالوجية كانت مفيدة للغاية ـ لأنّ التربية التي تلقيت أثّرت فيَّ بشكل قوي ـ وفي الآن نفسه، صادمة إلى حد بعيد، بما أنّ الجانب الأمومي قد ظل متواريًا، ولأنّ الشابة التي تكلفت بتربيتي كانت تحت وصاية الجدّين، علاوة على أنّ صورة أبي ـ وهي الصورة البطولية، والأنموذج الأسنى الذي ما لبث أن أصبح موضوع مساءلة كانت غائبة. كنت ألتقي من حين لآخر بأبناء عمومتي، لكن هذه اللقاءات لم تستطع مَلْءَ الفراغ الذي تركته الأم. أعترف أنّي لم أفهم، في العمق، معنى صورة الأم إلا من خلال الكيفية التي كان ينظر بها أبنائي لأمهم. فكلمة "أُم" تعودت سماعها منهم، لكني لم أنطق بها قطّ.
جاء على لسانك ذكر شقيقتك.
بول ريكور: نعم، وهذا جانب عميق جدّاً، ستعمل وفاةٌ أخرى على إيقاظه بعد وقت طويل. أصيبت أختي "أليس" (Alice) بداء السُّل وعمرها سبع عشرة سنة. كانت، وهي المولودة سنة 1911، تكبرني بعامين. توفيت وعمرها واحد وعشرون عاماً، غير أنّ شبابي حجب نوعاً ما شبابها. وهو الأمر الذي وَلَّدَ في نفسي ندماً لازمني طوال حياتي، مع انطباع راسخ بأنّها نالت أَقَلَّ مما تستحق، وبأنّي أخذت أكثر مما أستحق. والحق أنّي ما زلت أقاوم شعوراً بأنّ عليَّ دَيْناً لم أدفعه، وبأنّها تعرضت لظلم كنت أنا المستفيد منه. كان لهذه الأمور تأثيرها البالغ فيَّ، لذا تجد أنّ مفهوم "الدَّين غير المدفوع" هو واحدٌ من الموضوعات التي تتكرر بشكل مُلح في أعمالي.
ما الذي يدفعك إلى القول بأنّ شبابك حجب شبابها؟
بول ريكور: في الجواب على ذلك، أقول إنّي كنت تلميذاً نجيباً، فيما كانت هي تواجه الكثير من المصاعب في دراستها. لقد حظيتُ بتشجيع الجميع، فيما كانت هي تُعامل بنوع من التجاهل واللامبالاة. لطفها وطيبتها جعلاها لا تطالب بشيء لنفسها، وتَقبل بلا غِلٍّ أن أكون أنا من يجني ثمار النجاح.
وماذا عن العَمَّة التي تولت أمر تربيتكما؟
بول ريكور: هي أخت والدي، وتصغره بإحدى عشرة سنة، وقد كانت في ريعان شبابها لمَّا أخذت على عاتقها أمر تربيتنا أنا وأختي. توفيت عام 1968 بعد أن عاشت معنا السنوات العشر الأخيرة من حياتها. على هذا النحو، أكون قد أمضيت طفولتي ومراهقتي الأولى في وسط عائلي متقدم في السِّن، لعبت فيه القراءة دوراً مركزياً، مع قليل من اللعب، وكثير من القراءة، إلى درجة صارت معها الدراسة بالنسبة إليّ استراحةً أكثر منها فضاءً لتعلم الانضباط. كنت قبل الدخول المدرسي، وطيلة عطلة صارمة، ألتهم في وقت قياسي كل الكتب المدرسية، فالذهاب إلى المدرسة شَكَّل لي تسلية، وهو ما جعلني أبدو فيها لاهياً مشتت الذهن.
كيف تَوَلَّد عندك حب القراءة؟ وهل للجَدَّين فَضلٌ في ذلك؟
بول ريكور: لا، لقد اكتشفت القراءة بنفسي، إذ كنت أقضي وقتاً طويلاً في المكتبات. كان بوسعنا في تلك المرحلة أن نمارس القراءة داخل المكتبات، بالرغم من العوائق الني كانت تعترضنا بسبب كون صفحات الكتب غير مقطوعة، لذا كنَّا نقفز على الصفحات ونقرأ بطريقة غير مباشرة.
هل تتذكر الكتب التي تركت أثرها فيك طيلة مراحل بحثك واكتشافك؟
بول ريكور: قرأت كثيراً، في الفترة الممتدة بين عمر الاثنتي عشرة والخمس عشرة سنة، لـ "جول فيرن" (Jules Verne) و"ولتر سكوت"(Walter Scott)، ثم لـ "ديكنز" (Dikens) في الصف الثاني، "رابلي" (Rablais)، "مونتين" (Montaigne)، "باسكال" (Pascal)؛ أما في الصف الأول، وفي قسم الفلسفة، فقد بدأت أهتم بـ "ستاندال" (Stendhal) و"فلوبير" (Flauber) و"تولستوي" (Tolstoï)، وخصوصاً بـ "دوستويفسكي" (Dostoïeveski) الذي كنت دوماً معجباً به إلى درجة الافتتان.
لم تُخف إطلاقاً انتماءك للبروتستانتية. نريد أن نعرف منك هل كان الوسط الذي عشت فيه بمدينة «رين» شديد التدين؟
بول ريكور: ينحدر أجدادي ـ من جهة الأب ـ من مجموعتين بروتستانتيتين صغيرتين ضاربتين بجذورهما في القِدم، بحيث ترجعان إلى زمن الإصلاح، فقد قَدِمَتْ جدتي من "برن" (Béarn)، أما جدِّي فمن "لانورماندي" (La Normandie)، من بلدة اسمها "لونوراي" (Luneray)، وهي عبارة عن منخفض استطاع أن يحافظ على تراث الأجداد ويواصله منذ القرن السادس عشر، ولم يتأثر إلا قليلاً بحركة الهجرة أو بتغيير الدين الذي وقع تحت الإكراه. وَالد جَدّي كان صانعاً يحترف حياكة النسيج ويبيعه في مدينة "دييب" (dieppe). وعندما تعرض قطاع النسيج إلى الإفلاس بسبب دخول النسيج الصناعي، تَحَوَّل قسم من أفراد العائلة إلى عُمَّال كادحين، فيما توجه القسم الآخر إلى الوظيفة العمومية. بدأ جدِّي ـ من جهة الأب ـ مشواره معلمًا بروتستانيًّا، ولمَّا سَلَّمّت الكنائس البروتستانتية مدارسها للدولة، ذهب للعمل تحت إمرة الأمين العام للخزينة.
ومعلوم أنّ هذا التقليد البروتستانتي متجذر في التاريخ، فالتطور، من ناحية جدّي، كان يسير في اتجاه بروتستانتية ليبرالية، أما من ناحية جدتي، فإنّه كان يتجه بالأحرى في خط البروتستانتية التَّقَوية. أميل إلى الاعتقاد هنا بأنّ هناك تأثيراً قوياً لأولئك الذين نسميهم "الداربستيين"[1] (Darbystes)، والمشهورين بتعصبهم الشديد. والحق أنّ الوَسَط "الخورني" (Paroissiale)، الذي نشأت فيه كان من دون شك أكثر انفتاحاً من الوسط العائلي الذي كان يمثل لي على الخصوص الملاذ الآمن.
تربيتك الدينية كانت وراء إقبالك على قراءة التَّوراة.
بول ريكور: أجل لأنّ هذا الوسط كان مشبعاً، إلى حد كبير، بقراءة التوراة. فَجَدَّتي دأبت على قراءتها بانتظام، ومنها وَرِثتُ شغف قراءتها في شبابي كما في المراحل اللاحقة. كنت أبعد ما يكون عن القراءة الحَرفية، إذ كنت أملك تصورًا يجوز لي نعته بـ "الروحاني" (Pneumatologique)، هو تصور يلهم فعلاً الحياة اليومية، وتحظى فيه المزامير وكتب الحِكَم وعِظات الجبل ((Béatitudes بأهمية تفوق المعتقدات. صحيح أنّ هذا الوسط لم يكن مثقفًا، إلا أنّه كان مع ذلك أقل دوغمائية، يشهد على ذلك تفضيله للقراءة الخاصة، وللصلاة، ولمحاسبة النفس. لهذا كنت أتحرك على الدوام بين هذين القطبين: القطب التوراتي والقطب العقلاني النقدي، وهي الثنائية التي ظلت، في النهاية، تلازمني طوال حياتي.
وهل ترى فيها، تلقائيًا، نوعاً من الثنائية القطبية؟
بول ريكور: بكل تأكيد. وهو موقف، على كل حال، ليس أكثر تمزقًا من موقف "ليفناس" (Levinas) الذي ما فتئ يتنقل بين اليهودية ودوستويفسكي.
كنت مهووساً، وأنا أعيش هذا النوع من الانتماء المزدوج، بعدم الوقوع في آفة الخلط بين هاتين الدائرتين، وذلك عبر إقامة حوار مستمر في قلب هذه الثنائية القطبية الراسخة. وقد شكل لي قسم الفلسفة بهذا الصدد امتحاناً كبيراً، خصوصاً وأنّ هذه الفترة عرفت بداية التأثير الذي مارسه "كارل بارث" (Karl Barth)، على البروتستانية الفرنسية، حيث دفعها بقوة نحو عودة جذرية للنص التوراتي، وهي عودة كانت معادية للفلسفة، ينبغي أن نُقِرَّ بذلك. وخلال سنوات الإجازة وجدتني مشغوفًا بـ "برغسون" (Bergson)، خصوصًا كتابه "منبعا الأخلاق والدين" لذا كنت متأرجحاً بين الفلسفة الدينية على الطريقة البرغسونية والنزعة البارثية (نسبة إلى كارل بارث) الجذرية. عشت في هذه المرحلة بالذات صراعاً داخلياً تَفاقَم إلى درجة صار معها يهدد بالقطيعة انتمائي المزدوج الذي بقيت في نهاية المطاف وفياً له.
لنتوقف لحظة مع سنتك الأولى فلسفة بثانوية «رين»:
بول ريكور: قسم الفلسفة واللقاء بـ "رولان دالبييز" Roland Dalbiez))، الذي كان يتولى التدريس به، شكلا الحدثين البارزين في حياتي الدراسية، إذ كانا مصدرين للإبهار، والانفتاح الكبير. قرأت للكلاسيكيين بِنَهم ـ في الأدب، وقرأت كذلك لأولئك الذين نسميهم "الفلاسفة"، أمثال ديدرو وفولتير وروسو ـ وقد تأتّى لي الاحتكاك بهؤلاء أكثر من احتكاكي بـ "كورني" (Corneille) و"راسين" (Racine) و"موليير" (Molière). وقد ترك روسو فِيَّ انطباعاً قوياً، مما جعلني بصورة طبيعية أقف على عتبة قسم الفلسفة.
كان رولان دالبييز شخصية خارقة للعادة، بدأ ضابطاً في البحرية، ولم يكتشف الفلسفة إلا بشكل متأخر عن طريق "جاك مارتان" (Jaques Martin). سكولائي التوجه، محكوم في تدريسه بسيكولوجيا عقلانية وبنزعة واقعية على الصعيد الفلسفي، نَصَّب نفسه عدوّاً للفلسفة "المثالية"، من هنا حرصه على تقديمها بصورة كاريكاتورية، إن لم نقل باثولوجية؛ لم أعد أذكر تماماً هل يتعلق الأمر بذكرى أعدت تشكيلها فيما بعد، لكني أعتقد أنّي مازلت أستحضره وهو يُشَبِّهُ "المثالية" بملقط كبير، ممدود في الهواء، لا يقبض على شيء، وإنّما يرتد على نفسه باستمرار. تظهر "المثالية" عنده في شكل "نزعة لا واقعية" باثولوجية، يُقَرِّبُها من الفصام الذي أصبح في تلك الفترة يحظى باهتمام واسع.
الخاصية الثانية لتدريسه، والتي غنمت منها فوائد جمَّة، هي حرصه الدؤوب على الحجاج، وهذا ما لم يمنعه من إفحامنا حينما يلجأ بسرعة خاطفة إلى استعمال بعض العبارات اللاتينية التي لا تليق إلا بسكولائي كبير مثله، لاتينيتنا نحن لم تكن جيدة بما فيه الكفاية حتى تُوَفّر لنا القدرة على الاعتراض عليه أو حتى لتمنحنا الاستطاعة لفهم ما يقول واستيعابه. كان يلتزم في درسه بالمقرر (الإدراك الذاكرة، العادة...) ويراعي، ضمن منظور يحكمه التدرج، الانتقال من فلسفة الطبيعة إلى فلسفة النفس. غير أنّ ما أنا مدين له به أساساً هو ذلك المبدأ الذي تعلمته منه، عندما لاحظ ترددي بشأن الانخراط في شعبة الفلسفة، بسبب تخوفي من فقدان الكثير من يقينياتي، نصحني يومها قائلاً: يلزمك، حينما يعترضك عائق، أن تواجهه لا أن تلتف عليه، وأن تهزم الخوف الذي يحول بينك وبين مجابهته.
علاوة على ذلك، فقد كان من الأوائل الذين حاولوا القيام بقراءة فلسفية لفرويد[2]، وقد أفدت من ذلك كثيراً في مشواري الفلسفي في ما بعد. كان يقوم بتأويل فرويد على نحو "بيولوجي"، ومن ذلك اشتغاله على إبراز القصور "الواقعي" لـ "اللاشعور"، حتى يتسنى له تخليد "الوهم الديكارتي" للوعي بالذات، ولـ: الاختزال المفترض للعالم في التمثل.
لقد سنحت لي الفرصة مؤخراً لكي أرسم له بورتريه ضمن كُتَيِّب حمل عنوان "الاعتراف بالفضل للمُعلٍّمين"، من إنجاز "مارغيت لينا" (Marguerite léna)، تحدث فيه كل مشارك عن معلِّمه الأول. وكل ما أرجوه هو أن أكون قد وُفِّقْتُ خلال شهادتي في إعطاء رولان دالبييز[3] كل التقدير الذي يستحق.
لا يخفى أنّ «رين» كانت مَعْقلاً للكاثوليكية. فهل كان ينتابك نوع من الشعور بأنّك تنتمي إلى الأقلية؟
بول ريكور: من المؤكد أنّ هذا الشعور قد تملكني بقوة في هذه المرحلة. وقد بلغت حِدَّتُه درجات قصوى عند "سيمون لوجاس (Simon Lejas) "، التي ستصبح في ما بعد زوجتي، ربما يعود ذلك إلى كون الدين الكاثوليكي يترك بصماته بشكل أوضح عند الفتيات أكثر من الذكور. كان المجال الكاثوليكي بالنسبة إليّ عالماً غريباً، لم أتمكن إلا حديثاً من اقتحامه بفضل دعوة وُجِّهت لي لإلقاء محاضرة بمدرسة كاثوليكية خاصة بـ"رين"، ولم يكن يخطر ببالي حينئد أنّي سألج هذا العالم. بالطبع، سأحتك بالكاثوليكية، لكن ذلك لم يتم إلا في مدن أخرى، وبعد ذلك بوقت طويل؛ أما في "رين" فلم يكن ذلك ممكناً البتة، لأنّ البروتستانتيين فيها كانوا يُعتبرون أقلية، إذ يعيشون فيها بدون أيّ علاقات حميمية مع الدائرة الكاثوليكية المهيمنة، قد تكون هذه الوضعية شبيهة بوضع اليهود في الوسط المسيحي. لا أخفيكم أنّي كنت أشعر بأنّ الأغلبية تعتبرني مُهَرطقاً. هذا ما يفسر، بلا أدنى شك، لماذا لم أتأثر كثيراً بالوسط الحضري، فلم أصادف فيه إلا قدراً قليلاً من الحرية، ولم أكن أطمع فيه بنيل اعتراف كامل. ومع ذلك، أستطيع القول إنّي لم أكابد معاناة حقيقية، لأنّي كنت دائم الغطس في بحر الكتب، وهذا العالم الخارجي كان بالأحرى مصدراً للفضول.
هل كان لديك أصدقاء كاثوليكيون؟
بول ريكور: نعم، في الثانوية. معلوم أنّ الثانويات البروتانية [نسبة إلى منطقة "البريتاني" (Bretagne)] ـ التي عرفتها في ما بعد بوصفي أستاذًا دَرَّسَ في ثلاث منها، هي على التوالي: "سان بيريوك" (Saint-Berieuc) و"لوريون" (Lerient) و"رين" ـ التي كان يتردد عليها أبناء المعلمين والأساتذة على وجه الخصوص، لأنّ التعليم الثانوي الكاثوليكي، القوي جدّاً في هذه المنطقة، كان يجتذب نسبة مرتفعة من التلاميذ القادمين من عائلات معارضة للتعليم اللائكي. وحدها العائلات التي حسمت في اختيارها الجمهوري واللائكي ـ الأساتذة في المقام الأول ـ تحمست للدفاع عن التعليم العمومي وإرسال أبنائها إلى الثانويات. بيد أنّ الثانوية هي التي لعبت دور الوسيط بين المجال المغلق الذي ترعرعت فيه والوسط الكاثوليكي، الغريب إلى حد ما، الذي كنت أكتفي بتأمله من الخارج؛ لأنّ العائلات الكاثوليكية لم تكن كلُّها ميسورة لتدخل أبناءها إلى التعليم الخاص، أو لأنّ عداءها للتعليم اللائكي لم يكن من القوة ليقودهم إلى حرمان أبنائهم من المستوى البيداغوجي العالي الذي كانت تتمتع به هذه الثانويات. لذا لا أكشف لكم سرّاً إذا قلت بأنّي كنت أشعر بارتياح في الوسط اللائكي، لم أكن لأظفر به مع الكاثوليكيين، بالرغم من أنّ بعضهم كان بالنسبة إليّ من الرفاق الجيِّدين.
هل كان قرار اختيارك لشعبة الفلسفة سريعاً جدّاً؟
بول ريكور: لا، بل أبديت نوعاً من المقاومة في البداية، إذ حاولت الحصول على الإجازة في الآداب، لكن بما أنّ جميع كتاباتي الإنشائية كانت تُنتقد باعتبارها "مغالية في التفلسف"، فقد غيرت الاتجاه بعد انقضاء نصف السنة الدراسية. كما حاولت أيضاً ولوج المدرسة العليا للأساتذة، غير أنّ دالبييز، في الواقع، لم يقم بتهييئنا لهذا النوع من المباريات، حيث حصلت على نقطة تبعث على الشفقة (20/7) حول موضوع "معرفة النفس أسهل بكثير من معرفة الجسد". لقد كنت المتباري الوحيد الذي لم يكن يعلم أنّ هذه المقولة لديكارت. بالطبع، كان حجاجي مُوجَّهاً إلى التأكيد بأنّ جسدنا هو الذي نعرفه بصورة أفضل. واضح أنّي لم أكن أسير في الطريق الصحيح إلى "شارع أولم" (Rue d’Ulm) [المدرسة العليا للأساتذة]، إنّ وضعي ربيبًا للأمَّة كان يُحتِّم عليَّ أن أنهي دراستي بسرعة ـ وهو أمر مزعج للغاية ـ ولمَّا بلغت من العمر عشرين سنة، وبمجرد حصولي على الإجازة، توجهت إلى التدريس، لهذا لم أستطع التهيؤ بما فيه الكفاية لبلوغ شارع أولم، وكان عليَّ أن أذهب إلى "كاني" (Khâgne) الباريسية [الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى]. كنت متفوقاً في اللغتين اللاتينية والإغريقية، إلا أنّي لم أكن في المستوى المطلوب في الفلسفة ولا في اللغة الفرنسية. هكذا وجدتني، منذ أكتوبر 1933، في ثانوية "سان بيريوك" ـ وهي ثانوية للذكور وأخرى للإناث ـ أنجز ثماني عشرة ساعة من التدريس أسبوعياً، وفي الوقت نفسه أُحَضِّر لنيل دبلوم الدراسات العليا حول "لاشوليي" (Lachelier)و"لانيو"[4] (Lagneau)، تحت إشراف "ليون برانشفيك" (Léon Brunschvicg) في باريس.
حين بدأت التدريس، كان عمر تلامذتك قريباً من عمرك. هل من ذكريات عن هذه المرحلة؟
بول ريكور: كنت أَكْبُرهم بسنتين أو بثلاث سنوات. ويُعد انخراطي المُبَكِّر في سلك التدريس أمراً حاسماً، وظل يشكل ثابتاً؛ ذلك أنّ أعمالي الفلسفية كانت دائماً مرتبطة بالتدريس. لقد كان يتعين عليَّ أن أًحدِّد إطاراً لتفكيري الشخصي ـ الذي كنت أمارسه منذ تلك الفترة ـ يكون متناغماً مع المادة المُدَرَّسة. وبعد الموسم الذي قضيته في "سان بريوك" (1933- 1934)، استفدت من منحة للتبريز، دائماً بوصفي ربيباً للأمَّة وبفضل دعم "جورج دافي"[5] (George Davy). حالفني الحظ، إذن، لأكون طالباً في السوربون لمدة سنة، وسعيد الحظ لأنّي تمكنت، من المحاولة الأولى، من النجاح في المباراة والحصول على الرتبة الثانية، سنة 1935. وتعتبر سنة التبريز بالنسبة إليّ من أكثر السنوات كثافة. كان يغمرني انطباع بأنّه يتعين عليَّ دفعة واحدة أن أردم هوة سحيقة. ولم تمضِ سنة حتى استعدت زمام الأمور وتمكنت من الإحاطة بكل المواد التي فات دالبييز أن يدرسها لي، على الرغم من أنّه زودني بكل ما يلزم لتحصيلها: الرواقية، التي كان "ليون روبان" (Léon Robin) يحرص على جعلنا نقرأ لروادها الذين لم أكن أعرف عنهم أي شيء، ولكن أيضاً ديكارت، وسبينوزا. وقد قرأت علاوة على ذلك كل ما كتبه "غبرييل مارسيل" (Gabriel Marcel).
غابرييل مارسيل؟
بول ريكور: بكل تأكيد، كنت أزوره كل يوم جمعة، وقد استفدت كثيراً من أسلوبه السقراطي. لم يكن يفرض في جلساتنا إلا قاعدة واحدة، وهي عدم الاستشهاد بأي مؤلف، والانطلاق دوماً من الأمثلة والاعتماد على التفكير الذاتي. وفي السنة نفسها، وأنا أقرأ له مقالين، اكتشفت "كارل يسبرز" (Karl Jaspers). وفي الفترة نفسها شرعت في قراءة "أفكار مُوَجِّهة لفينومينولوجيا خالصة" لهوسرل (Husserl)، من خلال ترجمة إنجليزية.
حدِّثنا عن الفترة التي تَلت التبريز؟
بول ريكور: بعدها مباشرة عقدت قراني سنة 1935، على صديقة لي منذ الطفولة تنحدر من الوسط البروتستانتي. ثم توجهت للتدريس بـ "كولمار" (Colmar)، حيث أمضينا السنة الأولى من حياتنا الزوجية.
في السنة التالية، التحقت بالخدمة العسكرية ضمن فيلق المشاة، وأذكر أنّه خلالها كان مزاجي سيئاً وحملت نوعاً من الحقد الدفين تجاه الوسط العسكري؛ أولاً لأنّي كنت متقدماً كثيراً في السن على باقي الجنود، ثم لأنّ هذا الالتحاق شكَّل بالنسبة إليّ قطيعة على مستوى عملي الفكري. وفي إطار هذه التجربة اكتشفت أنّ فرنسا كانت ما تزال بلداً قروياً بصورة واسعة. عدد قليل من المجندين فقط كان حاصلاً على البكالوريا. كانت هذه المرة الأولى التي أحتك فيها بالوسط القروي، ذلك أنّي نشأت في وسط حضري. عانيت كثيراً في الأشهر التي قضيتها في المدرسة بـ "سان سير" (Sain Cyr) حيث كنت ضابطاً احتياطياً، وقد تعرضت لمعاملة سيئة من قِبَل الضباط الذين كانوا يشرفون على التدريب، لأنّي كنت أبدو لهم شديد العناد، وربما هذا ما كنته فعلاً. وفي هذه السنة، مدفوعاً برغبة جامحة في المعارضة، انكببت على قراءة ماركس بغزارة، بالموازاة مع "هنري دومان" (Henri de Man). ثم عدت بعد ذلك إلى منطقة "البريتاني" حيث دَرَّسْتُ في ثانوية "لوريان"، في الفترة الممتدة بين سنة 1937 و1939.
كانت السنة التي أمضيتها في "كولمار" بالنسبة إليّ بالغة الأهمية، لأنّي فهمت سلفاً أنّي سأتوجه صوب الفلسفة الألمانية؛ وهذا هو السبب الذي جعلني علاوة على ذلك أختار هذه المدينة. دأبت برفقة زميل لي في الثانوية على تحصيل دروس في اللغة الألمانية (وهو ما لم يتحقق طيلة مشواري الدراسي). ثم انتقلت إلى الجامعة الصيفية بـ "ميونيخ"، حيث تابعت دروساً مكثفة، انتهت سنة 1939 بإعلان الحرب. مازلت أتذكر الهتافات التي كانت تُحَيِّي توقيع المعاهدة الألمانية ـ السوفياتية، ذهبت في اليوم التالي إلى القنصل الفرنسي الذي قال لنا: "الآن ستقوم الحرب".
ماهي الذكرى التي تحتفظ بها عن الأجواء التي كانت سائدة في ميونيخ؟
بول ريكور: أتذكر جيّداً "الفلدرنهال" (Feldherrnhalle): عملاقان نازيان كانا يتوليان الحراسة، وكنا نسلك طريقاً طويلاً حتى نتجنب أداء التحية الهتلرية التي كانت إلزامية. كنا أنا وزوجتي ضيفين على أسرة كاثوليكية، تقول ربّتها، وهي شديدة العداء للنازية: "إنّ هتلر قد أخذ منا أبناءنا". وقد لاحظت بهذه المناسبة، تحفظات إزاء النازية التي أدانها "بي الحادي عشر" (PieХІ) بوضوح سنة 1937، ضمن رسالته البابوية (Mit Bernnender Sorge). أما بالنسبة إلى الألمانيين من أبناء جيلي، فقد كانوا إما هتلريين متحمسين أو أشخاصاً يفضلون الصمت.
ومما لفت انتباهي آنذاك هو أنّ الطلبة الرومانيين والهنغاريين كانوا جميعاً هتلريين، فالجامعة كانت تستقطب أشخاصاً يتم انتقاؤهم بعناية.
لم يكن ثمة أحد في فرنسا يعد أنّه من اللازم تجنب متابعة الدراسة في ألمانيا. إذ إنّ الحائزين على الرتب الأولى في التبريز ظلوا يقصدون برلين إلى غاية 1939.
هل كنت تتابع الأحداث في بداية الثلاثينات؟ وهل كان محيطك يخوض كثيراً فيها؟
بول ريكور: نعم، وهذا ما يتجلى في انخراطي السريع في حركة الشبيبة الاشتراكية. كنت مناضلاً متحمساً إبّان وجودي في "سان بريوك"، وفي "لوريون" بعد ذلك بوقت متأخر، وفي "كولمار" أتذكر أنّي شاركت في مواكب الجبهة الشعبية، في 14 يوليوز 1936. كنت أساند بعمق القضية الاشتراكية، تحت تأثير رجل لعب دوراً معيناً بعد الحرب، وهو "أندري فليب" (André Philip). وقد كان بروتستانتيا متأثراً بالنزعة البارثية عمل على الجمع بين البروتستانتية والاشتراكية دون أن يقع في آفة الخلط التي كان يسقط فيها الاشتراكيون المسيحيون الذين يعلنون بأنّ الاشتراكية قد ظهرت مكتملة في المسيحية. وهو الخلط الذي لم أقع فيه أبداً بفضل "أندري فليب" على الخصوص. أضطلع هنا بانتماء مزدوج يتجسد في توجهين متمفصلين بما يكفي من المرونة. نجد في الإنجيل بعض التعاليم الخاصة التي تهدي وتُرَشِّد العمل ـ كل الواجبات التي تحيل على الاحترام الخاص الواجب علينا نحو الفقراء بالتحديد ـ لكن لا بد لأجل توطيد عقلاني للالتزام الاشتراكي من حجاج اقتصادي ـ ماركسي أو غيره ـ من طراز آخر غير الوثبة الأخلاقية وحدها، والتي لا يمكن أن يستنتج مباشرة من حب القريب. وعلى هذا لم يكن هناك أبداً، من وجهة نظري، أي خلط بين هذين السِجِلين.
كيف تم لقاؤك بـ "أندري فليب"؟
بول ريكور: كان يشغل منصب أستاذ في كلية الحقوق بـ "ليون" عندما كنت في "سان بريوك"، التقيت به في إطار الحركات الطلابية البروتستانتية، حينما كان يتردد على المؤتمرات الاشتراكية ليقدم عِظاته يوم الأحد في المدن التي كانت تحتضن هذه المؤتمرات، وهذه طريقته في مجابهة النزعة المعادية للإكليروسية التي انتشرت داخل الحزب الاشتراكي في تلك المرحلة. وهي نزعة موسومة بالتبسيطية.
إذن، أنت أيضاً عملت على خلق امتداد لتربيتك البروتستانتية الدينية واندماجك في حركات الشباب عبر اندماجك في الحركات الطلابية.
بول ريكور: نعم، لقد كنت في هذه الفترة شديد الاطلاع على ماركس، وكثير التردد على الاشتراكيين الفوضويين، وقد جعلني "أندري فليب" أقرأ "هنري دومان". كان "فليب" يدعو إلى اشتراكية إنسانية، وذلك قبل أن تترجم أعمال ماركس الشاب خاصة مخطوطات 1844. غير أنّ هناك حدثين آخرين لعبا بالنسبة إليّ دوراً حاسماً بالرغم من دورانهما في فلك السياسة؛ أما الأول فالحكم بالإعدام على "ساكو" (Sacco) و"فانزيتي" *(Vanzetti) في الولايات المتحدة سنة 1927 فقد أغاظني كثيراً، والثاني قضيةً "سزنيك" **(Seznek)، لقد شعرت بنوع من التحول جعلني شديد الحساسية إزاء بعض أنواع الظلم التي اعتقدت فيما بعد أنّها كانت أعراضاً لظواهر أكثر عمومية. هذا النوع من الغضب هو ما تم تخليقه والارتقاء به إلى مستوى الفكر بفضل المذهب، المتمثل في اشتراكية متوافقة مع رؤية أخلاقية للعالم. كنت مع أصدقائي وعائلة زوجتي أصحاب نزعة نقابية ـ فوضوية: فأحد أعمام سيمون، وهو خبير طباعة جيد في "وست إكلير" (Ouest-Eclair)، كان ينتمي إلى هذا الوسط المهتم كثيراً بـ "الكتاب"، والذي كانت إيديولوجيته توافقني تماماً. فهو أقرب إلى التقليد الفوضوي منه إلى الماركسية التي من جهتي لم أشعر أبداً بأي نوع من الارتياح الفكري إزاءها.
هل كنت تشارك في الاجتماعات؟
بول ريكور: كنت أكتفي بتأملاتي الشخصية وقراءاتي المتنوعة، لأنّي لا أعتقد أنّه كانت توجد في "رين" حركة منظمة. ولم أتعرف فعلياً على الهيئات المحلية للحزب الإشتراكي إلا في "سان بريوك"، و"كولمار"، و"لوريون"، وبالخصوص في "لوريون" في الفترة الممتدة بين 1937 و1939، مباشرة بعد الجبهة الشعبية. وكلما أعدت التفكير في ما مضى، أفهم بصورة أفضل كيف كان الحزب الاشتراكي لتلك الفترة لا يرتكز على أسس قوية على مستوى الممارسة والمذهب. ولقد وجد نفسه إذن أمام فرصتين للاختيار، وكانتا بمثابة إنذار، وهما حرب إسبانيا وميونيخ: وفي كل مرة تلتبس عليه الأمور، لأنّه كان من اللازم اللجوء إلى القوة أو ترجيح استعمالها؛ وعلى هذا النحو، وجد نفسه مضطرّاً إلى التوافق مع عمقه ذي النزعة المعادية للحروب. فهو لم يفلح، إلى غاية اندلاع الحرب، في التخلص من هذه المعضلة. فكل اختياراته كانت مهزوزة، إذ كانت الأغلبية تتأرجح من اتجاه إلى آخر ـ وقد جَسَّدَ "بلوم" (Blum) أنموذجاً لهذا التأرجح، حيث كان موزعاً بين نوع من الرغبة في التدخل لإنقاذ مَن هم في خطر ـ ضمن منظور تضامني دولي ـ ونزعة عميقة معادية للحروب، تَعد الاختيار العسكري عدوها اللَّدود. وقد أعادت الحربُ الحزبَ الاشتراكي إلى الوضعية نفسها لمَّا صوتت الأغلبية سنة 1940، لصالح "بيتان"*** (Pétain).
كيف تفاعلت مع حرب إسبانيا؟
بول ريكور: كنت متردداً بين هذين التوجهين، والاختيار كان يأتي بمحض المصادفة، لأنّه لم تكن هناك أيّ حصيلة تنجم عن هاتين القوتين، اللهم إلا ما كان ظرفياً: فتصويت الرفاق خلال الاجتماعات كان يوزع بطريقة عشوائية. وقد حُسم الموقف لصالح عدم التدخل ضمن خط التراجعات المتكررة أمام هتلر؛ غير أنّنا لم نكن ندركه بهذه الكيفية. أستطيع القول بأنّ الإبهار السلبي الذي كانت تثيره جمعيات "صليب النار" (Croix-de-feux)، بقيادة "لاروك" (La roque) الذي انتهى به المطاف إلى معسكرات الاعتقال)، أدى إلى حجب أفقها العالمي. من المؤكد أنّه يتعين ألا نُسقط على الماضي ما لم يحدث إلا فيما بعد، كما لو أنّ الناس في تلك المرحلة كانوا يجدون أمامهم بدائل يعرفون نتائجها سلفاً. ومن الضروري أن نعترف بأنّ بعض القرارات كانت تُتخذ في أجواء يُخيم عليها الغموض.
وبهذا الصدد، يعتبر المؤرخ الإسرائيلي "زيف سترنهيل"[6] (Zeev sternhell)، الذي تعرفت عليه حديثاً، مثالاً غاية في الدلالة: نجد في كتاباته رؤية لهذه الحقبة من التاريخ تتسم ضمنياً بالغائية، وتفضي إلى تشويه المنظورات. فلا مشاحة في الوقائع التي يستشهد بها، لكننا لا يمكن أن نقول الشيء ذاته عن الإضاءة الغائية التي يقترحها. فهي تتحدث عن فرنسا كما لو أنّها لم تعرف إلا تاريخين: الأنوار من جهة، والوطنية الفاشية من جهة ثانية. والحال أنّ بعضهم انتمى إليهما معاً، في فترات تشابكت فيها الطرق واختلطت فيها الرؤى. أعتقد بأنّه، أكثر من غيره، وقع في آفة الانتقاص من ذلك الغليان الهائل الذي مَيّز سنوات ما قبل الحرب، حيث نجد على سبيل المثال كثيراً من الناس الذين أصبحوا فاشيين، قد خالطوا وعاشروا كثيراً ممن سيتحولون إلى "ديغوليين" (Gaulliste). لقد كانت تلك وضعية للتجريب على جميع الأصعدة تَمَّ فيها كشف وفضح لضعف مؤسسات الجمهورية الثالثة. لامراء أنّ مغالاتنا في توجيه النقد لها قد أدى في الوقت نفسه إلى إصابتها بالهشاشة، هذا على الأقل ما أفهمه الآن حين أعيد التفكير في ما حدث، فَمَواطن الضعف التي كنا نعيبها على الجمهورية كانت نتيجة للأعمال التي كنا نقوم بها ضدها.
ألا ترى، مع الفارق طبعاً، بأنّ هذا ما حدث تقريباً بالنسبة إلى ألمانيا مع جمهورية "فيمار" (Weimar)؟
بول ريكور: قطعاً، وهذا نوعاً ما، ما سيحدث مجدداً للجمهورية الرابعة. غير أنّنا فيما أعتقد كُنَّا قاسين جدّاً عليها، لأنّ حكومات الوسط المتعاقبة، وهي ضعيفة بالفعل، وجدت نفسها باستمرار قد أخذت مواربة بين الديغوليين والشيوعيين.
متى حصل عندك الوعي بحقيقة ما يجري في الاتحاد السوفياتي إبان حكم ستالين؟
بول ريكور: شكلت قضية "كرفشنكو" (Kravchenko)، عام 1949 مناسبة لتحول حاسم. فقد رفعت مجلة (Les lettres Françaises)، التي كان يرأسها "أراغوان" (Aragon) دعوى على أحد المنشقين عقب إصداره كتاباً بعنوان: اخترت الحرية، نُعت من قِبَل الشيوعيين بأنّه مُدَلِّس وعميل لـ "السِّي آي إيه" (CIA). فقبل الحرب، لم تستطع حتى المحاكمات الشهيرة في موسكو خدش الصورة الإيجابية التي رسمناها في أذهاننا عن الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين.
لكن الانتماء إلى الحزب الاشتراكي، فيما يخصني، كان يعني الدخول في مناقشة مع الشيوعيين، ويسمح بعدم الاستسلام لحماسة كثير من المثقفين تجاه "حزب العمل". أن تكون داخل "المنزل القديم"، كما كان يحلو لنا القول في تلك الفترة، معناه أنّنا في الجهة الأخرى. وهو ما كان يعطينا مناعة ضد السحر أو الإبهار الشيوعي. لقد كنت إذن، سواء قبل الحرب أو بعدها، بمنأى عن الوقوع في فتنته وإغوائه.
ما يثير انتباهي الآن هو الهشاشة التي كانت تطبع اتخاذ المواقف، حتى على مستوى السياسة الداخلية، فاختزال مجموع السياسة الاقتصادية، عبر تيمة "مئتي أسرة"، وشعار "جدار المال"، كان أمراً تبسيطياً للغاية. أذكر أنّي شاركت في بعض حانات "كولمار"، في 1935-1936، في بعض الاجتماعات حول موضوع تأميم بنك فرنسا: كنا نتوفر على لائحة صغيرة تضم الحجج التي كان يزودنا بها "المنزل القديم"، لكي يبرهن أنّ البلد لا يكون سيداً على اقتصاده إلا إذا بسط سيادته على عملته، ومن هنا لا بد من تأميم بنك فرنسا. لم نلمح قط الطابع "اليعقوبي" (Jacobin) لهذا الحجاج، ولا ما يفضي إليه بالضرورة من تركيزٍ للسلطات مضاد للرؤية الفوضوية، أو قل للرؤية الفوضوية ـ النقابية التي كانت قوية جداً في تلك الفترة. أعتقد أنّ الخلاف الذي ساد داخل الـ *(SFIO) بين التوجه الفوضوي والتوجه اليعقوبي كان يِؤدي إلى جعل الأغلبية تظهر في هذا الجانب أو ذاك، سواء تعلق الأمر بالسياسة الخارجية أو بالسياسة الداخلية. والواقع أنّ الـ (SFIO) نفسها هي حصيلة انصهار التوجه الفوضوي ـ النقابي والتوجه التجميعي المرتبط بالدولة. إنّ هذا العمق الفوضوي ـ النقابي هو الذي صاننا من الانبهار بالاتحاد السوفيتي، لكنّه أيضاً أفرز ثماراً مسمومة، في السياسة الخارجية على الخصوص، بحيث ساهم في تجريدنا من أسلحتنا أمام العدو الحقيقي: هتلر، الذي كان يمتح هو الآخر من هذا المعين الفوضوي ـ النقابي، فما كان سبباً في تجريدنا من أسلحتنا أمام هتلر هو نفسه الذي حمانا من ستالين.
بوسعنا القول، على وجه الإجمال، إنّ انتماءك السياسي في فترة ما قبل الحرب هو الذي حال بينك وبين الرؤية الواضحة للخطر القادم من ألمانيا؟
بول ريكور: إنّ الخطأ الذي وقع فيه كثير من أمثالي، تجسد أولاً في أنّنا لم نلمح قدوم الحرب، ثم لأنّنا، بعد علمنا باندلاعها، نظرنا إليها انطلاقاً من مقولات الحرب العالمية الأولى. فقد سبق لنا بسبب معاهدة فرساي إدانة أسباب الانخراط وطنياً في الحرب الأولى؛ فتقديم الثانية بوصفها صراعاً بين الأمم على أساس وطني كان يؤدي إلى الرفض نفسه. أعتقد اليوم بأنّ هذا التعميم كان خادعاً، على اعتبار أنّ الصراع الثاني نَجَم عن اتحاد مختلف تماماً. بيد أنّي مازلت أرى بأنّ الحرب العالمية الأولى تعتبر خطأً جسيماً وجرماً فظيعاً، فقد أدت بورجوازياتٌ متشابهة في الواقع إلى إفساد طبقاتها العاملة، وتحطيم الأممية الثالثة.
يتعين أن نعود دوماً إلى هذه النقطة، لأنّ الشعور بأنّ معاهدة فرساي كانت ظالمة هو الذي جعل النزعة السلمية عند اليسار تجد كامل تبريرها وغطائها. والحجة المقدمة هنا، هي أنّ هتلر لم يفعل شيئاً أكثر من استرداد حقوقه. مازلت أتذكر عنوان افتتاحية *(Grapouillot) أثناء احتلال الضفة اليسرى لـ "الراين" (Rhin): "ألمانيا تغزو ألمانيا". في الواقع، كان ينبغي أن نترك لهتلر ما كان من حق الألمان استعادته. ومع ذلك نبَّهني "أندري فليب" إلى خطورة ذلك، وهو الذي لم يوافق على هذا الاختيار. فقد كان معادياً لميونيخ بشكل واضح، بينما كنت أنا في حيرة من أمري. فقد كان لدي من جهة، شعور بأنّ "تشيكوسلوفاكيا" تتعرض لظلم كبير، بل إنّها ضحية لجريمة ترتكب ضدها، غير أنّي من جهة أخرى كنت أرى أنّ منطقة "السوديت" (Sudète) كانت بالرغم من كل شيء جزءاً لا يتجزأ من التراب الألماني. وقد فاجأني تماماً الاعتداء الذي تعرضت له بولونيا في شتنبر 1939.
هذا ما نعاينه في كل كتابات "باتوكا" (Patôcka): فهو ما فتئ يردد أنّ الحرب العالمية الأولى هي التي تشكل حقيقة الانعراج؛ فالحرب الأولى تمثل "انتحاراً لأوروبا". لم نكن نفهم أنّ الحرب الثانية ترتبط بإشكالية مختلفة، وأنّها نتاج صعود قوي للأنظمة الشمولية. إلا أنّه كان بوسعنا على الأقل أن نملك وضوح الرؤية لنفهم أنّنا تحولنا إلى حلفاء نظام شمولي ضد آخر.
هل كانت نزعتك السِّلمية تتغذى أيضاً من قراءتك لـ "ألان"؟ وهل كان يجسد شخصية هامة بالنسبة إليك؟
بول ريكور: لا، ليس تماماً. التقيته فقط بمناسبة مناقشة أطروحتي حول "لانيو"، لأنّه هو من نشر السلسة الأولى لـ "الدروس الشهيرة")(Célèbres leçons. ولم أقرأ كتابه خواطر إلا حينما كنت رهن الاعتقال برفقة صديقي الجديد "ميكل دوفرين" الذي كان واحداً من تلامذته.
وماهو الانطباع الذي تركه لديك؟
بول ريكور: انطباع قوي جدّاً، لكن ذلك حصل أيضاً بسبب توفر شخصيته على عناصر فوضوية بارزة، خصوصاً تلك التي تتجلى في معارضته للسلطات.
عدت من ميونيخ سنة 1939 عندما تم الإعلان عن الحرب. وعلى الفور إذن تم تجنيدك.
بول ريكور: جرى تعييني ابتداءً من 1939، في فيلق "بريتاني بسَان مالو" (Breton-de-saint-(malo؛ التقيت فيه بأناس مميزين. عايشت انهيار 1940 بإحساس شخصي عميق بالذنب. أحتفظ في ذاكرتي بصور لا تُحتمل لجيوش الشمال وهي تلوذ بالفرار؛ وما زلت أرى تلك الصورة النمطية لجندي بقبعة مستديرة على رأسه، وهو يدفع سيارة أطفال مملوءة بزجاجات الخمر. لم أستطع منع نفسي من القول: "هذا ما صنعته يداي، وقاد إليه خطئي السياسي وفتوري وسلبيتي، لأنّي لم أفهم أنّه لمواجهة الهتلرية ما كان ينبغي أن نُجَرِّد فرنسا من أسلحتها". هذا اللّوم للذات لم يفارقني قط، وهو الذي سيدفعني إلى الاحتراز دائماً من أحكامي السياسية. وبالرغم من أنّي ما زلت أحتفظ بنوع من الوفاء للاشتراكية، ولا أرفض بعض فرضياتها، فإنّي أعتقد بأنّ مواقفي السياسية في تلك الفترة كانت خاطئة، بل آثمة.
وفي سنة 1940 كنت ضمن وحدة عسكرية قاتلت بشراسة، وحاولت عبر مقاومتها أن توقف تقهقر الجيش المدحور. هذا بصرف النظر عن كونها وحدة صغيرة ومعزولة تماماً؛ وإلى الآن أذكر ما قاله لي قائدي في الجيش: "ريكور، توجه إلى الغرب وإلى الشرق لربط الاتصال". وبعد أن قطعت أربعة أو خمسة كيلومترات لم أجد أحداً على الجهتين. كُنّا في جَيْب، وحاولنا منع الألمان من العبور. ومن خلالي حظيت خليتنا بتنويه عسكري لقاء صمودنا. لكنّنا وقعنا في الأَسر، حين كان الأمر يتعلق بالاختيار بين الموت أو الاستسلام: وقد اخترت الحل الثاني. أتذكر جيّداً أنّه بعد مضي ثلاثة أيام قضيناها تحت قصف مكثف بـ "الشتوكا"* (Stukas) بدون عتاد ولا طيران مسحوقين، سمعنا في الساعة الثالثة مكبرات الصوت الألمانية تقول باللغة الفرنسية: "سنقوم بالهجوم في الساعة السادسة، وستموتون جميعاً"؛ قررت، مع المرشد، أن نوقظ هؤلاء الجنود المساكين المرابطين في الخنادق، وعددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين، لنعلن استسلامنا، مع نوع من الشعور بالذنب يبدو أنّ اختياري السياسي السابق هو الذي قاد إلى هذه الكارثة، وأنا نفسي أؤكده بهذا الاستسلام.
قضيت خمس سنوات في الأَسر بمنطقة "البوميراني" (Pomeranie). احتُجزت في معسكر يضم الأسرى من الضباط. ولا بد أن أُقِرَّ بأنّني إلى حدود 1941 كنت بمعية آخرين أبدي إعجاباً كبيراً ـ والدعاية كانت مكثفة ـ ببعض وجوه النزعة "البيتانية" **(Pétanisme). ربما أكون قد وجهت ضد الجمهورية الإحساس بأنّي ساهمت في ضعفها، إحساس بأنّه من الضروري إعادة بناء فرنسا قوية. كان هذا هو واقع الحال طالما لم نتلق أيّ معلومات، وما دامت أخبار "البي بي سي" (BBC) لم تصلنا، ولم تُتَح لنا فرصة الاستماع إليها إلا في شتاء 1941-1942، بفضل بعض الديغوليين في المعسكر. كان أحد الرفاق هو الذي يتولى نقل نشرة "البي بي سي" الصباحية، حالما يتوصل بها عبر شخص آخر كنا نجهل هويته. ثم حَلَقنا اللِّحى وارتدينا أحسن ملابسنا، مما دفع الجنود الألمان إلى التساؤل عن الحدث الذي جعلنا نغيِّر عادتنا، فأعلمناهم بانتصار الروس في ستالينغراد. في هذه اللحظة، أصبحت المعسكرات برمتها تحت سيطرة الشيوعيين والديغوليين. لكنّي نادم بسبب خطئي في الحكم، خلال السنة الأولى.
وأنتم هناك، ماذا كنتم تعرفون عما يجري في فرنسا؟
بول ريكور: كنا نعلم بوجود حكومة شرعية، وبأنّ ثمة سفيرًا بـ "فيشي" (Vichy) ـ كنا نراقب ذلك عن كثب ـ وأنّه يجري تفعيل التربية الوطنية عبر اللجوء إلى قيم الرجولة والخدمة والوفاء. وقد شعرنا بالقلق، ليس إزاء انتشار الوهن على مستوى الروح العامة فحسب، وإنّما تجاه إرادة الإصلاح انطلاقاً من قيم تكاد تكون فيودالية كذلك. كانت تلك ببساطة المبادئ التي تحكم مدرسة "أورياج"[7](école d’uriage). ولما اكتشفت بعد الحرب ما حصل فيها، تبينت أنّنا كنّا نطبقها بصورة تلقائية في المعسكرات. وقد تَعَرَّضَت مدرسة "أورياج" للنقد من قِبَل أشخاص مثل "سترنهيل"، بدعوى أنّ أيديولوجية مدرسة الأطر هذه كانت فاشية؛ والحال أنّ الروح العامة السائدة كانت على النقيض تماماً مما آلت إليه الأمور في فترة التعاون مع العدو. لقد تعلق الأمر بإعادة إصلاح فرنسا، وتصورنا حينها أنّ ذلك يتم من خلال تصورات "فيشي" التي كان يعرضها علينا مندوبو الحكومة.
فالكرّاسات التي كانت توزع علينا تتمحور حول هذه الفكرة: فرنسا تشكو من الضعف، ويجب إعادة بناء فرنسا قوية بمساعدة ألمانيا. ومع ذلك، أعتقد بأنّه لا أحد منا قَبِل التنازل والتعاون مع العدو. فالفكرة التي كانت توجهنا تتطلب إصلاحاً من الداخل، يتناغم مع حركات الشباب، ويسير على نهج كشافة ما قبل الحرب، وهذا ما آمنا به طيلة السنة الأولى حيث كنا معزولين عن العالم.
ومن داخل مركز الاعتقال، تجلت مساهمتنا الإيجابية في هذا الإصلاح في خلق سريع لحياة ثقافية، وذلك حتى لا تكون معاناتنا أكبر بسبب الهزيمة. فبصحبة "ميكيل دوفرين"، "روجيه إيكور" (Roger Ikor)، و"بول-أندري لوسور" (Paul-André Lesort)، ومثلما أقام آخرون مسرحاً، أعدنا نحن بناء حياة ثقافية مؤسسية ـ وهي ظاهرة شديدة الغرابة بلا شك خاصة بالاعتقال، تسعى إلى خلق سيمولاكر مجتمع حر في قلب مركز الاعتقال؛ وقد كنا نتوفر حتى على سوق بالجوار: إذ نجح طلبة وأساتذة الاقتصاد في تشغيل بورصة تضم أسعار السوق؛ الأثمان فيها محسوبة على قاعدة وحدة حساب غير مرتبطة بالذهب، وإنّما بالسجائر الأمريكية أو الروسية.
حاولنا في البداية تجميع كل الكتب الموجودة في معسكر الاعتقال. ثم قمنا بإنشاء ما يشبه جامعة تعمل وفق مقررات، ودروس، واستعمالات للزمن، وعمليات للتسجيل، وامتحانات تجري في أوقات معلومة. وطفقنا نتعلم كل اللغات الممكنة: الروسية، الصينية، العبرية، العربية...إلخ فخمس سنوات مدة طويلة، أليس كذلك؟
هل لك أن تخبرنا عن الكيفية التي كانت تدخل بها الكتب إلى المعسكر؟
بول ريكور: هناك الكتب التي حُملت في أكياس. وقد كان معي منها كتابان: قصائد "فاليري" (Valery)، والقصائد الغنائية الكبرى الخمس لـ "كلوديل" (Claudel)، وهما اللذان أغنيا فكري خلال السنة الأولى من اعتقالي، وإليهما يرجع الفضل في لقائي بـ"ميكيل دوفرين"، الذي ألقى محاضرة حول هذين المُؤلِّفين، الذي يعد تقديمهما مجتمعين فعلاً نادراً. ولمَّا كان عددنا داخل المعسكر يتراوح بين ثلاث آلاف وأربعة آلاف معتقل، فقد استطعنا بسرعة تنظيم مكتبة حقيقية، تتيح عملية الاستعارة بكيفية تمنع احتكار الكتب وتُيَسِّر عملية تداولها. المصدر الثاني للكتب، هو عائلاتنا والصليب الأحمر ـ وبفضل هذا الأخير تمكنتُ من قراءة "هوسرل" (Husserl) و"يسبرز". أما المصدر الثالث فقد كان سِرِّياً، إذ قام بعض قادة المعسكر المتسامحين باستعارة الكتب من المكتبة الجامعية. وهكذا تأتى لي قراءة العديد من الكتب المستقدمة من مكتبة "كريفسڤالد" (Greifswald) (الآن في بولندا) حصلت عليها مقابل بعض السجائر، وهي صفقة مربحة لي لأنّي لم أكن من المدخنين.
نجحت في إنقاذ نسختي من كتاب (Ideen I) في ظروف عجيبة. فمع نهاية فترة الاعتقال، وطيلة شتاء 1945-1944، نُقِل معسكر اعتقالنا إلى جهة الغرب، فقطعنا المسافة مشياً على الأقدام ــ وكانت مسيرة شاقة، لأنّ تغذيتنا لم تكن بالكافية (بالطبع لم نكن في حالة انهيار تام) كما أنّ قساوة البرد زادتنا إنهاكاً. كنا نَجُرُّ زلاّجاتنا الخشبية على الجليد، وهي تحوي أكياساً وضعنا فيها كتبنا التي عملنا جاهدين على إنقاذها. وفي نهاية اليوم الثالث من المسير بدأ الجليد في الذوبان. أضعنا كل شيء، لأنّنا لم نعد قادرين على حمل ما وُفقنا تقريباً في جرّه. كنت أقول مع بعض الأصدقاء، ومنهم "دوفرين"، و"إيكور" و"لوسور"، بأنّنا لن نستطيع الذهاب بعيداً. أردنا أن ننقذ بعض الأشياء، أوراقنا على الخصوص؛ من جهتي، كنت قد شرعت في كتابة أطروحتي المقبلة حول الإرادة. سِرنا قُدماً نحو الشرق آملين أن يتم تحريرنا من طرف الروس، فوجدنا أنفسنا داخل ضيعة بولندية تعرضنا فيها لقصف دورية روسية اختلط عليها الأمر، وحسبتنا من الأعداء. لسوء الحظ لم نكن نتوفر على بطاقات تثبت هويتنا، كما أنّنا كنا نجهل تماماً المكان الذي نحن فيه؛ والواقع أنّنا ضللنا الطريق المؤدي إلى الروس، فانحشرنا في مسافة فاصلة بين رتلين من الجنود، فوجئنا أثناءها بظهورعناصر من (*(SSجاءت لتقوم بعملية تمشيطية، فلمّا لاحظوا وجودنا، أرادو رمينا بالرصاص، إلا أنّنا نجحنا، بفضل إتقاننا للغة الألمانية، في إقناع أحد قادتها بالعدول عن قراره، فأرسلنا إلى سجن بـ "شتتن" **(Stettin)، حيث عكفت، لبضعة أسابيع، على مواصلة ترجمتي لكتاب هوسرل. ثم نُقلنا على متن قطار إلى الغرب، وهكذا قطعنا المسافة ذاتها، التي مشاها الآخرون على الأقدام، داخل عربة قطار. وصلنا نواحي "هانوفرر" (Hanovre) في يناير 1945. لم يكن مركز الاعتقال الجديد هذا صالحاً لاستقبال أعداد كبيرة من السجناء المُتكَوِّم بعضهم فوق بعض، واختفى الحراس شيئاً فشيئاً، مُرْتَدِين بِدَل السجناء، أو لجأوا إلى الاختباء خوفاً من الوقوع في الأسر لدى الروس. وفي أحد الأيام الجميلة، لم يعد هناك أثر للحراس فعدنا للقيام بمسيرتنا صوب الغرب، ووقعنا هذه المرة بين أيدي الكنديين. وهكذا حصلنا على "حريتنا".
وبعد عودتي إلى باريس، كان أول شخص قمت بزيارته هو "غبرييل مارسيل"، الذي استقبلني بحرارة كما لو كنت أحد أبنائه. ثم رأيت "أندري فليب" مجدداً، وقد كان عضواً في الحكومة، وهو الذي أرسلني إلى منطقة شامبو سور لاينو (Chambon-sur-Lignon)، التي كنت لا أعلم بوجودها ـ وهي ثانوية بروتستانتية قامت بحماية عدد من الأطفال اليهود، وقد حظيت إثر ذلك بتكريم إسرائيلي. وبهذا أجد نفسي مجدداً في وسط ذي نزعة سِلمية مناضلة، تضم مقاومين ينبذون العنف، اشتهروا بلعب دَور مُهَرّب للأجانب واليهود الفارِّين من النازية. استقبلتني هذه الثانوية التي كانت حلقة أساسية في هذا التنظيم المقاوم بصدر رحب، وفيها أتيحت لي فرصة الالتقاء، منذ الشتاء الأول، بـ"الكويكيرز" *(Quakers) الأمريكيين، وهم أيضاً من المقاومين الرافضين للعنف، جاؤوا للمساهمة في بناء ثانوية أكثر سعة. وعن طريقهم، ذهبت ـ بعد سنوات من ذلك ـ سنة 1954، إلى الولايات المتحدة بدعوة كريمة من ثانوية "الكويكرز" في الجهة الشرقية من الولايات المتحدة.
متى علمتم بوجود معسكرات الموت؟
بول ريكور: لقد كنا شهوداً على التعذيب الذي تعرض له السجناء الروس على مقربة من معسكرنا في "بوميراني". غير أنّنا لم نكتشف هول معسكرات الترحيل والإبادة وبشاعتها إلا في اليوم الذي أطلق فيه سراحنا، لأنّنا كنا بجوار معسكر الاعتقال النازي الألماني "برجن- بيلسن" (Bergen-Belsen). قرر الإنجليز إفراغ القرية على سبيل الانتقام، فسألنا هؤلاء الألمان الذين زعموا عدم معرفتهم بما كان يقع في المعسكر الذي يبعد عنا سبعة كيلومترات. عاينت خروج الناجين تائهين مرعوبين، أغلبهم مات مباشرة بعد قيامه بخطواته الأولى، أو أكله المرَبَّى أو أي شيء آخر. كان هذا مرعباً. فجأة تَولّد لدينا الإحساس بأنّنا نجونا بأعجوبة من الموت. ويعتبر الرفاق اليهود، بحق، الأكثر إحساساً بهذا الفرق العميق، لأنّ الجيش الألماني نجح دوماً في ترجيح كفته، ضد قوات الـ (SS)، في بسط مسؤوليته على المعسكرات التي تضم أسرى الحرب. فهذه المعسكرات لم تدخل أبداً تحت سيطرة قوات الـ (SS)، ولهذا كان "إيكور" و"ليفناس" بمنأى عن أيّ مضايقات قد تهدد حياتهم. أعلم بأنّ عدداً من اليهود تم تجميعهم في معسكر مستقل، أحياناً مع مساجين عُرفوا بالتخريب؛ إلا أنّي لم أقرأ أنّ هؤلاء الأسرى اليهود المُرَحَّلين تعرضوا لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة.
أما أنا فقد أَفْلَت من مراكمة ذكريات الأَسر عبر العمل الفكري. أغلقت خلفي باب المعسكر بمجرد مغادرتي له، مصطحباً معي من سيصبحون أصدقائي إلى آخر حياتهم، بالنسبة إلى من فارق منهم الحياة. بعض أصدقائي أرادوا زيارة أماكن اعتقالنا؛ من ناحيتي لم أُبْدِ أيّ رغبة للعودة إلى هذه "البوميراني" التي صَارت الآن تحت السيادة البولندية.
خلال فترة اعتقالك، قرأت كثيراً للكُتّاب الألمان على وجه الخصوص. وهكذا سَتَرْتسِمُ معالم واحد من خطوط القوة في فكرك: أقصد معرفتك العميقة بمفكري «ما وراء الراين» (Outre-Rhin). ألم يكن لهذه القراءات التي تمت داخل «الأوفلاغ» **(Oflag) نوع من الوظيفة العلاجية؟
بول ريكور: لقد كان حاسماً بالنسبة إليّ أن أقرأ هناك "غوته" (Goethe)، و"شلير" (Schiller)، وأقوم، خلال تلك السنوات الخمس، بتطواف على الأعمال الكبيرة في الأدب الألماني. فاوست الأول والثاني، من ضمن أعمال أخرى، ساعدتني على الاحتفاظ بصورة معينة عن الألمان وألمانيا ـ فالحراس في النهاية لم يكونوا موجودين، فكنت أحيا بين الكتب، تقريباً كما كان الشأن في طفولتي. فألمانيا الحقيقية هي ألمانيا "هوسرل"، و"يسبرز". هذا ما أتاح لي، حين كنت مُدرّساً بـ "ستراسبورغ"، أن أقدم كثيراً من العون لطلبتي، الذين كان معظمهم جنوداً في الجيش الألماني، فيأتون بشكل متأخر إلى الدراسة، معتقدين أنّ التحدث باللغة الألمانية ممنوع، فكنت أقول لهم: استحضروا في أذهانكم أنّكم بصحبة "غوته"، "شلير"، "هوسرل"...الخ
ماذا فعلتم مباشرة بعد التحرير؟
بول ريكور: أقمنا في شامبو سور لاينو في الفترة الممتدة من 1945 إلى 1948. بعد سنة تَمَّ اختياري للعمل في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) ولم يكن من حقي التدريس إلا خمس أو سِت ساعات؛ وهو ما يعني أنّي أقوم بنصف الخدمة، وأستثمر ما تبقى لي من وقت لإكمال ترجمتي لكتاب Ideen I لهوسرل. وقد انتابني شعور بالرعب لَمَّا علمت أنّ شخصاً آخر يقوم من جهته بترجمة الكتاب نفسه. وما أثلج صدري هو دفاع "مرلوبونتي" (Merleau-Ponty) عن ترجمتي ضد الأخرى التي لم تكن مكتملة. انتهيت من العمل بتحضير أطروحاتي سنة 1948. غير أنّي لم أدافع عنها إلا سنة 1950. وغير خفي أنّي عُيِّنت، بدءاً من سنة 1948 في جامعة ستراسبورغ، التي كنت أرغب في التوجه إليها لكي أكون قريباً من اللغة الألمانية. أمضيت فيها ثماني سنوات. أستطيع القول إنّها ثماني سنوات من السعادة العارمة، وهي السنوات الأجمل في حياتي؛ لأنّها كانت طافحة بالتناغم والألفة على مستوى حياتي الأسرية ـ زوجتي سيمون، أولادنا، "جون بول" و"مارك" المولودان قبل الحرب، وابنتنا "نويل"، المولودة في المرحلة التي كنت فيها في الأسر، ولم أتعرف عليها إلا حين بلغت من العمر خمس سنوات، ثم "أوليفي" و"إتيان" وقد أنجبناهما في ستراسبورغ. وترجع سعادتي كذلك إلى نوع الحياة التي استمتعنا بها في ستراسبورغ، فالمدينة لطيفة ومِضيافة، والجامعة تجذبك بقوة إليها. وقد كلفتنا شعبة الفلسفة، أنا و"غوسدورف" (Gusdrof)، بالإشراف على حلقة فلسفية، يكون النقاش وتبادل الأفكار فيها من الأمور الثابتة والقارة. عُيِّن "غوسدورف" في الوقت نفسه الذي تعينت فيه، إذ خَلَفت "جون هيبوليت" (Jean Hypolite)، بينما هو خَلَف "جورج كانغليم" George Canguillhem)). ومن ستراسبورغ، كنت كثيرالتردد على ألمانيا، وهكذا تمكنت من زيارة "كارل يسبرز"[8] في "هيدلبرغ" (Heidelberg) قبيل هجرته إلى سويسرا. تأثرت جدّاً بنبله الذي يكاد يكون غوتياً (نسبة إلى غوته). وهو شخص من الصعب اقتحامه، إذ تتولى زوجته بصرامة ترتيب علاقاته وضبط مواعيده. علمنا فيما بعد أنّ "حنا أرندت" (Hannah Arendt)، حاولت التدخل للمصالحة بينه وبين "هيدغر" (Heidegger). وقد توفقت في إقناع "يسبرز"، الذي أبدى كرماً كبيراً لكنّها اصطدمت بمقاومة شرسة من "هيدغر"، الذي كان يعتقد ـ هل كان ذلك مجرد ذريعة؟ ـ أنّه لا توجد كلمات في المستوى ترقى لقول... هذا. وهنا نشعر أنّه تنقصنا كلمات بعينها.
والحق أنّ "يسبرز"، انتظر من ألمانيا نوعاً من التوبة، أو اعترافاً جماعياً بالخطايا، وخَلُص إلى الاقتناع بأنّ ألمانيا لم تكن في مستوى الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء الجرم الذي اقترفته. لم ينجح، هو الذي تَحَمَّل النازية وصمد في وجهها، في الصبر على الجمهورية الجديدة. أظن أنّه لم يكن صبوراً بما يكفي، لأنّ "أدناور" (Adenauer) قد ذهب إلى أبعد حد ممكن، بالنظر إلى الظروف الكارثية للبلد، في إعادة بناء جمهورية حقيقية.
زرت "يسبرز" للمرة الثانية، بعد أن عُيّن في جامعة «بال» لكي أهديه نسخة من الكتاب الذي أصدرته بمعية "ميكيل دوفرين" (مُؤَلِّفنا الأول)، تحت عنوان: كارل يسبرز وفلسفة الوجود. قَبل بكتابة مقدمة لطيفة جداً، على الرغم من أنّه لم يعجب كثيراً بالكتاب؛ لأنّه وجد موقفنا مغالياً في نسقيته، وقد شاطرته "يان هيرش" (Jeanne Hersch) التي كانت، مثل "حنا أرندت"، واحدةً من أخلص تلامذته، على ما أعتقد هذه التحفظات. خصوصاً أنّها اعتبرت بعد ذلك أنّي خُنت فكر "يسبرز" لصالح "هيدغر"، وأنّي، شأني في ذلك شأن باقي المثقفين الفرنسيين، على ما تقول، قد وقعت في حبال السحر الذي يمارسه "هيدغر"؛ وهو رأي نصف صحيح، لكنه أيضاً نصف خاطئ.
هل التقيت بـ «هيدغر»؟
بول ريكور: أجل، بـ "سوريزي" (Cerizy)، عام 1955، وقد احتفظت بذكرى غير جيدة عن هذا اللقاء، إذ كان محاطاً، بل مُطوقاً بـ "أكسلو" (Axelos) و"بوفري" (Beaufret)[9]، اللذين يمنعان أي أحد من "الاقتراب" منه. وكان يتصرف كـ "مُعلِّم". جعل نقطة الارتكاز في درسه نصاً لكانط، مأخوذاً من كتابه «نقد العقل الخالص»: "الوجود موقف". وبإصبعه، يشير إلى هذا أو ذاك، لقراءة السطر الموالي، واقتراح تفسير له. غير أنّ تدخلاته كانت رائعة، خصوصاً تلك التي تحدث فيها عن الشعراء. أعتقد أنّها كانت المرة الأولى التي انتبهت فيها إلى علاقته بالشعر. تكلم بإسهاب عن "ستيفان جورج" (Stefan George)، ويبدو لي أنّي اكتشفت "بول سيلان" (Paul Celan) بعد هذا الكلام.
وشيئاً فشيئاً ركبت الموجة الهيدغرية، بسبب الملل الذي أصابني جراء الطابع التفخيمي، إلى حد ما، المكرور والمطنب الذي اتسمت به الكتب الكبيرة التي ألفها "يسبرز". لقد انبهرت بعبقرية "هيدغر" أكثر مما أبهرتني الموهبة العظيمة لـ "يسبرز". فلا وجود، عند هذا الأخير، لأي شيء يمكن أن يشدك إليه ويأخذ بتلابيبك. فهو صاحب فلسفة محكمة البناء موسومة بالاعتدال. أحببت كثيراً بعض نصوصه القصيرة، مثل كتابه حول "ستريندبرغ" و"فان غوغ" (Van Gogh)[10]، كما راقتني كثيراً عبارته الشهيرة: "إنّنا نفكر في مواجهة الاستثناء، نحن الذين لا نشكل استثناءً". والآن، أنا ممتن له لأنّه لم يعتبر نفسه استثناء ـ وهو الأمر الذي قد لا ينطبق على هيدغر.
هلاّ حدثتنا عن "هيدلبرغ" و"فريبورغ" (Fribourg) في تلك المرحلة؟
بول ريكور: في "فريبورغ"، التقيت "لاندغريب" (Landgrebe) و"فنك" (Fink)[11]، وتعرفت على "غادمير" (Gadamer) في "هيدلبرغ". غير أنّه لم يكن ثمة أيّ تعاون بين الجامعات الفرنسية والألمانية، وكم كانت خيبتي كبيرة! لأنّ "ستراسبورغ"، في تلك الفترة ولأسباب سياسية واضحة، لم تشكل جسراً ممدوداً مع ألمانيا، وإنّما جسدت هوة بين البلدين. فلا يُحَلِّقُ بنظره في الجهة الأخرى للراين إلا من أراد ذلك فعلاً. إنّ المشكل الأساسي يكمن في استعادة فرنسا للألزاس. زملائي في الجامعة، كما الألزاسيين أنفسهم، لم يستوعبوا أن يوجد من يهتم بما يحدث في الجهة الأخرى للحدود، وكنت ألحظ عند هؤلاء شيئاً شبيهاً بذلك الحذر الذي كان يُظهره الفرنسيون إزاء ألمانيا، ما قبل الحرب.
عندما استأنفت حياتك "الطبيعية"، سنة 1945، هل عدت إلى التزاماتك السياسية لما قبل الحرب؟
بول ريكور: أجل، لقد عدت إليها فيما وراء تجربة الأسر ـ لكن بعد أن تلقيت درس الحرب المرعب، الذي أبطل كل أحكامي السابقة وفرض عَلَيَّ نوعاً من إعادة النظر في تربيتي السياسية. فقد وجدت نفسي في بعض الأحيان قريباً جدّاً من بعض المواقف التي كنت أتبناها في الفترة ما بين 1934- 1936، وقد كنت أكن بسرعة كبيرة عداءً معيّناً تجاه اشتراكية "جي مولي" (Guy Molet). أما صداقتي مع "أندري فليب"، فقد تأكدت وتوطدت إلى آخر نفس في حياته، كنت أذهب إلى باريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات، فاكتشفت في سنوات 1947- 1950 مجموعة Esprit التي لم أكن أعرفها جيداً في مرحلة ما قبل الحرب، بسبب انخراطي القديم في الاشتراكية المناضلة، فكانت تبدو لي هذه المجموعة غارقة في التنظير. اقتربت كثيراً من هذه المجلة، ونشرت بها العديد من الدراسات. أما صداقتي مع "إيمانويل مونيي" (Emmanuel Mounier)[12] فقد تعمقت قُبيل وفاته التي شكلت بالنسبة إليّ حداداً كبيراً. مازلت أراني سنة 1950 داخل حديقة "الأسوار البيضاء" بـ"شاتوناي- ملابري" (Châtenay-Malabery)، دون أن أعرف أنّي سأقطن في يوم من الأيام هذا المكان، ووجهي تغمره الدموع. لقد تأثرت حقاً بشخص "مونيي" أكثر مما تأثرت بأفكاره، كنت مُزَوَّداً بما يكفي من العُدّة الفلسفية حتى لا أكون واحداً من مُريديه؛ بيد أنّي مع ذلك كنت رفيقاً له. وهو نفسه كان يبحث عن فيلسوف محترف يسنده ويشد عضده؛ لأنّه فَقد فيلسوفه "المفضل" في شخص "لاندسبرغ" (Landsberg)، ثم "غراسي" (Grasset)، المقاوم في منطقة البريتاني[13] الذي قُتل رمياً بالرصاص، ألحَّ مونيي عليّ أن أسكن شقتهم الفاخرة، وهو ما قبلته بصدر رحب؛ كان شديد الحساسية لافتقار كتابته إلى البنية المفاهيمية، ولاضطراره أحياناً للارتجال. وقد حاول تجاوز ذلك بتأليفه، داخل منفى بلدة "ديولوفيت" (Dieulefit)، كتابه الأكثر قوة: رسالة حول الطبع. لا جدال في أنّه كتاب جيّد، على الرغم من استعاراته المفرطة من علم الطباع، وسقوطه مع ذلك في آفة الاختزال والتبسيط على المستوى المفاهيمي.
مَن مِن الفلاسفة الفرنسيين كان الأكثر حضوراً بالنسبة إليك؟
بول ريكور: "غبريل مارسيل"، هو الشخص الذي نسجت معه العلاقة الأكثر عمقاً، منذ سنتي في التبريز، 1934- 1935، وأيضاً في ما بعد، وعلى مراحل، حتى وفاته سنة 1973. كنا خلال "أمسيات الجمعة" الشهيرة، نختار تيمة للنقاش الذي كانت تحكمه قاعدة تقضي بضرورة الانطلاق دوماً من أمثلة، والعمل على تحليلها، دون اللجوء إلى المذاهب، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بدعم المواقف التي ندافع عنها. كنت أستمتع هنا بفسحة للنقاش كانت غائبة تماماً عن فضاء "السوربون". فالانطباع الذي يتولد، حين نكون بصحبته، هو أنّنا أمام فكر حي يتوسل بسلاسل الحجج. ولهذا، حين نقرأ "غبرييل مارسيل"، ينتابنا غالباً إحساس بأنّنا لسنا إزاء تدفق وانسياب للفكر، وإنّما بصدد مقاربة دينامية مهجوسة باجتراح الكلمات البكر وإيجاد دقيق العبارات. وهكذا نتناقش في كل أسبوع، حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات، بطريقة نشطة وفعالة متجاسرين على ممارسة ذاتية للتفكير، وهو ما كان يشكل تعويضاً عن الثقافة التاريخية السائدة في "السوربون".
أعتقد أنّ هذا أساساً ما أدين به لهذا الرجل: فقد تعلمت منه كيف أجرؤ على التفلسف وممارسته بمسؤولية في وضع سجالي، وهذا هو وجه الشبه القائم في رأيه بين المسرح والفلسفة. وقد عبَّر عن كثير من أفكاره من خلال شخصيات المسرح. والحق أنّ مسرحياته، مهما كانت فكرته عنها، لم تكن بالجودة المطلوبة، وإن كان يرى أنّه من المجحف أن يحظى "سارتر" بالاعتراف والاحتفاء، فيما تبقى نصوصه عرضة للتجاهل. من الممكن اليوم أن أعامل مسرح سارتر بالقسوة نفسها التي عومل بها مسرح "غبرييل مارسيل"... أستحضر الآن مقالة جميلة جدّاً كتبها الأب "فيسار" (Fessard) بعنوان: المسرح والفلسفة، بسط فيها فكرة مؤداها أنّ كل الخصوم يملكون الحق في أن نستمع إليهم ـ دون أن يعني هذا أنّهم جميعاً على حق ـ طالما الكلام للجميع؛ وهو ما يسميه "العدالة العليا للمسرح"، وهي تميز، على الأقل نظرياً، المسرح الذي يقدم أطروحات عن المسرح الحقيقي الذي يملك فيه الجمهور حق إنشاء رأيه الخاص. يوجد "غبرييل مرسيل" في منتصف الطريق بين المسرحين، لأنّه مع ذلك، يمرر بعض قناعاته على لسان أحد شخوصه؛ إلا أنّه يمارس أيضاً نوعاً من توزيع الكلام، فالاهتمام البالغ الذي يعطيه "غبرييل مرسيل" للأشخاص كان مرتبطاً بتجربته خلال الحرب العالمية الأولى، حيث انهمك على حشد المعلومات الخاصة بالجنود المفقودين، وإعادة تشكيل مصائر فريدة.
أتوفر على بورتريه خاص به، الناظر إليه يحسبه قطاً. لقد كان رجلاً مرحاً جداً لاذعاً في سخريته، يهوى سرد الحكايات. غير أنّه له عدوٌّ، وهو ساتر الذي كان يبغضه، فيما هو يقدره على الرغم من تعرضه للتجريح من قِبله. كان سارتر موضوعاً دائماً للتجريح والنقد، ليس بسبب إلحاده فحسب، وإنّما لكونه يعتبر الإنسان عَدَمَ الأشياء. وهو مالم يستطيع "غبرييل مرسيل" التسليم به. ربما يعود ضعف اهتمامي بسارتر إلى غبرييل مرسيل، على الرغم من ميلي إلى إرجاع ذلك إلى تفضيلي لمرلوبونتي. لم أتوقف عن الالتقاء بشكل منتظم بغبرييل مرسيل إلى غاية العُشارية التي نظمناها على شرفه وحول أعماله في "سوريزي" (Cerisy)، قبل وفاته بقليل، وقد ظهر كعادته متواضعاً، إذ أبى إلا أن يتقدم بمساهمته مثل البقية، وإذا كنت قد ابتعدت عن فلسفته، فليس بسبب قناعاته الفلسفية العميقة، وإنّما لأنّي لمست عنده نقصاً على صعيد البنية المفاهيمية. إنّه صاحب فكر استكشافي للغاية، ينزلق من مفهوم لآخر، حيث تلعب الفكرة دور خلية موسيقية بالنسبة إلى متوالية من المتغيرات، فكر يتحقق عبر تجاور مفاهيمي، إذ تتحدد فكرة ما بالفكرة القريبة منها معنى ودلالة. لن أذهب إلى حد القول إنّ الأمر يتعلق بفكر ترابطي، لكنه يصدر عن آليات تناغمية، وأخرى تنافرية. وعموماً، فإنّ المسافات الفكرية التي تفصله عن أقرانه لم تنقص البتة من العطف الذي كان يكنه لهم. ولمّا ألفت كتابي حول فرويد، يجب أن أقول إنّه مع ذلك لم يتحمس له. وقد قال لي بوضوح شديد إنّي انسقت وراء ما أسماه "روح التجريد". وقد صرت أفهم بصورة أفضل حكمه هذا، على اعتبار أنّي أعاتب الآن نفسي لأنّي بَنيت كل شيء حول نصوص فرويد الأكثر نظرية (الفصل السابع من تأويل الأحلام، نصوص الميتاسيكولوجيا، إضافة إلى الأنا والهو) ولأنّي لم أحتك بما فيه الكفاية بالتجربة التحليلية من حيث هي كذلك: الرغبة التي تمتطي صهوة القول، والعلاقة مع الآخر ومع الأغيار الأوائل، المرور عبر الحكاية، الإكراه التكراري، وعمل الحداد. والحال، أنّي كنت أناقش المفاهيم، وهو الأمر الذي كان "غبرييل مارسيل" يناصبه العداء. يقول على الخصوص: إنّ الكوجيطو الديكارتي هو حارس عتبة المقبول فلسفياً ضد اللغز. بيد أني كنت دوماً حذراً من فكرة اللغز، متى كان المراد بها منعاً للعبور فيما وراء الحد، مخالفاً بذلك المبدأ الكانطي المنصوص عليه في: "نقد ملكة الحكم"، وحريصاً على أن أفرغ وسعي في التفكير. ومع ذلك، لا ينبغي أن يفوتنا أنّ غبرييل مارسيل كان يستكمل التعارض الذي يقيمه بين اللغز، الذي يشملني، والمشكل المطروح أمامي، بامتداح للتفكير من الدرجة الثانية، الذي يقوي نوعاً ما الحركة الأولى التي لا يمكن أن تكون إلا استشكالية. هذا على الأقل ما حرصت بنفسي على تأكيده عنده. وبالطبع، لم يحل بيني وبين الانتقال من مشكل الرمز إلى مشكل الاستعارة، لكي أجد سنداً سيميوطيقياً وأداة لغوية مشفرة ومعروفة عبر تاريخ البلاغة، فيما هو يتصور ذلك تضييعاً لنوع من الكثافة الرمزية التي يعتبرها أكثر أهميةً من بصمتها اللسانية على المستوى الاستعاري. أما بالنسبة إليّ، فقد اعتبرت الاستعارة تسمح بمعالجة النواة الدلالية للرمز. وفيما يتصل بالروح النسقية التي مافتئ غبرييل مارسيل يحذرني منها، فإنّي مازلت حريصاً على التشبث بها، على الرغم من أنّها أضحت عندي تنزع نحو نوع من الديداكتيكية، التي تجد جزءاً من تفسيرها في كون كل أعمالي الفكرية لم تنفصل قط عن التدريس الذي أعتبره أهم مِحَك لها. أعترف أنّي كنت دوماً في حاجة إلى النظام، وإذا كنت أرفض جميع أشكال النسق الشمولية، فإنّ ذلك لا يعني أنّي ضد نوع خاص من التنسيق.
أعتبر "غبرييل مارسيل" و"ميرسيا إلياد" (Mirecea Eliade) - اللذين سنتحدث عنهما مجدداً - أنموذجين للأشخاص الذين مارسوا عليّ تأثيراً من خلال علاقات الصداقة، لكن من دون أن أخضع على الإطلاق للإكراهات الفكرية التي يتعرض لها المريدون عادة. لقد صرت حرّاً بفضل هؤلاء الأشخاص. ربما كان بوسعي أن أنعم مع "جون نابير"[14] (Jean Naber) بالمستوى نفسه من التبادل الجيد، إلا أنّ هذا الأخير لم يكن من النوع الذي يرتبط مع الآخرين بعلاقات دافئة. ففي إحدى السنوات التي تواجد فيها بمنطقة البريتاني، تَصادف أنّي كنت هناك أيضاً فقررت زيارته، بل ومباغتته. وصلت في منتصف النهار، فوجدت باب الحديقة مفتوحاً، وصندوق رسائله مملوءاً عن آخره بالأوراق. انتظرته ساعتين، قطفت خلالها بعض أزهار البنفسج، التي قمت بإعادة غرسها في حديقتي، ومازالت تزينها إلى الآن. ثم علمت عبر الصحف أنّه نُقل إلى المستشفى حيث سَيَلفظ أنفاسه الأخيرة. لم أجرؤ يوماً على زيارته، ولم أقم بذلك إلا يوم وفاته.
ما نوع العلاقات التي جمعتك، حين كنت في ستراسبورغ، بالفلاسفة الباريسيين؟
بول ريكور: لم أكن باريسياً إلا بعد فترة متأخرة، وهكذا أفلتّ من أشياء كثيرة، لم أعرف بتاتاً وسط "سان جرمان- دي- بري" *(Saint-German-des-Prés)، كما لم أتعرف على سارتر شخصياً. المرّة الوحيدة التي دخلت فيها معه في نوع من العلاقة ـ بين سنتي 1963 و1964 ـ تمت عندما كنت مشرفاً على المجموعة الفلسفية الصغيرة بمجلة Esprit؛ كان ذلك بعد إصداره لـ «مسألة المنهج»، وهو الكتاب الذي خصصنا له، أنا و"دوفرين"، سنة كاملة للنقاش داخل هذه المجموعة، لذلك دعونا سارتر، وهيأنا اثني عشر سؤالاً لنطرحها عليه. للإجابة على السؤال الأول تكلم ساعتين ونصف، ولم نتمكن أبداً من أن نطرح عليه السؤال الثاني. حضرت "سيمون دو بوفوار" (Simone de Beauvoir) هذا اللقاء، وكانت تراقب ما إذا كان الجميع ينصت بشكل جيِّد. وفي السجالات التي دارت بينه وبين "كامي"، ثم "مرلوبونتي"، كنت أقف إلى جانبهما. جمعتني بسارتر أيضاً علاقة مراسلة بمناسبة صدور واحدة من مسرحياته التي أثارت اهتمامي وسخطي: الشيطان والإله الطيب. كتبت حينها مقالاً تفاعل معه بطريقة ودية ونبيلة. بوسعكم الاطلاع على هذا المقال، الذي يبدو لي اليوم ساذجاً، في كتابي "قراءات"[15].
كيف كانت تتراءى لك باريس السان جرمان دي بْري منظوراً إليها من الريف الفرنسي؟
بول ريكور: بدت لي كأسطورة سطحية. والحق أنّ هذا الشعور أيضاً لا يخلو من حكم مسبق قوي مضاد لكل ما هو باريسي وهو حكم تَقَوَّى بالمناخ الفكري لشامبو سور لاينو، ثم بـ"ستراسبورغ". غير أنّ هذه التجربة حَصَّنتني ضد كل ظواهر الموضة. أما في ما يتصل بمرلوبونتي، فقد تعرفت عليه عندما كنت في "شامبو سور لاينو" في الفترة الممتدة من 1945 إلى 1948؛ كان يُدَرِّس بـمدينة "ليون" (Lyon)، حيث التقيته عدة مرات كما قابلته مجدداً في "لوفان" (Louvain) ببلجيكا عند الأب "فان بريدا" (Van Breda)، في مركز "أرشيفات هوسرل" (Archives Husserl)، موسم 1946-1947، ثم في ندوتين: واحدة من محاضراته دارت حول الموضوع "فينومينولوجيا اللغة" [16] (1956)، كان فيها مذهلاً. وبما أنّه قد حدَّد بصورة كاملة معالم حقل التحليل الفينومينولوجي للإدراك وآلياته، فإنّه لم يترك مفتوحاً، هذا ما اعتقدته في تلك المرحلة على الأقل، سوى المجال العملي. ففي هذا الحقل شرعت في إنجاز أبحاث ستجد تطورها اللاحق حينما تناولت مفهوم الشر والإرادة السيئة - أي ما يعرف في الخطاب الديني بـ "الخطيئة". الانطباع الذي كان عندي هو أنّه، في المجال الفينومينولوجي، لم يُعالج حتى ذلك الحين إلا الجانب التمثيلي من القصدية، في حين أنّ الحقل العملي برمته، والحقل الانفعالي، أي حقل العاطفة والانفعال ـ بالرغم من أنّي أعجبت كثيراً بكتاب سارتر حول الانفعالات ـ لم يقع حقيقة استكشافه.
واليوم تظهر لي اختياراتي الخاصة كما لو كانت محددة بصورة مثلثة. أولاً، مرلوبونتي الذي ترك حقلاً للاستكشاف أدواتُه التحليلية كانت متوفرة، ثم انتباهي واهتمامي الكبيران بالنقاش بين ديكارت، "ليبنتز" (Leibniz)، "سبينوزا" (Spinoza)، و"مالبرانش" (Malebranche)حول الحرية والحتمية، وأخيراً لأنّي كنت مشدوداً إلى إشكالية مستلهمة من "أوغسطين" (Augustin)، تتعلق بالشر والخطيئة، وهي التي قادتني إلى دراسة رمزية الشر.
عثرت على ملاحظات تعود إلى زمن الاعتقال، دَوَّنها بطريقة تكاد تكون حرفية واحد ممن كانوا يتابعون دروسي في المعتقل، وقد كانت دهشتي كبيرة لمّا لاحظت إلى أي حد اسْتَبَقْتُ ما أنجزته لاحقاً، لقد وجدت فيها تقريباً المحتوى الدقيق لـفلسفة الإرادة. فالبنية الأساسية للكتاب كانت خُطاطتها مبسوطة سلفاً وفيها: تيمة المشروع، دوافعه، ثم تيمة الحركة الإرادية مع التناوب بين العادة والانفعال، وأخيراً، الانتقال من الموافقة إلى الضرورة. لهذا أتممت أطروحتي بسرعة كبيرة، بعد عودتي من الاعتقال سنة 1945، وأكملتها سنة 1948. كانت هناك خمس سنوات من التفكير والتدريس شَكَّلت، دون أدنى شك، أساس هذه الأطروحة.
واختياري لهذا الحقل يعود إلى ما قبل هذا التاريخ، كما تشهد على ذلك محاضرة ألقيتها بـ"رين"، في بداية الحرب، بمناسبة إحدى الإنجازات، حول موضوع الانتباه، الذي هو التوجه الإرادي للنظرة. أعتقد أنّ اختياري للحقل العملي قديم جداً؛ فأنا لم أتوقف منذ زمن عن إبداء الإعجاب برسالة "لوثر" (Luther)حول الحرية المقيدة Serf Arbitre وحول الحرية المسيحية، فضلاً عن النقاش الكبير الذي كانت تُثمره مواجهاته مع "إرازم" (Erasme). ثم جاء السياق السياسي ليدعم توجهي نحو هذه الأسئلة المتعلقة بـ "الحرية"، و"الشر" و"المسؤولية". وأعتقد أنّي قبل ذلك بكثير كنت شغوفاً بالتراجيديا اليونانية، التي تضع في المقام الأول مشكلة القَدَر، ولا أنكر التأثير الذي مارسته على تكويني الأساسي الثيولوجيا الكالفينية حول القَدَر. واضح إذن أنّ اختيار حقلي المفضل للدراسة، الإرادة واللاإرادي، قد تضافرت عدة عوامل في تحديده.
في سنة 1956، تَمَّ تعيينك في السوربون، فغادرت ستراسبورغ.
بول ريكور: كان بوسعي أن أبقى فيها، غير أنّي كنت أنتمي إلى جيل الهدف من مشواره الوصول إلى باريس. ترشحت للسوربون في المرة الأولى وقد قدمني "هيبوليت" وغالبية أعضاء شعبة الفلسفة؛ إلا أنّ المجلس انتقى "جون غيتون" (Jean Guiton). وفي السنة التالية، وقع عليَّ الاختيار، بعد أن شغر أحد كراسي الأستاذية. لم أشعر بأيِّ ارتياح داخل السوربون، لذلك اخترت في ما بعد الذهاب إلى نانتير. لم أجد في السوربون نظيراً للعلاقات التي نسجتها مع الطلبة في ستراسبورغ. فقد جسدت، بالنسبة إليّ، نقيض ستراسبورغ.
صحيح أنّ شعبة الفلسفة في السوربون كانت تضم أسماء لامعة جدّاً، مثل "أرون" (Aron)، "غورفيتش" (Gurvitch)، "يانكلفيتش"(Jankélévitch)، "فال" (Wal)، "غويي" (Gouhier)، "كانغليم" (Canguilhem)، "باشلار" (Bachelard)؛ وصحيح أيضاً أنّي كنت راضياً تمام الرضى عن نوع التدريس الذي قدمته. فالمدرجات كانت ملأى، والطلبة الذين لا يجدون مقاعد يجلسون قرب النوافذ لحضور دروسي حول "هوسرل، فرويد، نيتشه، سبينوزا"، سنوات 1956-1965. لكن، وبسبب هذا العدد الكبير، كان يصعب ضبطهم ويتعذر معرفتهم، فقد كان لدي شعور حاد بعدم تكيّف المؤسسة الجامعية وتناغمها مع مثل هذه الوضعية. وفي سنة 1956، بادرت إلى الإشراف على عدد من مجلة Esprit خصصت موضوعه للجامعة، حصيلته كانتجد قاسية، إذ أفضى إلى اقتراحات سيعاد طرح الكثير منها في موسم 1968-1969 (خصوصاً ما تعلق منها بتعيين الأساتذة من قِبَل كوليج السوربون بناءً على معايير بالية). يمكن الاطلاع عليها، اليوم أيضاً، لأنّي أعدت نشرها في الفصل الأخير من كتابي "قراءات1" (Lectures 1)، بصرف النظر عن طابعها الطوباوي الواسع، توخياً للصدق مع الذات والغير، وهو ما أنجزته في الإطار التحريري نفسه، بخصوص ملاحظاتي حول الصين وإسرائيل[17].
لكي أعود إلى تحفظاتي الفكرية، وإلى إحباطاتي ومشاريعي المتعلقة بالجامعة في السنوات التي سبقت 1968، أقول بأنّه كان عندي انطباع بأنّه يجري إهمال كلّي للمهمة التي تقضي بضرورة خلق جماعة تضم الطلبة والأساتذة؛ بل حتى العلاقات بين الأساتذة كانت تتلاشى يوماً بعد يوم، بحيث كنا لا نلتقي إلا بصورة عابرة. لم يكن هناك مكان نعقد فيه لقاءاتنا، باستثناء المناسبات التي تتيحها التجمعات العامة داخل الشعبة. كنا نجهل كل شيء عن حياة زملائنا، فما نعرفه عن بعضنا بعضاً لا يتجاوز معلومات تتعلق بالإنتاج الفكري لهذا أو ذاك. فلم يسبق لي أبداً أن تعرفت على السيد "ريمون أرون"، ولا على السيد "يانكلفيتش". فليس ثمة أعمال مشتركة تجمعنا، ولا سجالات أو نقاشات تتيح لنا الاحتكاك ببعضنا بعضاً. فالوضع شبيه بصحراء فكرية. ينضاف إلى ذلك، أنّه لمّا كنت غير متعود على الحياة الباريسية، ولا أنا من قدماء شارع أولم (Rue d’Ulm)، وجدتني منغمساً في أجواء تحددت معالمها منذ زمن طويل. الشيء الذي جعلني أشعر بذاتي كالجسم الغريب، منكَبّاً على أعمالي الخاصة، على الرغم من الانطباع الذي كان عندي بأنّي أحظى باستماع جيد من لدن الطلبة.
صحيح، مع ذلك، أنّ انشغالي الأساسي كان على صعيد شخصي: ما السبيل إلى رفع التناقض الذي تخلقه وضعيتي أمام تقاطع تيارين فكريين متنافرين، وهما: النقد الفلسفي والهرمنوطيقا الدينية؟ وما زاد مشكلتي تعقيداً هو رغبتي في معرفة ما إذا كان العمل الذي أنجزه داخل الحقل الفلسفي ليس ضرباً من ضروب الانتقاء، وما إذا كنت أفصل بشكل أصيل ونزيه بين مختلف المرجعيات التي يتألف منها إرثي الفلسفي: "غبرييل مارسيل، هوسرل، نابير"، دون أن ننسى فرويد والبنيويين.مشكل النزاهة الفكرية كان دوماً ما يؤرقني، فالمطلوب ألّا أخون ما أدين به للتيارات التي استلهمت منها كثيراً.
باسم هذه النزاهة الفكرية تصديت، في الستينات، إلى الهَرَمِ الفرويدي، لكي تختبر تأملاتك حول الوعي في ضوء التحليل النفسي.
بول ريكور: إنّ الباعث الأول الذي حملني على إنجاز هذا العمل هو سؤال المسؤولية عن الجُرم، لأنّي خصصت الجزأين الثاني والثالث من كتابي فلسفة الإرادة لتيمة الضعف الإنساني ـ وهو ما أسميته بـ "القابلية للخطأ"، في علاقة مع المسؤولية عن الجرم ـ ورمزية الشر، أي للانتقال من ماهية الإرادة إلى رمزية الأساطير التي تعبِّر عن صور الشر وجنيالوجياته. وجدت نفسي أمام نوع من البقية المستغلقة على التحليل وعلى المنهج الفينومينولوجي؛ أقصد بذلك الجرم الطفولي، القديم، والباثولوجي. كنت أرى جيداً أنّ حقل المسؤولية عن الجرم لا تغطيه ـ في كليته ـ رمزية الشر هذه، المجسدة في الأساطير والروايات التوراتية، وبأنّه ما زال هناك شيء آخر. الباعث الثاني، يرجع إلى كوني رأيت في التحليل النفسي بديلاً للفينومينولوجيا، ولفلسفات الوعي بشكل عام. فالحد الأساسي للمشروع الديكارتي القائم على مسلمة الشفافية، طرح لي مشكلاً على الدوام. وفي النهاية، التقيت مع الدوافع الخاصة بـ "دالبييز"، الذي يَعتبر التحليل النفسي فرعاً من فروع فلسفة الطبيعة، أي الدراسة الفلسفية التي تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة في الإنسان. كان الأمر مرتبطاً بمنظور مغاير للرمزية الدينية للشر ـ مسيحية كانت أم لا ـ وبتوجه يختلف، علاوة على ذلك، عن التوجه الذي بسطته الفينومينولوجيا.
مع شروعي في العمل، اعتقدت أنّني بصدد كتابة مقالة حول الشعور المَرَضي بالذنب. وإذ طبقت على فرويد عاداتي في القراءة الشمولية، ونظرت إليه كفيلسوف كلاسيكي، فإنّني وجدت نفسي بصدد إنجاز مُؤَلِّف ضخم[18] شَكَّلَ مناسبة لسجال داخلي، أو قل لتحليل نفسي ذاتي، أصفه الآن مازحاً بأنّه كان بأقل كلفة. والحق أنّ هذا العمل ساعدني على تجاوز الجانب الوسواسي العتيق لمشكل الشعور بالذنب، والذي تبدل عندي تدريجياً بسؤال المعاناة المفرطة التي باتت تُرهق العالم.
حين قررت الاشتغال على فرويد، وذلك قبل أن يتحول إلى موضة، هل كنت تشعر بنوع من العزلة؟
بول ريكور: كان هناك، على أيّ حال، "دنيال لاغاش" (Daniel Lagache) و"ديديي أنزيو" (Didier Anzieu) و"جولييت بوتونييي" ((Juliette Boutounier، وجميعهم دَرَّسوا بالسوربون. لكن من المؤكد أنّي لم أتأثر بهم. فإشكاليتي كانت حقاً شخصية، علاوة على أنّي كنت دوماً أبدي كثيراً من الاهتمام، دون أن أكون بوبرياً [نسبة إلى «بوبر» (Popper)]، لفكرة "التكذيب"، وتساءلت ما الذي "يُكَذِّب" الفينومينولوجيا؟ كانت هذه هي نقطة القوة في بحثي، فيما رأى فيها الكثيرون إقحاماً للتحليل النفسي في الفينومينولوجيا؛ غير أنّي على العكس تماماً أكدت استحالة القيام بذلك، وأنّ هناك حتماً شيئاً يحول دون ذلك، فللفينومينولوجيا آخرها. في كتابي الإرادي واللاإرادي عالجت مشكل اللاشعور في إطار ما أسميته "اللاإرادي المطلق": أقصد ما يُوَجِّه مقاومة شاملة للتحليل وللتحكم الواعي. قمت بتجريد النظر في ثلاث صور من هذا اللاإرادي المطلق، وهي على التوالي: الطبع واللاشعور والحياة (أعني أن يكون المرء على قيد الحياة). لقد كان اللاشعور، ومنذ العمل المنجز سنة 1948، بمثابة النقطة العمياء للوعي بالذات التي تمتنع عن الإدماج ضمن دائرة الوعي، كما أنّها ليست بالوعي الأدنى بل هي آخر الوعي، وبهذا المعنى كنت دوماً فرويدياً بقوة.
هل كانت هي الفترة التي التقيت فيها بـ "مرسيا إلياد"؟
بول ريكور: كنت أعرف "هنري بويش" (Henri Puech) و"جورج دومزيل" (George Dumézil)، تعرفت عن طريقهما على "مرسيا إلياد". شيء ما يبهر بصورة مطلقة في فضوله الذي لا سبيل لإشباعه وكرمه اللامحدود. كان شمولياً في معارفه، غزير الثقافة، كَتَبَ، وعمره لا يتجاوز الأربع عشرة سنة عن الخنافس (Coléoptères)، كان يملك في حوزته مجموعة من الطوابع البريدية النادرة والمدهشة.
حين تعرفت عليه كان يُدَرِّس بباريس تحت إشراف "بويش". أعجبت أَيَّما إعجاب بتفرد عمله الأول الذي ظهر تحت عنوان: "رسالة في تاريخ الأديان"[19]، فيما كان الأمر يتعلق بالنماذج الدينية كما بيّن ذلك دومزيل نفسه في المقدمة التي صَدَّر بها هذا العمل، والتي أوضحت كيف يندرج ضمن تحليل تصنيفي، بنيوي. فعوض أن يتبع خطاطة تاريخانية كما جرت العادة في المنظور القديم لتاريخ الأديان المقارن ـ حيث تُرتب الأديان، ابتداءً بأكثرها بدائيةً وصولاً إلى أكثرها تبلوراً ونضجاً، وذلك وفق رؤية تطورية ـ قام بإعادة بناء أبحاثه حول التيمات المهيمنة، وخصوصاً التقاطبات الكونية الكبرى: السماء، المياه، الأحجار، الريح... إلخ، مستعيراً أمثلته من مختلف المتون المكتوبة، وصنوف الممارسات والطقوس. إنّ ما شدَّني إليه هو هذا النهج المعادي للنزعة التاريخانية. غير أنّ هذا التصور البنيوي يبدو كما لو كان مخنوقاً بهاجس يكاد يكون إيديولوجياً، وهو ما يجسده التعارض القائم بين الزوج: مقدس/مدنَّس. نتيجة ذلك أنّ التنوع الذي يطبع صور المقدس بدا مسحوقاً بنوع من النهج الرتيب الذي يطبع الأفضلية، كيفما كانت السياقات التاريخية، لمفهوم المقدس ولقطبية المقدس/المدنس؛ وبهذا أضعف ما كان يمكن أن يشكل نقطة القوة، من الناحية المنهجية في الفكرة التي تنطلق من رمزية متنوعة. لقد انتهى به المطاف إلى جعل الشمانية* بنية مُفَضَّلة فرضت نفسها على المستوى التاريخي كبراديغم مهيمن. اعتقد إلياد أنّ بمقدوره مقاومة النزعة التاريخانية عبر تأكيد ما كان يتصوره ديمومة المقدس. أظن بأنّه من اللازم أن نفهم جيداً العناية الكاملة التي يوليها لهذا الطابع المعادي لكل نزعة تاريخية: في العمق، سيظل المقدس مطابقاً لذاته في كل مكان، لكن هذا لن يتحقق إلا على حساب وضوح المفهوم.
لا ترتبط المشاكل الأساسية التي واجهته في النهاية بمحتوى أبحاثه، ولكن بتطور هذا التخصص ذاته: إنّ فكرة علم الأديان تكون له القدرة على الإحاطة بكل شيء، لم تفقد سحرها وبريقها فحسب، بل أضحت فكرة مشكوكاً فيها أكثر فأكثر. فالإجماع حاصل بين أهل الاختصاص على أنّه من غير الممكن أن نعرف حق المعرفة ديانات متعددة في الآن نفسه؛ حتى أنّ إلياد اتُهِم في الأخير بادعاء الموسوعية. ولدفع هذه التهمة وجد نفسه مضطراً لتقوية القطب المُنَظِّم، أقصد القطبية المتكونة من الزوج مقدس/مدنس. لقد حصل عندي الوعي بعمق هذه الصعوبة التي واجهته، والمتمثلة في ضرورة الإمساك بناصية علم يزداد غزارة ووفرة ـ يكفي مثالاً على ذلك المجال الهندوسي، الذي يستدعي فهمه الإحاطة بمتن يتكون من عشرات الآلاف من الصفحات.
من المؤسف أنّ "بيوش" و"دومزيل" لم ينجحا في إقناعه بالبقاء في باريس، لأنّه لو كان يملك الاختيار، لما ترك "إلياد" فرنسا. بيد أنّ جامعة شيكاغو لم تكن لتُضيِّع الفرصة، فمنحته كرسي الأستاذية وضَمَّته إليها. ومعلوم أنّ اللغة التي كان يتكلم بها وهو بين أفراد عائلته هي الرومانية، في حين كانت لغة ثقافته وتأليفه هي الفرنسية، أما الإنجليزية فلم تكن سوى اللغة التي يُدَرِّس بها. وأعتقد بأنّ كل أعماله المنشورة باللغة الإنجليزية هي في الأصل مترجمة إليها من الفرنسية. وقد سبق له أن تعلم اللغة السنسكريتية على يد "بيتازوني"(Petazzonni) ومعلميه الهندوسيين؛ ناهيك عن إقامته لمدة سنتين داخل دير "تيبيتي"(Tibétain)، حيث تَعَرَّفَ، بل مارس في بعض الأحيان، كما يمكن لإنسان غربي أن يفعل، الفنون الزهدية والتأملية. وهكذا اكتسب من الداخل معرفة بالحكمة الخاصة بديانات الشرق.
هل كان هذا موضوعاً لمناقشاتكم؟
بول ريكور: بكل تأكيد، لقد كنا نتحدث على الخصوص حول إمكانية أن يسكن الإنسان في مواقع دينية مختلفة. من جهتي كنت أبدي كثيراً من التحفظ، لأنّه كان عندي دوماً شعور بأنّه من غير الممكن أن يحتك الإنسان بديانات مختلفة، تماماً كما لا يمكن أن يكون لنا إلا عدد قليل جداً من الأصدقاء: كنت أشاطر "مرلوبونتي" حذره، هو الذي كان يرى في سياق آخر أنّه من المتعذر امتلاك رؤية تنيف على الكل، وأنّه ليس في وسعنا سوى أن نسلك وفق منهج القرب. ينضاف إلى ذلك شعوري بمقاومة كبيرة للتقابل بين المقدس/المدنس، المرتبط بما اعتبرته استعمالاً مفرطاً للرمزية؛ وهو ما قادني إلى تفضيل مفهوم "الاستعارة"، الذي يجسد في نظري بنية بالوسع التحكم فيها أكثر. كان النقاش الدائر في ما بيننا يتحرك على ثلاثة خطوط: أبدأً بالإشارة إلى دقة التقابل بين المقدس/المدنس وملاءمته ـ وإن كنت أكثر اهتماماً بالتقابل الموجود بين الزوج طاهر/خطّاء؛ ثم بإمكانية بناء رؤية شمولية ـ وما أذهلني دائماً هو كون الديني لا يوجد إلا داخل مجموعات مهيكلة، تماماً مثلما أن ّاللغة لا توجد إلا داخل الألسن؛ وأخيراً هناك الدور الذي يلعبه النص والكتابة: كان يعتبرني مغالياً في تقدير دور النصِّية في توليد المعنى. فالمستوى النصي عنده، إن لم يكن سطحياً، فهو على الأقل ظاهرة مرتبطة بالسطح، وذلك قياساً إلى عمق تتشكل لُحمته مما هو شفوي ومن الإحساس. لقد اعتقد، وهذا ما أثار زوبعة من المقاومات لدى أهل الاختصاص، بأنّ الدائرة الدينية تتمتع بالاستقلالية، وأنّها مهيكلة ذاتياً عبر سيادة مفهوم المقدس. كان إلياد شديد التمسك بفرضية فَهْم محايث للظاهرة الدينية، حيث دافع عن فكرة مؤداها أنّ هذه الظاهرة تُفهم انطلاقاً من مفرداتها الخاصة؛ وليس في مستطاع المتخصص سوى الإقامة بنفسه، بلا مسافة، داخل الظاهرة التي يُحلّلها. وقد صرنا حالياً نعاين انتقاماً للمتخصصين؛ وحتى كرسي الأستاذية المخصص لتاريخ الأديان المقارن في السوربون قد غدا مُقَسَّماً إلى عدة شُعب مختلفة.
هل كان بدوره يتموقع داخل ديانة بعينها؟
بول ريكور: ينحدر إلياد من أصل أرثوذكسي، ومن الثابت أنّ المظاهر التعبدية والروحانية، عكس الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية اللوثرية، كانت تجعله قريباً من أفكار الشرق: قال لي أكثر من مرة: "ألا ترى إلى أيّ حد يؤدي تاريخ الإصلاح إلى تجذيره في قلب الغرب، في نسيان ثابت للشرق، مما جعله يتموضع فيما بعد ضمن الانشقاق الكبير عن الكنيسة الرومانية"؟. وهو نفسه كان في ريعان شبابه متأنِّقاً، منقطعاً إلى أبعد الحدود عن جذوره الدينية؛ ولم يعد إلى منابعه الرومانية والأرثوذكسية المسيحية إلا عن طريق الهندوسية، ولكن عبر أسلوب انتقائي. ومع ذلك، قد سمح له المعنى التعبدي للأرثوذكسية بالتأكيد على أنّ الاعتقاد سابق على المذهب، وأنّه قبل الاعتقاد هناك الشعائر، وقبل الشعائر يوجد التعبد.
أستطيع القول بأنّ صداقتي مع مرسيا إلياد كانت عميقة ووفية، وهو واحد من العناصر التي شكلت الثلاثي الروماني في باريس، الذي ضَمَّ إلى جانبه كلاً من "يونسكو" (Ionesco) و"شيوران" (Cioran). والصداقة بين هؤلاء الثلاثة لم تكن كلمة جوفاء، على الرغم من التباين الملحوظ بين شخصياتهم. كانوا، إلى جانب اشتراكهم في المصير نفسه، قريبين جداً من بعضهم بعضاً، وهو ما يفسر حرصهم على التلاقي باستمرار. أتذكر، خلال الحفل الذي أقيم على شرف "مرسياد إلياد" بمناسبة بلوغه سن الخامسة والستين، أنّ "يونسكو" سأله "هل تتذكر مرحلتنا الثانوية حينما كنتَ أكبر مني بكثير"؟. فبينما كان "يونسكو" خفيف الظل موسوماً بروح الدعابة، تميز "شيوران" بنزعة كلبية وقحة (Cynisme)، فقد كان مثلاً يحب الذهاب إلى حفلات الافتتاح من أجل الوقوف على تفاهتها. آخر مرة رأيته فيها كان بمناسبة الحفل الذي أقيم أمام منزل "غبرييل مرسيل" في 23 شارع تورنون (Tournon)؛ كنا قد نصبنا مرقباً صغيراً على الرصيف، لكنّ شيئاً ما انهار، فهرعنا لجمع أجزائه في الوقت الذي كنا نقرأ فيه مديحاً في حق الفيلسوف، وفيما كان المارة لا يتمالكون أنفسهم من الضحك، اكتفى هو بمعاينة المشهد وإطلاق ضحكات هازئة.
مَن مِن بين الفلاسفة الكبار الآخرين ظل الأكثر قرباً منك؟
بول ريكور: "هانز جورج غادمير"، بكل تأكيد، على الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل بيننا. كنت في البداية قارئاً لغادمير باعتباره أحد الوجوه البارزة في التيار الهرمينوطيقي. لقد انخرطت في سجاله القديم مع هابرماس "الأول"، وكنت أتموقع بينهما، رافضاً على الخصوص التعارض بين الحقيقة/المنهج[20]. أما شاغلي الأكبر فهو إدماج اللحظة النقدية في التأويل، أقصد العلوم الإنسانية التي كان غادمير يقذفها باتجاه ما أطلق عليه اسم المنهج، وهو بالأحرى أقرب إلى النزعة المنهجية. واليوم أقر بأنّه كان على صواب خاصة فيما يتصل بعدائه لهيدغر الذي كان ينزع بعض الشيء إلى معاملته كما لو كان خائناً لنفسه ولهوسرل. وفي سيرته الذاتية[21] يبدي غادمير عداءً شديداً للقراءة الهيدغيرية لأفلاطون، التي اعتبر فيها الأفلاطونية نظرية دغمائية ـ نظرية المثل، التعارض بين المعقول والمحسوس،... إلخ. كان غادمير أكثر اهتماماً بالحركة الدائمة للحوارات. وهو لم يكن ينظر إليها كثوب بلاغي وإنّما بوصفها حركة الفكر ذاته. وفي المرحلة التي كنت أخوض فيها سجالاً مع البنيوية، ألفيت نفسي أبتعد عن غادمير لكي أبحث عن موقع وسط بين النقد وهرمينوطيقا التملك ـ طالما يتحدد مسعى النهج الهرمينوطيقي، عند غادمير، أساساً في تخفيض المسافة وتقليصها، بل وعند الضرورة إلغائها، سواء كانت المسافة على مستوى الزمن، أو على مستوى المكان، وهذا بالضبط ما كنت أقاومه معتقداً بأنّ معرفة الذات تقتضي أن نمر عبر الغير، مانحاً دوماً لهذا المرور النقدي عبرة.
فالرجل مدهش للغاية. إنّه فكر مفعم بالشاعرية، يحفظ عن ظهر قلب الشعر الألماني بأكمله حيث يستحضره بسهولة في حواراته: "غوته"، "شيلر"، "غريلبارزر" (Grillparzer)، "ستفان جورج" (Stefan Goerge)، "بول سيلان" (Paul Celan). كما يتمتع بمعرفة عميقة بالتراجيديا اليونانية. إنّه يحيا حقاً داخل النصوص التي يسكنها من خلال الاستظهار. فعنده نوع من هرمينوطيقا الاستظهار الشفوي للمكتوب.
علاقاتنا اتسمت بالودِّية، غير أنّه كان يتملكني في الغالب إحساس بأنّه بقي متحفظاً إزائي، ظناً منه أنّي كنت في صف "هابرماس". أمضينا معاً أمسية عاصفة عندما أعدت، في ميونيخ خريف 1986، إلقاء محاضرات [22]Gifford Lectures. وقد حضر للاستماع إليّ، فيما كنت لا أشعر بارتياح كبير لأنّ ألمانيتي لم تكن بالجودة الكافية التي تسمح لي بالدخول معه في مناقشة نِدِّية، وقد أعطى بدوره بعداً سجالياً لهذا اللقاء، ومنذ ذلك الوقت التقيته مجدداً في باريس ثم في ألمانيا عدة مرات. بعدها شعرت بأنّ علاقتنا صارت هادئة. والآن ونحن بصدد الابتعاد عن مسرح العالم، نقوم بذلك بثبات وبكثير من المحبة المتبادلة. ولَكَمْ كانت سعادتي غامرة حينما شاركت، بدعوة كريمة منه، لإلقاء"الخطاب الشرفي" في الحفل الذي أقيم في هيدلبرغ، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والتسعين.
لنعد، إذا سمحت، إلى التسلسل الزمني. مر بنا أنّك لم تكن مرتاحاً في السوربون للعلاقات بين الأساتذة وللعلاقات مع الطلبة. قلت بأنّك لم تتردد لحظة في قبول الدعوة التي وُجهت إليك للتدريس بجامعة "نانتير".
بول ريكور: لم أعرف شيئاً عن المساومات المتعلقة بتأسيس هذه الجامعة التي كانت ملحقة بالسوربون، ولم يكن لها وضع مستقل بل يتكفل بإدارتها مجلس تدبيري فقط. تلقيت هذه الدعوة دون أن أكون مطلعاً على مداخل هذا المشروع ومخارجه، ولا حتى طبيعته. ففي أحد الأيام أخبر عميد السوربون الأساتذة بأنّ هناك جامعة جديدة سترى النور. والذين قبلوا الالتحاق بها كانوا ثلاثة ـ "بييرغرابان" (Pierre Grapin). "جون بوجو" (Jean Beaujeu)، وأنا ـ، وتناوبنا العمادة، التي كُلِّلت بالنجاح كما هو معلوم. أول من تولى هذا المنصب كان هو الجرماني"غرابان"، الذي تعرفت عليه في ستراسبورغ على المستويين المهني والسياسي ـ كان شيوعياً أو قريباً من الحزب الشيوعي، وأتذكر أنّي شاركت في اجتماعات مشتركة نُظِّمت، إلى حد ما، تحت رعاية حركة السِّلم، أعرف أنّها ليست بالمرجع الجيد، وإنّ ما كان يجمعنا هو نوع من القرب من اليسار، فضلاً عن إعجابي بأعماله الجرمانية، الوفية لـ "هاين" (Heine)، وبنزاهته الفكرية.
كانت أمنيتي ترك السوربون وخوض غمار تجربة أستطيع فيها مُجَدَّداً إنشاء علاقة حَيَّة مع الطلبة. حين ذهبت لأول مرة إلى نانتير، وكان الفصل شتاء، رفض يومها سائق التاكسي مواصلة الطريق إلى النهاية، بسبب كثرة الأوحال، فقال مُعلِّقاً: "هل تظن سيارتي زورق إنزال"؟.
أتذكر الفصل المضحك لوضع حجر الأساس. فقد قمت، بمعية "بيير غرابان"، بحمل هذا الحجر على سيارة تاكسي، دون أن نعرف ماذا سنصنع به، وضعناه في الوحل، ثم انصرفنا إلى حال سبيلنا. والغريب أنّي لم أنتبه من قبل لبؤس المكان. الراجح أنّه قد تملكتني نزوة عمالية جعلتني أعتقد أنّه لا بأس من استنبات جامعة وسط مدن الصفيح. غير أنّ نانتير جسدت بالنسبة إليّ تحولاً جذرياً بالمقارنة مع السوربون والحي اللاتيني. والغريب أنّي لم ألمح بشاعتها المعمارية، وهو ما يجعلني اليوم في منتهى الذهول.
اعتُمِد في إنشاء نانتير على قطع صغيرة من السوربون وزمرة من الأساتذة المستقدمين من الأقاليم، على رأسهم "ميكيل دوفرين". أَسَّسنا شعبة الفلسفة، وأفتخر بأنّي ضممت إليها ثلاثة أساتذة غير مبرزين، وهم: "هنري دوميري" (Henri Deméry) بشهاداته الكنسية، و"شلفيان زاك"(Sylvian Zac) الذي لم يتمكن من اجتياز مباراة التبريز، سنة 1935، بموجب القوانين الأولى لـ "الحماية" المُوجَّهة ضد اليهود الأجانب، والتي كانت تنص على أنّ الترشيح للتبريز يتطلب خمس سنوات من التجنيس؛ ثم "إمانويل ليفناس" الذي سبق لي الاطلاع على أعماله، إضافة إلى أنّه كان، في مدينة "بواتيي" (Poitiers)، زميلاً لـ "ميكيل دوفرين"، علاوة على التعيينات التي كانت تأتي بقرار رسمي، أذكر من ذلك عدداً من الزملاء المطرودين من الجزائر الذين تم تعيينهم دون أن يخضعوا لعملية انتقاء، وقد تم استقبالهم بحفاوة. إلا أنّه لم تكن لدينا أيّ استقلالية، طالما كان اختيار الأساتذة يصدر دوماً عن السوربون.
عشت تجربة موسمين جامعيين (1966 - 1967 و1967- 1968) خصبين وسعيدين إلى أبعد الحدود. فعدد الطلبة لم يكن كبيراً، وهو ما كان يسمح بسهولة التعرف عليهم وتتبع مسار تطورهم. كنا نمضي في الجامعة وقتاً أطول من الآن، بحيث نقضي فيها، باختيارنا، اليوم بأكمله. هذه كانت بالنسبة إليّ طريقة لاستعادة أجواء ستراسبورغ وبعثها في باريس. لم تبرحني قط فكرة تكوين جماعة تضم الأساتذة والطلبة، وهو ما قادني إلى دعم مشروع يقضي بإدماج الطلبة في مجلس الجامعة. أعتقد اليوم بأنّه كان خطأً فادحاً، فأن تكون طالباً ليس معناه الانخراط في سلك مهنة ما.
يعد النظام الأنجلوسكسوني، بهذا الصدد، أفضل بكثير، لأنّه يتوفر على منظمات طلابية قوية جداً، تُحاوِر من الخارج، لكنّها مع ذلك تملك وزناً أكبر مما لو كانت تائهة داخل المجالس الإدارية حيث لا تتخذ أيّ قرارات تحظى بالأهمية في تلك المرحلة التي كانت فيها كل الصلاحيات بيد الوزارات.
كنت سنة 1968 أستاذاً ورئيساً لشعبة الفلسفة. وكنت في المكان نفسه حينما اندلعت "الأحداث" كما يقال.
بول ريكور: انطلقت الأحداث في نانتير لأسباب لا تتعلق بالتدريس، مثل حق الذكور في زيارة الإناث في أماكن إقامتهن، لقد كانت "الثورة الجنسية" هي الشرارة التي فجرت الأحداث. عانت نانتير من عائقين اثنين: الأول يرتبط باختيار التخصصات المتوفرة من مثل: الآداب والحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية، وقد كان لطلبة الآداب يسار قوي، فيما كان لطلبة الحقوق يمين نشيط، أما المواجهة بينهما فكانت محتومة. أما العائق الثاني فيقترن بجغرافية الاستقطاب الطلابي، حيث إنّنا نجد الطلبة المنحدرين من وسط بورجوازي، من الضواحي السكنية لـ"نويلي" (Neuilly)، ومن الدائرة VIХ وXVII، وهناك الطلبة القادمون من وسط شعبي، من نانتير والضواحي الأقل غنًى. بنات وأبناء البورجوازيين كانوا يساريين أما البقية فمن الشيوعيين الذين أبدوا تشبثهم القوي بالسير الجيد للمؤسسة، لأنّ الجامعة مازالت تمثل بالنسبة إليهم وسيلة تقليدية لتحصيل المعرفة والارتقاء الاجتماعي. أما البورجوازيون فقد كانوا، على عكس ذلك، يشعرون بأنّ الجامعة لم تعد العامل المفضَّل للارتقاء الاجتماعي. فلما كان آباؤهم قد اكتسحوا هذه المواقع، فإنّ أبناءهم سيتحالفون مع أولئك الذين تواجدوا في الجامعة، من دون أن تكون لهم أيّ وسيلة للنجاح، وشرعوا في التفكير في كيفية تدمير الأداة التي ما عادت، في نظرهم، وسيلة مضمونة للنجاح في المستقبل. وعندما أصبحتُ عميداً، في مارس 1960، استفدت من دعامتين إيديولوجيتين، إذا جاز لي قول ذلك: الشيوعيون المعادون للنزعة اليسارية والكاثوليك الملتزمون اجتماعياً؛ أما خصومي فكانوا بشكل مفارق، من البورجوازيين التقليديين والبورجوازيين اليساريين.
ماهو الحكم الذي كنت تصدره سنة 1968 حول ما كان يجري؟
بول ريكور: كان الحكم إيجابياً في البداية، إذ كنت أُقدِّر أنّ الإيجابي سيتغلب على السلبي؛ لقد بدت لي تجربة تحرير القول، حيث أصبح الكل يتكلم مع الكل، وجميع مظاهر المشاركة في المأدبات رائعة. واليوم أتساءل ماذا حدث فعلاً؟ لاشيء أم الكثير؟ هل كان الأمر لا يعدو كونه حلم يقظة كبير؟ أم أنّه نوع من اللعب كما كان يذهب إلى ذلك "ريمون أرون"؟ أم أنّ شيئاً مهمًّا حصل لم يتمكن من إيجاد تصريف سياسي، لكنه يملك مع ذلك، دلالة ثقافية عميقة، كانت بمثابة كشف عن كل ما كان مخبوءاً أو مستوراً، وكل ما تمت الحيلولة بينه وبين الطفو على السطح ـ نوع من التحرير والانبجاس الاجتماعي؟ لماذا حدث هذا بشكل متزامن في كل أنحاء العالم، في باريس، وطوكيو، وبرلين، وفي كل المدن الجامعية الأمريكية؟ إنّ العنصر المشترك الوحيد بينها، في ما يبدو لي، هو النمو الديمغرافي السريع غير المتحكم فيه من قِبَل مؤسسة كانت نخبوية في الأصل، فوجدت نفسها، بسرعة فائقة، مُلزَمة بالخضوع لتوجه أكثر شعبية، مع أنّها ظلت عاجزة عن ملاءمة بنيتها النخبوية مع وظيفتها الجديدة المتمثلة في نشر عام للمعرفة. لا أجد سوى هذا العامل لتفسير ما حصل، خاصة أنّه القاسم المشترك بين الأنظمة الجامعية الأربعة التي شهدت أحداثاً مماثلة. أضف إلى ذلك، أنّ تحولات في العادات، التي تتقاطع على الرغم من تمايزها، قد أبرزت صعوداً قوياً لفئة عُمرية حال بينها وبين حلمها بالتحرر تبعية حقيقية على المستويين الاقتصادي والمالي ستزداد حِدَّتها في ما بعد.
هذا صحيح. غير أنّ هذه الظاهرة في فرنسا تجاوزت فضاء الجامعة.
بول ريكور: أجل، وذلك لأنّ الطلبة نجحوا في تعبئة النقابات العمالية. غير أنّهم وفي الوقت نفسه لم يتفطنوا إلى كون النقابات تسيطر على الوضع بصورة أفضل منهم، وتعرف جيداً الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها. والأمر المُحيِّر، من جهة أخرى، هو الاعتدال الذي طبع أداء الشرطة. تردد على لسان بعضهم أنّها كانت عنيفة في تدخلاتها، إلا أنّها في الواقع أثبتت مهارتها وحنكتها، إذ لم تُسَجل أيّ حالة وفاة، وهو أمر مذهل، قياساً إلى عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرات، وبالنظر أيضاً إلى عدد التظاهرات المنظمة.
متى شعرت بأنّ الأمور بدأت تخرج عن اختصاصك؟
بول ريكور: بعد رجوع الجنرال دوغول في 31 ماي 1968. قبل هذا التاريخ كان هناك مشروع سياسي؛ صحيح أنّه مجنون بعض الشيء، لكنه لم يكن يفتقد إلى التماسك، إذ كان يقوم على فكرة مفادها أنّ المؤسسات سلسلة تُعتبر الجامعة حلقتها الأضعف، وأنّه بالانتقال من حلقة ضعيفة إلى حلقة أقل ضعفاً، ستسقط كل قطع الدومينو. والحال أنّه منذ اليوم الذي استلم فيه الجنرال الحكم، لم يجد في مواجهته أي مشروع سياسي واضح المعالم، المشروع الوحيد الذي كان وقتها هو تخريب المؤسسة. هذا ما وَرَثْتُهُ سنة 1969 حينما تم اختياري لمنصب العمادة. وجدت أمامي إرادة الفوضى التي لم يعد لها أي مبرر سياسي، بل مبرر محلي قائم على تعطيل الجامعة ومنعها من الاشتغال، لقد كان هامش المناقشة ضيقاً جداً. كان الوضع، عام 1969 متعفناً وبلا أي مشروع سياسي، اللهم إلا ما تعلق بمجابهة إيديولوجية خالصة، حيث تتم مماهاة السلطة بالعنف، وإدانتها على هذا الأساس، بلا أدنى تمييز.
هل حظي انتخابك عميداً بالإجماع؟
بول ريكور: لقد تم انتخابي بطريقة مدهشة للغاية. سبقت لي المشاركة مع مجموعات تضم الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والطلبة في الكثير من القرارات والنقاشات والمشاريع الطوباوية إلى حد ما، والطامحة إلى إعادة خلق الجامعة. وُضِعْتُ إلى جانب "روني ريمون" (René Rémond) في حالة تنافس دون أن يكون أيٌّ منا قد رَشَّح نفسه، والسبب الوحيد وراء ذلك هو تركه للنقابة المستقلة، ومغادرتي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (S.N.E.S.U.P): رفضنا العمل النقابي لأسباب عديدة؛ وقد تَمَّ انتخابي من طرف مجلس التدبير المؤقت، الذي كان يتألف في تلك الفترة من الأساتذة، والأساتذة المساعدين والطلبة. وبعد فرز الأصوات، حصلت على شبه إجماع الطلبة، وظفرت بغالبية أصوات الأساتذة المساعدين، في حين لم أحصل إلا على ثقة عدد قليل من الأساتذة. شعرت بأنّه من واجبي القبول، لكن بشرط أن يكون "روني ريمون" هو خليفتي؛ غير أنّ من منحوني ثقتهم لم يستسيغوا هذا الشرط، لأنّ "روني ريمون" حصل على معظم أصوات الأساتذة. إلا أنّنا مع ذلك عملنا سوياً على الدوام. ولا يخفى أنّ "روني ريمون" قد أَلَّفَ كتاباً [23] هاماً جدّاً روى فيه القصة الكاملة لـ "نانتير". وقد برهن عن وفائه المطلق لاختياراتي حتى عندما كان لا يشاطرني الرأي فيها، أذكر، على سبيل المثال، مؤاخذته لي بسبب صبري الطويل على اليساريين.
إجمالاً يمكن القول بأنّ سنة 1969 كانت، بحسبك، مختلفة عن سنة 1968، من حيث أنّ عداء الطلبة صار موجهاً بجرأة نحو الأساتذة.
بول ريكور: شهدت سنة 1969 نوعاً من الرفض للمعرفة. وأتذكر أنّي سُحبت مَرَّة إلى مدرج كبير لكي أشرح موقفي. سئلت: "ما الذي تملكه أكثر منا؟" فأجبت: "إنّي قرأت من الكتب أكثر مما قرأتم". كان هذا الرفض يُماهي، بلا أدنى تمييز، بين المعرفة والسلطة، فيما اختُزلت السلطة في العنف، بحيث تَرَسَّخ عندهم الاعتقاد بأنّ كل ما له صلة بالعلاقة العمودية لا يمكن أن يُعايش بصدق ونزاهة.
احتفظت بمنصبك عميدًا لمدة سنة تقريباً، قَدَّمت بعدها استقالتك عام 1970. ومعلوم أنّ الأحداث التي سبقت استقالتك قد أدت إلى تعليقات كثيرة ووَلَّدت حكايات أقرب إلى الخيال. هل لك أن تروي لنا الوقائع كما حدثت، وبالأخص نريد أن نعرف الطريقة التي اقتحمت بها الشرطة الحرم الجامعي؟
بول ريكور: أنا شَديدُ الحرص، وكشهادة للتاريخ، على تصحيح ما ورد بصدد قدوم الشرطة إلى نانتير، لأنّ التأويل الذي أعطي له كان مخجلاً بالنسبة إليّ. ففي أوج الأزمة، استدعيت من طرف الوزير "غيشار" (Guichard)، في الوقت الذي صادق فيه مجلس تدبير الجامعة، في هذه الظروف الاستثنائية، على نص يقول بأنّنا نتخلى عن الحفاظ على الأمن داخل الحرم الجامعي، فيما نحتفظ بمسؤوليتنا السيادية على البناية. قال لي الوزير في ليلة هذا التصويت نفسها: "لا بد من استتباب الأمن، إذ لا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه". ولمّا عدت إلى المنزل، اتصل بي كاتبه في منتصف الليل ليقول لي: "غداً صباحاً، في الساعة السابعة، ستداهم الشرطة الحرم الجامعي". أجبته بأنّه لايمكنه فعل ذلك، فرد قائلاً: "كلاّ، لقد صوّتم ليلة أمس على نص يقضي بجعل الحرم خارج سلطتكم. إنّنا سنتدخل لأنّكم تَخَلَّيتم عن سلطتكم"، وعلى هذا النحو، وجدت الشرطة في المكان نفسه. لم أقم باستدعائها، فقد كانت موجودة سلفاً.
قال لي "روني ريمون" مؤخراً: "الغريب أنّ كل ما حصل كان غير قانوني. لم يكن لنا الحق في التصويت على مثل هذا النص، فضلاً عن أنّه لم تتم المصادقة عليه من طرف أيّ سلطة مختصة" أي أنّني كنت في الواقع، دون أن أعلم، مسؤولاً عن الحفاظ على الأمن داخل الحرم، طالما كان تصويتنا بترك مسؤوليتنا عنه بدوره باطلاً. رد فعلي حينها كان باختيار أسوأ الحلول، لأنّ الشرطة المُحاصرة للبنايات تعرضت لـ "القصف" بالآلات الكاتبة والطاولات... إلخ، وما كنت أخشاه حقيقة هو سقوط ضحايا؛ لقد تعرضت "نانتير" لثلاثة أيام من التخريب. وبعدها بثمانية أيام قَدَّمْتُ استقالتي.
والآن، بعد مرور كل هذا الزمن، أيُّ تأويل تعطيه لاستقالتك؟
بول ريكور: أستطيع القول بأنّ فشلي في "نانتير" كان فشلاً لمشروع مستحيل سعى إلى التوفيق بين التدبير الذاتي والبنية التراتبية المحايثة لكل مؤسسة؛ أو على أيّ حال للتوزيع اللامتناسق للأدوار المتمايزة التي يفضي إليها. لكن ربما يكون عمق المسألة الديمقراطية كامناً في القدرة على التوفيق بين العلاقة العمودية لفعل الهيمنة ـ إذا ما أردنا استعمال قاموس "ماكس فيبر" والعلاقة الأفقية للعيش المشترك ـ أو إن شئت قُل التوفيق بين "ماكس فيبر" و"حنا أرندت". يعود إخفاقي الأساسي إلى كوني رغبت في إعادة بناء العلاقة التراتبية انطلاقاً من العلاقة الأفقية. وبهذا الصدد، أشير إلى أنّ الأحداث التي رافقت المدة التي قضيتها في العمادة قد أَغنت تأملاتي اللاحقة في السياسة.
أعتقد بأنّه قد انغرس عميقاً بداخلي، وبصورة دائمة، خليط غير مستقر بين حلم طوباوي بالتدبير الذاتي، والتجربة الدقيقة والإيجابية جدّاً للحرم الجامعي الأمريكي والتي يتعين أن نضيف إليها معرفة الجامعة الألمانية التي تشكل واقعاً بَيْنِياً. كنت أتحرك بين طوباوية غير عنيفة، وشعور بأنّ هناك شيئاً لا يُقهر يظل حاضراً في علاقة السيادة، وفي الحكم؛ وهو ما أعقلنه الآن باعتباره الصعوبة المتمثلة في مفصلة العلاقة اللامتناسقة والعلاقة التبادلية. عندما يملي علينا الواجب أو التفويض أن نتحمل مسؤولية العلاقة العمودية، فإنّنا نبحث باستمرار كيف نعطي لها شرعية مستمدة من العلاقة الأفقية. ولا تكون هذه الشرعية، في النهاية، أصيلة إلا إذا كانت تسمح باختفاء كُلِّي للتناسقية المرتبطة بالعلاقة المؤسسية العمودية؛ والحال أنّ هذه العلاقة لا تختفي تماماً، لأنّها لا تقهر: لا يمكن أبداً لسلطة اتخاذ القرار أن تتطابق بشكل تام مع التصور المثالي لديموقراطية مباشرة يكون في وسع كل واحد أن يساهم في اتخاذ القرار. ألا نلاحظ اليوم، على المستوى القضائي ـ السياسي، بأنّ المشاكل الحقيقية التي تواجه العدالة ليست تلك التي تتعلق بالتوزيع المتكافئ، وإنّما تلك التي تترتب على التوزيع غير المتكافئ؟ والسؤال يعود، في النهاية، إلى تحديد ما هي التفاوتات الأقل ظلماً؟ إذ تعتبر التوزيعات غير المتكافئة بمثابة الخبز اليومي للسلطة التي تحكم مختلف المؤسسات. إنّه المشكل الذي ألفيه مجدداً، اليوم، عند "رولز" (Rawls)، وعند مختلف نظريات العدالة.
لكني لا أخفي أنّي تعلمت الكثير من هذه المحاولة، ومن هذا الفشل. فعبر محاولتي فهم أسباب فشلي، ومن خلال فحص دقيق للمؤسسة، حصل عندي الوعي أكثر بتربيع الدائرة الخاصة بالسياسة، حيث يلوح التوفيق بين التراتبي والتعايشي حلمًا مستحيلاً، على هذا النحو تتبدى لي متاهة السياسة.
Paul Ricoeur: La critique et La conviction, entretiens avec Francois Azouvi et Marc de Launay, Paris, Calmann-Lévy, 1995
[1] نسبة إلى جون داربي (1800ـ1882)، وهو ثيولوجي إنجليزي وقس أنجليكاني بلور مذهباً انتشر على الخصوص في البلدان الأنجلوسكسونية، وفي فرنسا بصورة هامشية، يبدو كنوع من الكالفينية الصارمة التي تركز على القدرية و« إفلاس الكنيسة».
[2] Roland Dalbiez, la méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, Desclée de Brouwer, 1936
[3] Honneur aux maîtres, présenté par Marguerite Lena, Criterion, Paris, 1933.
4 جون لانيو (1851 - 1894) وجول لاشوليي (18 18- 1832) يجسدان التراث التأملي الكبير في الفلسفة الفرنسة. وقد كان لانيو بالأخص أستاذاً للفيلسوف ألان، الذي لم يخف يوماً إعجابه وتقديره له، يشهد على ذلك نشره لدروسه بعد وفاته تحت عنوان: Célèbres Leçons et fragments، وبالنسبة إلى لاشوليي يمكن الاطلاع على أعماله التي ظهرت في مجلدين:
Œuvres,2 vol,Paris 1993,t1.Fondement de l'induction suivi de la psychologie et métaphysique et de notes sur le pari de Pascal, t2: Etudes sur le syllogisme, suivi de l’observation de platon et de notes sur le Philébe.
5 جورج دافي (1883 - 1976) كان على التوالي رئيساً لجامعة رين (1939)؛ ثم أستاذاً لعلم الاجتماع بالسوربون (1944 - 1955).
* نقابيان أمريكيان قادا تظاهرات عمالية احتجاجًا على ظروف العمل القاسية في ثمانينات القرن التاسع عشر، أدت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين تسببت في قتل شرطي. فألقي عليهما القبض، حكم عليهما بالإعدام ظلمًا، ونفذ فيهما الحكم على الرغم من عدم كفاية الأدلة. ومعلوم أنّه قد ثبت فيما بعد أنّ الشرطي قتل بيد أحد زملائه. (المترجم)
** سزنيك: حكم عليه عام 1924 بالسجن المؤبد بتهمة قتل بيير كيمنور أحد رجالات الصناعة بفرنسا، علمًا بأنّ جثة هذا الأخير لم يعثر عليها أبدًا. وقد حصل سزنيك على العفو سنة 1947 من دون أن تتم تبرئته تمامًا من التهمة المنسوبة إليه.مات سنة 1954 متأثرًا بجراحه بعد أن دهسته شاحنة سرعان ما لاذت بالفرار. (المترجم)
*** المارشال بيتان: عسكري وسياسي فرنسي، نال في الحرب العالمية الأولى شهرة واسعة بعد الانتصار الكبير الذي أنجزه على القوات الألمانية في معركة فردان سنة 1960، ثم صار في الحرب العالمية الثانية شخصية مثيرة للجدل بعد تعامله المشبوه مع الاحتلال الألماني وقبوله تولي منصب الرئاسة في القسم غير المحتل من فرنسا. وبعد انتصار الحلفاء قدم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام لتعاونه مع الاحتلال النازي، ولكن ديغول أنزل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتوفي عن عمر يناهز 95 عامًا. (المترجم)
[6] Z.Sternhell, Ni droite ni gauche, Le Seuil, Paris 1993
ولمناقشة أطروحات سترنهيل سنعتمد على الدراسة التي أنجزها فيليب بورين ضمن كتاب:
Histoire des droites en France (sous la direction de J.F.Sirinelli), Gallimard, Paris, 1992, t1, chap x, «le fascisme», p603-652 (coll «NRF-Essais»).
* (SFIO): هي الفرع الفرنسي للأممية العالمية. (المترجم)
* جريدة ساخرة كانت تتداول في الخنادق من قبل الجنود، أصدرها جوى غالتيي بواسيير عام 1915. (المترجم)
Stukas *: قاذفة قنابل ألمانية استعملت خلال الحرب العالمية الثانية. (المترجم)
Pétanisme **: نسبة إلى المارشال بيتان (المترجم).
7 أقيمت هذه المدرسة في البلدة الصغيرة لأورياج، بالقرب من غرونوبل، وهي أشهر مدرسة لتكوين الموظفين السامين والمسؤولين عن أوراش الشباب خلال أشهر تُخَصَّصُ للتمارين البدنية والسجالات الإيديولوجية. وقد تولى الإشراف عليها النقيب دونوايي دوسيغونزاك (Dunoyer de segonzak)، وشَكَّل فيها كل من برودون، وموراس (Maurras)، وبيجي (Peguy)، المراجع الفكرية الأساسية.
ss *: وحدات من الشرطة العسكرية التي كانت تحارب على الجبهة في عهد هتلر (المترجم).
** شتتن: عاصمة مقاطعة بوميرانيا فويفود الغربية في بولندا. وتعد سابع أكبر مدينة في البلاد (المترجم).
Quakers *: أعضاء في حركة دينية تنتشر أساسًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، عُرفت برفضها للحرب ودعوتها للسلم والبساطة في العيش(المترجم).
Oflag **: معسكرات اعتقال ألمانية خصصت للأسرى من الضباط خلال الحرب العالمية الثانية (المترجم).
8 كارل يسبرز) 1883 ـ 1969 (: مارس التدريس بهيدلبرغ في الفترة الممتدة من 1922 إلى 1937، أقاله النازيون من مهامه سنة 1937. وبعد الحرب، قرر بعدما خاب أمله في ردود الأفعال الأولى إزاء المسؤولية الجنائية عما حدث، الهجرة إلى سويسرا حيث درّس في جامعة «بال» ابتداءً من سنة 1948 إلى غاية بلوغه سن التقاعد.
9 قام كوسطاس أكسلو وجون بوفري بإنجاز ترجمة مشتركة لكتاب: ما الفلسفة؟ لهيدغر(Gallimard,1957)؛ لقد مر استقبال هيدغر في فرنسا بصورة تكاد تكون كلية عبر بوفري الذي وجه له رسالة حول النزعة الإنسانية (1947)، كما أتيح لهيدغر التعرف على روني شار سنة 1955، من خلال جون بوفري.
[10] Karl Jaspers, Strindberg et Van Gogh, trd fr, Paris 1953
11أوجين فنك (1905 ـ 1957) ولودفيغ لاندغريب (1902 ـ 1992) كانا معاً أستاذين مساعدين لهوسرل في العشرينات.
12 إيمانويل مونيي، المتأثر كثيرًا بـجاك ماريتان (J. Maritain) وغبرييل مارسيل، يجسد الوجودية المسيحية. أصدر قبل اندلاع الحرب أعمالاً من أهمها:
Revolution personnaliste et communautaire, Paris 1935
وبعد الحرب، نشر علاوة على كتابه: Traité du Caractère (1946) كتابين هامين هما:
Introduction aux existentialismes (1947) وQu’est ce que le personnalisme? (1947).
13 ترك بول لوي لاندسبيرغ (1905 - 1944) ألمانيا مباشرة بعد وصول هتلر إلى السلطة. وبعد انصرام مدة قصيرة درّس فيها بإسبانيا (1936-1934)، حَلَّ بفرنسا حيث تعاون مع مونيي في تسيير مجلة إسبري، بعدها نُفي إلى معسكر للاعتقال بـ "أورانيينبورغ". (Uranienburg)
14 يُصَنَّفُ جون نابير (1960-1881) ضمن التراث الفرنسي للفلسفة التأملية. أهم أعماله:
Liberté (1924)l᾽expérience intérieure de la، وقد أعيد نشره سنة 1944 في سلسلة P.u.f وقدّم له بول ريكور؛ ثم كتاب: Eléments pour une éthique (1924)، تمت إعادة طبعه ضمن منشورات أوبيي (Aubier)عام 1962 بمقدمة خَطّها أيضاً بول ريكور؛ وكتاب: Essai sur le mal (1955]، أعيد طبعه ضمن منشورات أوبيي (1970).
*حي يقع في المقاطعة السادسة، وهو مكان يلتقي فيه المثقفون الباريسيون، وقد ذاع صيته أيام ازدهار الفلسفة الوجودية في سنوات 1940 ـ 1950 (المترجم(.
[15]. Paul Ricoeur: Lectures II, La contrée des philosophes, Le seuil, Paris, 1922, p137-148
16- أعيد نشره ضمن كتاب: Eloge de la philosophie, Gallimard Paris, 1965
[17] Paul Ricœur, Lecture I. Autour du politique, Le seuil, Paris, 1991, p 368-397.
[18] De l’interprétation, Essai sur Freud, Le Seuil, Paris, 1965, 534 pages.
[19] Mircea Eliade: Traité d'histoire des religions, Payot, Paris, 1949.
* الشمانية: ديانة بعض شعوب سيبريا ومنغوليا الوسطى، تتميز بعبادة الطبيعة والقوى الخفية... (المترجم).
20 إنّه عنوان أكثر كتب غادمير شهرة، صدر سنة 1960 في توبنغن Tubingen وعنوانه الكامل هو:
Warheit und Methode. Grunzug philosophischen Hermeneutik.
[21] Hans Georg Gadamer, Années d’apprentissage philosophique: une rétrospective, Critérion ,1992.
22 تعتبر هذه الدروس الملقاة في جامعة إدمبورغ بمثابة امتياز أو وسام على صدره.
[23] René Rémond, La règle et le consentement: gouverner une societe, Fayard, Paris, 1979,480 pages.






