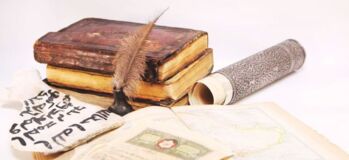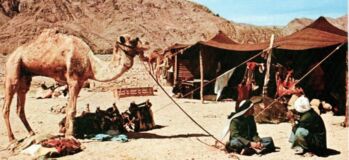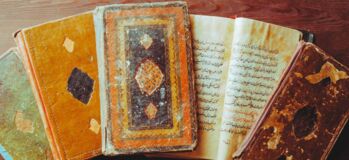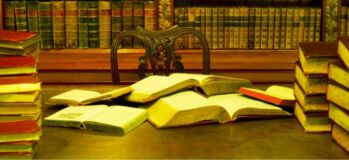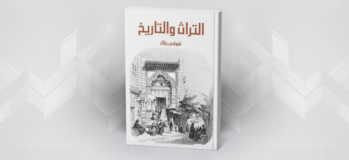غادامير* والعـودة إلى التُراث، والتاريخ مُطارحات في نقـد المنهج الوضعي
فئة : مقالات
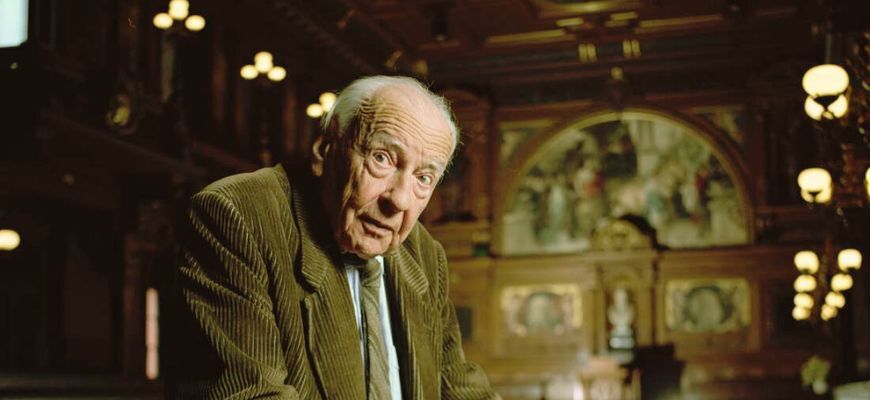
غادامير* والعـودة إلى التُراث، والتاريخ
مُطارحات في نقـد المنهج الوضعي:
فرش تقديمي:
إذا كان ثـمَّة ما يُعطي لـ غادامير خُصوصيته الفكرية، فهو ذلك الوعي بإشكالية التراث والميراث التي بلغها المشروع الثقافي الغربي، وهو يشارف عصـر انهيار الإيديولوجيات الكبرى وانقضاء سلطانها الفكـري على الأقل الذي سيطبع تاريخانية هذا المشروع مع اقتراب القرن العشرين من نهايته. فلا يضير خصوصيته الفكر الغاداميري في هذا المضمار جنوحه نحو المنهج المعرفي أحيانا في تلمسه لنظرية التأويل التي كان مطمحها الأساسي يتمحور حول إعادة اكتشاف العلاقة الكينونية بين الوعي والتراث بشموليته الإنسانية وعمقه التاريخاني.[1] فهو الذي حقق تلك القفزة الوجودية بين أن يكون موقف المؤول ناقلاً ومُفسراً للماضي، وبين أن يكون سائلا ومحاورا. فالمؤول لا يرث ميراثا ولكنه يستحضر تراثا. والاستحضار لا يأتي إلا نتيجة كون السؤال هو فن التفكير؛ أي تجاوز حُدود الميراث وإطاراته نحو آفاق التراث الذي صنعه وجعل الطريق مفتوحا في الوقت ذاته نحو تجاوزه. فالميراث غير القابل للتأويل ليس سوى عقبة في وجه الفكر السائل. إنه يطلب منه التلقي فقط. وبذلك يشل حريته؛ لأنه يطلب الاقتداء به لا الانتماء إلا الاستراتيجية التي صنعته وسمت عناوينه وتصانيفه.
من هُنا يغدُو التأويل مُثاقفةً؛ لأنه لا يوجه سؤاله إلى الأصل: كيف هو بل كيف كان. إنه يُريد أن يكشف عن الفعل، عن القوة الخارقة التي عندما عملت في كنف الجماعة خلقت شيئا صار اسمه أصل. المثقافة هي مُساءلة التراث عن فعل كينونة التي صيرته تراثا. إنها تتخطى حاجة الفهـم، كما فسر ذلك غادامير، إلى حاجة إعادة الأنباء. لا تريد اكتشاف أو فهم القوة الخارقة للأصول فحسب، بل تُريد استعادتها، استحضارها. إنها تمارس عمـل الفهـم من أجل تخطي الكينونة إلى ما يجعلها كينونة دائماً "فإن غادامير لا يستطيع أن يكون هيدغرياً حقيقياً، دُون أن يكون نيتشوياً فـي الآن ذاتِه. ولكنه لـم يكن نيتشوياً أبداً. ولذلك، ظل درجة أدنى في سلّم الصُعود الهيدغري. إنه أقل طموحاً، وفكـرته عن التراث لم تبرح كثيراً حدود نظرية المعرفة التي ثار عليها."[2]
والحقيقة، فإن كبار فلاسفة التاريخ كانوا يقعون، عندما يُبالغون فـي خطأ إجرائي أو تصـور تجريدي شُمولي فـي ذلك الالتباس بين التراث والميراث. وكانت تلك الصلة العضوية التي تربط فيلسوف التاريخ بميراثه القومي والحضاري تحكم موقف التأويل عنده في صلته الكينونية بالتراث. وفرق نوعي كبير بين الصلة العضوية والصلة الكينُونية، يتجاوز المرتيبات والدرجات؛ وذلك ما يميز هايدغر عن نيتشه. فلقد أنسن نيتشه التاريخ من مدخل حيوي ديونزيوسي، ولكنه لم يكتشف فيـه الميثولوجيا، بِقدر ما تماهى مـع ميثولوجيا تتشبه بالكينونة دُون أن تُدركها؛ لأن هُـوة سحيقة تفصلهما دائماً، كمـا تفصل بين التراث والميراث. ولـعل ذلك أيضاً هـو السبب نفسه الذي باعد فكريا وشخصيّا بين نيتشه وصديقه المؤله لديه الموسيقار فاغنر؛ إذ كان أسلوب اللحن الموحّد LEITMOTIV الفاغنري يراه نيتشه تتويجا للوحدة العضوية للميراث الجرماني، فـي حين كان صديقه يجهد في سبيل تحريره من ربقة الميراث للقفز بـه إلى حلبة الكينونة التراثية للإنسان. فقد كانت ملامحه الموسيقية الكـُبرى تضج بالتجربة الجرمانية، ولكـن بوصفها جسراً مشرُوعاً مُتميزاً، وربما مُتفرداً، فانه يدخل تراث الإنسانية مُكوناً لـهُ وكينونياً فيـه وبه.
أما غادامير الذي كان يهمُه أن يقدم تجربة شخصـية تبلور علاقـة الوعـي بالكينونة، فقد وجد في العلاقة مع التراث ما يعطي أساسا موضوعية لهذه التجربة، إلا أنه دخل إلى هذه التجربة من باب الفلسفة التاريخانية. في هذا السياق، يقول مطاع صفدي: "لقـد خشي من التقاليد المنهجية حول الموضُوعية أن تلقي بظلها البارد على حرارة الموضوع الإنساني الذي اكتشفه فـي حواريته الغنية مع التراث. فانتقد كل الميراث الموضوعـي في البحث التاريخي ليجعل الاعتراف بمؤثرات الذاتية عاملاً ايجابياً وليس سلبيا في تكوين النظرية تأويل"[3]. إلا أنَّ ذلك لا يكفـي، فما نأخذه على غادامير أنه خرج عن منهـج الكينونة الزمـانية عنـد هيدغر، واتخذ لـه كرسياً علموياً حول مائدة العلمويين التاريخويين ليناقشهم من موقعهم وبسلاحهـم، وليجعلهم يقرون له أخيرا بنقل ما كان فـي مرتبة السلب ضمـن سياقهم بالذات، إلى مرتبة الإيجاب فيـه. فهُو ذهب إلى حقلهم وجلس فيه، ولم يأت هو بهم إلى حقله؛ أي إنـه قبل أن يغادر شخصيتهُ كصاحب نظرية في التأويل، إلى شخصية بين مفسر بين المفسرين. ولـكنه مُفسر يعترف بين أعضاء ناديه أنه ذاتي، وأنهُ لم يستطع أن يتخلص تماماً من هذه الذاتية التي ندري إن كان يستحسن في النهاية رفضها من حيث يتم الاعتراف بها على استحياء.
1-1 نقد مـزاعم المنهج التجريبي:
تجلّت عودة غادامير إلى العلوم الإنسانية في مُساءلة نقدية لأسس وشرعية هذه العلوم، وهذا المسار التقويم من شأنه أن يفند مزاعم الحقيقة المثالية كأساس نهائي للحقيقة الإنسانية كما رفعت رايتها التاريخانية والوضعانية[4].
فما ينبغي، تأكيده ههُنا، إنّ غادامير لا يُعارض العلم التجريبي في ذاته، ولكن ما يرفضه هو إسناد المناهج العلمية وإجراءها داخل الدراسات الإنسانية، وغادامير في هذه العودة الدؤوبة يُحاول تبيين الخاصية الجوهرية التي تنفرد بها العلوم الإنسانية عن نظيرتها العلوم الطبيعية وهو هنا، يتبـع دروب "هيدغر"2 **.
وأما السؤال الذي يطرحه هو كالآتي: هل يمكن إخضاع هرمينوطيقا الفهم إلى مزاعم المنهج الإجرائي، الذي حدّده العلم الحداثوي؟ أم إنّ فهم النصوص وتأويلها لا يتعلق أصلا بمسألة إجراء منهجي بحكم موضوعها هو عالم الإنسان؟ وعلى الرغم من أن الهرمينوطيقا تعنى بالمعرفة والحقيقة أيضا، لكنها لا تعنى ابتداء ببناء المعرفة المثبتّة، حتى تفيّ بمطالب النموذج المنهاجي للعلم؛ وفي ضوء هذا، فأيّ نوع من المعرفة، وأيّ نوع من الحقيقة نريد؟[5]
يًجيب غادامير قائلا: »إن العلوم الإنسانية مرتبطة بأشكال من التجربة تقع خارج العلم؛ أي إنها ترتبط بتجربة الفلسفة، والفنّ والتاريخ نفسه، وهذه هي جميع أشكال التجارب التي بلغتها حقيقة معينة، حيث لا يمكن التثبت منها بوسائل منهاجية مناسبة للعلم«[6].
فالكثير إذن مما يمكن أن نجاهره لا يمكن بلوغ الحقيقة بواسطة التصورات المحضة والأطر المنهجية والقوالب المجردة[7] وهذا يصدق بوجه خاص على التراث ومن ثمة على التاريخ والفن. وبما أن التراث ليس مثبّتا بقواعد علمية، وبالتالي لا يمكن إعادة تأصيله بطريقة اصطناعية[8]. فنحن لا يمكننا أن: "نتعامل معه عن بعد من خلال قواعد وأدوات منهجية، كما لو كان موضوع منفصلا عنا. فالوعي الإنساني عند غادامير هو وعيٌ محكوم تاريخيا؛ أي محكوم بمحدّدات تاريخية فعالة، ومؤثرة في وعينا التاريخي والعلمي الحديث"[9].
وبـاتخاذ غادامير، موقفا لترجيح الوعي التاريخاني، ومسألة شروط إمكان علوم الروح بؤرا لتفكيره. فإنه حتما قد وجه الفلسفة الهرمينوطيقا لرد الاعتبار للأحكام المسبقة، ونحو تقريظ التراث والتقاليد والسلطة، كما أنه قد وضع هذه الفلسفة في مركز نزاعي مع كل نقد الإيديولوجيات[10].
إنَّ القضية التي تمرد عليها مؤرخو القرن التاسع عشر جميعا، لم تكن حقا تاريخية، وإنما فلسفية، وفي أساس الاتجاه التجريبي قام افتراض – تاريخي-يطالب بإزاحة الذاتية في البحوث التاريخية، بدعوة لابد أن تكون هنالك هوة أبدية بين طالب المعرفة، وموضوع المعرفة؛ أي (معرفة ما حدث موضوعيا وبالاستقلال عن العارف (، وهكذا يصبح التاريخ علميا.[11]
2-2 تجاوز الموضوعاتية في التاريخ
ومن بين هؤلاء، نجد المؤرخ الألماني فون رانكيه )1795 - 1886(، والمؤرخ درويسن الذين حاولوا "بناء تصور تجريبي حول التاريخ يجمع بين التجربة والفهم ويتجاوز التصور العقلي المحض الذي تبناه هيغل. وعليه، لا تنفك هذه الدعوة إلى بناء تاريخ وفق أسس علمية، عن درجة العلمية التي تتوخاها أو بالأحرى إلى الارتقاء بالتاريخ إلى (علم تجريبي)، ولا يتسنى له ذلك سوى باستعارة المفاهيم والآليات التي تتبناها علوم الطبيعة وتطبيقها على المنهج التاريخاني".[12]
لكن من وجهة غادامير، فإن النزعة التاريخية لا يمكن وصفها إلا بـ ـ"التاريخانية الساذجة"[13]؛ لأنها لم تنظر إلى أسبقية المباعدة الزمنية بوصفها عامل إيجابي لإنتاج الفهم، فهـي مشبعة بالاستمرارية لمصدر التراث. كما أنها النور الذي ينير كل مرجعية تقليدية[14].
وبما أن المؤرخ في التاريخ، مقيد بتجربته الخاصة في دراسة الحادثة التاريخية الأمر الذي يفصح باستحالة إخضاعها للإجراء العلمي، كما أن الأحداث التاريخية لا تقدم ذاتها للمؤرخ في صور أحداث جاهزة ومنتظمة، بل هي مواضيع تبدو بالجملة، أحداث مبعثرة ومتنافرة، لكنها تدور وتتمفصل حول تجربته. وفي ضوء هذا السيلان الأبدي لهذه الأحداث والتجارب تغدو تلك الحادثة، المرآة التي تتأمل عبرها اجتهاداته وإمكانياته المكتوبة وكذا حدوده الممكنة. وأما معضلة الروح الموضوعية، تحل مكانه المسافة الكائنة بين فهم الذات، وبين التجارب كموضوع للمعرفة التاريخية[15].
زد على ذلك، التراث ليس مجرد أثر من الأثريات، التي تعيننا على إنتاج أو إعادة تأثيل العالم العقلاني الذي تنتمي إليه بوصفها بقايا الماضي، ولا هو مجرد مصدر من المصادر التي تؤلف تراثا لغويًّا مفسّرًا لعالم ما، وتكون بمثابة سجلات تمّ حفظُـها، وآلت إلينا بغرض الاسترجاع[16].
ولا يخفى على ذي نظر فالمأزق الذي وضعت فيه التاريخانية ذاتها، يبدو بشكل واضح للعيان، هو لما ألغت جميع الأحكام المسبقة الخاصة بالمؤرخ لصالح مناهج صارمة، جاء في اعتقادها أنه لو احتذى أي مؤرخ بهذه النمذجة حتما سيضمن الموضوعانية في أبحاثه التاريخانية والإنسانية معا[17].
لكن نحن كما يعتقد ريكور- ليس بمقدورنا أن نتجرد من الصيرورة التاريخية، ولا يمكن أن نضع ذواتنا عن مبعدة عنها، وحتى يصير الماضي بالنسبة لنا كموضوع، فنحن دوما ساكنون في التاريخ؛ أي إدراكنا يتحدّد بإزاء هذه الصيرورة التاريخية حقيقية، حيث لا توجد لنا حرية لإزاحة الماضي. ويدعونا بول ريكور تارة أخرى، إلى إدراك الفعالية التاريخية التي تؤثر فينا، أو تضغط علينا؛ ذلك لأن كل تاريخ عشناه يفرض علينا حتمًا أن نأخذه بعين الاعتبار، سواء أشئنا ذلك أم كرهناه. وعلى هذا الأساس لا بد أن نتحمل عواقبه وحقيقته[18].
وفي ما يزعم غادامير، نحن لا يمكننا أن نتصور أحداث الحرب العالمية الثانيـة مثلا، كمجرد نسخ انبثقت من رحم الحرب العالمية الأولى، ولا يمكنها أن تكون بنفس النمذجة؛ ذلك لأن الإدراك اللاحق للأحداث الثانية جاء بأبعاد دلالية مغايرة، وقيما رمزيَّة ً متفاوتة في الصراعات التي ميزت الإنسانية في القرن الماضي بعد حرب 1914- 1918[19]يضيف قائلا: »فالمؤرخ لا يعيش الأحداث التي عاينها الأفراد، والتي يخضعها للتحليل والبحث والاستقصاء؛ لكنه يستعين بتجربته الخاصة في إدراك وفهم هذه الأحداث، وهو في نهاية المطاف إدراك عميق لتجربة الحياة كما تنكشف في وعي ممارسات الأفراد، كما يذهب إلى ذلك دلتاي )...) وعليه يدرك الفرد حياته كجملة مركّبة ومتداخلة من التجارب الحيوية، ويدرك هذه الأخيرة بناءً على رؤيته الكلّية والشاملة لحياته في خصوصيّتها. بالقياس، يدرك المؤرخ في حقل التاريخ مواضيعه كجملة أحداث مبعثرة ومتنافرة، لكنها تدور وتتمفصل حول تجربته في ضوء هذا السيلان الدائم لهذه التجارب والأحداث التي تصبح المرآة التي تتأمل عبر اجتهاداته وإمكانياته المكتوبة وكذا حدوده الممكنة. حلقة الفهم، فهم الكل والأجزاء في صورة متبادلة واستلزامية«[20].
وعلى الجُملة، فإن ما يمكن قوله، إنّ النزعة التاريخانية أطمئنت إلى إجراءاتها المنهجية، وتغافلت بشكل كبير عن تاريخيتها، [21] وهي بذلك تخفي حقيقة مفادها؛ أن الوعي التاريخي هو ذاته متموضع ضمن نشاط التأثيرات التاريخية، وهي بهذا الزعم المنهجي، تحاول التخلص من اعتباطية تكييفات الماضي ولكنها في جانب أخر تحتفظ بطبيعتها الأصيلة، وتغفل الصلّة الخاصة بالافتراضات المسبقة، والتي في الأصل، هي من يحدّد فهمها الخاص[22].
فالموضوعية التاريخية تشبه، إلى حدّ ما الإحصائيات التجريبية هذه الأخيرة التي تستخدم أدوات بارعة، حيث تغدو الوقائع عبر هذه الأدوات تتحدث بذاتها، لكن على مستوى التاريخ الأمر مضاد تماما؛ ذلك أن علم تاريخ لا يمكننا إدراجه في قالب إجرائي. بما أنه يتعلق بفعالية التاريخ التي تؤثر فينا عبر المسافات الزمنية. وحين يتنصل إيمان ساذج بالمنهج العلمي وجود التاريخ المؤثّر، فحتما سيفضي بالمعرفة التاريخية تشويها حقيقيا. ونحن ندرك هذا جيدا، من خلال تاريخ العلم، حيث تتنازع فيه الحجج الدامغة على أشياء زائفة، ولكن على الإجمال، حتى التاريخ لا يعترف بها – الموضوعانية-وهذه هي بالتأكيد السلطانة التي يزاولها التاريخ على وعينا الإنساني المتناهي؛ فالتاريخ يظل يؤثر فينا باستمرار حتى لو دفع الإيمان بالمنهج الفرد إلى إنكار تاريخانيته.[23]
لكن ومهما يكن من أمر، فإن ما ينبغي إقراره، في ختام هذه المحطة، هو أنّ النزعة التاريخانية، لا تتعامل مع التراث كموضوع عياني ملتحم بخبراتنا، وإنما تتعامل معه بصورة تجريدية مقننة، ومن ثم فهي توسع الفجوة بين الذات والموضوع ومثل هاته النزعة المنهجية التي تحاول أن تموضع التاريخ كليا، هي نزعة ساذجة؛ لأن الوعي الذي يحاول الفهم في هذه الحالة يجهل علاقته بالمحددات المسبقة أو التاريخ الفعال الذي يؤثر فيه، وبالتالي يفترض أن فهمه لا يكون مثبتا بالحدث التاريخي وداخلا في سياقه[24]. وفي نفس الأرضية، نجد التاريخانية، تقع في نفس المأزق الذي وقعت فيه الرومانسية، هذه الأخيرة التي كانت تتباهى بالخرافة عوض أن تحتفي باللّوغوس، وترافع عن القدامة على حساب ما هو حديث، وفي ما يخص المسيحية التاريخية في مقابل الدولة الحديثة والجماعة الأخوية في مقابل الاشتراكية القانونية، واللاوعي الإبداعي، في مقابل الوعي العقيم، والماضي الأسطوري ضد مستقبل اليوتوبيات العقلية، والمخيلة الشعرية ضد العقلانية الباردة.[25]
لقـد دلتاي اهتم بالتأصيل المنهجي للتاريخ، وهو في هذا يؤكد أن هذا التأصيل دخل حالة أزمة حادة مع الروح العلمية التي حاولت السيطرة على العلوم التاريخية، خاصة كما تجسدت عند المؤرخ الإنجليزي "توماس بكل" )1828-1868(، الذي حاول تطبيق المنهج العلمي على التاريخ، سعيا من وراء ذلك التنقيب عن قوانين علمية، تتحكم بالحركة التاريخية وذلك في كتابه تاريخ الحضارة البريطانية[26]. وقد أعطى درويزن، )1808-1884 (، في كتابه التاريخ شكل أولي ومنهجي خاص بالعلوم التاريخية، حيث كان لها أثر كبيرا لدى المهتمين كونها كانت ملحقة؛ إذ صح التعبير، ومرتبطة أشد الارتباط بالإشكال الذي طرحه كانط في هذا المجال[27]. وينبغي، أن ندرك تمام الإدراك، بأنَّ الحادثة التاريخية كيما يتصورها درويزن، لها خصوصياتها ومنطقها الخاص، فهي ظاهرة محكومة أساسا، بالأطر الأخلاقية والروحية، فالتاريخ مثل الطبيعة له نظامه الخاص، وهو معاد بكيفية أخرى، وله حريته، ومسؤوليته ومضمونه الأخلاقي[28].
وكان دروسين يؤكد أن الاستمرارية هي جوهر التاريخ؛ لأن التاريخ فيما يؤكد دروسين يحمل دلالات ابيستمية مصوبة في الصميم إلى المثالية التاريخانية لدى هيغل والقائلة "بوجود غائية قبلية خاصة بالتاريخ[29]. يرفض-درويسن-هذا التصور وحجة في ذلك »فنحن في دراستنا للتاريخ، لا نستطيع مشاهدة الغاية الدورية للتاريخ، إنما نشاهد اتجاهها فقط، إن هاته الغاية مجرد شيء نشعر به بغموض ونؤمن به فقط. يرتقي التاريخ إلى مرتبة الحصافة العلمية، وبهذا الافتراض أيضا يكون هنالك توازي بين يقين المعرفة التاريخية وموضوعية العلوم الطبيعية[30]. إن المشكلة المركزية التي شغلت أبحاث المدرسة التاريخانية*، وكرّست من أجلها جل جهودها، هي "الموضوعية التاريخية"، التي بمقتضاها يقف المؤرخ على مسافة من الواقعة التاريخية، محاولاً الإمساك بها والسيطرة عليها على نفس النحو الذي يسيطر به العالم الطبيعي على الظاهرة الطبيعية أثناء البحث.
وبهذا الاعتبار، يمكننا القول، إن المدرسة التاريخانية هي أحد التيارات الفلسفية التي تأثرت بالمنهج العلمي، وعملت على تطبيقه في مجال البحوث الإنسانية، حيث نجد في مقدمتها المؤرخ "درويسن" 1884-1808 الذي أهتم بالتأسيس المنهجي للتاريخ[31]. وهو في هذا يرى بأنه: »لا يوجد مجال علمي لا ينبع من التاريخ فالعلوم الطبيعية تحمل دلالات تاريخية، وجاذبية علوم الروح، تتمثل في المعرفة التاريخية، ومن خلالها تتحرك هذه العلوم، وتؤكد مبدأ الديمومة والاستمرار في أبحاثها«[32].
إنّ النموذج الذي يستعيره درويسن هنا فيما يخص العلوم الطبيعية، يحمل دلالات إبيستمية مصوبة في الصميم إلى المثالية التاريخانية لدى هيغل والقائلة "بوجود غائية قبلية خاصة بالتاريخ[33].
يرفض-درويسن-هذا التصور وحجته في ذلك »فنحن في دراستنا للتاريخ، لا نستطيع مشاهدة الغاية الدورية للتاريخ، إنما نشاهد اتجاهها فقط، إن هاته الغاية مجرد شيء نشعر به بغموض ونؤمن به فقط«[34]. وأما الغاية النهائية لجميع أهدافنا التي يتجه نحوها النشاط الإنساني المتواصل. فيما يعتقد- درويسن-لا يمكن إثباتها إلا بواسطة البحث نحو الذات؛ بمعنى أن يرتبط المؤرخ بالظواهر والحذر من فرض بنية ميتافيزيقية عليا؛ بمعنى آخر إن غاية البحث التاريخي كما يفترضه هذا التصور، لابد أن يتوجه نحو) الماضي التاريخي ذاته (؛ لأنه لا وجود لشيء خارج التاريخ، ولا يتحقق الفهم إلا بالرجعة إلى التراث التاريخي.[35]
وقد ذهب إلى نفس هذا التصور-المؤرخ الألماني رانك rank، )1795 - 1886(، الذي اعتبر أن الوعي التاريخي مهم لفهم الشهادات الماضوية، لكن تحري الموضوعية العلمية، بحسب زعمه لا يمكنها أن تتأسس، إلا إذا اعتبرنا أن كل حادثة جزئية تاريخية ينبغي أن تفهم في سياق عصرها.[36]
والواقع، أن هاته التوجيهات الفلسفية التي يفترضها - كل من درويسن ورانكي- تفترض بوجود هوة أبدية بين "طالب المعرفة" و"موضوع المعرفة"- وتساوي بين يقين المعرفة التاريخية وموضوعية العلوم الطبيعية، ومعرفة ما حدث موضوعيا بالاستقلال عن العارف[37] .
وبهذا يصبح التاريخ علما؛ بمعنى أن همة درويسن ورانكي-تبحث في، إثبات الوقائع وتركها "تتكلم بنفسها".
لقد أصرّ هذا الطرح - فيما يرى غادامير- على موضوعية الماضي، واعتقدوا أن معناه يمكن أن يتحقق، بواسطة استخدام مناهج البحث العلمي، حيث يتم استعادته في شكله الأصلي، دون الرجوع إلى اللحظة الحقيقية للواقعة التفسيرية. وفى هذه الحالة، ستكون حقيقة الماضي مجرد مطابقة لما حدث حقيقة، مع إعادة بنائه النموذجي في عقل المؤرخ، ونتيجة لذلك يتقيد المؤرخ بموقفه الأثري archéologique.[38]
لكن السؤال الذي يطرحه غادامير هاهنا: أين تتجلى درجة العلمية في هذا الافتراض الأثري archéologique الذي يلجأ إلى مثل هاته الافتراضات النسبية، دون الاستناد إلى أحكامنا وتصوراتنا التي نكونها على التاريخ الماضي؟[39] فالتراث ليس مجرد أثر من الأثريات (Vestiges)، التي تعيننا على فهم أو إعادة تأسيس العالم العقلاني الذي ننتمي إليه بوصفه بقايا الماضي، ولا هو مجرد مصدر من المصادر resources التي تشكل تراثا لغويا مفسرا لعالم ما، وتكون بمثابة سجلات تم حفضـها وآلت إلينا بغرض استرجاعها في حاضرناـ[40]
ولا يخفى فالمأزق الذي وضعت التاريخانية فيه نفسها عندما حاولت الدفاع عن الماضي على حساب الحاضر[41]. ويعبِّر البعض عن فداحة هذا المأزق بأنه إذا كان كل عصر يمكن أن يُفسَّر عن طريق الرجعة إلى ذاته، فإن نفس هذا المبدأ ينبغي أن يكون صحيحًا بالنسبة إلى عصرنا الراهن. فرأينا المتعلق بعصرنا ينبغي أن يتحدد بالرجوع لحاضرنا، وبذلك يكون رأيًا نسبيًا؛ لأن عصرنا يمثل عصرًا واحدًا فقط من بين عصور عديدة.[42] وبناء على هذا الأساس، فإن التاريخانية الساذجة كما يصفها غادامير، تتجاهل تاريخا نية الفهم التاريخي برجعتها إلى الماضي، وهي بذلك لا تضع في الحسبان الإطار الجدلي الذي تتحول فيه هاته التجربة. يقول غادامير: »فـنحن لا يمكننا أن نرى في أحداث الحرب العالمية الثانيـة مجرد نسخة طبق الأصل تتكرّر في أحداث الحرب العالمية الأولى، وإنما إدراك المعنى الأصيل لهذه الأخيرة الذي يجد نفسه في تحول مستمر ويتخذ أبعادا دلالية وقيما رمزيا متباينة في الصراعات التي ميزت الإنسانية في القرن الماضي بعد حرب 1914-1918.« يضيف قائلا: »فالمؤرخ لا يعيش الأحداث التي عاينها الأفراد، والتي يخضعها للتحليل والبحث والاستقصاء؛ لكنه يستعين بتجربته الخاصة في إدراك وفهم هذه الأحداث، وهو في نهاية المطاف إدراك عميق لتجربة الحياة كما تنكشف في وعي وممارسة الأفراد كما يذهب إلى ذلك دلتاي.«[43].
وعليه، يدرك الفرد حياته كجملة مركبة ومتداخلة من التجارب الحيوية، ويدرك هذه الأخيرة بناءً على رؤيته الكلية والشاملة لحياته في خصوصيتها. وبالقياس، يدرك المؤرخ في حقل التاريخ مواضيعه كجملة أحداث مبعثرة ومتنافرة، لكنها تدور، وتتمفصل حول تجربته في ضوء هذا السيلان الدائم لهذه التجارب والأحداث والتي تصبح المرآة التي تتأمل عبر اجتهاداته وإمكانياته المكتوبة وكذا حدوده الممكنة؛ أي حلقة الفهم، دوما تتخذ جدلية الكل والجزء، ففهم الكل والأجزاء في صورة متبادلة واستلزاميه.
* غادامير جورج هانس (1900-2002 (فيلسوف ألماني، معـاصر، يـعد من أبرز مؤسسي مبحث التأويلية أو الهرمينوطيقا إلى جانب شلايرماخر، صاحب مؤلف الهرمينوطيقا الشهير، من أهم كتبه الحقيقة والمنهج الترجمة الفرنسية 1976م، فن الفهم الكتاب الأول 1982.ينظر جان غرا ندان، المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، ترجمة وتقديم عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون(بيروت)، بالاشتراك مع منشورات الاختلاف (الجزائر)، ط1 2007م ينظر في: ص ص 20-21
[1] - مطاع صفدي، إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت ط1 1986، ص 249
[2] - المرجع ذاته، ص 246
[3] - المرجع السابق، ص 248
[4] - محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات ص 60
2 - Paul Ricœur, Du texte à l‘action (Essais d‘herméneutique II),Editions Du Seuil, novembre , paris 1986, p96
يرى بول ريكور في كتابه هذا: بأن غادامير في كتابه "الحقيقة والمنهج" يقدم ذاته لإعادة إحياء الجدل الخاص بعلوم الروح، وهو في هذا ينطلق من الأنطولوجية الهيدغرية وبلمح أدق من انزياحها الأخير حول أعماله الشعرية الفلسفية. Ibidem
**هيـدغر (مارتن): (1889-1976) Heidegger (Martin) فيلسوف ألماني ذائع الصيت، يعد العرّاب الحقيقي للفلسفة الأنطولوجية. من أهم كتبه: الكينونة والزمان 1927 Être et temps، كانط ومشكلة الميتافيزيقاKant et le problème de la métaphysique 1929. ما الميتافيزيقا ؟métaphysique، ماهية الحقيقة 1932 De l’essence de la vérité محاولات ومحاضرات 1958Essais et conférences، بالإضافة إلى أبحاث أخرى كثير جدا. جان غرا ندان، المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، ترجمة وتقديم عمر مهيبل، مرجع سابق، ص 20
[5] - في الواقع، مطارحتنا لهذا السؤال جاءت بأسلوبنا الخاص، لكن المعنى العام، لهذا السؤال الذي طارحناه لا يخل بمحتوى السؤال الذي صاغّه الفيلسوف غادامير في كتابه: "الحقيقة والمنهج"، ينظر في كتاب: هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج (الخطوط الأساسيّة لتأويلية فلسفية)، مصدر سابق، الصفحة 27
[6] - المصدر ذاته، ينظر في المقدمة، الصفحة 28
[7] - هانس جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، مصدر سابق، ينظر في مقدمة المترجم "سعيد توفيق"، ص.14
[8] - المصدر ذاته، ينظر في مقدمة المترجم، الصفحة ذاتها.
[9] - المصدر ذاته، ينظر في مقدمة المترجم، الصفحة ذاتها.
[10] - "En prenant de préférence pour axe de réflexion la conscience historique et la question des conditions de possibilité des sciences de l‘esprit. Gadamer orientait inévitablement la philosophie herméneutique vers la réhabilitation du préjugé et l’apologie de la tradition et de l‘autorité, et plaçait cette philosophie heméneutique dans une possition conflictuelle avec toute critique des idélogies» Paul Ricœur, du texte à l‘ action (Essais d‘herméneutique II), p337
[11] -هشام شرابي، الفلسفة الوجودية والتاريخ، فيلهلم دلتاي، أوراق فلسفية، القاهرة ـ مصرـ العدد 07 ديسمبر 2002، ص ص 08-09
[12] - هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل: (الأصول، المبادئ، الأهداف)، ترجمة محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت )لبنان(، منشورات الاختلاف )الجزائر(، المركز الثقافي العربي )المغرب(، ط2 2006، ص 17
[13] - "la naïveté de ce qu‘on a appelé l‘historicisme. »Voir, Gadamer Hans George, la philosophie herméneutique, Avant-Propos, traduction et notes par Jean Grondin, op, cit, P83
[14] - Ce qui compte un vérité، C‘est de reconnaître dans la distance du temps une possibilité positive et productive de compréhension. Cette distance est remplie de la continuité de la provenance et de la tradition. À la lumière de laquelle se manifeste pour nous toute tradition. Ce n‘est pas trop peu que parler ici d‘une authentique productivité de ce qui est arrivé. chacun connaît L’impuissance singulière de notre jugement là où la distance des temps ne nous a pas dotés de critères Sûrs." ibid, P P 81-82
[15] - هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل: (الأصول، المبادئ، الأهداف)، مصدر سابق، ص ص18-19
[16] - هانس جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، مصدر سابق، ينظر مقدمة المترجم، ص22
[17] - هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل: (الأصول، المبادئ، الأهداف)، مصدر سابق، ص 19
[18] -p" ar là je veux dire d‘abord que nous ne pouvons pas nous extraire du devenir historique, nous mettre à distance de lui, pour que le passé soit pour nous un objet(…) Nous somme toujouurs situés dans l‘histoire(…) Je veux dire que notre conscience est déterminée par un devenir historique réel en sorte qu‘elle n‘à pas la liberté de se situer en face du passé. Je veux dire d‘autre part qu‘il s‘agit toujours à nouveau de prendre conscience de l‘action qui s‘exerce ainsi sur nous, en sorte que tout passé don nous venons à faire l‘expérience nous contraint de la prendre totalement en charge, d‘assumer en quelque sorte sa vérité". Paul Ricœur ,du texte a l‘ action (Essais d‘herméneutique II ),op cit , p 98-99
[19] - هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل: (الأصول، المبادئ، الأهداف)، المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.
[20] - المصدر ذاته، ص ص.19.18
[21] - هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج (الخطوط الأساسيّة لتأويلية فلسفية)، مصدر سابق، ص 409
[22] - هانز جورج غادامير، المرجع نفسه، الصفحة 411
[23] - المرجع نفسه، الصفحة ذاتها.
[24] - هانس جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، مصدر السابق، ينظر مقدمة المترجم، ص14
[25] - « c’est sur ce même terraine, sur ce même sol de question, que l’on magnifie le muthos au lieu, de célébrer le logos, que l’on plaide pour L’Ancien aux dépens. du nouveau, pour la Chrétienté historique contre l’état moderne pour La communauté fraternelle contre le Socialisme juridique, pour l’inconscient généal. contre la conscience stérile, pour le passé mythique contre le futur des utopies rationnelles, pour l‘ imagination poétique contre la froide ratiocination » Paul Ricœur, du texte à l‘ action (Essais d‘herméneutique II ), op cit, p 339
[26] - خديجة هني، إشكالية التأسيس المنهجي في العلوم الاجتماعية، طرح دلتاي، أوراق فلسفية القاهرة ـ مصرـ العدد 07، ديسمبر 2002، ص 15
[27] - Gadamer Hans George, L'art de comprendre. Écrits I: herméneutique et tradition philosophique, tradiction De l‘allemand par Marianna Simon, Introduction DE Pierre fruchon, Editions Aubier –Montaigne Paris, 1982 Voir (chapiter III Herméneutique et historicisme), P 49
[28] - بوزيد ص 76
[29] - Jean Grondin, Introduction à Hans –George Gadamer , Ed, du cerf paris ,1999 pp 98.99
[30] - هشام شرابي، الفلسفة الوجودية والتاريخ، فيلهلم دلتاي، أوراق فلسفية، القاهرة ـ مصر ـ، العدد07 ديسمبر 2002، ص ص 08-09
*كان نقد "الوعي التاريخي" عند كل من غادامير وهيدغر، موجها بالدرجة الأولى إلى المدرسة التاريخانية في ألمانيا؛ تلك المدرسة التي كان يمثلها في القرن التاسع عشر درويسن وفون رانكه، والتي تمثل امتدادا للهرمينوطيقا الرومانسية (التي يمثلها شلايرماخر ودلتاي بوجه خاص) على أن نفهم من ذلك أنها تضفي على التاريخ صبغة رومانسية على طريقة سير ولتر سكوت. إنها على العكس كانت تمثل اشد المحاولات صرامة لبلوغ تاريخ "موضوعي" لا يدع فيه عالم التاريخ مشاعره الشخصية تتسرب إلى التاريخ بل يدخل بكليته في العالم التاريخي الذي يود أن يصفه ينظر في كتاب
عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط2003.1 ص211
[31] - Droysen Georges, historique, vrin, 1967, p 97.99
[32] - ibid. 97
[33] - Jean Grondin, Introduction à Hans –George Gadamer ,Ed, du cerf paris ,1999 pp 98.99
[34] - Droysen Georges, historique, op cit, p 96
[35] - Hans. George. Gadamer, vérité et Méthode, op.cit ,p 240
[36] - Jean Grondin, l‘horizon herméneutique, de la pensé, contemporaine, paris, librairie philosophique, vrin,1993, p 76
[37] - هشام شرابي، "الفلسفة الوجودية والتاريخ: فيلهم دلتاي"، (أوراق فلسفية، العدد السابع، القاهرة، السنة 2002م) ص9
[38] - Hans .George .Gadamer , vérité et méthode , Op. Cit ,p 289,290
[39] - ibid , P291
[40] - هانس جورج غادامير، تجلي الجميل ومقالات أخرى، مصدر سابق 22
[41] - Paul Ricœur ,du texte a l‘action (Essais D‘herméneutique II ), op cit, p 339.
[42] - Jean Grondin ,l‘horizon herméneutique, de la pensé ,contemporaine, paris, librairie philosophique. Op cit, P. 77
[43] - هانس جورج غادامير، فلسفة التأويل: (الأصول، المبادئ، الأهداف)، ترجمة محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، منشورات الاختلاف الجزائر، ط2 2006 ص ص.19.18