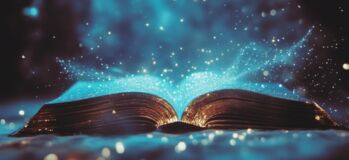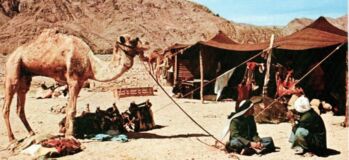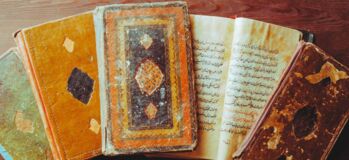التراث وجدل القراءة بين الداخل والخارج
فئة : مقالات

التراث وجدل القراءة بين الداخل والخارج
إن مجمل النصوص الأدبية والفلسفية والدينية لها "داخل" و"خارج". فالداخل هو البنية المكوّنة للنص: من كلمات وجمل وفقرات وموضوعات، وما تحمله من مضامين ورسائل. ولا شك أن النصوص تتفاوت من حيث هذا البناء؛ فبعضها محكم النسق والبنية، وبعضها الآخر أقل تماسكًا، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على المضمون سلبًا أو إيجابًا.
أما الخارج، فهو مختلف السياقات الزمانية والمكانية والثقافية التي ساهمت في تشكل النص، فضلًا عن القراءات والتأويلات التي رافقته عبر الزمن. فكثيرًا ما نتعامل اليوم مع تصورات وأفكار منسوجة حول نصوص فلسفية أو شعرية، دون أن نعود إلى النص نفسه لفهمه قراءة جديدة. وهذا يؤكد أن الداخل والخارج أمران لا مهرب منهما: فكل نص وُلد في سياق معين، ولا يمكن أن يظهر في فراغ. إن الداخل يتشكل من الخارج، لكن دون أن يستوعبه كليًّا، بل يوظف ما يخدم مقاصده ورسالته. فالنصوص لا تنشأ لأجل الداخل وحده، وإنما هي دائمًا في جدل مع الخارج: نقدًا أو توصيفًا أو تبجيلاً أو تبخيسًا.
ولهذا، فالنصوص التي خلّدها التاريخ هي تلك التي كان داخلها في اشتباك نقدي أو جدلي مع الخارج، فأنتجت معاني متجددة، وتناسلت عنها نصوص أخرى عبر أزمنة وأمكنة مختلفة. ومن هنا يتبين أن علاقة الداخل بالخارج تبدأ منذ لحظة الكتابة نفسها: فالنص الذي يكتبه المؤلف في شبابه قد يختلف عن نصوصه في مراحل لاحقة، بتغير الظروف الزمانية والمكانية التي تحيط به، رغم وحدة المصدر. ففكرة انبثاق النص من عقل المؤلف ووجدانه لا يمكن فصلها عن الخارج الاجتماعي والثقافي الذي يحيط به. وهنا يطرح السؤال: هل الخارج هو الذي ينعكس في الداخل على شكل نصوص؟ أم أن الداخل بطبيعته تطلع دائم إلى تجاوز الخارج مهما كان، والبحث عمّا هو أرقى؟ المؤكد أنه لا داخل بلا خارج، ولا خارج بلا داخل.
وتسري هذه الجدلية في الوجود كله؛ فالشجرة مثلًا لها داخل: الجذور والأغصان والأوراق والثمار، ولها خارج: الشمس، والتربة، والماء. وكلاهما هو الذي جعلها على ما هي عليه. ففهم الشجرة يستلزم دراسة تفاعل الداخل والخارج معًا. وكذلك النصوص، لا يمكن فهمها بمعزل عن الخارج، ولا يمكن أن تكتسب قوتها إن لم تكن لها بنية داخلية محكمة قادرة على التفاعل مع السياقات.
إن القراءة الداخلية تُعنى ببنية النص ومضمونه، بينما القراءة الخارجية تُعنى بسياقاته وتاريخه وتأويلاته. فهل هناك تعارض بين القراءتين؟ أم إن إحداهما لا تكتمل إلا بالأخرى؟ في الحقيقة، المطلوب وعي منهجي يربط بينهما تكامليًا، بعيدًا عن القراءات التي تغرق في الخارج وحده، أو تلك التي تنكفئ على الداخل وحده. لأن الهدف الأسمى هو تجديد معنى النصوص في ضوء السياقات الراهنة.
فعندما تهيمن القراءة الخارجية دون عناية بالداخل، تقع في فخّ الاختزال، إذ تنشغل بتاريخ التأويلات والجدالات التي أحاطت بالنص أكثر من انشغالها بالنص ذاته. وحين تهيمن القراءة الداخلية وحدها، تهمل السياقات التي نشأ فيها النص أو يُعاد قراءته فيها، فتظل قراءة ناقصة لا ترقى إلى مستوى التأويل الخلاق.
وهذا الإشكال يصدق بوضوح على علاقتنا بالتراث الإسلامي. فكثير من المختصين في أصول الفقه يتعاملون مع النصوص من الداخل فقط، فيربطون بعضها ببعض، لكن بمعزل عن السياقات التاريخية والسياسية والثقافية التي أسهمت في تشكلها. وهكذا تتحول المضامين إلى نصوص ثابتة لا تقبل النقد أو التجاوز. بينما القراءة الخارجية تفتح آفاقًا أرحب بتتبع العلاقات التاريخية بين النصوص وبين الثقافات والأديان، وهو بعد إنساني لا مفر منه. والقراءة الداخلية التي تستحضر الخارج تمنح بدورها فهمًا أشمل، إذ تتيح الوقوف على رؤية النصوص للوجود والأخلاق والعدالة.
وباختصار، إن التعاطي مع التراث يقتضي تكاملاً منهجيًا بين القراءة الداخلية والخارجية، بحيث يُعاد فتح النصوص على ضوء الحاضر، ويُستثمر جوهرها الحي بدل تجميدها في قوالب جامدة.