الجُبَّائيّ والأشعريّ والإخوة الثلاثة استخدامات الخيال
فئة : ترجمات
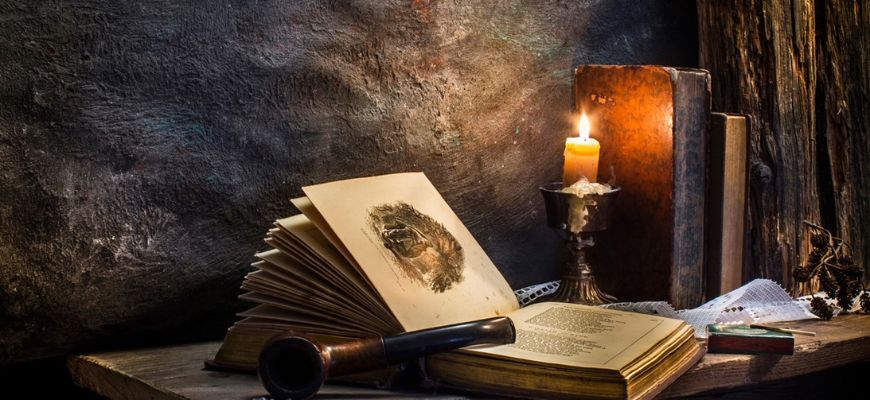
الجُبَّائيّ والأشعريّ والإخوة الثلاثة
استخدامات الخيال
تأليف: د. روزاليند وارد غوين
ترجمة: د. عَبد الكريم مُحَمَّد عَبد الله الوظّاف
مقدمة المترجم
صدرت هذه المقالة في مجلة العالم الإسلاميّ The Muslim World، العدد 75، الصادر في يوليو-أكتوبر عام 1985م، من الصفحة 132-161 تحت عنوان “Al-Jubbā'ī, al-Ashʿarī and the Three Brothers: The Uses of Fiction.
لطالما كان الخلاف الفكريّ العقائديّ طاغيًا على الحياة الثقافيَّة والعلميَّة في العالَم الإسلاميّ؛ بين من يرى تقديم العقل على النقل، وتقديم النقل على العقل؛ على الرغم من أن العقل هو هبة إلهيَّة، والنقل هو تنزيلٌ سماويّ.
صعد نجم المُعتزلة أيام الدولة العباسيَّة، وعلى نحوٍ خاص أيام الخليفة العَباسيّ المأمون ومَن خلفه من الخلفاء. واجه المُعتزلة الهجمة الضارية للمِلل الواقعة في جغرافيَّة العالَم الإسلاميّ، أمثال المانويَّة والغنوصيَّة. لا يُنكر المرء تأثر الفكر المُعتزليّ بهذه التيارات الفكريَّة غير الإسلاميَّة؛ لكن هذا التأثير يقع بين مدٍ وجزر. في مُقابل المُعتزلة ظهرت مدارس فكريَّة إسلاميَّة؛ كان أشهرها هم الأشعريَّة، أصحاب أبي الحَسن عَلِىّ الأشعريّ. كان الأشعريّ مُعتزليًا، ثم انشق عن المُعتزلة، وأسس له مدرسة وسطيَّة فكريَّة كلاميَّة ما بين المُعتزلة من جهة، والمُجسمة وغيرها من المدارس من جهةٍ أخرى.
اُشتُهر أن انسلاخ الأشعريّ عن المُعتزلة كان بسبب أو وقت مناظرة جرت بين الأشعريّ ذاته وشيخه أبي عَلِيّ الجُبائيّ المُعتزليّ (مدرسة بغداد على وجه التحديد). هذه المناظرة تضمنت استفسارًا أو تساؤلًا مُوجَّهًا للجُبًّائيّ من الأشعريّ عن مسألة ثلاثة إخوة: اثنان بالغان؛ أحدهم كافر والآخر مؤمن، فيما الأخ الثالث لا يزال صغيرًا، فماتوا؛ فما هو محلهم من الحساب يوم القيامة.
هذه المقالة تُناقش هذه القصة، وتُحلِّلها من خلال استقراء عشر روايات عن هذه القصة، حسب الترتيب الزمنيّ، بدءًا بعبد القاهر البغداديّ (ت. 429هـ/1037~1038م)، وانتهاءً بطاشكبريّ زاده (ت. 968هـ/1561م). وقد قامت مؤلِّفة هذه المقالة، روزاليند وارد غوين، بدراسة هذه الروايات والخروج بنتيجة؛ قد تكون صادمة لبعضهم.
روزاليند وارد غوين: باحثة بريطانيَّة في اللغة العربيَّة والدراسات الإسلاميَّة. تلقت غوين تعليمها في جامعة أكسفورد، حيث درست اللغة العربيَّة، ثم أكملت دراساتها العليا في المجال نفسه. ركزت أبحاث غوين في المقام الأول على القرآن الكريم وتفاسيره الكلاسيكية.
في الأخير، هاك أيها القارئ ترجمة أخرى لدراسة من الغرب فيما له علاقة بالدراسات الإسلاميَّة. أرجو النفع بها، وأن لا تقف أيها القارئ عندها، بل تكون لك بذرة للتفكير، والله الموفق.
تنويه للقارئ:
كل ما يُوضَع بين حاصرتيْن { } في المتن أو الهامش، فهو من إضافة المترجم، وما كان من إضافة أو تعليق للمؤلِّفة في النصوص المقتبسة؛ فقد جاء بين معقوفتين [ ].
قائمة المصادر والمراجع من صنع المُترجم
{مقدمة}
من بين كلّ الحكايات المُتكررة في أعمال وأدبيات عِلم الكلام، لا نجد أكثر شيوعًا من مُعضلة الإخوة الثلاثة - أحدهم مؤمن، والآخر كافر، والثالث مات صغيرًا - وكيف كان على المُعتزلة التوفيق بين انعدام تكافؤ مصائر الثلاثة في الآخرة، والناتج عن تفاوت واضحٍ في فُرَص الإيمان في الدنيا، وبين عقيدة المُعتزلة في العدل الإلهيّ والعِلم الإلهيّ.
يعرف معظم دارسي عِلم الكلام هذه القصة بوصفها حادثةً من حياة أبي الحَسن عَلِيّ بن إسماعيل الأشعريّ (ت. 324هـ/935~936م)، حيث يُقال إنه طرح المُعضلة في شكل سلسلةٍ من التساؤلات على شيخه القديم أبي عَلِيّ مُحَمَّد بن عَبد الوهاب الجُبَّائيّ، المُتكلم المُعتزليّ (ت. 303هـ/916م). وقيل إن أبا عَلِيّ، الذي لم يتمكن من حل المُعضلة دون التخلي عن مبدأ العدالة الإلهيَّة المُعتزليَّة، قد اضطر إلى الصمت. تُشير بعض روايات القصة إلى أن هذا هو الحدث الذي دفع الأشعريّ إلى الانشقاق عن المُعتزلة لصالح الإسلام السُّنِّيّ-الجماعيّ؛ ويُقدمها بعضهم على أنها خدعة لعبها الأشعريّ على أبي عَلِيّ بعد القطيعة لإثبات عجز المُعتزلة عن التوفيق بين مبادئ العِلم الإلهيّ، والقُدرة المُطلقة، والعدالة، والقيام بذلك بطريقةٍ أذلت أبا عَلِيّ علنًا. تربط معظم الروايات القصةَ على نحوٍ خاص بمبدأ الأصلح، وهو التزام الله بالتصرف وفقًا لمصالح المؤمنين الفُضلى خشيَّة أن يتخلى عن مكانته بوصفه إلهًا عادلًا. بيد أن هناك أدلةٌ على أن أبا عَلِيّ لم يلتزم بمبدأ "الأصلح"، بل إنه في واقع الأمر كتب كتابًا ضده، والفكرة نفسها ترتبط عادةً بمُعتزلة بغداد وليس بمُعتزلة البصرة. جميع المؤلفين الذين يقتبسون القصة يستهلونها بمقدمةٍ، أو يُتبعونها بملاحظاتٍ توضيحيَّةٍ، أو يُدرجون مثل هذه الملاحظات في متن القصة؛ لكن ليس جميعهم يفعلون ذلك للغرض نفسه إلا بقدر ما يستخدمونها جميعًا لدحض المُعتزلة. لم أجد أيّ مصدرٍ مُعتزليٍّ حتى الآن يذكر الحادثة المزعومة على الإطلاق.
إن أطروحة هذه المقالة تتلخص في أن القصة نشأت بمثابة مُعضلةٍ كلاميَّةٍ على هيئة سؤال وجواب افتراضيَّة، دون أيّ ادعاءٍ بأنها تُمثل حادثةً تأريخيَّةً فعليَّةً؛ وأن المقصد الأصليّ من المُعضلة كان إظهار عجز المُعتزلة (البغداديّين) عن الدفاع عن عقيدتهم في "الأصلح"؛ لكن أفسحت المجال لإعادة تفسيرٍ من قبل عدة مؤلفين في ضوء العديد من نقاط الخلاف الكلاميّ والسياسيّ؛ وأن فخر الدين الرازيّ هو من وضع اسمي الجُبَّائيّ والأشعريّ على الشخصيات في المناظرة، والتي لم تُذكر بعد ذلك إلا على أنها سردٌ لحدثٍ حقيقيّ.
ستتناول هذه المقالة عشر رواياتٍ من القصة، وهي حسب الترتيب الزمنيّ:
- عَبد القاهر البغداديّ (ت. 429هـ/1037~1038م)، كتاب أصول الدين([1])؛
- أبو حامد الغزّاليّ (ت. 505هـ/1111م)، إحياء علوم الدين([2])؛
- فخر الدين الرازيّ (ت. 606هـ/1209م)، التفسير الكبير([3])؛
- ابن خلِّكان (ت. 681هـ/1282م)، وفيات الأعيان (طبعتان)([4])؛
- عضد الدين الإيجيّ (ت. 756هـ/1355م)، انظر: الشريف الجُرجانيّ؛
- تاج الدين السُبكيّ (ت. 771هـ/1370م)، طبقات الشافعيَّة الكبرى([5])؛
- سعد الدين التفتازانيّ (ت. 722هـ/1389م)، شرح العقائد النسفيَّة([6])؛
- الشريف الجُرجانيّ (ت. 816هـ/1413م)، شرح مواقف في عِلم الكلام([7])؛
- طاشكبريّ زاده (ت. 968هـ/1561م)، مفتاح السعادة([8]).
سيُفحص كل مؤلَّف من حيث المحتوى، والصياغة، والتحيُّز، ونقطة الخلاف، والعلاقة بالمؤلَّفات السابقة، وأيّ ميزاتٍ بارزةٍ أخرى. بعد تحليل كل عملٍ على حدة؛ ستُعرض السمات البارزة لكل كتابٍ في شكل جدول، وتُستخلص الاستنتاجات العامة.
للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا
([1]) عَبد القاهر البغداديّ، كتاب أصول الدين (اسطنبول، 1348هـ/1928م؛ إعادة النشر: بغداد، المثنى، 1963م)، ص ص151-152
([2]) أبو حامد الغزّاليّ، إحياء علوم الدين (القاهرة، 1387هـ/1967م)، 1/153
([3]) فخر الدين الرازيّ، التفسير الكبير =مفاتيح الغيب (القاهرة، 1357هـ/1938م)، 13/185-186
([4]) ابن خلِّكان، وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عَباس (بيروت، دون دار نشر)، 4/267-268؛ وقاموس تراجم ابن خلِّكان، lbn Khallikān 's Biographical Dictionary, tr. B. Mac Guckin de Slane (Paris, 1847-1871; repr. New York, 1961), II, 669-670
([5]) تاج الدين السُبكيّ، طبقات الشِّافعيَّة الكبرى (القاهرة، 1384هـ/1965م)، 3/356
([6]) سعد الدين التفتازانيّ، شرح العقائد النسفيَّة (القاهرة، 1329هـ/{1911]م؛ إعادة النشر: 1397هـ/1976-1977م)، 1/20-21
([7]) عَلِيّ بن مُحَمَّد الشريف الجُرجانيّ، شرح مواقف في عِلم الكلام: الموقف الخامس في الإلهيات، تحقيق: أحمَد المهديّ (القاهرة، 1977م)، ص325
([8]) أحمَد بن مصطفى طاشكبريّ زاده، مفتاح السعادة (القاهرة، 1968م)، 2/165-166






