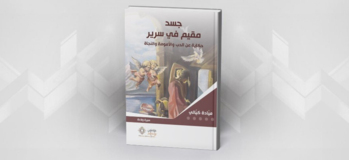حوار مع د. ميادة كيالي حول: جسد مقيم في سرير الجزء الثاني
فئة : حوارات

حوار مع د. ميادة كيالي حول:
جسد مقيم في سرير
الجزء الثاني
حاورها د. حسام الدين درويش
د. حسام الدين درويش:
مبارك لك مرةً ثانية بصدور كتابك "جسد مقيم في سرير حكاية عن الحب والأمومة والنجاة "، والعنوان الفرعي "سيرة ولادة". سنتابع اليوم الحديث عن الكتاب، المعروض في معرض إسطنبول للكتاب العربي الذي يقام هذا العام، 2025، تحت شعار: "وتبقى العربية".
في متابعةٍ للحوار الأول الذي أجريناه حول مسألة تلقّي الكتاب أو القارئ المثالي، تحدّثنا عن التلقّي الأوّلي، وعن تفاعل الأصدقاء والصديقات والمقرّبين مع الكتاب، وعن الحرص على أن يكون الكتاب متوفرًا أيضًا في المراكز الطبية، لدى الأطباء والمستشفيات، خصوصًا في ما يتعلّق بمسألة الولادة، إضافةً إلى المهتمين بالشأن العام.
سؤالي هو: لمن وُجِّه الكتاب؟ هل هو موجَّه إلى الجمهور العام؟ أم إلى الأشخاص الذين مرّوا بالتجربة نفسها؟ هل هو موجَّهٌ إلى الرجال عمومًا، لكي يدركوا أبعاد هذه التجربة؟ أم إنه موجَّهٌ تحديدًا أو خصوصًا، إلى فارس وكريم (حفظهما الله) بما أنه مهدى إليهما في الأصل؟ أم هو موجَّهٌ إلى كلّ الأشخاص الذين ارتبطوا بهذه التجربة، مثل الطبيب الذي رافقك، الدكتور جوني عوّاد، زارع الأمل وواهب المسرّة؟ إذن، عندما كتبتِه، من كان القارئ المثالي أو النموذجي في بالك؟
د. ميادة كيالي:
حين شرعتُ في كتابة هذه التجربة، لم يكن في ذهني قارئ بعيد أو جمهور عام، بل كنتُ أكتب، أوّلًا وأساسًا، لفارس وكريم. أردت أن أترك لهما أثرًا مكتوبًا يخلّد لحظة ميلادهما الأولى، لا بمعناها البيولوجي فحسب، بل بمعناها الوجودي العميق: منذ الانقسامات الأولى في المختبر، إلى لحظة زراعتهما أجنّة في رحمي، مرورًا بأيام القلق والخوف التي رافقتني طيلة الحمل، حتى ساعات الولادة، ثم ذلك الألم الممزوج بالبرد حين تركتهما في الحاضنة، وعدتُ إلى البيت من دونهما. كانت تلك اللحظات أقسى اختبار للأمومة: أن تحملي الحياة في أحشائك، ثم تعودي فارغة اليدين، منتظرة أن يكتمل نمو تلك الأرواح الصغيرة بعيدًا عن حضنِك.
لكن كل هذا الوجع تبدّد حين استعدتهما، حين أكملا نموهما وعادا إلى صدري. عندها شعرت أن دوري لم يكن فقط أن أمنحهما الحياة بجسدي، بل أن أكون أيضًا ذاكرتهما الحيّة وصوتهما الأول؛ أن أتكلم عنهما قبل أن يقدرا على التعبير عن نفسيهما. لذلك، كتبت تفاصيل قد تبدو صغيرة وعابرة، لكنها كانت في حقيقتها بحجم العالم بالنسبة لي: أوّل لمسة لجسديهما الضئيلين الممدّدين على منصة الحاضنة، تلك النظرة الطويلة لأحدهما، وهو يراقبنا من خلف الزجاج حين خرج أخوه من المشفى، وبقي هو وحيدًا، حتى غبنا عن عينيه. تلك اللحظات لم أرد لها أن تضيع، فأمسكتُ القلم ودوّنتها لهما، واحدة تلو الأخرى.
وكنتُ أقول دائمًا: "سأكون أنا صوتكما إلى أن تملكا صوتيكما الخاصّين، وسأكتب عنكما حتى تصيرا قادرين على كتابة حياتكما بأنفسكما".
مع الزمن، أدركت أن هذه التجربة ليست ملكًا لفارس وكريم فقط، ولا لي وحدي كأمٍّ، بل هي تجربة إنسانية عميقة تخصّ كل امرأة تُقدِم على رحلة الأمومة. هي رحلة تبدأ بالرجاء، تمرّ بالخوف، وتنتهي بالدهشة أمام المعجزة التي يُحدثها الجسد. فالمرأة حين تدخل إلى تجربة الحمل والولادة تدخل في مواجهة صريحة مع ذاتها، مع ألمها وهشاشتها، ومع قدرتها المذهلة على الاحتمال والصمود. إنها تجربة تجعل المرأة تقف عند حدود الجسد، لتكتشف أن هذا الجسد، الذي اعتادت أن تراه في المرآة كيانًا يوميًّا عابرًا، يمكن أن يكون مصدر حياة، ومعملًا للخلق، ومسرحًا لمعركة فيها من الضعف بقدر ما فيها من القوة.
أتذكّر أنني في التجربة الثالثة، قلت لنفسي: "إن فشلتُ هذه المرة، فلن أكرّرها". كنت على وشك إعلان الاستسلام، لكنّ الله أرسل لي رسالة بليغة من خلال النجاح الذي تحقّق، فقد حصل الحمل لكنه لم يصمد. كانت تلك الرسالة بالنسبة لي إعلانًا أن الأمل لا ينقطع، وأن جسدي الذي ظننته قد أُنهك ما زال قادرًا على أن يكون وطنًا للحياة. ومن هنا، صار الكتاب شهادةً على معركة الأمل، بقدر ما هو توثيقٌ لسيرة ولادة.
المفاجأة جاءت بعد النشر؛ إذ تبيّن لي أن القارئ الحقيقي لم يكن النساء وحدهنّ. لقد وجدت أن الرجال تفاعلوا معه بعمق لم أتوقعه. كثيرون قالوا لي إنهم لم يعرفوا من قبل حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في الحمل والولادة. أحدهم أخبرني أنه عاد إلى زوجته بعد أن أنهى قراءة الكتاب، قبّل يدها وقال لها: "أدركت الآن كم عانيتِ، وكم كنت أظنّ الأمر يسيرًا". عندها فهمتُ أنني لم أكتب فقط لأبنائي، ولا فقط للنساء اللواتي يمررن بالتجربة ذاتها، بل كتبتُ أيضًا للرجل. كي يدرك أن ما يظنه واجبًا طبيعيًّا أو وظيفة جسدية عابرة هو في الحقيقة، زلزال داخلي تمرّ به المرأة، لا يقل شأنًا عن أيّ معركة يخوضها في حياته.
دعني أخبرك أمراً آخر هنا، كثيرًا ما تعتقد النساء أنّ الرجل «يعرف» ما يجول في دواخلهنّ، بينما هو في الحقيقة قد لا يعرف. يحدث ذلك حتى في أبسط التفاصيل اليومية؛ فحين يسألها: «هل تريدين أن تأكلي؟» قد تلتزم الصمت، وكأن عليها أن تنتظر منه أن يخمّن رغبتها أو حاجتها، بدل أن تصارحه بما تشعر به. فإذا كان سوء الفهم ينشأ من هذه الجزئيات الصغيرة، فكيف سيكون الحال مع القضايا الكبرى كأوجاع الحمل والولادة التي لا يختبرها الرجل في جسده أصلًا؟
من هنا أدركت أنّ الصمت لا يصنع شراكة حقيقية، وأن التعبير عن الألم والخوف، ومشاركة الرجل في هذه التجربة، لا ينتقص من دور المرأة، بل يعيد للرجل حضوره الحقيقي ويمنحه فرصة أن يكون شريكًا واعيًا في رحلة الحياة، بدل أن يظلّ على هامشها أو مجرد متفرّج.
فالمرأة حين تكتب عن الولادة لا تكتب عن حدث بيولوجي فحسب، بل تكتب عن إعادة تعريف ذاتها، عن حدود قوّتها وضعفها، وعن معنى أن تُسلِّم جسدها للتحوّل وتظل واقفة بعد ذلك. لقد علّمني هذا الكتاب أن الكتابة ليست توثيقًا وحسب، بل هي أيضًا مساحة للحوار، ودعوة إلى إعادة النظر في العلاقات الإنسانية. كتبتُ في البداية لطفلين، فاكتشفت أنني أكتب لعالم أوسع، ولرجال ونساء يحتاجون أن يدركوا أن التجربة الإنسانية، بكل هشاشتها وقوّتها، لا تُعاش في عزلة، بل تُكتَب ليُعاد اكتشافها مع الآخرين.
د. حسام الدين درويش:
المسألة لا تتعلّق بالجسد فحسب، بل بالولادة وخصوصيتها. والسؤال هنا: إذا كان القارئ الأوّل المفترض هو فارس وكريم، فهل قرآ الكتاب؟ وهل دار بينكم أيّ تفاعل حول هذه المسألة؟
لقد لاحظت أنّه على الرغم من أنّكِ ربما تحدّثتِ كثيرًا مع المقرّبين حول هذه المواضيع، فإنّ ردود أفعالهم كشفت أنّهم عرفوا أمورًا لم يكونوا يعرفونها من قبل. ويبدو أنّ النص يُظهر تفاصيل جديدة تجعل القارئ يكتشف أشياء لم يكن يراها سابقًا. أنا أعرف أنّ إحدى صديقاتك قالت لك إنها اكتشفت أشياء جديدة، رغم أنّها عاشت معك التجربة أو كانت قريبة منها. وسؤالي: هل قرأ فارس وكريم الكتاب؟ وهل تفاعلا معه؟ وماذا عن الأشخاص القريبين جدًّا، مثل الدكتور جوني وغيرهم ممّن لهم صلة مباشرة بالموضوع؟
د. ميادة كيالي:
أما عن فارس وكريم، فلا أخفيك أنني لا أتمنى أن يقرآ الكتاب الآن. نعم، لقد كتبته لهما ومن أجلهما، لكن القراءة لها وقتها، ولها نضجها. أشعر أن اللحظة لم تحن بعد، وأن عليهما أن يعيشا مسافة زمنية كافية بين ما دُوّن لهما وما يختبرانه بأنفسهما. فالطفل حين يكبر في كنف أمّه يظن أنها باقية أبدًا، وأن وجودها مضمون كالماء والهواء. لا يخطر في باله أن هذا الحضن الذي يأويه قد يغيب يومًا. لذلك، أتركهما الآن لبراءتهما، مؤمنة بأن اللحظة ستأتي حين يحتاجان العودة إلى هذا النص، لا بوصفه كتابًا فقط، بل بوصفه ذاكرة مكتوبة، ووصية حبٍّ، وعلامة على أن أمّهما كانت هنا، عاشت، كتبت، وواجهت كل شيء كي تمنحهما الحياة.
إن أجمل ما قد يحدث للكاتب أن يقرأ أبناؤه نصًّا كتبه من أجلهم، لكن الأجمل من ذلك أن يأتي هذا اللقاء في الزمن المناسب، حين يكون النص قادرًا على ملامستهم بوعي مختلف. لذلك، أفضّل أن يأخذا وقتهما، وأن يلتقيا بهذه التجربة حين يبلغان مرحلة تجعل القراءة فعل اكتشاف حقيقي، لا مجرد فضول عابر. يكفيني الآن أن أشعر بالطمأنينة؛ لأنني تركت لهما شيئًا يخصّهما، شيئًا سيظل في انتظارهما مهما تغيّر الزمن أو تغيّرت أنا.
د. حسام الدين درويش:
إذا ما سنحت الفرصة في المستقبل.
د. ميادة كيالي:
صحيح أنّني أرسلت نسخة إلى كريم، وصار لدى فارس نسخته أيضًا، لكنني ما زلتُ أرى أنّ الوقت الأمثل لقراءته لم يحن بعد. فهما نشآ وتعلّما بلغتهما الأقوى، الإنجليزية، بينما النص مكتوب باللغة العربية، وهذا يجعل مسافة إضافية بينهما وبينه. أفضّل أن يأتيا إلى النص حين يشعران أنه يخاطبهما بعمق، لا حين يكون مجرد تمرين لغوي أو قراءة مجاملة. فالمسألة هنا ليست أن يقرآ وحسب، بل أن يلتقيا بالتجربة في زمنهما الخاص، بالوعي الذي يسمح لهما أن يدركا أنها تخصّهما.
د. حسام الدين درويش:
الرسالة الآن تتعلق بدور المتلقي ووقته؛ أي إن الكرة في ملعبه؟
د. ميادة كيالي:
في النهاية، الكتابة التي أنجزتها لم تكن مجرد تسجيل يوميات عابرة، بل كانت محاولة لتدوين ذاكرتي معهما منذ اللحظات الأولى لوجودهما، وحتى آخر يوم من عمري معهما. لكنني حين أعدت النظر، وجدت أن هذه الصفحات ليست مذكرات أطفال فقط، بل شهادة امرأة كاملة تحوّلت مع الولادة، امرأة تغيّر جسدها وروحها، وأعادت تعريف ذاتها من خلال الألم والمعاناة والأمل. لهذا السبب، حرّرت هذا الجزء من سياق المذكرات الخاصة، وتركته نصًّا قائمًا بذاته، يصلح أن يكون شهادة إنسانية عامّة، لا مجرد رسالة خاصة موجّهة إلى فارس وكريم.
د. حسام الدين درويش:
إنّ هذا النوع من الكتابة خاصٌّ جدًّا ومتعلّق بشخص واحد أو بمجموعة من الأشخاص، أو قد يكون رسالة موجّهة من شخص إلى آخر من ناحيةٍ أولى، لكنه، من ناحية ثانية، يمكن أن يكتب بطريقة تجعلها موجَّهًا إلى الجميع. ما رأيك؟
د. ميادة كيالي:
صحيح.
د. حسام الدين درويش:
فهنا تكمن الفكرة؛ تعرفين أنّ هناك رسائل كثيرة في الأدب، أو قصصًا كثيرة مكتوبة من أبٍ إلى ابنته، أو من ابنة إلى أبيها، أو غير ذلك. ومع ذلك، يبقى البعد الإنساني حاضرًا، وتبقى تلك الأفكار والخبرات العامة التي يمكن لأيٍّ كان أن يقرأها ويتأثر بها، كما لو كانت موجهة إليه شخصيًّا.
د. ميادة كيالي:
صحيح تمامًا. وهذا هو السبب الذي جعلني أتردّد طويلًا قبل اتخاذ قرار النشر. كنتُ أرى هذه الصفحات جزءًا من ذاكرتي الشخصية مع فارس وكريم، قطعة حميمية من حياتي لا تخصّ سواي وسواهما. لم أتصور يومًا أنها ستغادر الدائرة الضيقة لتصبح بين يدي قرّاء لا يعرفونني. لكن مع مرور الوقت، اكتشفت أن التجربة تحمل في طياتها أبعادًا أبعد من خصوصيتي، وأنها ليست مجرد حكاية أمّ مع ولديها، بل شهادة إنسانية يمكن أن يجد فيها الآخرون صدى لتجاربهم.
لقد أدركت أن ما كتبته، وإن بدأ كرسالة خاصة، يحمل رسالة عامة تستحق أن تُروى، وأن تصل إلى شرائح متعدّدة من القرّاء. ففيه شيء من المعرفة، وشيء من الحكمة، وشيء من الألم الذي يمكن أن يُقرأ بوصفه تجربة فردية، لكنه في الوقت نفسه جزء من التجربة الإنسانية المشتركة. وهذا ما منحني الشجاعة لأن أضعه بين أيدي الناس، إيمانًا بأنّ النصوص الأكثر صدقًا، حتى وإن وُلدت من رحم الخاص، تستطيع أن تخاطب الجميع وكأنها كُتبت لهم شخصيًّا.
د. حسام الدين درويش:
هناك فكرة أساسية في الكتاب تتعلق بمغزى الكتابة أو قلقها؛ إذ يبرز توتر بين فكرتين، أخبريني كيف تجمعين بينهما؟ من ناحية أولى، تؤكدين وجود شيء إنساني مشترك يمكن أن يلامس كلّ إنسان، رجلًا كان أو امرأة، عربيًّا أو غير عربي، شيءٌ يحرّك في القارئ إحساسًا يفهمه ويتفاعل معه. ومن ناحية أخرى، تؤكدين في النص أكثر أنّ مثل هذه التجارب لا تُروى؛ لأنّها أعمق وأبعد من أن تُسرد في قصة، ومع ذلك فقد رويتها. فأنتِ تنوسين بين هذين الأمرين: إيمان بالمشترك الإنساني، وهو لا يخص النساء أو العربيات فقط، بل يشمل الرجال والجميع على اختلافهم، وفي الوقت نفسه تعطينا الانطباع بأنّ ما نكتبه، مهما كتبنا، لن يعبّر عن القصة كلّها؛ لأنها أبعد وأعمق، تمسّ خبرةً وتجربة حياة لا تُحكى. كيف توفّقين بين هذين البعدين؟
د. ميادة كيالي:
نعم، بالتأكيد، فالكلام عن التجربة لا يرقى إلى عيشها في جسدك وروحك. ومهما بلغت الكتابة من قدرة على الوصف أو الدقة في التعبير، فهي تظل عاجزة عن الإحاطة الكاملة بما يجري في أعماق المرأة حين تعبُر تجربة الحمل والولادة. هناك أوجاع لا تُنقل، وتحولات لا تُختزل، ومشاعر تتجاوز اللغة نفسها. فالكتابة تستطيع أن تقترب، أن تلمح، أن تُشير، لكنها لا تستطيع أن تستوعب التجربة كلّها.
ومع ذلك، تبقى الكتابة ضرورية؛ لأن ما لا يُحكى يظلّ ناقصًا، ولأن الإنسان محتاجٌ دائمًا إلى أن يضع لتجاربه كلمات، ولو كانت قاصرة. إن الكتابة هنا ليست فعلًا لإغلاق الحكاية أو استنفادها، بل هي محاولة لملاحقة ما ينفلت منها. ولذلك، فإن هذه الصفحات القليلة ليست كلّ القصة، بل هي إشارات إليها، نوافذ صغيرة على عالم أكبر بكثير ممّا يمكن أن يُقال.
أؤمن أن ثمة جزءًا من الخبرة يظلّ عصيًّا على التعبير، يخص المرأة وحدها، ولا يمكن أن يُنقل بكامله. لكن هناك أيضًا جزءًا آخر ينجح في العبور عبر اللغة، ويصل إلى القارئ مهما كانت المسافة. هذا الجزء هو الذي يسمح للآخر أن يقترب، أن يفهم، أن يتعاطف. هو الذي يفتح باب المشترك الإنساني، ويجعل من تجربة فردية جدًّا شهادة يمكن أن تمسّ الرجل والمرأة، العربي وغير العربي، كل من له قلب وتجربة إنسانية.
لهذا أكتب وأنا مدركة أن الكتابة لن تقول كل شيء، لكنها ستقول ما يكفي ليفتح بابًا إلى ما لا يُقال. فاللغة لا تملك أن تروي الحكاية كاملة، لكنها قادرة على أن تمنح القارئ خيطًا يلمس به جوهر التجربة، وأن تجعله شريكًا فيها، ولو للحظة.
د. حسام الدين درويش:
لأن ثمة شيئًا يصل.
د. ميادة كيالي:
وهذا بالضبط ما اكتشفته؛ على الإنسان أن يحكي، أن يكتب ويشهد. حتى لو لم يكن ما يكتبه كاملًا أو خاليًا من النقص، فهو على الأقل يؤدي ما عليه؛ يبعث رسالته، ويقول كلمته، ويروي سرديته التي قد تتقاطع مع سرديات أخرى. قد يتقبّلها البعض أو يرفضونها، قد يناقشها البعض أو يحبونها أو لا يحبونها، لكن الأهم أن يكون قد أدّى أمانة الحكاية، وقدّم شهادته عن نفسه وحياته، بدل أن يترك الآخرين يروونها عنه، أو يكتبونها بالنيابة عنه.
لقد كان بإمكاني - وربما كان أسهل لي - أن أستفيد من هذه المحطات في حياتي وأحوّلها إلى رواية، إلى شخصيّات وأحداث من نسج الخيال. لكنني حين حاولت ذلك، أدركت أن المشاعر التي مررت بها لا يمكن أن تُحمَّل إلى شخصية أخرى من الورق. هناك صدق لا يحتمل الأقنعة، وتجربة لا تحتمل الإسقاط. لذلك، آثرت أن أرويها بصفائها وصدقها كما حدثت معي، لا كما يمكن أن تُختلق في حكاية.
بهذه الطريقة، أشعر أنني لم أكتب مجرد نصٍّ، بل وضعت شاهدًا على حياتي، نصًّا لا يستعير صوتًا آخر ولا يختبئ وراء أسماء وأقنعة، بل يقدّم نفسه كما هو: شهادة امرأة عاشت وتألمت، أحبّت ونجت، ثم قررت أن تكتب.
د. حسام الدين درويش:
أتفق معك على أنّه في النهاية، حين نكتب، يكون هناك اختلاف قائم بين النص والتجربة المعيشة؛ أي إن في الأمر شيئًا مختلفًا. لكن أرى أنه ينبغي لنا ألا نذهب في هذا الاتجاه إلى أقصى حدٍّ، حيث نتحول إلى فردانية أو غنوصية أو خصوصية منغلقة على نفسها، وكأن من لم يعش تجربتي، لن يتمكن من فهمها. فليس من الضروري أن تكوني فقيرة كي تفهمي ما قد يعنيه الفقر، ولا أن تكوني سارقة لتدركي ما هي السرقة. فإذا أخذنا الخصوصية إلى حدها الأقصى، فلن يبقى هناك شيء مشترك بين البشر. إضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون التجارب متناثرة، فتشعرين بهذا الشعور أو تعيشين تلك الحالة. أما في الكتابة، فنحن نربط بين هذه المشاعر والحالات، ونشكل منها سردًا مترابط الأجزاء، ثم إنّ الكتابة لا تعبر فقط عن واقعٍ ما، بل تضيف أشياء لا توجد في التجربة المعيشة. لهذا السبب، قد يلتقط الأصدقاء أو الصديقات الذين عاشوا معك بعض هذه التفاصيل، أو قد تنتبهين أنتِ شخصيًّا إلى أشياء لم تكن حاضرة قبل فعل الكتابة.
إذن، نحن متفقان في النهاية على محدودية الكتابة، غير أن لهذه المحدودية نفسها حدودًا؛ فالكتابة بطبيعتها بنائية، تضيف وتوسّع، دون أن يعني ذلك أنها اختلاق زائفٌ.
د. ميادة كيالي:
بالتأكيد. في النهاية، كلّ ما نفعله حين نكتب هو أن نحاول التعبير عمّا في داخلنا، ونترك المجال مفتوحًا للقارئ ليتفاعل مع النص بطريقته الخاصة. لهذا، أرى أن في كل تجربة تُروى مستويين: جانب يُمكن أن يُحكى وتستوعبه اللغة، وجانب آخر يظلّ عصيًّا على التعبير، باقٍ في منطقة الصمت والعمق. لكن ما اكتشفته هو أن الصدق والشفافية هما ما يقرّبان المسافة بين هذين المستويين. فكلّما كتبت بصدق أكبر، كلّما أحسست أنني أقترب أكثر إلى الآخرين، وأن شيئًا من تجربتي يجد صداه في قلوبهم.
وقد شعرت بسعادة غامرة حين لمست هذا الأثر بشكل مباشر. القراءات التي تلقيتها من أصدقائي وأحبّتي أكدت لي أن النص وصل إليهم بعمق وبساطة في آن. كثير منهم أخبروني أنهم قرأوه دفعة واحدة، في جلسة واحدة، كأنهم انجرفوا مع سيل الحكاية دون أن يتمكنوا من التوقف. كانت هذه الاستجابة أعظم حافز لي؛ لأنها منحتني ثقة بأن ما كتبته ليس مجرد بوح خاص، بل شهادة يمكن أن تلمس الآخرين.
هكذا صار الصدق في الكتابة بالنسبة لي ليس مجرد خيارٍ أسلوبي، بل شرطًا أساسيًّا لولادة النص. هو الذي يحوّل التجربة الفردية إلى جسرٍ إنساني، ويجعل القارئ يرى نفسه في مرآتها، حتى وإن لم يعش تفاصيلها. إن الكتابة، في نظري، فعل مشاركة لا انعزال والجسر الذي نعبره لندرك أننا لسنا وحدنا.
د. حسام الدين درويش:
عندما أقول إن الكتابة ليس فقط تعبيرًا عن المعنى، بل هي أيضًا إنتاج للمعنى؛ أعني أنّه عندما كتبت أمورًا خاصّة بي، ساعدتني الكتابة على فهم أشياء، أو الانتباه إلى أشياء، أو إدراك أمور لم أكن ألاحظها من قبل. وهذا ما يمكن أن يعنيه قولك المتكرر في الكتاب إنك بعد الكتابة، أنت ككاتبة، تولدين من جديد كشخص.
د. ميادة كيالي:
تماماً.. فالكتابة ليست فقط تعبيرًا عن تجربة سابقة، بل هي أيضًا عملية ولادة جديدة للمعنى. حين أنظر اليوم إلى النص الذي أنجزته في 1999 واشتغلت عليه لاحقاً في فترات متباعدة جدًّا، أجد أن ما خرج في النهاية يختلف كثيرًا عمّا كتبته في البداية. الكتابة الأولى كانت أقرب إلى تدفق عاطفي مباشر، إلى تسجيل للوجع والدهشة كما عشتهما في لحظتهما. أما النص الأخير، فحمل معه نضوجًا أكبر؛ لأنه لم يكن حصيلة التجربة وحدها، بل حصيلة الزمن الذي مرّ عليها أيضًا.
الكتابة تتغذى من التراكم: من الخبرة، من العمر، من تغيّر الأمكنة، من الأحداث التي تترك أثرها فينا شيئًا فشيئًا. أن تكتب عن تجربة تمتد لخمسة وعشرين عامًا؛ يعني أنك تكتب ليس فقط عن لحظة الولادة، بل عن كل ما تلاها من انعكاسات، وعن كيفية استمرار التجربة في تشكيلك كإنسانة، وأم، وكاتبة. فالنص هنا لا يوثق الماضي فقط، بل يعيد صياغته في ضوء ما أضافته السنوات، وما نضج في داخلي من وعي وتأمل.
أتذكر أن المفكر هاني فحص قال لي يومًا: "حتى لو أحببت النص جدًّا وكنت مسرورة به، لا تنشريه فورًا، اتركيه جانبًا، ثم عودي إليه فيما بعد".
كنت أتساءل وأستغرب حين أسمع أن أحدهم كتب رواية، وظل يعمل عليها عشر سنوات؟! لكنني اكتشفت لاحقًا أن هذا ممكن جدًّا، بل هو ما يمنح النص عمقه الحقيقي. فالنصوص، مثل الأبناء، تحتاج إلى زمن لتنمو، وإلى صبر كي تكتمل.
اليوم، وأنا أعود إلى نصوصي الأولى، أرى بوضوح أن الكتابة ليست مجرد تسجيل لما كان، بل هي إعادة خلق، توليد جديد لشخصي ولوعيي من خلال اللغة. وهذا ما يجعلني أؤمن أن كلّ نصٍّ حقيقي يحتاج أن يمرّ بمخاضٍ طويلٍ، كما يمرّ الجسد بمخاض الولادة، ليخرج إلى النور مكتملًا.
د. حسام الدين درويش:
فترات عدم الكتابة هي فترات إنضاج للعمل.
د. ميادة كيالي:
نعم، فترات التوقف عن الكتابة ليست فراغًا، بل هي جزء أساسي من مسارها. هي فترات إنضاج صامتة، يعمل فيها النص في أعماقك من دون أن تدرك ذلك. أستحضر هنا تجربتي مع رواية بدأت كتابتها عام 2007، كنت أعود إليها تقريبًا كلّ عام: تجد لديّ نسخًا منها معنونة "يونيو 2008"، "سبتمبر 2012"، وهكذا. في كل مرة أقرأ ما كتبته وأضيف شيئًا جديدًا. أحيانًا كنت أشعر بالملل منها، وكأنها تكرر نفسها عليّ، لكنني مع الوقت أدركت أن هذا التكرار لم يكن عبثًا، بل كان علامة على أن النص ينمو ببطء في داخلي، وأنه يحتاج إلى كلّ هذه العودة ليكتمل.
الكتابة لا تأتي كلها دفعة واحدة. قد يبدأ النص كوميض، ثم يظل كامنًا سنوات طويلة إلى أن يحين أوان نضجه. الوحي لا يزورك إلا في لحظة محددة، لكنها لحظة محمّلة بكل ما سبقها من تراكم وصمت وانتظار. وفي تلك اللحظة، يتفجر كل ما خزنته السنوات، فتجد نفسك تكتب وكأنك تفرغ حملًا ظلّ ثقيلًا داخلك طوال الوقت. عندها فقط تدرك أن النصوص، مثل البشر، تحتاج إلى زمنها الخاص كي تولد، وأن الاستمرارية ليست مجرد فعل كتابة متواصل، بل هي أيضًا صبر طويل على النضج.
د. حسام الدين درويش:
لا أريد أن أستبق قراءة القرّاء، لكن لتجنب إعطاء أي انطباع خاطئ، أودّ التشديد على أن الكتاب ليس بكائيات، وليس مجرد تعبير عن المعاناة أو الشكوى. بالعكس، ومن دون الانزلاق إلى تمجيد الألم، فإن الألم مُقدَّم بطريقة رواقيةٍ تسهِّل من تفهمه وتسويغه، ويظهر ضمن إطار أكبر وإيجابي، كما في قولك، مثلًا: "الألم ليس عدوّنا ...، بل المعبر السرّي نحو القوة التي نجهل أننا نملكها".
د. ميادة كيالي:
نعم، لأن الألم يمكن أن يخلق فينا ما لا يخلقه أي شيء آخر. أستطيع القول إن الجمل التي وضعتها بين مقاطع الكتاب ليست مجرد عبارات عابرة، بل هي خلاصة نظرتي إلى ما حدث معي بعد مرور السنوات. لقد صرت قادرة، بعد أن انقضى الزمن، على أن أقرأ نفسي من جديد. ففي لحظة التجربة، كنت أعيش الألم بكثافته الكاملة، كنت أتصور أنني غارقة فيه، وأنه أكبر من احتمالي. كان الحمل والولادة تجربة قاسية إلى حد أنني لم أكن أرى فيها سوى صعوبة مطلقة، ممتزجة بفرح صغير ومرهق في آن واحد.
لكن عندما تجاوزت المحنة بعد سنوات، اكتشفت أن الألم لم يكن عدوّي، بل كان المعبر السري إلى ما لم أكن أعلم أنني أملكه من قوة. لقد غيّرني، صاغني من جديد، منحني نظرة مختلفة إلى نفسي وإلى الحياة. من هنا جاءت قناعتي بأن الألم، مهما كان مرهقًا، هو الذي يعيد تشكيلنا، وأنه ليس نهاية الطريق بل بدايته. هو جسر نعبره، مؤلم ومخيف، لكنه يقودنا إلى ضفة أوسع وأكثر امتلاءً بالمعنى.
لهذا، فإن الكتاب ليس رثاءً للمعاناة ولا بكائيات على الجسد، بل هو شهادة على ما يمكن أن يفعله الألم حين نواجهه بوعي: أن يحوّل التجربة القاسية إلى حكمة، وأن يجعل من الوجع مساحة للنمو، لا للانكسار.
د. حسام الدين درويش:
كيف يمكننا استثمار هذه اللحظات، ليصبح الألم معبرًا للحياة؟ وما هذا الألم "الذي لا يكتبه الطب، ولا يفهمه العلم، والذي يصنعنا من جديد"، كما تقولين في كتابك؟
د. ميادة كيالي:
نحن لا نحتفظ بالألم لنفسه، بل نُحوِّله؛ ما نعيشه من جراح يمكن أن يصبح مصدرًا للتفاؤل، لمشروعية قصية، لسردية نجاح تُعيد صياغة معنى الحياة نفسها. في تجاربي، اكتشفت أن تحت طبقات المعاناة تكمن قدرة لم أكن أعرفها في داخلي؛ قوى صامتة تستيقظ وتفرض دفاعًا عن الوجود. تلك القوة تجعلني، مثلاً، غير قادرة على تقبّل فكرة أن يجهض طفل، حتى وإن كان في أطوار التخلق الأولى. حين أتأمل الجنين الذي شاهدته تحت المجهر، ثم أتصور أن يتم القضاء على هذا الكيان أيًّا كانت الظروف، يعتريني ارتياب شديد؛ كيف يمكن أن نقرر بحرّية قَتل ما بدأ يتشكّل؟
هذا الدفاع عن الحياة ليس مجرد موقف عاطفي؛ إنه نتاج لقاء طويل بين ما عشناه من ألم، وما تَرَسَّخ فينا من قدرة على الاحتمال. من هنا، يتحول الألم إلى فعلٍ بنّاء: نكتب عنه كي نصنع منه سردًا يحفظ وجوده، ونحوّله إلى طاقة تحثّنا على الدفاع عن حياة الغير، وعلى إعادة تعريف معنى الرحمة والمسؤولية. إنّها ليست دعوة إلى تمجيد الوجع، بل إلى التعامل معه كخامةٍ خامٍ يمكن صقلها: نُعيد قراءتها، ننحت منها حكمةً، ونسمح لها أن تولد فينا إرادةً جديدة للحياة، حياةٍ تحقّق قدرًا أكبر من الحماية والاحترام لكل كائن يبدأ وجوده.
د. حسام الدين درويش:
من الأمور الصعبة في هذا النقاش، أنّ بعض الأسئلة قد تكون شخصية جدًّا، ولهذا لك الحق في الإجابة بالطريقة التي تناسبك. فالسؤال هنا مشروع ومفتوح.
د. ميادة كيالي:
يحق لي أن لا أجيب.
د. حسام الدين درويش:
بالتأكيد، وهذا أحد أشكال الإجابة الممكنة.
هناك العديد من الجمل الجميلة في البناء والعميقة في المعنى، والتي أعجبتني وأثارت تفكيري، ومن بينها قولك: "الوحدة ليست غياب الناس، بل غياب من يرى هشاشتك ولا يخاف منها".
فترة الحمل والولادة، والفترة التي يحاول النص التعبير عنها، هي الفترة التي شعرتِ فيها بالوحدة أثناء التجربة التي كنت تخوضينها بمفردك. فماذا عن الأشخاص المحيطين بك آنذاك؟ ألم يقلّل وجودهم من شعورك بهذه الوحدة. إلى أي حدّ كنت تشعرين بالوحدة، في تلك الفترة، وبشكل عام؟ وما وضع المرأة الحامل عمومًا في هذا الصدد؟
د. ميادة كيالي:
المرأة الحامل، في كلّ الأحوال، تعيش تغيرات هرمونية ونفسية تجعلها تشعر أنها تخوض التجربة بمفردها، حتى لو كانت محاطة بالآخرين. فهي تحمل الحمل في جسدها وحدها، وتشعر أن لا أحد يشاركها ذلك العبء الخفي الذي يتنامى بداخلها. أمّا في حالتي، فقد كان الأمر أشدّ قسوة.
منذ سنوات طويلة، كنت في عائلتي بمثابة "نَبطشي المستشفى": أيّ طارئ يقع، أيّ عملية، أيّ ولادة، أيّ مرض، كنت أول من يُستدعى. رافقت الجميع في ولاداتهم وآلامهم، حملت أطفالهم وسهرت بقربهم، وقفت إلى جانبهم في أصعب اللحظات. لكن المفارقة المريرة هي أنه حين دخلت تجربتي الخاصة، وجدت نفسي وحيدة.
أتذكر الأيام السبعة الأخيرة بوضوح مؤلم. وُضعت في غرفة ضيقة لا تتجاوز مساحتها مترين ونصف في مترين ونصف، أشبه بالزنزانة، فيها سرير جامد مغطى بجلد قاسٍ كالمقصلة، مثبتة فيه أجهزة تمنعني من أيّ حركة. مكثت هناك سبعة أيام كاملة دون أن ألمس الأرض. كانت الغرفة باردة، صامتة، ومعزولة، شعرت معها بأقصى درجات هشاشتي. كنت أخاف في كلّ لحظة من فقدان الأجنّة، وأشعر أن جسدي بأسره على حافة الانهيار. زوجي كان معي طوال اليوم، لكن قوانين المستشفى لم تسمح له بالمبيت، فكانت الليالي طويلة وقاسية، يتضاعف فيها شعوري بالوحدة.
في تلك اللحظات عرفت معنى أن تكون المرأة جسدًا مثقلًا بالألم، بلا أيّ حماية سوى قوتها الداخلية. كان خوفي عظيمًا، وهشاشتي أوضح ما يكون، والأصعب أنني شعرت أن لا أحد يراني حقًّا.
د. حسام الدين درويش:
وجود الناس حولك لا ينفي إمكانية أن تكوني وحيدة؟
د. ميادة كيالي:
نعم، وجود الناس من حولك لا يلغي بالضرورة شعورك بالوحدة. فالوحدة ليست فراغ المكان، بل غياب من يرى هشاشتك ولا يخاف منها. أحيانًا يكفي شخص واحد يمنحك هذا الأمان، فيخفف عنك وطأة هشاشتك، وأحيانًا قد تكون محاطًا بالكثيرين، لكن لا أحد يرى ضعفك حقًّا، فيتضاعف شعورك بالعزلة.
هذه الفكرة بالذات جعلتني أراجع نفسي مرارًا. كنت أسأل نفسي: هل أفعل الأمر نفسه مع الآخرين؟ هل مرّ بي شخص قريب هشّ ولم أنتبه إلى هشاشته؟ هل جعلته يشعر بالوحدة وأنا إلى جانبه؟ صارت هذه التساؤلات صارت بالنسبة لي تمرينًا دائمًا على المحاسبة والمراجعة مع الأصدقاء والمقرّبين. كأن التجربة أعادت إليّ حساسية مختلفة تجاه الآخر، وجعلتني أكثر وعيًا بضرورة الإصغاء إلى هشاشته، وعدم الاكتفاء بالمظاهر الخارجية التي قد تخفي جرحًا عميقًا.
وأتذكر أنّ هذه المحاسبة لنفسي تجددت بقوة بعد تجربة أخرى عابرة، يوم خضعت لعملية المرارة. عندما وضعوني على سرير التخدير، غمرني شعور مباغت بالهشاشة، كأنني على الحافة بين الحياة والموت. أول فكرة خطرت في بالي حينها كانت: لماذا لم أنهِ ما كنت أريد كتابته؟ لماذا لم أنجز ما حلمت به؟ وبعد العملية، حين خرجت مثقلة بالضعف، تذكرت مرة أخرى أن الإنسان يخرج من كل تجربة جسدية عنيفة أكثر هشاشة مما يتوقع، وأن هذه الهشاشة ليست عيبًا، بل حقيقة وجودية. هي ما يذكّرنا بأننا بشر، وأننا بحاجة دومًا إلى من يرانا، لا إلى من يكتفي بالحضور الشكلي إلى جانبنا.
د. حسام الدين درويش:
في الكتاب، تكتبين إن الإنسان، في مثل هذه اللحظات، بحاجة إلى من يرى هشاشته ويتقبّلها، أو لا يخاف منها. والوحدة ليست غياب الناس عمومًا، بل غياب الإنسان القادر على رؤية هشاشتنا وتقبّلها. أليس كذلك؟
د. ميادة كيالي:
أحيانًا يظنّ من حولنا، بحسن نيّة، أنّهم حين يسردون معاناتهم أو يُقزّمون معاناتنا يخففون عنّا الألم. لكن ما نحتاجه في تلك اللحظات ليس المقارنة ولا التصغير، بل أن يتقبلوا ضعفنا ووجعنا كما هو. يكفينا أن يكونوا معنا من دون كلام، وإن لم يملكوا إلا الصمت، فالصمت في حضرة الهشاشة قد يكون عزاءً أعمق من ألف كلمة.
ربما لهذا السبب، قررتُ أن أكتب، أردتُ أن أدوّن حتى لحظات خوفي وهشاشتي، أن أتركها عارية على الورق، علّ امرأة أخرى، حين تمرّ بالتجربة نفسها، تجد في هذه الصفحات ما يعينها على فهم مشاعرها، أو ما يمنحها يقينًا بأنها ليست وحدها، وأن خوفها مفهوم ومشروع. الكتابة، في النهاية، كانت لي وسيلة لقول ما لم يُقَل، ولإيصال رسالة صادقة: نحن لا نحتاج دائمًا إلى من يُقلّل من وجعنا، بل إلى من يراه ويتقبّله، أو إلى صمت رحيمٍ يرافقنا في محنتنا.
د. حسام الدين درويش:
في الكتاب تقولين أيضًا: "لا نحتاج في اللحظات الحرجة من يملك القوّة ...، بل من يرفض أن يرانا نسقط"، بأيّ معنى يرفض أن يرانا نسقط، ويساعدنا على عدم السقوط؟
د. ميادة كيالي:
المقصود أن الإنسان في لحظاته الحرجة لا يحتاج دائمًا إلى من يتولّى أمره أو يحمل عنه ضعفه، بل إلى من يذكّره بأنه قادرٌ على أن يقف بنفسه. نحن لا نبحث عن قوة خارجية تستبدل ضعفنا، بل عن كلمة أو موقفٍ يعيد إلينا الثقة بقوتنا الداخلية.
أحيانًا تكون الكلمة البسيطة كافية: "أنتِ قوية، أنتِ قادرة، لا تدعي ما يحدث يهزمك". مثل هذه العبارات قد تصنع الفارق أكثر من أيّ مساعدة مادية أو عملية. فهي لا تلغي هشاشتنا، بل تضيء على القوة التي نملكها في داخلنا، حتى وإن كنا قد نسينا وجودها لحظة الضعف.
أذكر أن ما يعجبني في بعض الحوارات معك، أنك كنت تقول لي: "لا بأس، يمكنك أن تضحكي"، كأنك تذكّرني بأن الحزن ليس قدَرًا، وأن في داخلي ما يكفي لتجاوز القصة. لم تكن تحاول أن تلغي ما أمرّ به، بل أن تمنحني نافذة صغيرة نحو نفسي، نحو قدرتي على الاستمرار.
أحيانًا لا نريد من يقاتل بالنيابة عنّا، ولا من يمدّ لنا يدًا يحملنا بها. نريد فقط من يرفض أن يرانا نسقط، فيمدّنا بكلمة تجعلنا نعيد اكتشاف قوتنا، ونقف من جديد.
الدعم الحقيقي ليس أن يحملك الآخر، بل أن يذكّرك أنك تملك ساقين تستطيع أن تقف عليهما.
د. حسام الدين درويش:
في الكتاب تجمعين بين إيمان بالعلم وتمجيده وشكره، وإبراز أبعاده ونتائجه الإيجابية، من ناحية، وبين الإشارة إلى محدوديته وتشديدك على أهمية الجانب الروحاني الذي يتخذ أحيانًا الشكل والمضمون الديني من ناحية أخرى. حديثنا عن هذه الثنائية: من ناحية تبرزين المسألة الجسدية العضوية المادية العلمية البحثية التقنية، ومن ناحية أخرى تبرزين أن المسألة روحية، روحانية، فكرية، شخصية، ذاتية، إلى آخره؟
د. ميادة كيالي:
أنا فعلًا أؤمن بما تعلّمته من أستاذي محمد شحرور - رحمه الله - حين كان يفرّق بين القدر والقضاء. كان يقول: قوانين الكون هي القدر؛ قدر حتمي لا فكاك لنا منه، نحن محكومون به. أما القضاء، فهو المعرفة، فكلما ازددنا معرفة، توسّع قضاؤنا في قدرنا. هذه الفكرة أصبحت بالنسبة لي إطارًا لفهم تجربتي: العلم هو قدرنا، لكن القضاء - أي المعرفة - هو ما يجعلنا أوسع حرية في التعامل مع هذا القدر.
لهذا أرى أن العلم، رغم أنه واسع، يظل محدودًا؛ لأنه دائم التطور. ما كتبته اليوم عن تجربة طفل الأنبوب وآلياته مضى عليه سنوات، وقد يكون تم تجاوزه اليوم، أو قد يكتشف الطب دواءً جديدًا أو تقنية مختلفة تجعل ما مررتُ به أسهل على نساء أخريات. نحن بحاجة دائمة إلى المعرفة. لكن إذا قال لي الطبيب: "هذه هي الحالة ولا سبيل آخر"، وانتهت القصة بالفشل، فهنا يأتي الجانب الآخر من التجربة: الجانب الروحي والإيماني. فبعد حدود العلم، هناك شيء داخلي على الإنسان أن يُغلقه بنفسه، أو أن يستمدّ منه قوته كي يواصل.
الإنسان بطبيعته كائن إيماني، يؤمن بشيء: بالجمال، بالفن، بالله. أنا علاقتي بالله علاقة كبيرة، أطمئن إليها وأستمد قوتي منها. أشعر أنني كلما آمنت بنفسي آمنت بالله أكثر؛ لأن الله منحني العقل، والإرادة، والقدرة على التفكير والبحث. واجبي أن أفعل ما عليّ، أن أواصل المحاولة وأن أجد السبيل. فإذا لم يتحقق ما أريد، فأنا على الأقل فعلت ما بوسعي، وهذا يكفيني.
هناك دائما إحساسٌ داخلي لدينا لا يفهمه الآخرون، لكنه يكون بالنسبة لنا بمثابة مؤشّر أو إشارة. في تجارب حملي كانت المؤشرات تقول إنَّ الأمر شبه مستحيل وعليّ ألّا أحاول للمرة الرابعة، لكن شيئًا داخليًّا كان يقول لي: "لا، بل سأفعل". أذكر ما رويته مرة عن مظلة ابني فارس: حين كنا في معسكر في لندن وسافرنا إلى فرنسا، وهو يصطحب مظلته من ضباب لندن إلى حرّ نيس، حيث لا أحد يتوقع المطر، وكنت ألومه على حملها على الطيارة بعصاتها الغليظة طوال الرحلة. لكنه أصرّ على الاحتفاظ بها. وعندما وصلنا مطار نيس، وخرجنا منه هاجمنا رعد وبرق وأمطرت السماء، ففتح فارس مظلته ولمعت عيناه بالفخر وسط دهشة الجميع، ووقفت أنا أراه بعين مختلفة: وكأن القدر نفسه كان يناصره على هذا الحدس الداخلي.
هذا حصل معي تمامًا في تلك اللحظة التي قررت فيها خوض غمار التجربة الرابعة - رغم قراراتي السابقة بالاستسلام- كنت أمتلك هذا المؤشّر الداخلي نفسه. وأشعر أن عليّ أن أواصل، وأن المؤشرات، مهما بدت صغيرة أو غير منطقية للآخرين، كانت بالنسبة لي بوصلة داخلية تقول لي: ما زال الطريق مفتوحًا.
د. حسام الدين درويش:
دعيني أوضح أن البعد الروحي أو الروحاني أو غير العلمي، غير موضوعي، لا يقتصر على المعنى الديني بالمعنى الضيق للكلمة. فمثلًا تقولين: "ثمة لحظة يتوقف فيها العلم ويبدأ النداء الخفي بين الجنين والروح". كما أنك في مرحلة ما طلبت من الأطباء أن يقوموا بشيء، بناء على شعورٍ لديك، وكنتِ ترين أن هذا الشعور أصدق وأهم من معرفة الطبيب التقنية. فإلى أي حدّ يرتبط بك هذا الجانب الروحاني بهذا المعنى؟
د. ميادة كيالي:
نعم، العلم يمنحنا أدوات الفهم، ويضع بين أيدينا وسائل للقياس والاختبار، لكن الحياة والتجارب علّمتني أن هناك بعدًا آخر ينمو داخل كلّ إنسان؛ حدسًا خاصًّا به يتشكّل حسب ما مرّ به من تجارب وما اعتنقه من أفكار. هذا الحدس، إذا جاز التعبير، هو قدرة استباقية على قراءة إشارات المستقبل أو شيفرات تحوّلات الجسد والنفس، قبل أن يتمكن العلم من رصدها أو تفسيرها.
أحيانًا أشعر أنّ في دواخلنا "نظامًا" يشبه ما نعيشه اليوم مع التكنولوجيا: كما نستغرب حين نتحدث عن شيء ما، ثم نفاجأ بظهور دعاية عنه على هواتفنا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، فنفهم أنّ هناك تطبيقًا يتجسّس على أصواتنا، كذلك في دواخلنا أيضًا شيء شبيه يتجسّس على أفكارنا، يلتقطها قبل أن ندركها نحن أنفسنا، ثم يعيدها إلينا على شكل إشارات أو رسائل صغيرة.
هذا الحدس ليس بديلاً عن العلم ولا نقيضًا له، بل هو الوجه الآخر لتجربتنا الإنسانية؛ ذلك الجزء الذي يُنصت إلينا حين يصمت كل شيء آخر، ويعطينا جوابًا أو إشارة دون أن نبحث عنها.
الحدس ليس علمًا، لكنه ذاكرة الروح، وهي تتحدث قبل أن يصل العلم.
د. حسام الدين درويش:
تحت عنوان "اصرخِي ولا تصمتي"، تكتبين: "ليست كل الحروب بالرصاص ...، بعضها بالصبر والصمت إلى أن يحين أوان الصراخ". يبدو أن لديك مراحل للصمت، أو ما يمكن أن نسميه الحروب بالصمت، والصبر، والصمت الطويل. كنا نتحدث عن أكثر من تجربة، في أكثر من مرحلة، مع أكثر من طرف، مهنيًّا أو غير مهني، عن ممارسة الصبر والصمت، إلى أن يبدأ الصراخ. ونعني بالصراخ هنا القيام بفعلٍ ما لإيقاف ظلمٍ ما. كنا نتحدث عن الدكتورة لطيفة، وعن الصراخ من خلال الكتابة. وأظنها قالت: "جئتُ للصراخ من خلال الكتابة". حدثينا عن ثنائية الصبر والسكوت من ناحية، والصراخ والكتابة من ناحية أخرى، في حياتك؟
د. ميادة كيالي:
بالطبع، هناك عتبة للاحتمال، وهذه العتبة تختلف من شخص لآخر. في حياتي كانت هناك دائمًا معارك بالصمت ومعارك بالصوت. كنتُ أسمّي الصمت الطويل أحيانًا "المعركة بالزمن"، أقول لنفسي: "هذه حرب لا تستحق أن أستنزف حياتي من أجلها الآن"، فأمضي فيها صامتة، أراقب وأصبر، وكأنني أُعِدُّ نفسي لما بعد ذلك.
في حياتي، تكررت هذه الثنائية كثيرًا: الصبر والصمت حتى تتهيأ اللحظة، لحظة الصراخ الذي لا يكون عشوائيًا، بل هو قرار تقول فيه: "كفى"، قرار للخروج من حالة انتظار طويلة إلى موقف واضح.
في ولادة أبنائي، وجدتني صامتة على ألمي حتى اللحظة الأخيرة، وكأنني أعيش حالة "ولادة مسروقة بصمت". وحين أتت اللحظة، أصبح الصراخ كتابًا، فكان نوعًا من استعادة الحق، واستعادة الصوت، وربما استعادة الذات.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا كثيرًا على هذه الصرخة الجميلة، في انتظار صرخاتك القادمة، إن شاء الله.
د. ميادة كيالي:
إن شاء الله.