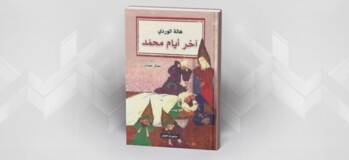قراءة في كتاب: من الإيغو إلى الإيكو - استراتيجية إنقاذ الأرض-
فئة : قراءات في كتب
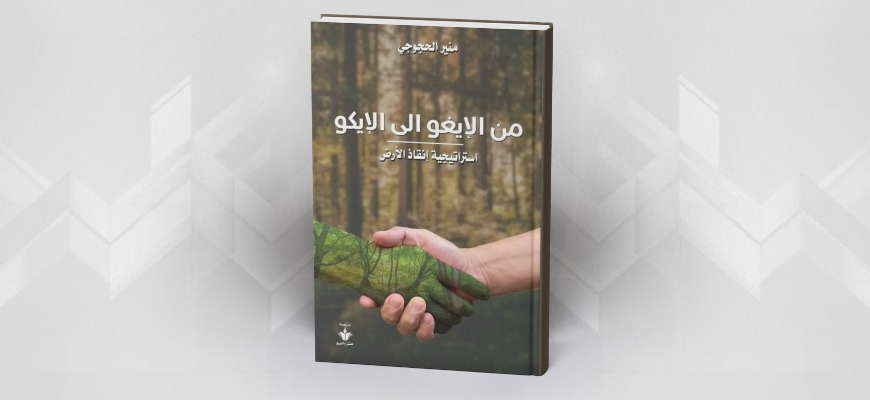
قراءة في كتاب:
من الإيغو إلى الإيكو
- استراتيجية إنقاذ الأرض-
مقدمة عامة
أثبتت الأدلة الأحفوريّة والجينية الحديثة أن أول إنسان عاقل ظهر على الأرض يعود إلى حوالي 300 ألف سنة مضت. ويمكن القول إنه في أكثر من 90 بالمئة من هذه المدة الطويلة نسبياً، عاش الإنسان في وفاق وانسجام تام مع الطبيعة، حيث كان نشاطه فيها يقتصر على تلبية احتياجاته الأساسية، دون تدمير لأنساقها أو تدخل في نظامها.
بيد أن هذه العلاقة ساءت كثيراً في القرنين الأخيرين؛ فمع سيادة العلم والتقنية، أصبح الإنسان ينظر إلى الطبيعة كشيء خارجي (آلة) يمكن التحكم فيه واستغلاله كما يشاء. هذه النظرة الأذاتية التشيئية أدت به إلى ممارسة اعتداءات شنيعة جداً في حق البيئة، أهمها تلويث التربة والهواء والماء، وتدمير واسع للنظم الإيكولوجية...
تفاقم المشكلات البيئية، وتحولها إلى أزمة عالمية شاملة، أوعزا لمفكرين من مشارب مختلفة الانعطاف نحو الحفر عن الأسباب أو الجذور العميقة لهذه الأزمة، مسددّين نظرهم إلى الثقافة والقيم والأفكار التي تصدر عنها السلوكات غير الحصيفة بيئياً، التي جعلت الإنسان يسير في طريق يخرّب فيه مسكنه ويعبث بمحتوياته. وفي نفس الوقت، البحث عن حلول ومنافذ للإفلات من هذه الأزمة التي أصبحت تهدد كل أشكال الحياة على كوكب الأرض. مجهود كهذا أصبح يدخل ضمن ما أضحى يعرف بفلسفة البيئة أو الإيكولوجيا.
كتاب محمد منير الحجوجي، الذي يحمل عنوان من الإيغو إلى الإيكو، الصادر عام 2024م، عن دار بصمة للتوزيع والنشر، يندرج ضمن هذا الإطار، حيث يعد محاولة جادة لتقريب الفكر الأخضر من القارئ العربي، الذي ما زال يظن أن فلسفة البيئة وبعض القضايا المرتبطة بها، مثل البحث والتساؤل عن حقوق الحيوان والنبات والمنظومات البيئية، ربما تكون من قبيل الترف الفكري، أو على الأقل ليست من القضايا الملحّة علينا نحن أبناء المجتمعات المتخلفة، مقارنة بالحاجة إلى تلبية حقوق الإنسان الأساسية والمتنوعة.
وصف الكتاب:
يتكون الكتاب من مقدمة ومحورين أساسيين:
المحور الأول عنونه الحجوجي بـمحطات كبرى، وتوقف فيه عند اللحظات الأساسية لأهم مؤتمرات المناخ المنظمة لحد الساعة (استوكهولم، ريو، باريس، برشلونة...)؛
أما المحور الثاني، فعنونه بـأسماء مفصلية، وتناول فيه أهم التصورات المهتمة بالبيئة، مستنداً في ذلك إلى قائمة مطوّلة تشمل أكثر من أربعين اسماً من رواد الفكر الأخضر.
المقدمة: بيان من أجل الأرض
قدم الحجوجي في المقدمة تصوراً عاما مركزاً لمضمون الكتاب، حيث أشار بداية إلى أن "العالم -الطبيعي- يوجد على شفير غير مسبوق". إنه حرفياً يسير بخطى حثيثة نحو الهاوية، ما لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل. ومن أمارات هذا التدهور الحاد، الذي طال وما زال يطول كوكب الأرض، يرصد الحجوجي، استناداً إلى "منظمة الكوكب الحي" وهي منظمة معروفة بجديتها في متابعة الحالة البيئية: انقراض 30 في المئة تقريباً من الأحياء -البرية والبحرية، وتدمير حوالي 50 في المئة من غابات العالم، وتلويث المحيطات والتربة والهواء والفرشة المائية [1].
يرى الحجوجي أن الأسباب المسؤولة عن هذه الأهوال بشرية خالصة، يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب التلوث الصناعي، وانفجار ديموغرافي مجنون، تضاعف بمقتضاه عدد سكان العالم ثلاث مرات في السبعين سنة الأخيرة. فبسبب هذا العامل الأخير، انخفض الرصيد البيئي العالمي بشكل مهول، وإذا استمر البشر في التكاثر بنفس الوتيرة، فإن حاجتهم إلى الموارد الطبيعية ستزداد بما يفوق قدرة الأرض على توفيره بمقدار الثلث [2].
لذلك، فإن النمو الديمغرافي المطرد، ونمط العيش المعاصر القائم على الاستهلاك الفاحش، جعلا الكثير من الدول، وخاصة منها الدول الاقتصادية الكبرى، "مدينة بيئياً". هذا العجز أو العوز يدفعها، عبر شركاتها العابرة للقارات، إلى الزحف على مقدّرات الدول الأخرى واستنزاف ما تبقى من موارد طبيعية.
إن الإنسان، عبر اختياراته الاقتصادية ذات التوجه الرأسمالي الجشع، القائم على ثنائية الإنتاج والاستهلاك اللامحدود، هو جذر الشر وأصل الخراب الذي يشهده كوكب الأرض. فخطورة الرأسمالية، في نظر الحجوجي، لا تنحصر في حدود ما تمارسه من استنزاف للموارد الطبيعية لسد حاجات غير أصيلة في الإنسان، بل تتعدى ذلك لتخرب عبر "صناعة الإنسان المخرب" [3]: إنسان مهووس بالتملك والاكتناز والاستهلاك اللامحدود، ظاناً أن هذا النمط في العيش، الذي لا يراعي فيه إلا نفسه، كفيل بمنحه الرضا والسعادة المرجوة.
لقد أصبحت الرأسمالية بهذه الاستراتيجية، تزاحم الفلسفة، وتحاول أن تفتكّ منها مشروعها التقليدي المتمثل في الوعد بالسعادة؛ إذ لمّا كانت إحدى معاني السعادة الموعودة في الفلسفة تتحقق بالقبض على الحقيقة، والحقيقة لا تكشف عن نفسها مباشرة في العالم المحسوس، بل توجد مستترة خبيئة فيما وراء العالم المادي، وللوصول إليها تقترح الفلسفة مسارات معقدة من التحليل والتأمل، مع ما يقتضيه ذلك من كبح للرغبات الحسية؛ فإن الرأسمالية، يقول الحجوجي: «... لا تصدمك بمثل هذه الشروط المعقدة والطويلة، ولا تطلب منك بذل أيَّ مجهود شاق، ولا تدفعك نحو التوقيع على أيِّ التزامات من أيِّ نوع، ولا تفرض عليك اجتياز أيَّ امتحانات حتى تفوز بالجائزة الكبرى... يكفي أن تستهلك وتستهلك إلى ما لا نهاية» [4]. والمزيد من الاستهلاك يعني المزيد من الضغط على الموارد الطبيعية، والنتيجة في المحصلة النهائية: دمار كوكبي محتوم، والمسألة مسألة وقت فقط.
ما العمل إذن أمام هذا المأزق الوجودي -الكوني، الذي أوجد الإنسان نفسه فيه، بدافع من الاستهلاك المفضي إلى سعادة أشبه بالسراب؟
يجيب الحجوجي عن هذا السؤال بما مفاده أن الخطر الداهم الذي يتهدد كوكب الأرض، لا يمكن مجابهته باتباع تصورات الإيكولوجيا الإصلاحية أو الضحلة؛ لأن التدابير التي تدعو إلى اتخاذها «قد يكون لها بعض المنافع على المدى القريب، لكنها لن تكون نافعة على المدى البعيد، لأنها ببساطة تتجه نحو الأعراض لا نحو جذور الأزمة» [5]. لهذا السبب، يرى الحجوجي -بإيعاز من رواد الفكر الأخضر- أنه لا مندوحة عن النهل من تصورات الإيكولوجيا العميقة بتياراتها الثلاث: النسوية، الاجتماعية، والسياسية؛ لأنها تطرح قضية البيئة في شموليتها، وتنفذ إلى أعماقها لإضاءتها من الداخل. فهي، على مستوى التشخيص، تعتبر أن "جذر الشر هو تلك الشوفينية البشرية التي تعتقد واهمة أن البشر هم مقياس كل قيمة، أما باقي الكائنات الأخرى، فهي مجرد أدوات ولواحق للحاجات البشرية" [6].
أما على مستوى العلاج، فتراهن على تمثّل ونشر الوعي الإيكولوجي؛ لأنه نصف المعركة، ونصفها الأهم. إذ بفضله سيتمكن الإنسان من الثورة على النظام الاقتصادي السائد، وسيبدع وسائل الانتقال صوب مجتمعات جديدة، تستطيع أن تحصّل سعادتها خارج الإعدامات البيئية، وأن «تحقق وجودها بالثقافة، والفن، والتواصل، والقراءة، والكتابة، والنضال السياسي، واللعب، والممارسات الاحتفالية» [7].
المحور الأول: محطات كبرى
توقف الحجوجي في هذا المحور عند أهم مؤتمرات المناخ المنظمة من قبل الأمم المتحدة، بدءا بمؤتمر استوكهولم (1972)، مرورا بمؤتمر ريو (1983)، وصولا إلى مؤتمري باريس (2015) وبرشلونة (2019). ولفت الانتباه إلى أن هذه التظاهرات العالمية تطورت على مستوى الوفود المشاركة؛ فبعد أن كانت هذه الأخيرة تقتصر على العلماء وخبراء المناخ وبعض النشطاء، توسعت اللائحة، شيئًا فشيئًا، لتشمل رجال السياسة (رؤساء وبرلمانيين). غير أن هذه المشاركة النوعية الموسعة لم تحمل أي جديد لصالح حماية البيئة. وعلّل الحجوجي ذلك بكون أصحابها عبّروا عن انشغالهم "الكاذب" بمخلفات التغير المناخي، بتلاوة خطابات إنشائية دامعة، منافقة، محكومة بمنطق "لنأكل مع الذئب ولنَبكِ مع الراعي".
أما فيما يخص البيانات الختامية لهذه المؤتمرات، فقد أقرّ المؤلف أنها نصّت على توصيات مهمة، يمكن -في حال التجاوب مع الإشارات والتنبيهات التي ترسلها- النجاح في تجاوز بعض تبعات الأزمة البيئية، ومن أهم هذه التوصيات:
• الاعتراف بأن النشاط البشري هو المسؤول الأول والأخير عن تخريبات عالمنا؛
• الاقتناع بأن الأرض كوكب محدود الموارد، وبالتالي من الغباء عدم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، والاستمرار في سيرورة تنمية بلا حدود؛ بل لا بد من خفض النمو؛
• الوعي بأن مستقبل الأجيال القادمة رهين بالقرارات التي نتخذها اليوم؛
• تكثيف الضغط على كل الدول، وإلزامها بعدم القيام بعمليات مؤذية للطبيعة، تحت ذريعة أنها لا تتوفر على المعطيات العلمية الكافية؛
• الدعوة إلى تدشين وإرساء "عصر تنمية اقتصادية جديد"، يرتكز على مفهوم "التنمية القابلة للتحمل"، كاستراتيجية تنموية تستجيب لحاجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة؛
• الاتجاه نحو نظام تدبير كوكبي ذكي، وهو نظام يرتكز على مجموعة من الإجراءات، من أهمها إطلاق برنامج أممي للحفاظ على البيئة، ينشد:
- مراقبة التلوثات العالمية؛
- حماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض؛
- تدوير النفايات؛
- الحد من التصحر...
تدابير تقنية من النوع المذكور أعلاه من شأنها أن تشيع ثقافة بيئية وسط المجتمع المدني، الذي سيعمل بدوره على إبطاء وتيرة التدميرات البيئية. لكنه لن ينجح في فرملتها نهائيًا، نظرًا لوجود مانع سياسي صرف، يُعزى إما إلى تواطؤ حكومات الواجهة، أو إلى عدم قدرتها على حماية أمنها البيئي بإلزام اللوبيات الصناعية الناشطة على حدودها الجغرافية باحترام إجراءات السلامة البيئية، أو إلى عدم وجود تشريعات تستهدف حماية البيئة، بسبب ضحالة التكوين السياسي للجهة المشرّعة وضعف ثقافتها البيئية.
هذا الاختلال الأخير، المتمثل في الفراغ التشريعي، حاولت البيانات النهائية لمؤتمرات المناخ تداركه بإصدار توصية مهمة في هذا الشأن، تلح على ضرورة:
• تربية السياسيين، وإكسابهم ثقافة بيئية تجعلهم يأخذون التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند سنّ القوانين الوطنية والجهوية والمحلية.
المحور الثاني: أسماء مفصلية
تناول الحجوجي في هذا المحور أهم التصورات المهتمة بقضية البيئة، مستندًا في ذلك إلى قائمة موسعة تشمل ما يفوق أربعين اسمًا من رواد الفكر الأخضر. وبحكم أن هؤلاء المفكرين جميعهم ينشطون في مجالات بحثية مختلفة، كالفلسفة، البيولوجيا، علم النفس، السياسة، والفن... فقد جاءت مقارباتهم للمسألة البيئية متفاوتة، من حيث، العمق والوضوح؛ ففي الوقت الذي انشغل فيه بعضهم بسؤال "النظر"، وفضّلوا البقاء في دائرة الفهم، وكرّسوا جهودهم للبحث عن الجذور الفلسفية والاقتصادية والسياسية والثقافية للأزمة البيئية، اهتم بعضهم الآخر بسؤال "العمل"، وحاولوا الإجابة عن السؤال اللينيني الشهير: ما العمل؟ ما العمل لإيقاف استغلال الإنسان للطبيعة بشكل غير طبيعي؟
فدعوا بهذا الخصوص إلى مباشرة إجراءات ذات صبغة عالمية/كوكبية لضمان البقاء، وأدلوا بحزمة من المقترحات، اتسمت جلّها بالجدّة والعقلانية والقابلية للتطبيق. بينما لم يخلُ بعضها الآخر من الطرافة والهبل، إما لشدّة انحدارها إلى مستوى الواقعية الساذجة، أو لارتقائها إلى مستوى المثالية المفرطة؛ كذاك المقترح غير المسبوق الذي دعا إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية «بتشتيت البشرية على مختلف الكواكب، وأولها كوكب مارس» [9]. وكأن أمرًا كهذا هو في حكم الممكن، كل ما ينقصه القرار فقط. قرار، يقول مقترٌحٌ ثانٍ لا يقل غرابة، يمكن الحصول عليه بسهولة «بتعيين حكومة عالمية تتكفل بتدبير الديموغرافيا» [10].
جذور الأزمة البيئية
• ترسيخ الفلسفة الغربية، من أفلاطون إلى مشارف اللحظة البيئية، لفكرة في غاية الخطورة، تقوم على "الفصل بين الكائنات البشرية والمحيط الطبيعي"، وتنظر إلى الإنسان باعتباره غاية في ذاته، وأصل كل قيمة. أما "الطبيعة بكل ما فيها، فلا توجد إلا بوصفها وسائل يتوجب تسخيرها من أجل الخدمة الحصرية للبشر" [11]، وليس ككيان يستحق الاحترام في ذاته.
انطلقت الإرهاصات الأولى لهذا التصور -المتمحور حول الإنسان- مع ديكارت، الذي كما نعلم، أقام قسمة ثنائية بين جوهرين اثنين: الأنا المفكر والمادة الممتدة. وبناءً على هذه الثنائية الأساسية، وضع الذات مقابل الموضوع، والإنسان مقابل الطبيعة، والأنا مقابل العالم؛ "الأنا" جوهر مفكر، عاقل، ومستقل عن العالم والآخرين، و"الطبيعة" عبارة عن آلة ضخمة، تحولت أسرارها إلى قوانين وقوى ميكانيكية، يتوجب علينا نحن البشر أن نسعى إلى معرفتها، لنصبح سادة ومالكين لها، ونسخّرها بشكل أمثل لصالحنا. غير أن هذا الطموح الديكارتي فاق السقف المسموح به، وتحول -تحت طائلة الجشع البشري اللامحدود- إلى تشييء للطبيعة، مما «شكّل مع مرور الوقت مدخلًا لكل الإعدامات البيئية التي نراها اليوم» [12]؛
- تغوّل النظام الرأسمالي، عبر شركاته العابرة للقارات، وضغطه على الحكومات للحصول على التشريعات الملائمة للاستثمار، تشريعات تسمح لأي "شركة كبرى بوضع شكاية ضد حكومة ما، في شأن أيّ قانون أو قرار قضائي، يمكن أن يهدد أرباحها الحالية والمستقبلية؛ والنتيجة المترتبة عن ذلك، أن "الحكومة تفكر ألف مرّة قبل إقرار أيّ قانون" له علاقة بالسلامة الصحية والبيئية، "خوفًا من أن يجرّها ذلك إلى أداء تعويضات بالملايير" [13].
هذا الشكل من الاستعمار الحديث، القائم على النفوذ السياسي والاقتصادي، ليؤبّد سيطرته أكثر فأكثر، يفرض أنظمة تعليمية وإدارية غريبة عنِ السكان الأصليين؛ الهدف منها تكوين جيش من البيروقراطيين، الذين يعملون نيابة عنه على تغيير البنى الزراعية والاقتصادية لدولهم لصالح القوى المستعمِرة. الأمر الذي يدفع الناس مع مرور الوقت، إلى استبدال "أنماط عيشهم التقليدية، الصديقة للبيئة، القائمة على الزهد والكفاف، بأنماط عيش رأسمالية معاصرة" [14]، ملوّثة للبيئة، مخربة للأنساق الطبيعية؛
• عمل الرأسمالية، عن طريق التسويق والإشهار، على خلق حاجات جديدة في عقول الناس، وتصويرها كما لو أنها حاجات أصلية فيهم؛ لرفع مستوى الاستهلاك لديهم إلى أقصى حد ممكن. وقد نجحت الرأسمالية في هذا المسعى نجاحا باهرا، إلى درجة أن واقع الاستهلاك في المجتمعات المعاصرة تحوّل إلى ما يشبه الإدمان الجماعي؛ ليحصل المرء على جرعته، أصبح مستعدا لفعل أي شيء، بما في ذلك تدمير الطبيعة بما فيها، أو تمهيد الطريق إلى ذلك [15]؛
• سطو الرأسمالية على مفاهيم الفلسفة والعلوم الإنسانية، وعلى رأسها "النزعة الفردانية"؛ فبعد تشويه هذا المفهوم وتزييفه، تشجّع على استحسان وتبنّي النسخة الرديئة والباهتة منه، تلك التي تدفع الفرد إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة فقط، وذلك بأن "يأكل، ويسافر، ويغني، ويرقص على الأنغام الباهرة للعالم، وألّا يكترث مطلقا لما يُحاك في محيطه" [16] الاجتماعي والطبيعي، مهما بلغ منسوب الفظاعات المرتكبة فيه. عبر هذه الآليات المخاتلة، تُغرق الرأسمالية الناس في مستنقع اللامبالاة، و"تمنع انبثاق الأشخاص المتشبعين بقيم المسؤولية، والأخوة، والتعاطف، والتعاون من أجل البقاء"، وغيرها من القيم التي يمكن أن تشكّل نقيضًا للقيم المنتجة للسلوكيات غير الحصيفة بيئيًا؛
• اعتماد المجتمعات المعاصرة على نظام زراعي معولم وصناعي، يستعمل بذورا معدّلة جينيا، تطلق عند نموّها كميات هامّة من الغازات الاحتباسية (N₂O)، تُسخّن الجو 28 مرة أكثر من البذور العادية. كما يعتمد على المبيدات الكيماوية لزيادة الإنتاج، وهي مواد تستقر وتتراكم في عمق الأنساق الطبيعية من ماء وهواء وتربة، محدثةً تخريبات لا حصر لها.
إن ما لا يتم الانتباه إليه، أو بالأحرى ما يتم التغاضي عنه من قبل المنتفعين من هذا النظام، أن الطبيعة عبارة عن مركّب يتكوّن من مجموعة من الأجزاء المترابطة فيما بينها، وأيُّ مسٍّ أو إتلاف لأيِّ عنصر من العناصر المكوّنة لهذا النسق، يتسبّب في إلحاق الضرر بالنسق برمّته [17]. فمثلا، الاستعمال الواسع للمبيد الحشري (DTT) يقتل الحشرات المضرّة (من منظور الإنسان، أما هي في الحقيقة فلها دور معيّن في التوازن الطبيعي)، وهذه الأخيرة تتغذّى عليها الطيور، فيؤدّي ذلك إلى إضعاف بيوضها، ممّا يعجّل بانقراض بعضها [18]. الأمر الذي يتسبّب، مع مرور الوقت، في القضاء على التنوع البيولوجي، والإخلال بالتوازن البيئي، فضلًا عن تراجع مستوى الجمال في الطبيعة (الربيع الصامت)؛
• تخلي غالبية المثقفين عن مسؤولياتهم في الاشتباك مع القضايا الوجودية الكبرى، قضايا العيش المشترك والمصير، والتزامهم المعيب بواجب التحفّظ إزاء ما يحدث؛ تصوّر كهذا، يقول الحجوجي: «مشبوه، لأن التحفّظ في مرّات كثيرة هو الصيغة اللبقة للانسحاب من العالم، وللتحلّل من التزامات المواطنة الكونية» [19].
إن المثقفين هم ضمير البشرية، وصمتهم عمّا يحدث من انتهاكات وإجرام في حق الطبيعة هو عمليًا وقوف إلى جانب القوي، وتواطؤ مع المخرب (الرأسمالي وربيبه السياسي)، وتشجيع له للقيام بالمزيد من الدمار والتخريب. وأسوأ مكان في الجحيم، كما قال "مارتن لوثر كينغ" ذات مرة، محجوز لأولئك الذين يقفون على الحياد في عزّ المعارك الأخلاقية.
الحلول ومنافذ الإفلات من الأزمة البيئية
• التبنّي الكامل لأطروحات الإيكولوجيا الجذرية، التي تتجاوز أخلاق "المركزية البشرية"، مركزية الإنسان الغربي تحديدا وحصرا، إلى مركزيات جديدة تشمل الإنسان والكائنات المحرومة أخلاقيا؛ كأخلاق "المركزية الحيوية"، التي تقوم على فرضية أساسية مؤداها أن "كل الكائنات الحية لها قيمة في ذاتها، بغض النظر عن استخداماتنا لها، وبشكل مستقل عن كونها حاسة أو مبالية" [20]. وما دامت كذلك، فالإنسان ملزم أخلاقيًا بحمايتها وتعزيز خيرها لأجل ذاتها فقط.
وأخلاق "المركزية البيئية" أو "أخلاق الأرض"، التي تذهب أبعد من الأولى وتؤكد أن "كل العناصر الطبيعية من تربة، ومياه، ونباتات، وحيوانات... جديرة بالاعتبار الأخلاقي" [21]. أخلاق -كونية شاملة- تراهن على جعل الإنسان العاقل أكثر تواضعًا عبر تغيير دوره من مستعمر لمجتمع -الأرض- إلى عضو عادي ومواطن فيه، من الواجب عليه احترام الأعضاء الزملاء له، وأيضا احترام المجتمع بحد ذاته؛
• بناء وعي إيكولوجي بخلفية فكرية إيكو- ماركسية، يتجاوز المقاربات التقنية لأسئلة الأرض والحياة والإنسان، ويستعيد أفكار ماركس الشاب، ماركس العائلة المقدسة 1844م، لماذا ماركس وليس غيره؟ لأن ماركس، في نظر الحجوجي، يساعدنا على تعيين الأعداء الحقيقيين، ويؤمن بأن التحرير الشامل، يبدأ أولا بإعلان الحرب على الاستغلال بكل أشكاله، لاسيّما استغلال الإنسان -البرجوازي- لأخيه الإنسان. وكل تفكير بيئي يغضّ الطّرف عن هذا المعطى، ولا يستحضر الصراع الطبقي في السعي لحل الأزمة البيئية، سيكون النشاط المترتب عنه (التشجير، تدوير النفايات...) مجرد بستنة" [22] أو سيكون أشبه بعمل ذاك المحقق الفاسد الذي يضلّل العدالة بطمس أهم الأدلة التي تدين الجلاد؛
- وضع بداهاتنا الفكرية، وعلى رأسها المفاهيم المؤسسة للحداثة الاقتصادية، كزيادة النمو والتنمية المستدامة والتقدم... محط مساءلة؛ وسرعان ما سيتبيّن لنا أنها مقولات جوفاء ومخادعة؛ لأنها أدت إلى عكس المتوخى منها، فإذا أخذنا على سبيل المثال مفهوم "التقدم"، سنلاحظ بسهولة بالغة أن الإنسان أحرز تقدما كبيرا، لا شك في ذلك، لكنه تقدم كمي، أمعن فيه في تصفية شركائه على الأرض، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل إنتاج المزيد من العنف والجوع والمرض والمعاناة والفوارق الطبقية [23]؛
• تربية الناشئة تربية عقلانية معاصرة، تنأى بنفسها عن بعض السرديات الكبرى، الدينية والفلسفية-العلمية، التي كرّست فكرة الإنسان/الإله، سيّد ومالك الطبيعة، وكل ما هو موجود مسخّر لخدمته [24]. وترتكز في المقابل، على خلفية علمية رصينة وبيداغوجيا مفكّر فيها، تغرس في نفوس الأطفال ثقافة الاحترام الشديد للطبيعة، وتشرح لهم "كيفية نشأة الحياة على الأرض"... وأن الكائنات الحية، بما فيها الإنسان، تنحدر من عائلة واحدة تربطها قرابة معيّنة تعود إلى تاريخ محدّد في سلسلة التطوّر اللامتناهي.
تربية من هذا النوع، هدفها القريب "صناعة أجيال مستقبلية تمتلك وعيا بيئيا متقدّما، يجعلها تقف ندّا للندّ أمام الأجيال التي تصنعها الرأسمالية، وتحضّرها لتخريب العالم" تحت مسوّغات الربح والمردودية والإنتاج [25]. وهدفها البعيد: الهدم الكلي لفكرة/وهم تفوّق الإنسان على باقي الكائنات، ودفعه لتغيير دوره من مستعمر وطاغية إلى مجرّد قيّم أو مشرف على مجتمع -الأرض، بحيث يصبح دوره كدور مدير المزرعة في جعل الطبيعة منتجة عبر مساعيه، دون أن يؤدّي ذلك إلى تدهور متعمّد في مواردها؛
• خوض نضال إيكولوجي واسع وموسّع، يقوده ويتوحّد تحت رايته كل أصحاب النوايا الحسنة، ممّن يحملون على عاتقهم همّ حماية البيئة. وتُستغل فيه كل الوسائل الممكنة، من "إعلام، وأفلام، وأغانٍ، وأناشيد، ومعارض للصور، ووثائقيات" [26]، ووعظ ديني وغيرها؛ "لتعرية الأخطار المحدقة بالبيئة، وفضح المتسبّبين فيها، والضغط عليهم بشتى الطرق، بمقاطعة منتجاتهم، وبالتظاهرات، وبالعصيان المدني"، وهلمّ جرّا [27]؛
• وضع الرهانات الإيكولوجية في قلب العملية السياسية، بدمج القضايا البيئية ضمن البرامج السياسية للأحزاب، وجعل حماية البيئة من الأولويات الأساسية للمترشّحين للانتخابات (الرئاسية، البرلمانية، المحلية) [28]. وعند تقلّد المسؤولية، يجب العمل فورا على سنّ قوانين زجرية، تُضيّق الخناق على من يريد، مثلًا، خصخصة الماء -لأن هذه الثروة لا يجب أن توضع تحت قبضة أيّ أحدٍ، إنها ملك للبشرية- وتضع قيودا صارمة على المزروعات المعدّلة جينيا، وتمنع إنتاج واستيراد اللحوم المعتمد في إنضاجها على هرمونات النمو [29]؛
• فساد الإنسان في الطبيعة نابع من فساد علاقاته الاجتماعية؛ بسبب التراتبية الجنسية والاجتماعية والسياسية (هيمنة الذكور والبرجوازية على النساء والطبقة الكادحة). وبالتالي، فإن إحياء الأمل في بيئة سليمة معافاة رهين بكفّ أذى الناس عن بعضهم البعض، وبإعادة تجسير العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، عبر العمل على إشاعة القيم الإيجابية، النقيضة للعنف والظلم والاستغلال (المساواة، الاحترام، الأخوة، التعاون، الغيرية، والإيثار).
أهداف لا يمكن أن تتحقق في الواقع إلا بالتنظيم، وبالسعي إلى اكتساح الحقل السياسي، وتعويض عمودية السلطة، حيث الأقلية تفرض خياراتها على الجميع، بأفقية التداولات الشعبية [30]. وعندما ستدبّ الديمقراطية والعدالة (التعويضية والتوزيعية) في مفاصل المجتمع، ستنصلح أحوال الناس بشكل شبه تلقائي، وعندها سيميلون إلى الالتزام طواعية بالقوانين التي تستهدف السلامة الصحية والبيئية، هذا إن كانت هناك حاجة أصلًا إلى وضع قوانين من هذا النوع؛
• تشجيع المبادرات والسلوكيات الصديقة للبيئة، كتلك التي تحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة، وتقتصد في مختلف أشكال الطاقة، أو تعتمد كليا على الطاقات المتجددة... ومكافأة أصحابها بشكل من الأشكال، عبر تخفيض الضرائب على الوحدات الصناعية التي تبدي تجاوبا والتزاما بقضايا البيئة، وخفض مبالغ التأمين على السيارات التي قطعت كيلومترات قليلة... [31]. في أفق التخلي كليًا عن النموذج الاقتصادي الحالي، الملوّث للماء والهواء والتربة، وبناء نموذج اقتصادي جديد (الاقتصاد الأزرق)، يستوحي آليات اشتغاله من المحاكاة البيولوجية للأنساق الطبيعية، بحيث تكون فيه نفايات مرحلة إنتاجية ما، المادة الأولية لنشاط إنتاجي لاحق، وهكذا دواليك [32].
• التخلي عن الزراعة المحكومة بالاستعمال المكثف للمواد الكيماوية، والتحول صوب زراعة إيكولوجية، يتماهى فيها النشاط البشري مع دورة الأرض. هذا التوجه، فضلًا عن أنه سيؤدي إلى الحصول على إنتاج أوفر وأجود [33]، سيدرك الإنسان من خلاله أن الطبيعة تعمل وفق مبدأ التوازن الذاتي؛ أي أن العمليات التي تقوم بها ليست عشوائية، بل هي نتاج توازن دقيق وتكامل وظيفي بين الكائنات الحية ومحيطها. هذه الثقافة البيئية، القائمة على الفهم العميق لدينامية النظم البيئية، من شأنها أن تقوّي علاقة الإنسان بالأرض، وتُعزّز احترامه لها أكثر فأكثر؛
• الاحتفاء بالهامش، بثقافات المجتمعات البدائية وأنماط عيشها الصديقة للبيئة، والسعي لاستلهام نموذجها، وذلك لعدة اعتبارات: أولها أن هذه المجتمعات استطاعت أن تحقق المعادلة الكبرى، المتمثلة في تلبية حاجاتها الأساسية، لكن في وئام حقيقي مع الطبيعة؛ فبانصهار أعضائها في الطبيعة، اكتسبوا معرفة تتجاوز الإمكانات التي تتيحها الأعضاء العادية للإدراك، وتعلّموا ألّا يأخذوا من الطبيعة إلا ما يحتاجونه، وفقًا لما يعرفونه، دون تحدٍّ للعناصر الطبيعية، لعلمهم أن الطبيعة تعمل وفق مبدأ التوازن، وأي خلل هنا سيؤدي إلى خلل فضرر هناك [34]. وثانيها، أن هذه المجتمعات ترفض الدولة كجهاز قائم على الضبط والهيمنة، وتعمل وفق ميكانيزمات سلطوية أخرى، لا أحد ينكر أن فيها نوعا من العنف والضبط، لكنه عنف مبرّر بالنظر إلى هدفه الأخير، المتمثل في منع انبثاق الفرد [35] في نسخته الباهتة المشار إليها أعلاه.
• إبطاء وتيرة النمو الديمغرافي؛ لأن "الأرض -كوكب محدود- لا يمكنه أن يستجيب إلى ما لا نهاية للحاجات الطاقية والغذائية والعمرانية لبشر لا يتوقفون عن التكاثر" [36]. ويمكن النجاح في هذا المسعى بالانكباب على بعض التدابير، مثل: "تحديد النسل، وشرعنة الإجهاض، وتشجيع الزيجات المتأخرة، والعلاقات التي لا تفضي إلى حمل، والاشتغال على تمثّل المرأة لذاتها، بدفعها لتغيير تلك الصورة النمطية عن نفسها، باعتبارها آلة منذورة خصيصًا للإنجاب..." وفي حال عدم تجاوب الأغلبية مع هذه المقتضيات الضرورية/الصعبة، لاعتبارات معينة، "يمكن المرور إلى إجراءات أكثر سلطوية، كإجبارية الإجهاض لمنع الطفل الثاني أو الثالث... لأن مصير النوع البشري، ومعه كوكب الأرض، أكبر من أي اعتبارات عائلية أو دينية أو غيرها" [37].
خاتمة
على الرغم من توفر العديد من الدواعي، ما تزال قضايا البيئة تعاني من غبن كبير على مستوى التأليف والترجمة في الثقافة العربية-الإسلامية. في هذا السياق الموسوم بالنذرة والنقص الشديد، جاء كتاب من الإيغو إلى الإيكو ليسدّ هذا الفراغ، ويعزّز قائمة الكتب -القليلة جدًا- المهتمّة بالشأن البيئي.
تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه ذا طابع تثقيفي وتعليمي بامتياز؛ هدفه تبسيط وتقريب الفكر الأخضر من القارئ العربي، فاتحا أمام ناظريه نافذة فكرية جديدة في التعاطي مع الأزمة البيئية، تتجاوز البعد التقني الضيق لتلامس الجذور -الثقافية والفلسفية والاقتصادية- العميقة لهذه الأزمة.
فقد بيّن الحجوجي، على امتداد صفحات هذا الكتاب، أن التدهور البيئي ليس مجرد خلل مادي، كما يدّعي المفترسون الكبار، يتبعهم في ذلك بعض النشطاء السذّج، والساسة المنافقون؛ بل هو انعكاس لأزمة فكرية عميقة، تتجلّى في نظرة الإنسان إلى الطبيعة بوصفها شيئا خارجيا قابلا للاستغلال بلا حدود. وأكد أن تجاوز هذه الأزمة سيبدأ حين يغيّر الإنسان علاقته بالعالم الطبيعي (من خلال الوعي، والتربية، والنضال السياسي) ويدرك أنه جزء لا يتجزّأ من منظومة حياتية مترابطة. عندئذٍ، ستنعكس هذه الرؤية الجديدة على أفعاله، لتصبح أكثر انسجامًا مع مبادئ الاستدامة ومتطلبات التوازن البيئي.
الهوامش:
[1] الحجوجي، محمد منير، من الإيغو إلى الإيكوـ استراتيجية إنقاذ الأرض، دار بصمة للتوزيع والنشر، 2024، (ص ص: 8–10)
[2] نفسه، (ص 9)
[3] نفسه، (ص 13)
[4] نفسه، (ص 15)
[5] نفسه، (ص 12)
[6] نفسه، (ص 11–12)
[7] نفسه، (ص 20)
[8] نفسه، (ص25–35)
[9] نفسه، (ص 90)
[10] نفسه، (ص 75)
[11] نفسه، (ص 128)
[12] نفسه، (ص 52)
[13] نفسه، (ص 179)
[14] نفسه، (ص 79)
[15] نفسه، (ص 92–94)
[16] نفسه، (ص 173–174)
[17] نفسه، (ص 65–66)
[18] نفسه، (ص41)
[19] نفسه، (ص 89)
[20] نفسه، (ص 44)
[21] نفسه، (ص 46–48)
[22] نفسه، (ص 87–88-101)
[23] نفسه، (ص 132-133- 162)
[24] نفسه، (ص 129)
[25] نفسه، (ص 122-123)
[26] نفسه، (ص116- 136-137)
[27] نفسه، (ص 39)
[28] نفسه، (ص 109)
[29] نفسه، (ص 113–114)
[30] نفسه، (ص 96-97)
[31] نفسه، (ص 200)
[32] نفسه، (ص 199-201)
[33] نفسه، (ص 143–174)
[34] نفسه، (ص 186–187)
[35] نفسه، (ص 57–58)
[36] نفسه، (ص 74)
[37] نفسه، (ص 75)