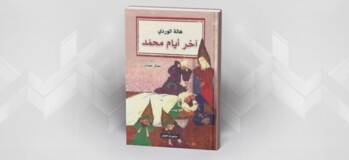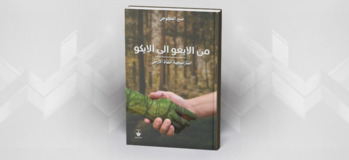الحاجة إلى إبستمولوجيا التعقيد في الدرس الفلسفي
فئة : مقالات

الحاجة إلى إبستمولوجيا التعقيد في الدرس الفلسفي
الملخص:
يندرج هذا المقال ضمن مجهود بحثي يروم مساءلة المنظومة التعليمية، من خلال اقتراح فكر التعقيد كمدخل إبستمولوجي وتربوي لتجديد الدرس الفلسفي وتفعيل فاعليته النقدية. وقد انطلقت في هذا الاشتغال من قناعة راسخة بأن الفلسفة لكي تستعيد راهنيتها، مطالبة بالانخراط في أسئلة العصر المعقدة، وبأن المتعلم لا يحتاج أجوبة جاهزة بقدر ما يحتاج أن يتعلم كيف يسأل. من هنا، سعيت إلى بناء تصور يحاور الجدل القائم بين البنية التقليدية للمعرفة المدرسية، وتعقيد الواقع المعاصر، عبر تفكيك المفارقات التي تعيق حضور الفلسفة كخطاب نقدي. لقد كان الرهان هو أن أعيد تموقع الذات المتعلمة في قلب العملية التعليمية التعلمية، بوصفها فاعلة في بناء المعرفة. واستنادًا إلى فكر إدغار موران Edgar Morin، دافعت عن ضرورة الانتقال من تعليم فلسفة مجزأة ومجردة إلى فلسفة تعاش كتجربة وجودية تسائل الحياة في مجملها، وتستوعب تعدديتها، في أفق بناء وعي نقدي منفتح ومسؤول.
"وبما أن الحياة ولدت في مشيمة بحرية، فإنها لم تعد يتيمة"[1].
إدغار موران
تقديم إشكالي:
تعرف المعرفة الإنسان في العصر الراهن تقدما متسارعًا عبر بوابة التقدم العلمي، مما يفضي إلى ضرورة تغيير جذري في مفاهيمنا حول العلم والعالم والإنسان، وموقعه ضمن النسيج الكوني. تتسم هذه المرحلة بتداخل الأقاليم العلمية، كالفيزياء والبيولوجيا والأنثروبولوجيا، حيث لم يعد من الممكن تفسير الظواهر ضمن حدود ضيقة أو بمقاربات فكر التبسيط. لكن، ما يستدعي المساءلة والتفكير هو تغييب مستجدات التقدم العلمي من مضامين تدريس الفلسفة، التي لا زالت تعتمد على نماذج تقليدية تعزل الفكر الفلسفي عن التقدم العلمي المعاصر، وتفصل الإنسان عن بيئته الكونية والاجتماعية.
ينبثق هذا التضارب من شرخ معرفي قائم بين بنية ثقافية تكرس تصورات جامدة وتابعة لأنماط فكرية موروثة، عاجزة عن استيعاب المنطق التركيبي والمعقد الذي أصبحت تتطلبه مقاربة الظواهر، وتصورات علمية للعالم تتأسس على مفاهيم التعقيد والتعددية واللايقين. بسبب هذا التضارب، تعاني المضامين الفلسفية من العزوف عن مواكبة التحولات الإبستمولوجية التي أحدثها التقدم العلمي، فيظل حضورها محصورًا في إطارات تاريخية بعيدة عن معالجة التعقيدات الوجودية والمعرفية التي يفرضها العصر. من هذا الجانب بالذات تأتي الحاجة إلى إعادة التفكير في طبيعة الفلسفة ووظيفتها التعليمية، لتصبح جسرا بين المستجدات العلمية وأسئلة الإنسان الوجودية المعاصرة، مما يعيد الحيوية والحياة إلى الدرس الفلسفي.
ومنه، فإن تدريس الفلسفة بمنطق التجزيء، وبانفصال واضح عن تحولات العلوم وأسئلة العصر الراهن الكبرى، يطرح تحديات حقيقية على مستوى تجديد مضمون الدرس الفلسفي؛ بمعنى أن التقدم المعرفي لم يصاحبه بالقدر الكافي تحول جذري في أنماط التفكير التربوي والفلسفي؛ ذلك أن التعليم يكرس أحيانا معارف منفصلة عن الرهانات المعرفية الكبرى، بل وتغيب عنه الجرأة على مساءلة الأساطير الفكرية اللاعقلانية التي تقيد وعي المتعلم، وتمنعه من ممارسة حقيقية للفكر النقدي الحر.
يقدم فكر التعقيد، تصورا فلسفيا وإبستمولوجيا يتجاوز الانقسامات التقليدية، عبر الاعتراف بالعالم ككل متداخل، دائم التحول والانكشاف، والإنسان كجزء لا يتجزأ من بنية الكون. ينطوي فكر التعقيد على إمكانات جديدة لتجديد طرائق تدريس الفلسفة، ليصبح مدخلا لبناء رؤية نقدية تأخذ بعين الاعتبار تعقيد مكونات الوجود وتقاطعها، وبالتالي مساعدة المتعلم على إنماء وعي نقدي منفتح وعقلاني.
وعليه، إذا كان الإنسان المعاصر يعيش في كون معقد، لكنه غالبا ما يفكر فيه بعقلية التبسيط والاختزال، وكان المتعلم يواجه تحديات وجودية ومعرفية كبرى، لكن المدرسة لا زالت تقدم له مضامين فلسفية منفصلة عن هذه التحديات، ومفاهيم مجزأة لا تسمح له بفهم ذاته ولا واقعه كما يجب، وكان فهم الواقع يتطلب أنساقا متعدد ومترابطة، إلا أن المنظومة التعليمية تعلم معارف منفصلة وثابتة، كأن المعرفة لا تنفي ذاتها باستمرار، فإن هذه الإحراجات تقودنا إلى صياغة الإشكال التالي: هل يمكن لفكر التعقيد أن يشكل بديلا إبستمولوجيا وتعليميا يمكن المتعلم من فهم الحياة في انتمائها الكوني وبناء وعي نقدي يحرره من يقينيات الخرافة وفكر التبسيط؟
1. أصل الحياة والهوية الإنسانية في فكر التعقيد:
إن الغزارة المعرفية المعاصرة بمختلف فروعها أزاحت الحواجز الصلبة بين التخصصات. وأصبح من غير الممكن الاستمرار في طرح الأسئلة الوجودية الكبرى-حول أصل الحياة، معناها، ومآلها- وفق الصيغ التي سادت في الفلسفات التقليدية، أو في التصورات الأسطورية والدينية ذات البعد الميتافيزيقي، أو بشكل عام في فكر التبسيط الباحث عن نقطة ارتكاز ثابتة؛ ذلك أن الواقع العلمي أفرز تصورات علمية للعالم تتقاطع فيها جهويات علمية متعددة، وتتفاعل فيها الرؤية العلمية مع فعل التفلسف كدافع لتأسس الفهم على فكر مركب لا يستكين إلى التبسيط والاختزال[2].
ولذلك، فإن الأنساق المعرفية المركبة توقظ الوعي إلى تعقيد الظواهر وتمفصل مستوياتها في حلقة ضخمة؛ تتشكل من سلاسل وحلقات متعددة دائمة التفاعل والتطور، والتأثير في بعضها البعض[3]. ولأن الكون في توليد ونفي مستمر، فإن التفكير الصائب يفرض أن تكون المعرفة تفاعلاً وتوليدًا وتعالقا، ونفيًا مستمرا[4]. ولا إمكانية لتأسيس فهم شامل، إلا بالقطيعة مع فكر التبسيط والاختزال؛ لأن الكون المعقد يستدعي فكرا معقدا[5]. لا يعني ذلك إلغاء التبسيط، إن فكر التعقيدLa pensée complexe، يرحب به ويدمجه، لكن ما يرفضه هو سيادة التبسيط. إن التبسيط قاتل، ويجب مكافحته.
من ينبوع هذا التحول المعرفي، تنبثق قولة إدغار موران - وبما أن الحياة ولدت في مشيمة بحرية، فإنها لم تعد يتيمة- كقولة تحتضن في بساطتها الظاهرة تصورًا فلسفيًّا-علميًّا مركبا، يدعو إلى إعادة صياغة علاقتنا بالحياة بوصفها تجربة وجودية كونية شديدة التعقيد. إذ يهدف إلى تجاوز اليقين الدوغمائي والتفسير الاختزالي نحو تصور فلسفي يتغذى على العلم، ويرى في كل ظاهرة وحدة في التعدد، وبنية جدلية تفهم من خلال العلاقات التي تؤسسها؛ ذلك أن فكر التعقيد فكر دوار وحلزوني، يكمل الفصل بالوصل والتقاطع، ويحترم التنوع كضرورة لإدراك التعدد على مستوى الأبعاد والتفاعلات والتضامنات بين كل العمليات الفكرية[6].
حين ناظَرَ موران بين الحياة والمشيمة البحرية، فإنه شيد استعارة معرفية علمية مفعمة بدلالة وجودية، حيث إن المشيمة من حيث هي عضو يربط الجنين بالأم، تمثل المنطلق الأمثل لفهم أصل الحياة كما تكشف عنه علوم الأحياء والجيولوجيا الحديثة. انبثقت الحياة من رحم الأرض، تحديدا من محيطاتها المائية البدائية؛ حيث احتضنت المياه الجزيئات الأولى وتفاعلت الطاقة مع المادة لتنتج أول أشكال التنظيم الحي. ومن ثمَّ فإن المشيمة البحرية تشكل تجسيدًا لهذا الحضن الكوني الأول، الذي يتماشى وفكرة أن انبثاق الحياة، وكذلك انبثاق الإنسان، مرتبطين أشد الارتباط بتاريخ نشأة الكون.[7].
وعليه، فإن الحياة والإنسان لم يكونا انبثاقا مفاجئا، كما تزعم أسطورة الخلق. والمستجدات العلمية، خصوصا في علم الوراثة، تعزز ذلك وتدعمه بأدلة دقيقة. ويبقى من الواضح أن رفض المجتمع لنظرية التطور إنما يعود بالأساس إلى تعارضها مع التفسير اللاهوتي لنشأة الحياة[8].
نشأت الحياة في الأرض بفضل الشمس المنتجة للهيدروجين والكربون والآزوت والأكسجين والمعادن التي نعد نتاجا لها ولا زلنا نتغذى منها[9]. ولذلك، فإن كل الآلات الحية المتعددة تطورت بفضل الفوتون الذي تولده الشمس بشكل مستمر. ومن الآلات الحية المتعددة تطورت آلات أنثروبولوجية اجتماعية، التي أدت بدورها إلى تطوير آلات اصطناعية ذاتية التشغيل.
والانتقال من آلة الشمس إلى آلة الأرض، ثم الآلات الحية المتعددة، ثم الآلات الأنثروبولوجية الاجتماعية الضخمة، ثم الآلات الاصطناعية، يتم عبر التفاعل والتعالق والتمفصل[10]. إننا أبناء آلة نارية مشتعلة، تحترق بشكل دائم؛ إنها على حد تعبير موران قنبلة هيدروجينية عملاقة دائمة. إنها مفاعل نووي هائج.
وبناء على ما سبق، يتضح جليا التداخل المركب الناتج عن اندماج التنظيم البيولوجي والنظام الكوني الفيزيائي. حيث إن كل الأحداث الواقعة على مستوى الكوكب الأرضي المتمثلة في تناوب النهار والليل، وتعاقب الفصول، وتحولات درجات الحرارة والمائيات، تنعكس على المناخ العام. مما يقود إلى تأثيرات معقدة على مستوى التنظيم البيولوجي للأفراد والأنواع والأنساق البيئية (الإنبات، التفريخ، التخصيب، الموت...)[11] في دوريات دقيقة يسميها موران نظام الساعة: "وهكذا، يشكل نظام الساعة الذي يدوِّر كوكبنا باستمرار أساس جميع التنظيمات الحية، بما في ذلك الأنثروبولوجي الاجتماعي"[12].
ومنه، فإن الحياة انبثاق وليست معجزة خارقة. بما يفيد أن الحياة ومصدرها ينتميان إلى نسق الوجود، ويعبران عن وحدة حيوية متجددة. ولأن تقدم الحياة حدث عبر حدوث طفرات جينية، فإن كل كائن امتداد لكائن آخر، وكل وجود مرتبط بأصل كوني مشترك[13]. و"كل شيء يحدث في الواقع، ليس كما لو كان النظام البيئي يتوفر على دماغ، بل كما لو كان يشكل هو نفسه في مجمله كائنا آلة-دماغا-بيئيا عملاقا...يعالج وينظم معلوماته واتصالاته، انطلاقا من التفاعلات بين عدد لا يحصى من الأجهزة الخلوية والعصبية الدماغية للكائنات التي تكونه"[14]. ومن ثمَّ، فإن الحياة لم تعد يتيمة.
يرفض موران التصور الميتافيزيقي الذي ينظر للحياة كحدث معزول، كما ينتقد الرؤية العلمية الوضعية حين تختزل الحياة في تفاعلات مادية صرفة. وإذا كانت الرؤية العلمية نصبت الإنسان سيدا والطبيعة عبدا، مما أدى إلى التلاعب المفرط بالحياة والإنسان؛ فإن موران يقترح بدلا من ذلك أن تكون علاقتنا بالحياة علاقة انتماء ومسؤولية، وبالتالي الانتقال من غزو الطبيعة إلى أنسنة الطبيعة[15]. إن استعباد الإنسان للطبيعة، استعباد لحياته، وتحرره رهين بفهم العالم فهما علميا، يضع الإنسان وأصله في قلب الطبيعة. بفضل هذا الفهم، يمكن الحد من الصراع والتعارض الذي شيده الفكر الغربي الحديث بين الإنسان والطبيعة[16].
إن الإنسان في فكر التعقيد، لم يعد مركز* الكون ولا غايته، بل إنه نتاج لمسار تطوري طويل على مدى مليارين إلى ثلاثة مليارات سنة[17]. وإذا كانت أسطورة الخلق تضع الإنسان في مرتبة مستقلة عن المملكة الحيوانية، فإن الإنسان حسب العلم، يحمل في بنيته البيولوجية آثار ملايين السنين من التطور البيولوجي، ظلت محفورة في قلب شجرة الحياة التي ينتمي إليها، "لأنه عند انبثاقه حامل كل الصفات التي تسمى حزمتها الحياة"[18].
فهوية الإنسان إذن، مركبة ومعقدة، وليست مستقلة وبسيطة؛ لأنها تنطوي على تاريخه الجيني التطوري[19]. بتعبير أدق، إن الإنسان يحمل تاريخه وأصله معه. ومن ثم، يصبح وعي الإنسان بالحياة وعيًا بأصله ومآله، وعيًا بضرورة الانخراط في الفهم والتعايش، في الحوار مع الطبيعة لا في اغتصابها. لقد أعاد موران الإنسان إلى صيرورته الكونية دون أن يسلبه قيمته، بما يفيد منحه إمكانية أكثر نجاعة؛ أن يتحمل مسؤوليته تجاه الحياة، عبر فهمها وتصورها وتوجيهها بشكل عقلاني وكوني خدمة لحيواتنا.[20]
2. الدهشة والسؤال دافعان لمواجهة الجمود الثقافي وتجديد الدرس الفلسفي:
إن تطهير الوعي من التصورات الباطلة، يقتضي مساءلة المصدر والأساس المنتج لهذه التصورات، حيث إن كل تصور للعالم له مصدر ينتج منه وعبره، واختلاف وتناقض تصورات العالم، يعود إلى اختلاف المصادر والمنطلقات والأسس[21]. وإذا كانت الخرافة لا يمكن أن تنتج سوى الخرافة، وكانت الثقافة السائدة تعتمد على مصدر وطريقة التفكير السائدين، فإن غياب التصورات العلمية للعالم داخل الثقافة، يعود إلى نقص في التفكير من منطلق علمي. والناشئة التي نريد، تتحدد عبر أساس ومصدر المعرفة التي نعتمدها.
ينبغي ألا يظل فكر التعقيد حبيس الدوائر الفلسفية المغلقة، أو الخطابات الأكاديمية المعزولة المعلقة في سماء المعقولات. فكل تصور علمي-إبستمولوجي- ينبغي أن ينعكس عمليًّا داخل الفضاء التربوي، وفي قلب الدرس الفلسفي، الذي أريد له أن يكون حصنا للعقل النقدي في وجه المد الخرافي، وفضاء لتحرير الفكر من قيود السكون والدوغمائية. إن الجهل يمثل الجذر الأساسي لكل أشكال الشر، في حين أن المعرفة بوصفها فهما أفضل للكون، تشكل الأساس الضروري للوصول إلى الحكمة والسلوك السليم والعقلاني.[22]
ولما كان تعليم الفلسفة لا زال مشوبًا بأوجه قصور حقيقية على مستوى المضامين؛ بما في ذلك غياب الجرأة الفكرية على مساءلة الأساطير الفكرية والثقافية التي تقيد وعي المتعلم وتجهض أسئلته، "فيجب أن يعود فكرنا إلى مصدره عبر حلقة استفهامية ونقدية، وإلا ستستمر البنية الميتة في إفراز أفكار متحجرة"[23]. بما يفيد إعادة بناء عقل المتعلم؛ عقل يواجه تعقيد الواقع بعقلانية منفتحة. لماذا؟
لأن اختزال الواقع في تصور واحد أمر غير ممكن، مهما كانت طبيعته ومنطلقاته؛ فالواقع يجب أن يفهم ويبنى وفق أنساق متعددة ومنفتحة؛ إنه مشروع أنطولوجي متعدد الأبعاد يتغذى على الكل ومنه يتخذ معناه. ولذلك، فإن الكون الفيزيائي بما في ذلك الحياة أكثر من أن يترجم إلى نسق واحد متسق من الأفكار. والعقلانية المنفتحة تنسجم واستحالة غلق الواقعي في الفكري[24].. مقتضى القول، إن اللقاء المتجدد مع الواقع الذي ينبغي اكتشافه، يجعلنا دائما معرضين للتيه والخطأ.[25]
وعليه، فشرط إمكان ركب العقلانية العلمية المنفتحة، هو انخراط البرامج التعليمية في سياق طبيعة التقدم العلمي، بترك الأخطاء والمعارف المضمحلة، وترسيخ النظريات السابقة في إطار المعارف الجديدة والمستجدات العلمية[26]. بما يفيد التحديث على المستوى المضامين المُدرسة، بما في ذلك المضامين الفلسفية، نظرا لتقاطع العلم والفلسفة والمستجدات الإشكالية التي تنبثق من قلب العصر الراهن. ولما كان النفي محرك دائم للمعرفة، يجب أن نكون مستعدين دائمًا لإعادة النظر في معرفنا.
إذا كانت المقررات الحالية، في أغلبها، لا زالت مشدودة إلى نموذج تقليدي يفصل بين الفلسفة والعلوم، بين الفكر والواقع، بين الكوني والمحلي، مقدما الفلسفة في شكل أنظمة مغلقة أو تأريخ مفصول عن نبض الواقع وتحدياته؛ فإن فكر التعقيد يفرض علينا مقاربة* جديدة، تجعل من الفلسفة ممارسة حية ومفتوحة على مختلف الإشكالات المعاصرة. لأن الإنسان، وبشكل خاص المتعلم، يصبح في ظل غياب ثقافة نقدية مستنيرة عرضة لتلقي أجوبة جاهزة للعالم، يمكن أن تتحول إذا لم تخضع للفحص، إلى مداخل لتبني مواقف أيديولوجية متطرفة[27].
علينا أن نتخذ التعقيد منطلقا تربويا للربط بين ما يبدو متفرقا، وإدراك العلاقات بين الظواهر في تعدديتها، عبر مد الجسور بين علوم الطبيعة وعلوم الإنسان؛ "إننا نحتاج إلى نظام متماسك للأفكار والنظريات تستطيع العلوم الطبيعية وكذلك الفلسفة والإنسانيات أن تجد مكانا لها في هذا النظام"[28]. لتتجاوز الدروس الفلسفية الصيغ المدرسية الجامدة التي تقسم المفاهيم وتفصل بين النظريات، نحو دروس تفاعلية، تساؤلية، منفتحة على القضايا المعاصرة وتحولات العلوم، والكوارث البيئة والأزمات الوجودية، وإمكانات العيش المشترك. كما ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار واقع التعدد البشري في الفضاء العمومي[29]، بما يسمح بتعزيز الاعتراف بالاختلاف كشرط للحوار.
وعليه، فإن مهمة المدرسة اليوم، أن تجعل الفلسفة مجالا لبناء هذا الفكر، من خلال مناهج تجعل المتعلم فاعلا في بناء المعرفة، وتعيد للفلسفة قيمتها النقدية كقوة اقتراحية، تربط بين الذات والعالم، وتحصن العقل من الجهل الذي يظهر في شكل عوائق دائمة التحول، وتمنح الوعي القدرة على الرؤية المعقدة والمركبة، حيث لا تختفي البساطة، ولكنها تفهم ضمن تعقيد أكبر؛ لأن "اللعبة التاريخية ستعتمد أكثر على الخطأ والوهم والكذب والحقيقة والوعي نفسه"[30].
وفقا لذلك، فإن المتعلم في حاجة إلى فلسفة غير منفصلة عن نبض الواقع؛ تسمح له بالتفلسف من قلب التناقضات التي يعيشها، ارتباطا ومشاكله الذاتية والمعرفية، على مستوى وجوده وهويته، قلقه وتطلعاته أيضا. وكذلك الانفتاح على الأسئلة التي تفرض نفسها اليوم حول العدالة الكونية، الذكاء الاصطناعي، الهوية، الحرية، الحب*، الجسد، الحياة، الموت، التقنية، الحرب، المصير(...). لا يمكن إذن، أن يبنى وعي فلسفي حي ما لم ينخرط المتعلم في التفكير في المشاكل الراهنة: الوجودية والمعرفية والسياسية والأخلاقية.
إن تحقيق هذا المسعى، يتطلب أن تتحول الفلسفة من مادة دراسية إلى تجربة وجودية، فيها يصوغ المتعلم ذاته ويعيد تشكيلها. خدمة لإمكانية ولادة جديدة للإنسان؛ ولادة يتقاطع فيها: النوع والفرد والمجتمع والإنسانية. إن المصير مشترك؛ ومن ثمَّ ينبغي ترسيخ الإنسانية في الناشئة، وزرع الحبّ كشكل من أشكال المقاومة ضد القسوة والتشتت[31].
لا زال العقل يعيش مفارقة عويصة؛ إذ بالرغم من التقدم العلمي على مستوى الفيزياء في عزل الظواهر وأسبابها ونتائجها، والانتقال من الكون المسحور -الروحاني- المسكون بالجن والأرواح والنفوس إلى الكون المفتت بالتجريب والإثبات والعقلنة[32]، فإن الثقافة الاجتماعية، بل بعض المضامين التعليمية أيضا، لا زالت متشبثة بفهم تقليدي للظواهر بعيدًا عن الفهم العقلاني للإنسان والطبيعة.
يرجع التفكير الخرافي، سواء الذي يتوارى في المضامين المعرفية التعليمية داخل المدارس أو في المجتمع ككل، إلى غياب الوعي الإبستمولوجي وعدم التشبع بالتصورات العلمية للعالم، والانقياد وراء ثقافة التسليم بالجاهز وترميمه بدل ممارسة القطيعة معه. وتواصل المؤسسات التعليمية، توخي الحذر والمواربة في تقديم النظريات العلمية، من أبرزها* نظرية التطور، متجنبة بذلك مواجهة الموروثات الأسطورية، والتقاليد الراسخة، التي لا زالت تؤثر في المحتوى الدراسي.
تشكل بعض التأويلات الدينية المغلقة، عائقًا معرفيًّا يعيق إمكانية ترسيخ الفكر العلمي والنقدي. إذا كان العلم يقوم على المناهج الموضوعية الصارمة؛ وكانت الفلسفة في جوهرها تفكير غير وثوقي يفعل البحث والتساؤل والحوار والحجاج الاستدلالي[33]؛ فإن الأفكار الأيديولوجية الموروثة التي تتخلل البنية الاجتماعية تثبت بداهات لا تقبل المراجعة.
إن إقصاء النظريات -والتصورات- العلمية للعالم أو تقزيمها داخل الفضاء التعليمي ينتج وعيًا محدودًا، يفتقر إلى القدرة على استيعاب التعقيدات والتنوع المعرفي، ويغلق الباب أمام التساؤل الحر والتفكير المستقل. إن ما نسعى إليه ليس الخلط بين الفلسفة والعلم أو اختزال أحدهما إلى الآخر، بل تجديد وتفعيل التبادل والاتصال بينهما[34].
وعليه، لا سبيل لتحرر العقل من أسر القوالب الثابتة والأفكار اليقينية، إلا بإعادة تأهيل العلاقة بين الفلسفة والعلم والدين في فضاء معرفي مفتوح على حرية الكلام والبحث والتفكير. مناط ذلك استحالة إدراك العالم بشكل مناسب من زاوية نظر واحدة. ولما كان العالم مشتركا، فإن فهمه وإدراكه كما هو بالفعل، ممكن عبر تبادل الآراء والتفاعل مع الآخرين[35]. ومن هنا تنطلق أهمية استحضار التعدد والاختلاف كضرورة بيداغوجية لإنقاذ الفكر من العطب، وتوجيه المتعلم إلى أن الحياة إمكان كوني مفتوح على الفهم والمساءلة؛ ومسؤولية إنسانية تتجاوز كل الانتماءات الضيقة*. ومتى تحقق هذا الوعي، غدا الدرس الفلسفي أداة فعالة في ترسيخ القيم الكونية، وتفكيك البنى الذهنية الخرافية المتكلسة التي تروج لتصورات لا عقلانية للوجود.
إن التحدي الحقيقي أمام تجديد الدرس الفلسفي يتمثل في صعوبة انفلات المؤسسة التعليمية من قبضة الأيديولوجيا، لا سيما أن النظام الأيديولوجي السائد في المجتمع غالبا ما يحدد ويوجه برامج التعليم ومناهجه، سواء في العلوم الإنسانية أو الطبيعية[36]. لكن، وبالرغم من ذلك، فإن جوهر الفلسفة يكمن في التحرر من كل إيديولوجيا تعارض العقلانية وتحد من فعاليتها. ومن ثمَّ، على المؤسسة التعليمية أن تتخذ من الفلسفة شرطا أساسيا لبناء مجتمع عقلاني متشبع بالتفكير النقدي؛ حيث لا سلطة تعلو على سلطة العقل.
يتمظهر التفلسف في حضوره النبيل كفعل مقاومة ضد السطحية والاغتراب واختزال الإنسان إلى مجرد مستهلك وتابع، حتى لو كان هذا الاستهلاك استهلاك معرفة لم تعد تجيب عن مفارقات الواقع والمعيش اليومي؛ مما يعني أن المعرفة نفسها قد تتحول إلى عائق في حالة ما لم تتكيف مع مستجدات العلوم ومتطلبات الواقع المعاصر. "لهذا السبب أعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في المبدأ التنظيمي للمعرفة، وما هو حيوي اليوم ليس التعلم فقط، وليس إعادة التعلم فقط، وليس التخلص مما تعلمناه فقط، بل إعادة تنظيم نظامنا العقلي لإعادة تعلّم التَّعلُّم"[37].
يقودنا ما سبق، إلى استنتاج أن المتعلم لا يتهرب من الفلسفة في جوهرها، لكنه يرفض طرحها لقضايا لا تلامس أسئلته الحقيقية. لا بد من احتواء التناقضات التي يعيشها المتعلم؛ وتَقصي الشرط البشري في صورته الجديدة بشكل معقد. ولبلوغ هذا الهدف، من اللازم إحياء أصل الفلسفة من جديد في حياة المتعلمين والمدرسين والمجتمع ككل؛ الأصل المتمثل في الدهشة والتساؤل.
يجب التشبث بالسؤال لطالما كانت الدهشة تنطفئ بمجرد تلقي الأجوبة. هذا ما يؤكده مارتن هايدجر Martin Heidegger، حينما حدد أصل -وجوهر- الفلسفة في السؤال[38]؛ لأنه يحرض على تقليب الأفكار على أوجهها المختلفة، ونحن في حاجة ماسة إليه أمام ثقافة تكرس سلطة الجواب والتقليد والأخذ بالجاهز، ثقافة تجيب أكثر مما تسأل، بل أكثر من ذلك، تنبذ السؤال وتقضه.
إذا كانت الفلسفة منذ القدم محاولة لاكتشاف الوجود في كليته[39]، وبحثا عن المعنى في عالم يعج بالمتناقضات والتحول الدائم؛ فيجب أن تظل الفلسفة شاملة، ولا تقتصر على أبعاد منفصلة، حيث لا يمكن أن تتحقق وظيفة الفلسفة النقدية، إلا إذا كانت تتعاطى مع الحياة ككل مركب، مما يزيد من قدرتها على مواجهة جوهر الوجود؛ الذي يتسم بالتعقيد واللايقين[40].
ولهذا، يجب دائما البدء من انطفاء الوضوح الزائف، لا من الواضح والمألوف؛ لأن الوضوح يخفي هشاشة الفهم، وينتج وهما مستمرا بأننا نعرف العالم لمجرد أننا نملك كلمات تصفه وتقننه. إن التفكير الحقيقي يبدأ من الارتباك والسؤال والدهشة؛ ذلك ما يشير إليه موران حين يؤكد في كتاباته أن المعرفة التي لا تعترف بتعقيد الواقع، وتخضع لوضوح مصطنع، ليست سوى معرفة مبسطة عاجزة عن فهم العالم كما هو. فالوضوح المفرط يقيد الفكر؛ لأنه يخفي اللايقين، والغموض، والتناقض، والفوضى، وهي من بين العناصر الجوهرية التي تشكل الوجود.
إن بداية الفلسفة هي نقد الضمانة؛ أي تفكيك وهم امتلاك الحقيقة أو المعرفة النهائية. فالمعرفة إذا لم تمارس بوصفها تساؤلا مستمرا تتحول إلى عائق إبستمولوجي يعطل الفهم، ويعيد إنتاج الوثوقيات ذاتها[41]. ومن ثم، يتضح أن الانطلاق في كل إصلاح حقيقي للفكر والتربية، كما يرى موران، يكمن في الاعتراف بالغموض واللايقين كشرط للمعرفة المنفتحة، ومحرك للتساؤل. وهكذا، تصبح الفلسفة فعل مقاومة إبستمولوجية ضد الانغلاق والبساطة الخادعة.
خاتمة:
يتضح أن فكر التعقيد يشكل تصورًا إبستمولوجيا أساسيا لفهم واقع الحياة والإنسان والكون بأبعاده المتعددة. إن العقل الذي يعتمد على التبسيط والاختزال لم يعد يكفي في مواجهة تعقيدات العالم المعاصر؛ إنه عاجز عن استيعاب الظواهر المتداخلة والمتقاطعة التي تشكل نسيج وجودنا. وعليه، من الضروري الانخراط في موقف إبستمولوجي يعترف باللايقين والتعدد، ويفتح مسارات جديدة لإعادة النظر في مفاهيمنا التقليدية، ويوجهنا نحو بناء وعي إنساني أكثر مسؤولية.
هذا الوعي يجب أن يشمل إعادة التفكير في العلاقة بين الأنا والغير، بين الإنسان والعلم، وبين الإنسان والطبيعة، حيث يتحول إلى تصور فلسفي يدفعنا إلى مراجعة الأطر المعرفية السائدة. وتجديد الدرس تحرير للعقل من القيود التي تعيق التفكير النقدي الحر وتحد من قدرة المتعلم على مواجهة تحديات عصره. ومن ثمَّ، يصبح تعليم الفلسفة تجربة وجودية حية ترتبط بشكل مباشر بمشاكل المتعلم وأسئلته الراهنة، حيث تدفعه إلى الانخراط في التساؤل المستمر، والانفتاح على الشكوك والاحتمال، بما يعزز قدرته على التفكير النقدي والإبداعي.
ولا يمكن فصل التحدي الفكري عن الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم المعرفة ذاتها؛ إذ تفرض تعقيدات الواقع ضرورة تبني تصورات فكرية تتسم بالمرونة والتكامل والاحتكام إلى التعددية بدل التفكير المغلق. إن فكر التعقيد محاولة جريئة، لإعادة صياغة العلاقة بين المعرفة والواقع، حيث يعيد للإنسان موقعه كجزء لا يتجزأ من الكون، وليس ككائن منفصل ومستقل. كما يدعونا إلى تحمل مسؤوليتنا في حوار دائم ومتبادل مع الحياة والطبيعة، من منطلق إدراك أننا لا نملك الحقيقة المطلقة، وإنما نسعى إلى فهم متجدد يراعي إمكانية النفي.
بناء على هذا التصور، يمكن أن نبني مجتمعا معرفيا أكثر انفتاحًا وتسامحًا، مجتمعا يعترف بتعددية الاختلاف والآراء، ويواجه الجهل بكل أشكاله عبر تعزيز قيم الحوار والتفاهم والبحث العلمي الذاتي المتواصل. إن بناء هكذا مجتمع، لا يتحقق إلا عبر تأسيس ثقافة نقدية حقيقية، ترتكز على إدراك أهمية التعقيد في كل مناحي الحياة، وعلى تمكين الأفراد من أدوات التفكير التحليلي والنقدي التي تسمح لهم بالمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبلهم، بعيدا عن السطحية والجمود الفكري.
منتهى القول، إن تبني فكر التعقيد ضرورة وجودية تفرضها تعقيدات عالمنا المعاصر، ومفتاح لفهم أفضل لذواتنا ومجتمعنا وعلاقتنا بالكون، ودعوة مفتوحة نحو استمرار البحث والتطوير في مناهجنا وأساليبنا، سواء البحثية أو التعليمية، لتظل المعرفة أداة فعالة في مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل إنساني ممكن.
المصادر والمراجع العربية:
¾ إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، ترجمة يوسف تيبس (المغرب: أفريقيا الشرق، 2023).
¾ يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2014).
¾ إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، ترجمة يوسف تيبس، (المغرب: أفريقيا الشرق، 2024).
¾ برتراند راسل، حكمة الغرب، الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة فؤاد زكريا (الكويت: عالم المعرفة، الطبعة الثانية، 2009).
¾ فيليب فرانك، فلسفة العلم الصلة بين العلم والفلسفة، ترجمة علي ناصف (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1983).
¾ عبد المجيد الانتصار، الأسلوب البرهاني الحجاجي في تدريس الفلسفة من أجل ديداكتيك مطابق (المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1997).
¾ لوي ألتوسير، الفلسفة وفلسفة العلماء العفوية، ترجمة رضا الزواري (المغرب: عيون، الطبعة الثانية، 1989).
¾ حنة أرنت، في السياسة وعدا، ترجمة وتقديم معز مديوني (لبنان: منشورات الجمل، الطبعة الأولى، 2018).
Les références:
Guillaume Badoual, la vie- cours de philosophie (Casablanca: Afrique Orient, 2015).
[1] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، ترجمة يوسف تيبس (المغرب: أفريقيا الشرق، 2023) ص 411
[2] يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2014) ص 112
[3] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، ترجمة يوسف تيبس، (المغرب: أفريقيا الشرق، 2024) ص ص 39-40
[4] يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، المصدر نفسه، ص 193
[5] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 85
[6] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 421
[7] يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، المصدر نفسه، ص 529
[8] Guillaume Badoual, la vie- cours de philosophie (Casablanca: Afrique Orient, 2015), P 63-64.
[9] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 79
[10] إدغار موران، المنهج، المصدر نفسه، ص 202
[11] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 36
[12] إدغار موران، المصدر نفسه، ص 38
[13] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 81
[14] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 51
[15] إدغار موران، المصدر نفسه، ص 464
[16] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 36
* "يا لها من سخرية في هذا التمركز للأنا حيث نعتبر أنفسنا مركز العالم! يا له من حمق في هذا التعالي الذاتي، حيث نتموضع فوق الكائنات الأخرى!". (إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 305.)
[17] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 447
[18] إدغار موران، المصدر نفسه، ص 304
[19] إدغار موران، المصدر نفسه، ص ص 294-295
[20] إدغار موران، المصدر نفسه، ص 465
[21] يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، المصدر نفسه، ص ص 32-33
[22] برتراند راسل، حكمة الغرب، الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة فؤاد زكريا (الكويت: عالم المعرفة، الطبعة الثانية، 2009)، ص 77
[23] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 33
[24] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 445
[25] Guillaume Badoual, Ibid, P 120
[26] لوي ألتوسير، الفلسفة وفلسفة العلماء العفوية، ترجمة رضا الزواري (المغرب: عيون، الطبعة الثانية، 1989)، ص 102
* مقاربة توطد التقاطع والتمفصل بين برنامج مادة الفلسفة وباقي برامج المواد الأخرى؛ بحيث يشعر المتعلم أثناء تنقله بين المواد المدرسية أنه أمام جزيرة معرفية تشكل وحدة، وليس أمام جزر معرفية معزولة ومنفصلة عن بعضها البعض.
[27] يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، المصدر نفسه، ص34
[28] فيليب فرانك، فلسفة العلم الصلة بين العلم والفلسفة، ترجمة علي ناصف (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1983) ص 11
[29] حنة أرنت، في السياسة وعدا، ترجمة وتقديم معز مديوني (لبنان: منشورات الجمل، الطبعة الأولى، 2018)، ص 113
[30] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 481
* لم تعد فكرة الحب على حد تعبير إدغار موران مقتصرة فقط على توالد الزوجين والأسرة والعشيرة والأمة: لقد برزت كفكرة عامة، تعبر عن أخلاقيات إنسانية خالصة (أحبو بعضكم البعض)، ومطلب عضوي للإنسانية (سيكون الدولي هو الجنس الإنساني).
[31] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص ص 484-485
[32] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 405؛ ويوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم، قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، المصدر نفسه، ص 40
* نضيف إلى ذلك نظرية الانفجار العظيم.
[33] عبد المجيد الانتصار، الأسلوب البرهاني الحجاجي في تدريس الفلسفة من أجل ديداكتيك مطابق (المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1997) ص 24
[34] إدغار موران، المنهج، حياة الحياة، المصدر نفسه، ص 308
[35] حنة أرنت، في السياسة وعدا، المصدر نفسه، ص 189
* كل انتماء يتمركز حول هوية مغلقة؛ فإنه انتماء ضيق، وعدو للاختلاف والتعدد.
[36] لوي ألتوسير، الفلسفة وفلسفة العلماء العفوية، المصدر نفسه، ص 61
[37] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 33
[38] حنة أرنت، في السياسة وعدا، المصدر نفسه، ص 106
[39] لوي ألتوسير، الفلسفة وفلسفة العلماء العفوية، المصدر نفسه، ص 39
[40] إدغار موران، المنهج، طبيعة الطبيعة، المصدر نفسه، ص 401
[41] إدغار موران، المصدر نفسه، ص 27