تجدد الحديث عن الإثنيات والأقليات؛ دراسة نقدية
فئة : مقالات
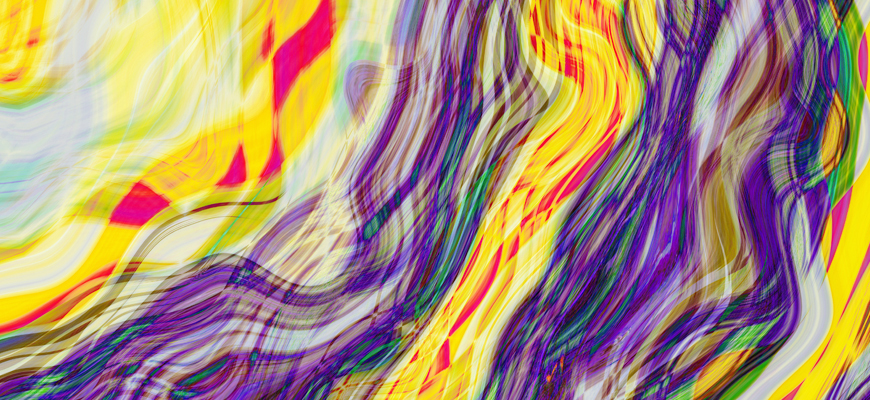
تجدد الحديث عن الإثنيات والأقليات؛ دراسة نقدية
يرتبط تجدد الحديث عن الإثنيات والأقليات في الأوضاع العربية الراهنة، حسب ما يمكن استخلاصه من تجارب التاريخ المعاصر، بأسئلة الدولة والمجتمع في تشكّلهما وتطورهما المتواصلين، ويرتبط كذلك بقضايا الاندماج الاجتماعي في الدولة الوطنية الحديثة تحديدًا، إذ مارست وتمارس عمليات في التوحيد والتنظيم المجتمعيين الخاضعين لسلطة مركزية، أو ما يعادلها من السلطات داخل المجتمع. وتندرج الإشكالات المرتبطة بموضوع الإثنيات والطوائف في المجتمعات العربية ضمن السياق العام للأسئلة السياسية والتاريخية المرتبطة بالإصلاح والتحول الديمقراطيين في هذه المجتمعات، في أزمنة ما بعد ثورات 2011 وتداعياتها المتلاحقة.
وإذا كنا نؤمن بأنه لم يعد ممكنًا اليوم العودة إلى نظام الملل والنحل بأسمائه القديمة أو الجديدة، بحكم أن انخراط مجتمعاتنا في التمرس بقواعد وتنظيمات المجتمعات الجديدة، منذ ما يزيد على قرن من الزمان، ساهم في بلورة روافع مجتمعية، نحن مطالبون اليوم بالمحافظة عليها وتطويرها للتمكن من إعادة بناء مجتمعاتنا، فإن ما ينتج عن ذلك هو أن مختلف صور التوظيف الإثني الحاصلة في الراهن العربي، تستعمل منطقًا يعادي، في روح خياراته العامة، المجتمع والدولة ومختلف جوامع الحياة المشتركة، مما يؤكد حاجة مجتمعاتنا، أمسِ واليومَ وغدًا، إلى مزيد من استيعاب قيم التحديث السياسي وإعادة تركيبها في ضوء حاجتنا التاريخية.
ولا يجادل أحد في أن التهميش الذي عرفته الإثنيات داخل المجتمعات العربية قد أدى إلى مراكمة أخطاء عديدة، ترتب عليها ما نراه اليوم من العودة بشكل مخيف إلى مجتمعات بدون قيم سياسية، مجتمعات يحكمها نظام لا علاقة له بمكاسب الفكر السياسي الحديث وقيمه المُعْتَمَدَة في تدبير الحياة المدنية. وإن فشل الدولة العربية في تبيِئة قيم التحديث، واستمرار عملها بآليات انتقائية في التدبير السياسي، وتغليبها للنزعات التسلطية والعنف، سهّل إمكانية توظيف مفاهيم وآليات لا علاقة لها بنظام الدولة الوطنية كما نشأت وتطورت في الأزمنة الحديثة. لذلك نرى، ضمن هذا السياق، أن لا خلاص لنا من فتن الطائفية والإثنيات في مجتمعاتنا إلا بمزيد من توسيع مجالات قيم التحديث والمشاركة السياسية، وذلك بالصورة التي تعزز أواصر الاندماج المطلوبة في مجتمعٍ حديثٍ ودولةِ مؤسساتٍ قادرة على تنظيمه.
ولا بد من توضيح أننا عندما نتحدث عن ضرورة استحضار الحداثة ومقدماتها عند التفكير في موضوع الانفجارات الإثنية والطائفية فإننا لا ندعو إلى نسخ تجارب بعينها قدر ما نعني الاستئناس بتجارب محددة في التاريخ، ومحاولة إبداع الوسائل الذاتية القادرة على استيعاب وترسيخ كل ما هو مفيد فيها، وذلك بحسب ما يتطلبه سياق التحولات الناشئة في مجتمعاتنا. ومن هنا فإن إيماننا بالحداثة السياسية سبيلاً لتخطي مأزق المذهبية والطائفية والإثنية في فكرنا ومجتمعنا، يصاحبه إيمان مماثل بنظرتنا إلى كل ما سبق من زاوية أنه عبارة عن أفق مفتوح على كل ممكنات الإبداع الذاتي في التاريخ، فلا يمكن تصور إمكانية تَحَقُّق الحداثة بالتقليد، بل إن سؤال الحداثة في أصوله ومبادئه العامة يُعَدّ،ُ في العمق، ثورة على مختلف أشكال التقليد.
صحيح أننا انخرطنا قهرًا في التعلم من مكاسب مجتمعات سبقتنا في هذا المضمار، وأن زمن تعلمنا واكب انفراط دولة الخلافة، كما واكب أزمنة الحماية والاستعمار، إلا أنه فتح أمامنا، بمنطق التاريخ، أبوابَ عوالم جديدة، عملنا على تكييف ومواءمة تاريخنا ومجتمعنا وثقافتنا معها، بكل ما يتطلبه الأمر من عدم التفريط بكل ما يمكن أن يؤهلنا مجددًا للتنافس على الخيرات وصناعة التقدم.
إن الاقتناع بالمبادئ الكبرى الناظمة للمشروع الفلسفي الحداثي، بالنظر إلى الإنسان والتاريخ والمعرفة، يتيح لنا إطارًا مرجعيًا جديدًا للتفكير في حاضرنا ومستقبلنا، وهو إطار مرجعي مختلف عن سقف العقائد التقليدية المهيمنة على ذهنياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية والسياسية والتربوية، ويفتح أمامنا إمكانية تأسيس المشروع السياسي الديمقراطي، بوصفه مشروعًا تاريخيًا قابلاً للتطوير والتجاوز، وذلك اعتمادًا على مبدأ تدبير التوافقات السياسية والتاريخية والعقلانية المطابقة لإشكالاتنا السياسية والتاريخية.
ونفترض أنه لا خلاص لنا من الانغلاق الإثني والطائفي الذي ازداد في الآونة الأخيرة استفحالاً، إلا بتوسيع دوائر التشارك في العناية بالشأن العام، ولا يمكن تحقيق ذلك دون سيادة قيم المواطنة والتعاقد، وذلك لأنه يستحيل بناء الإنسان في ظل قيود الأعراق والمذاهب والطوائف.
ويترتب على كل ما سبق، أن الانتصار لقيم التحديث السياسي التاريخية والنسبية يعد الصيغة المناسبة لاستيعاب التَّعَدُّدِيَّة المُوَاطِنَة بمختلف صورها ومختلف أبعادها. ونستطيع أن نقول هنا إن مجتمع التعدد يثري في العمق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه في غياب الديمقراطية يظل مصدرًا قويًا لكثير من صور التوتر والاضطراب في مجتمعاتنا، وما وقع في لبنان ويقع اليوم في العراق وسوريا وليبيا يعد دليلاً على ما نقول.
إن تجدد الحديث عن الإثنيات واللغات والأقليات في الأوضاع العربية الراهنة، وهو تجدد ينتعش ويقوى بصيغ لا تساعد على استيعابه بالأساليب التاريخية والسياسية والثقافية المناسبة، نقصد بذلك أساليب الوعي التاريخي القادر على التصالح الإيجابي مع مكوناته، والتسليم، في الآن نفسه، بالأهمية التاريخية لدوره المُخْصِب للتنوع في التاريخ، لنتمكن من إدراك أن قيم التحديث السياسي هي التي تحول العدد إلى إسمنت للاندماج والوحدة.
ولا نتحدث هنا عن صور التعدد الإثني المصطنعة والموظفة بكثير من العنف لتفتيت مجتمعاتنا، ذلك أن هذا النوع من التعدد يندرج ضمن العتاد الحربي الجديد الذي أصبح يُسْتَعْمَل في المعارك والحروب المشتعلة داخل كثير من مجتمعاتنا، وهو يتطلب ولوج الشبكات الاجتماعية لتركيب أسلحته المضادة وبناء ما يمكّننا من الانتصار عليه. أما محتوى ما نحن بصدده، فيتعلق بالتعددية التاريخية الفعلية، ولا شك أن الأمرين معًا يتطلبان مزيدًا من ترسيخ قيم التحديث السياسي.
ويُمَكِّنُنَا الانتعاش المتجدد للإثنيات في صورتيه التاريخية والمصطنعة، من التأكيد على حاجتنا الفعلية إلى الحداثة السياسية، وما يرتبط بها من التدبير التعاقدي للسلطة، وفصل السلطات، وتوسيع دائرة الوعي بقيم المواطنة، ولا يحصل ذلك إلا بنبذ أخلاق القبيلة وأساطير أشجار النسب المفترضة والمتخيلة.






