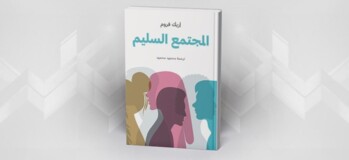الاعتراف والحرية عند أكسيل هونيث: مسارات جديدة لبناء الهوية الاجتماعية
فئة : مقالات

الاعتراف والحرية عند أكسيل هونيث:
مسارات جديدة لبناء الهوية الاجتماعية
الملخص:
في أزمنة تتلاشى فيها شرعية النظم الأخلاقية والسياسية، وتنهار فيها التصورات الليبرالية للعدالة والحرية، تستعيد الفلسفة مكانتها العميقة في مساءلة مفهومي الاعتراف والحرية اللذين يشكّلان لبّ الوجود الإنساني المشترك. في هذا الإطار، يبوح أكسيل هونيث برؤية نابعة من تراث هيغل الفينومينولوجي، حيث لا تتجلى الذات إلا عبر شبكة من الاعتراف المتبادل، تنبثق منها الحرية بوصفها تجربة حية متجددة تتجاوز الفردانية الجامدة والامتثال القانوني البارد. يبين البحث كيف تتحول مظاهر النفي الاجتماعي إلى انتهاكات تنزع من الذات كرامتها وحريتها، ويؤكد أن الاعتراف، بأبعاده الثلاثة: الحب، والحق، والتقدير، هو الركيزة التي تنهض عليها الحرية الحقيقية، وسبيلها لإعادة التأسيس في زمن الاغتراب والتمييز البنيوي. ومن ثم، تبدو الحرية في فلسفة هونيث كرحلة وجودية تتشكل في حضرة الآخر، حيث تُهدى الذات حقها في الوجود، والاحترام، والكرامة، فتتفتح على نور التحقق الذاتي والحرية الصادقة.
تمهيد:
في كل لحظةٍ تاريخيةٍ تنحسر فيها شرعيةُ الأنظمةِ الأخلاقيةِ والسياسيةِ، وتتكشفُ حدودُ التصوراتِ الليبراليةِ للعدالةِ والحريةِ، تستعيدُ الفلسفةُ دورَها في مساءلةِ المفاهيمِ المُؤسِّسةِ للحياةِ الإنسانيةِ المشتركة. ولعلَّ من أبرزِ هذه المفاهيمِ التي خضعت لتفكيكٍ وتجديدٍ في الفكرِ الفلسفيِّ المعاصر: الاعتراف والحرية. فإذا كان هوبز وروسو قد طرحا الحريةَ في علاقتها بالتعاقدِ والسيادة، وإذا كان كانط قد ربطها بالاستقلالِ الذاتيِّ والعقلِ العمليِّ، فإنَّ التحولاتِ الاجتماعيةَ والسياسيةَ التي شهدها القرنُ العشرون – خاصةً مع بروزِ قضايا الإقصاءِ والتمييزِ واللامساواةِ البنيوية – جعلت من الحاجةِ إلى إعادةِ التفكيرِ في الحريةِ ضمن أفقِ العلاقات الاجتماعية أمرًا ملحًّا.
في هذا السياق، تأتي فلسفةُ أكسيل هونيت كامتدادٍ نقديٍّ للمشروعِ الفرانكفورتي، وخصوصًا هابرماس، غير أنَّها تنفرد بتركيزها على البعدِ العلائقيِّ للذات؛ إذ لا تُفهَمُ الذاتُ في نظرِه إلا في ضوءِ شبكةٍ من علاقاتِ الاعترافِ المتبادل التي تُتيح لها إمكانيةَ التحقّقِ الأخلاقيِّ والاجتماعيِّ. لقد استلهم هونيت من هيغل فينومينولوجيا الروح، ومن ميادينِ السوسيولوجيا وعلمِ النفسِ الاجتماعي، ليُعيد بناءَ مفهومِ الاعتراف كمطلبٍ أنطولوجيٍّ وأخلاقيٍّ وسياسيٍّ، يجعل من الحريةِ نفسِها مرتهنةً بمدى تحقُّقِ الاعترافِ في أشكاله الثلاثة: الحب، والحق، والتقدير الاجتماعي.
وهكذا، فإن مقاربةَ هونيت تُعيد موضعةَ الحريةِ بعيدًا عن التصوراتِ الليبراليةِ المنغلقةِ التي تحصرُها في الاستقلالِ الفرديِّ أو الامتثالِ القانونيِّ، لتؤسس تصورًا بينذاتيًّا يجعلُ من الاعترافِ شرطًا ضروريًّا لممارستها. من هنا، تكتسبُ نظريتُه راهنيتَها وجدّتَها، خصوصًا في ظلِّ أزماتِ التهميشِ واللامساواةِ والهشاشةِ الوجوديةِ التي تُعانيها الذاتُ المعاصرةُ في عالمٍ يعجُّ باللامرئيةِ الرمزية.
وانطلاقًا من هذا الأفقِ النقديِّ، يسعى هذا البحثُ إلى مساءلةِ العلاقةِ الإشكاليةِ بين الاعترافِ والحريةِ في فلسفةِ أكسيل هونيت؛ وذلك من خلالِ فهمِ كيف تتحوَّلُ أنماطُ النفيِ الاجتماعيِّ إلى ممارساتٍ تسلبُ الذاتَ حريتَها، وكيف يمكنُ لنظريةِ الاعتراف أن تُشكِّلَ مدخلًا فلسفيًّا وأخلاقيًّا لفهمٍ أعمقَ للحرية.
فما هي طبيعةُ العلاقةِ بين الاعترافِ والحرية؟ وهل يكفي الاعترافُ بوصفِه فعلًا رمزيًّا لتأسيسِ حريةٍ فعلية؟ أم أنَّ الاعترافَ ذاتَه يظلُّ مرهونًا بشروطٍ اجتماعيةٍ-تاريخيةٍ تفرضُ إعادةَ تفكيرٍ مستمرةٍ في إمكاناتِه وحدودِه؟
1. نحو أنطولوجيا الاعتراف في مواجهة التفكك الاجتماعي
1.1. الباتولوجيا الاجتماعية كتشويه للعلاقات بين الذوات
في صميم النظرية الاجتماعية النقدية التي صاغها أكسيل هونيث، تتبدّى الباثولوجيا الاجتماعية لا كاختلالات عابرة تصيب البنية المجتمعية، بل كتشوّهات بنيوية تضرب عمق العلاقات التي تقوم بين الأفراد داخل المجتمع. ليست هذه الباثولوجيا مجرد أعراض مرضية يمكن تجاوزها بالإصلاح السطحي، بل هي دليل على انهيار أنماط الاعتراف الأساسية التي تجعل من التعايش الإنساني ممكنًا، وتحفظ للفرد كرامته وهويته. إنها، إذًا، ليست اضطرابًا على مستوى الوقائع فحسب، بل تشويه في أنسجة الوجود العلائقي للإنسان، أي في صيرورته الذاتية بوصفه كائنًا لا يتحدد إلا عبر نظرات الآخرين واعترافهم به.
إن هونيث، استنادًا إلى تقاليد هيرمينوطيقية وهيغلية، يرى في الاعتراف شرطًا تأسيسيًا لبناء الذات. ومن هذا المنطلق، فإن حرمان الفرد من الاعتراف لا يؤدي فقط إلى فقدان موقعه الرمزي داخل المجتمع، بل يمسّ وجوده الأخلاقي نفسه؛ إذ "حين يُحرَم الفرد من الاعتراف الذي يليق به، فإن استجابته تتجلّى وفقًا للقاعدة الأخلاقية العامة التي تصاحب تجربة الإهانة، والتي تنجم عنها مشاعر الغضب والسخط والعار."[1] إن هذه المشاعر ليست فقط انعكاسًا داخليًا لضرر اجتماعي، بل تعبير عن خرق جوهري في علاقة الفرد بالعالم؛ خرق يقوّض قدرته على إقامة علاقات سليمة مع الآخرين ومع ذاته.
وتتمظهر الباثولوجيا الاجتماعية، كما حللها هونيث، في أشكال العنف المادي والمعنوي التي تشهدها الدولة الحديثة. فبعيدًا عن منطق العدالة والاعتراف المتبادل، تتفاقم الظواهر التي تحيل إلى غياب مؤسسي ومجتمعي للاعتراف، ومن أبرزها العنف ضد الجسد، والجريمة المنظمة، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. ففي هذا السياق، يؤكد هونيث أن: "الكرامة الجسدية والمعنوية للأفراد أصبحت مهدَّدة بفعل تفشي مظاهر العنف في الدولة الحديثة، ولا سيما في ظل تصاعد الجريمة المنظمة. كما تثير شبكات الدعارة وأفعال الاغتصاب إشكالات عميقة، وجدت صداها في الحركات النسوية التي تناضل من أجل إقرار كرامة المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل".[2]
إننا هنا أمام اختلال لا يطال فقط كرامة الأفراد كضحايا مباشرين، بل يُعيد إنتاج ذاته عبر البنى والمؤسسات، حيث يُمنَع البعض من حقوقهم، أو تُختزل إنسانيتهم في قوالب دونية. ومن ثم، فإن "معاناة الحرمان من الحقوق لا تُقاس فقط من منظورها الكوني، بل أيضًا على مستوى تحققها المادي داخل الأطر المؤسسية التي تضمنها فعليًّا"[3]؛ إذ لا يكفي أن تُقر القوانين نظريًّا بمساواة البشر وحقوقهم، ما لم تُترجم إلى ممارسات ملموسة تضمن اعترافًا فعليًا وشاملًا بكل فرد بوصفه فاعلًا أخلاقيًا مستحقًا للكرامة.
ويبلغ تشوّه العلاقات الاجتماعية مداه الأقصى حين يتحوّل الاعتراف نفسه إلى لحظة منسيّة، وتُصبح العلاقات الاجتماعية مفرغة من أبعادها الأخلاقية، يقول هونيث: "إننا نقف هنا أمام نسيان للاعتراف (oubli de la reconnaissance)؛ إذ في خضم عملية المعرفة يغيب عنا الانتباه؛ لأن هذه المعرفة ذاتها ترتكز منذ البدء على فعل اعتراف أولي سبقها ومكَّنها من التحقق."[4] فكل علاقة معرفية أو أخلاقية أو اجتماعية، إنما تنبني أولًا على فعل اعتراف ابتدائي يهيّئ إمكانية التفاعل. وإذا ما غاب هذا الاعتراف، فإن كل ما يتأسس عليه ينهار أو يفقد معناه.
ولا يقل هذا عن البُعد الأكثر خطورة، والمتمثل في اللامرئية الاجتماعية للفرد. فحين لا يُعترف بالإنسان في كيانه وكرامته ومكانته، يصبح وجوده مهددًا لا على المستوى البيولوجي فحسب، بل أيضًا على المستوى الرمزي؛ إذ يؤكد هونيث أن "اللاوجود في بُعده الفيزيائي، بل بالأحرى، في دلالته الاجتماعية المحضة"[5]؛ أي إن النفي لا يكون فقط بمنع الجسد من الحياة، بل بنفي الكينونة الاجتماعية، وتهميش الحضور الرمزي للفرد داخل الجماعة.
هكذا تبرز الباثولوجيا الاجتماعية، من منظور هونيث، كتشويه مادي ورمزي للروابط الإنسانية التي تجعل من الحياة المشتركة ممكنة. فلا عدالة دون اعتراف، ولا حرية دون احترام، ولا كرامة دون تقدير متبادل. ومن ثم، فإن تجاوز هذه الباثولوجيا لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة بناء العلاقات الاجتماعية على أسس الاعتراف المتعدد الأبعاد: الحب، والاحترام، والتقدير، بوصفها اللحظات الثلاث التي تُكوّن الذات وتمنحها حق الوجود والحرية في آنٍ معًا.
2.1. الاعتراف كأفق نقدي لإعادة إنتاج الارتباط الاجتماعي
لا شك أن مفهوم الاعتراف يشكل لبَّ الفلسفة الاجتماعية المعاصرة، كما بلوره الفيلسوف الألماني أكسيل هونيث؛ إذ يُنظر إليه بوصفه الشرط الأساسي لتكوين الهوية الإنسانية وإعادة إنتاج الروابط التي تضمن التماسك الاجتماعي واستقراره. فكيف يمكن للذات أن تتشكل وتتحقق دون أن تُرى وتُسمع وتُقدَّر من قِبَل الآخرين؟ هذه المسألة المحورية تلقي بظلالها على الجوهر الإنساني، وتضيء الطريق لفهم الصراعات الاجتماعية التي تنبع من نكران هذا الاعتراف، بل وغيابه التام أحيانًا.
يقول هونيث: "يُعدّ الاعتراف، من منظور اجتماعي، شرطًا جوهريًا لتشييد هوية الشخص؛ إذ إن غيابه يولّد بالضرورة شعورًا بالاحتقار، وهو ما يُفضي إلى تهديد كينونة الفرد وإمكانية تلاشي شخصيته واندثارها."[6] في هذه العبارة تتجلى قوة الاعتراف كفاعل مكافح للاغتراب والحرمان الاجتماعي، فهو السد المنيع أمام الانحلال الشخصي والتفكك الاجتماعي، وبدونه يصبح الإنسان كائنًا ضائعًا في متاهات الرفض والنبذ. ومن هنا تتضح أهمية الاعتراف، ليس فقط كمسألة أخلاقية فحسب، بل كأرضية وجودية لا مناص منها لتحقيق الذات والكرامة الإنسانية.
وفي هذا الإطار، يشير هونيث إلى أن "الحب يشمل مختلف أشكال العلاقات الأولية، سواء كانت علاقات عاطفية أو صداقات أو روابط أسرية، حيث تنعقد بين أفراد قلائل تجمعهم أواصر متينة وعميقة."[7] فالهوية لا تُبنى في فراغ، وإنما تتشكل في أجواء من العناية المتبادلة والاهتمام المتواصل، حيث تتسرب بذور الاحترام والاعتراف في كل تفاعل إنساني حميمي، لتمنح الذات معنى ودفئًا، ولتعزز تلاحم الروابط بين الأفراد، فتتحول العلاقات إلى شعاع يضيء دروب الوحدة ويقوي البناء الاجتماعي.
ولا يغفل هونيث في تحليله البعد القانوني للعلاقات، حيث يرى أن "العلاقة القانونية ترتكز على دعائم تمس البنية الحيوية للروابط الاجتماعية."[8] فالعلاقة القانونية ليست مجرد قواعد جامدة، بل هي شبكة من القيم التي تحافظ على توازن الحرية وتكفل حقوق الفرد، فتتحقق بذلك مصالحة بين الحرية والعدالة، وينشأ النظام الاجتماعي المتوازن الذي يقوم على الاعتراف المتبادل.
إنّ الاعتراف بهذا المعنى هو أفق نقدي ينهض به الإنسان ليُعيد إنتاج الارتباط الاجتماعي، مُحدِثًا بذلك قطيعة مع أشكال العزلة والاغتراب التي تفرزها المجتمعات المعاصرة في ظل التوترات والصراعات التي تهدد البنية الاجتماعية. فالأفق الاعترافي لا يقتصر على كونه مفهومًا نظريًا بحتًا، بل هو ممارسة حيّة تأبى القبول بالظلم الاجتماعي أو الإقصاء أو الاستلاب، وتسعى إلى مجتمع يسوده الاحترام والتقدير، حيث يحيا الفرد في كنف الكرامة والاعتراف، ويشعر بأنه ليس مجرد رقم أو وسيلة، بل غاية في ذاتها تستحق التقدير والحماية.
وفي هذا السياق، يصبح الاعتراف وسيلة فعالة لبناء مجتمع يرتكز إلى تواصل إنساني راقٍ، يرتقي فيه الإنسان فوق شقاء الاغتراب والاحتقار، ويعيد صياغة ذاته في فضاء من الحرية التي تتكامل مع العدالة الاجتماعية. إنه إذًا أفق نقدي يُثري فكرنا الاجتماعي والأخلاقي، ويعيد الاعتبار إلى الروابط التي تضمن السلام الاجتماعي والاستقرار النفسي، فنشعر مع هونيث أن مسألة الاعتراف ليست خيارًا، بل ضرورة وجودية لا يمكن التنازل عنها.
2. الحرية كتجلي للذاتية ضمن دينامية الاعتراف المتبادل
ليست الحرية مجرد انعتاق من قيد خارجي، ولا حركة في فراغ، بل هي ـ في أعمق معانيها ـ التجلي النابض للذات، وهي تعبّر عن كينونتها في مرآة الآخر، في سياق اعتراف متبادل يؤسّس للشرعية الأخلاقية والاجتماعية للفرد. هكذا تتجلّى الحرية، لا كفردانية منغلقة، بل كعلاقة؛ كمطلب أنطولوجي ينهل من نبع الاعتراف، ويعيد بناء الذات في قلب العلاقة الإنسانية.
لقد صاغ توماس هوبز، في منطق الفيزياء السياسية، تصورًا للحرية باعتبارها "انتفاء القوة المقاومة من الخارج، مع احتمال وجود عوائق تُبطئ أو تُعيق حركة الأجسام الطبيعية"[9]، وهي رؤية أدرجها أكسيل هونيث في سياق نقده لمفاهيم الحداثة التي اختزلت الإنسان في كائن ميكانيكي يتحرك ما لم تقاومه قوة. لكن، هل تكفي هذه الرؤية لفهم الحرية بما هي انعتاق إنساني؟ كلا. فحرية الذات لا تختزل في انعدام العوائق، بل في اعتراف يبعث فيها الوجود، ويمنحها الحق في التعبير والتقدير والمشاركة.
في هذا المنحى، يستأنف هونيث التصور الهيغلي العميق للحرية، بوصفها اندماجًا ذاتيًا في القيم الكونية. يقول هيغل: "إن الحياة الأخلاقية تتمثل في الاستعداد الباطني للفرد لأن يتماهى مع ما هو حق في جوهره"[10]، ومن هنا تنبع الحرية كفعل إرادي ينبثق من الذات، لا لأن الآخر أفسح الطريق، بل لأن الذات رأت ذاتها في مرآة الواجب والعدالة، ووجدت نفسها حيث يجب أن تكون.
الحرية، إذن، لا تُفهم إلا ضمن شبكة من العلاقات الاعترافية؛ فهي تُبنى حين يُرى الفرد، ويُحترم، ويُعترف به لا كرقم في معادلة سياسية، بل ككائن يملك قيمة في ذاته. بهذا المعنى، ليست الحرية شعارًا، بل هي تجربة وجودية يتذوقها من حصل على الحب، ونال الاحترام، وحاز التقدير. إنها ليست فقط غيابًا للقهر، بل حضور مشعّ للكرامة.
وهكذا، يغدو مشروع هونيث مشروعًا أخلاقيًا عميقًا، يسعى إلى إعادة تأسيس المجتمع على قاعدة الحرية المعترف بها، لا الحرية المفروضة أو المتخيلة. فكل حرية لا تنبع من قلب الاعتراف، تظل مهددة بالوهم. وكل اعتراف لا يُثمر حرية، يبقى شكلاً دون روح.
الخاتمة
في الختام، تتجلى أمامنا حقيقة جوهرية لا تقبل التأويل أو الجدل، مفادها أن الحرية ليست حالة انعتاق مجردة من القيود، ولا فضاءً شاسعًا يخلو من العلاقات والروابط، بل هي تجلٍّ حيٌّ ومباشر للذات في مرآة الآخر، ونتاجٌ متين لشبكة معقدة من علاقات الاعتراف المتبادل التي تمنح الإنسان وجوده الأخلاقي والاجتماعي. لقد بيّنت فلسفة أكسيل هونيث بجلاء أن الإنسان، في سعيه نحو الحرية، لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف به كذات فاعلة وذات قيمة، وأن غياب هذا الاعتراف يفضي إلى تشوهات اجتماعية عميقة تنعكس على كرامته وهويته ومكانته داخل المجتمع.
كما أشرنا إلى أن الباثولوجيا الاجتماعية ليست مجرد أزمات سطحية، بل هي اختلالات بنيوية تصيب النسيج العلائقي للإنسان، فتقطع أواصر التضامن والتلاحم الاجتماعيين، وتُفضي إلى إقصاء واغتراب يهددان الاستقرار النفسي والعدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن إعادة بناء هذه العلاقات على أسس الاعتراف المتبادل – الحب والاحترام والتقدير – تشكل شرطًا لا غنى عنه لقيام مجتمع عادل يحفظ كرامة الإنسان ويدافع عن حريته في أفق من العدالة الاجتماعية.
وعليه، يصبح مشروع هونيث الفلسفي دعوة ملحة لإعادة التفكير في مفهوم الحرية بعيدًا عن التصورات الفردانية والليبرالية الضيقة التي تحصرها في استقلالية فارغة أو امتثال قانوني جاف. إن الحرية الحقة، في فهم هونيث، هي حرية معترف بها ومرتكزة على احترام الذات وكرامة الآخر، حرية تتطلب مجتمعات أكثر عدلاً وإنسانية، تُعلي من شأن الاعتراف كرافد أساسي لتماسك المجتمع وازدهار الفرد.
وفي نهاية المطاف، إن فلسفة الاعتراف ليست مجرد نظرية فلسفية بحتة، بل هي مشروع حياة يحثنا على بناء عالم يسوده الاحترام المتبادل، وتُحتفى فيه كرامة الإنسان، وتُصان فيه حريته كقيمة سامية لا تقبل المساومة أو التجزئة. وهذا ما يجعلها في صميم التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات المعاصرة في سعيها نحو العدالة والحرية والتماسك الاجتماعي.
المصادر والمراجع:
- هيغل فريديرك، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبولي، القاهرة 1996
- محسن الخوني، "الفهم والتفاهم والحوار والاعتراف في فلسفة التواصل بين هابرماس وهونيت"، مجلة التفاهم، العدد 36، 2012
- هونيت أكسل، التشيؤ: دراسة في نظرية الاعتراف، ترجمة كمال بومنير، الجزائر، 2010
- Honneth Axel, The Freedom’s Rights, Trans. Joseph Ganahl, Berlin, Polity Press, 2014
- Honneth Axel, La société du mépris: vers une nouvelle théorie critique, trad. Olivier Voirol, Pierre Ruschet Alexandre Dupeyrix, Paris La Découverte, 2006
- Honneth Axel, la lutte por la reconnaissance, trad. Pierre Rusch, Paris Cerf, 2000
[1] - Honneth Axel, La société du mépri: vers une nouvelle théorie critique, Trad. Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, Paris, La Découverte, 2006, p.193
[2] - محسن الخوني، "الفهم والتفاهم والحوار والاعتراف في فلسفة التواصل بين هابرماس وهونيت"، مجلة التفاهم، العدد 36، 2012، ص 94 (بتصرف)
[3] - Honneth Axel, la lutte por la reconnaissance, trad. Pierre Rusch, Paris Cerf, 2000, p.228
[4] - هونيت أكسل، التشيؤ: دراسة في نظرية الاعتراف، ترجمة كمال بومنير، الجزائر، 2010، ص64 (بتصرف)
[5] - Honneth Axel, La société du mépris: vers une nouvelle théorie critique, trad. Olivier Voirol, Pierre Ruschet Alexandre Dupeyrix, Paris La Découverte, 2006, p.225
[6] - Honneth Axel, La société du mépris: vers une nouvelle théorie critique, trad. Olivier Voirol, Pierre Ruschet Alexandre Dupeyrix, Paris La Découverte, 2006, p.193
[7] - Honneth Axel, la lutte por la reconnaissance, trad. Pierre Rusch, Paris Cerf, 2000, p.161
[8] - Honneth Axel, la lutte por la reconnaissance, trad. Pierre Rusch, Paris Cerf, 2000, p.183
[9] - Honneth Axel, The Freedom’s Rights, Trans. Joseph Ganahl, Berlin, Polity Press, 2014, p.44
[10] - هيغل فريديرك، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبولي، القاهرة 1996، ص319، (بتصرف).