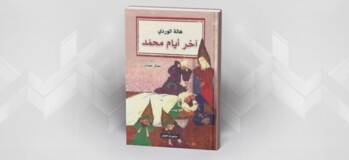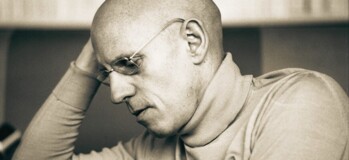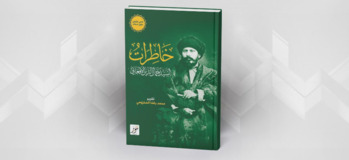ما بعد الحداثة والفلسفة
فئة : ترجمات
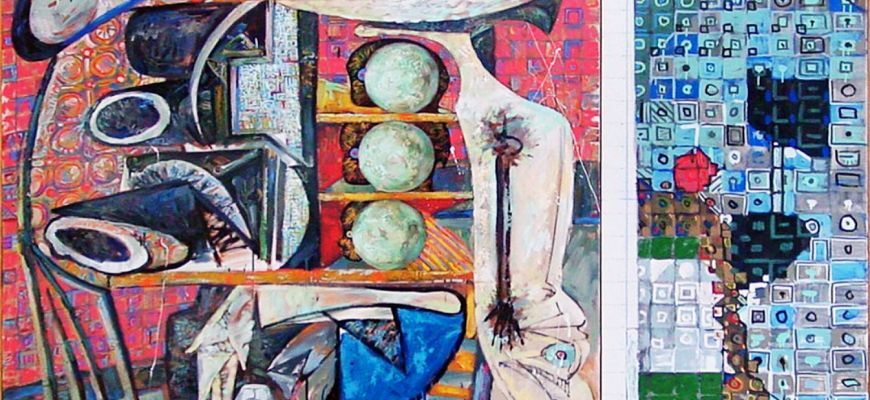
ما بعد الحداثة والفلسفة
ترجمة: سليمان الطعان
تعد الفلسفة الفرنسية المعاصرة الساحة الأساس للنقاش والجدل حول ما اصطلح على تسميته "ما بعد الحداثة"، وهي كذلك أيضا مصدر للعديد من النظريات التي شكّلت ونظّرت لهذا التيار الفلسفي. ولعل الشخصية الرائدة في هذا المجال هي جان فرانسوا ليوتار، الذي يُعد كتابه "حالة ما بعد الحداثة: تقرير عن المعرفة" (1979) الكتاب النظري الأهم لشرح ما بعد الحداثة. ويبدو أن دعوة ليوتار إلى رفض "السرديات الكبرى" (أي النظريات العالمية) للثقافة الغربية؛ لأنها فقدت مصداقيتها- تُلخّص جوهر فلسفة ما بعد الحداثة، بازدرائها للسلطة بكل مظاهرها وتجلياتها. ويذهب ليوتار في هذا الصدد إلى أنه لا جدوى من الدخول في نقاش وجدل مع الماركسية، بل يجب تجاهلها فهي غير ذات صلة بحياتنا.
لعل أفضل وسيلة لوصف ما بعد الحداثة كحركة فلسفية هي النظر إليها على أنها شكل من أشكال الشك؛ أي: الشك في كل من السلطة، والحكمة المتوارثة، والمعايير الثقافية والسياسية، إلخ. وهذا ما يدرج ما بعد الحداثة في تقليد عريق في الفكر الغربي يمتد إلى الفلسفة اليونانية. والشكّ شكل سلبيٌّ من الفلسفة، هدفه تقويض النظريات الفلسفية الأخرى التي تدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، أو معايير لتحديد ما يُعد حقيقةً مطلقة. والمصطلح الذي يصف هذا الأسلوب من الفلسفة هو "مناهضة التأسيسية". فمناهضو التأسيسية يشككون في صلاحية أسس الخطاب، ويطرحون أسئلة مثل: ما الذي يضمن صحة الأساس الذي تنطلق منه؟ وقد استمدت ما بعد الحداثة الكثير من الأمثلة من الفلاسفة المناهضون للتأسيسية antifoundationalist وعلى رأس هؤلاء الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، والذي خرج على تقاليد القرن التاسع عشر بدعوته إلى "إعادة تقييم القيم". وقبل الخوض في أساسيات ما بعد الحداثة بالتفصيل، يبدو من المفيد أن نحدد ما الذي يندرج تحت عنوان فلسفة ما بعد الحداثة. ولن يندرج هنا مفكرون وفلاسفة ما بعد الحداثة مثل ليوتار، ولكن ستندرج أيضا خطابات أخرى مثل التفكيكية التي تقع تحت اسم ما بعد البنيوية.
يُشكل رفض ما بعد البنيوية للتقليد البنيوي ملمحًا آخر من ملامح الشك نحو السلطة المُسلَّم بها، ويمكن أن يُعد جزءًا من المشهد الفكري لما بعد الحداثة. وعلى الرغم من أن فلسفة ما بعد الحداثة تُعد مجالًا متنوعًا إلى حد ما، فإنه يُمكننا ملاحظة بعض السمات المشتركة داخلها، مثل الشك، والتحيز المُعادي للأسس، والكراهية شبه التلقائية للسلطة، مما يجعل من المنطقي مُناقشتها كأسلوب فلسفي مُميز قائم بذاته.
وما بعد البنيوية حركة ثقافية واسعة النطاق تشمل تخصصات فكرية مختلفة، قامت لا على رفض البنيوية ومناهجها فحسب، بل رفضت كذلك الافتراضات الأيديولوجية التي تقوم عليها. ولذلك، يمكن عدها حركة فلسفية وسياسية في آن واحد، كما هو الحال مع ما بعد الحداثة عمومًا. وقد شككت ما بعد البنيوية في اليقينيات الثقافية التي ساد الاعتقاد بأن البنيوية تجسدها؛ يقينيات مثل الاعتقاد بأن العالم قابل للمعرفة في جوهره، وأن البنيوية قد منحتنا مفتاحًا منهجيًّا لفك طلسمات الأنظمة المختلفة التي شكلت هذا العالم. تستمد البنيوية مبادئها من النظريات اللغوية لعالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير، الذي أحدث ثورة في دراسة اللسانيات في كتابه المنشور بعد وفاته، "دروس في الألسنية العامة" (1916). والنقطة الرئيسة التي جاء بها سوسير حول اللغة أنها قبل كل شيء نظام: نظام ذو قواعد وأنظمة (أو قواعد داخلية) تحكم كيفية عمل عناصر اللغة المختلفة. تتكون اللغة من علامات، وكل علامات تتكون من جزأين: دال (كلمة) ومدلول (مفهوم)، يجتمعان معًا لتكوين العلامة. وعلى الرغم من عدم وجود صلة ضرورية بين الكلمة والشيء الذي تُسمّيه (كانت "اعتباطية"، كما أقرّ سوسير)، فإن قوة العرف تضمن عدم تغيرها تبعًا لهوى أحد. يوجد استقرار نسبي للغة وإنتاج المعنى، ويُنظر إلى اللغة كنظام من العلامات يُثير استجابة متوقعة من جانب المجتمع اللغوي.
شكّل النموذج اللغوي الذي وضعه سوسير أساس التحليل البنيوي، الذي طبّقه على الأنظمة عمومًا، مفترضًا أن لكل نظام قواعد نحوية داخلية تحكم عملياته. وكان الهدف من التحليل البنيوي كشف تلك القواعد، سواءٌ أكان النظام المقصود أسطورة قبلية، أم صناعة إعلانية، أو عالم الأدب أو الموضة. في النهاية، فإن ما تعترض عليه ما بعد البنيوية هو الترتيب العام للمشروع البنيوي، حيث لا توجد نهايات مفتوحة، وكل شيء يسير في مكانه بدقة. لهذا، فعند مفكر مثل كلود ليفي شتراوس، أو رولان بارت في بداياته، فإن كل تفصيل في السرد له أهمية من حيث بنية الناتج النهائي (حيث لا توجد عناصر عشوائية)، وتندرج السرديات تندرج ضمن أنواع أدبية محددة، وبعض الأمثلة (مثل أسطورة قبلية معينة) هي مجرد تنويعات على موضوع مركزي. من هذا المنظور، يبدو أي نظام (أو سرد) مشابهًا جدًا لأي نظام آخر، ويصبح تحليل قواعده تمرينًا متوقعًا إلى حد ما، كما لو كان المرء يعرف مسبقًا ما سيجده؛ يمكن للمرء أن يجادل، وقد فعلت ذلك ما بعد البنيوية، بأن الأساليب التحليلية التي يستخدمها البنيوي هي التي تحدد النتائج. فالبنيوية لا تسمح إلا بمساحة محدودة للصدفة والإبداع أو ما هو غير متوقع. فيما يخص ما بعد البنيوية، فإن هذه الأمور أكثر أهمية بكثير من كل أوجه التشابه بين الأنظمة، ولدى ما بعد البنيوية ما يرقى إلى الالتزام بالبحث عن الاختلاف، والتباين، وعدم القدرة على التنبؤ بالتحليل.
تعد تفكيكية جاك دريدا إحدى أهم تجليات فلسفة ما بعد البنيوية. وقد انصب جهد التفكيك ضد جانب بناء النظم في البنيوية، وعارض فكرة أن جميع الظواهر قابلة للاختزال، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية السيطرة الكاملة على محيطنا. ما كان دريدا مهتمًا بإظهاره هو عدم استقرار اللغة، والأنظمة عمومًا. فليست العلامات كيانات متوقعة من وجهة نظر دريدا، بل لا يوجد اقتران تام بين الدال والمدلول لضمان تواصل سلس، فثمة نوع من "الزلل" في المعنى. فالكلمات تحمل دائمًا أصداء وآثارًا لكلمات أخرى، فجودة نطقها، على سبيل المثال، تُذكّرنا دائمًا بمجموعة من الكلمات المتشابهة. قدّم دريدا دليلاً على هذا الزلل من خلال مفهوم يُسمى "difjerance"، وهو مصطلح مُستحدث مُشتق من الكلمة الفرنسية "different" (بمعنى الاختلاف والتأجيل). فلا يمكن اكتشاف أي الكلمتين كانت مقصودة، إلا من الكتابة، فهما تنطقان بالطريقة نفسها. فعند دريدا، ما يظهر هو عدم التحديد المتأصل للمعنى. فالمعنى اللغوي ظاهرة غير مستقرة: ففي كل الأزمنة والأمكنة، كان الفارق ظاهرًا. (تجدر الإشارة إلى أن دريدا ينكر أن الاختلاف مفهوم؛ فهو عنده مجرد تعريف لعملية مُضمَّنة في اللغة نفسها). إن الشغف بالتورية والتلاعب بالألفاظ في الكتابة التفكيكية (وهي سمة متكررة لدى كل التفكيكيين) يهدف إلى توضيح عدم استقرار اللغة، فضلاً عن قدرتها الإبداعية التي لا نهاية لها على توليد معاني جديدة وغير متوقعة.
لذا، فإن المعنى ظاهرة عابرة، تتلاشى تقريبًا بمجرد ظهورها في اللغة المنطوقة أو المكتوبة (أو تتحول باستمرار إلى معانٍ جديدة)، بدلًا من أن تكون شيئًا ثابتًا يدوم مع مرور الوقت لسلسلة من المستمعين المختلفين. يزعم دريدا أن الفلسفة الغربية برمّتها تقوم على افتراض حضور المعنى الكامل للكلمة في ذهن المتكلم، حيث يمكن إيصاله إلى المستمع دون أي زلل يُذكر. هذا الاعتقاد هو ما يُطلق عليه دريدا "ميتافيزيقا الحضور"، وهو بالنسبة له وهم، فالفارق يتدخل دائمًا في التواصل ليمنع ترسيخ "الحضور"، أو اكتمال المعنى. إن التركيز على الاختلاف، على ما لا يتوافق مع القاعدة أو بناء النظام، الذي نجده في التفكيك، هو سمة مميزة جدًا للفلسفة ما بعد الحداثية.
ميشيل فوكو هو مفكر آخر انقلب على توجهات الفكر البنيوي في بناء النظام واستبعاد الاختلاف. مرة أخرى، يُشدد على حقيقة الاختلاف، ففي حالة فوكو، ثمة اهتمام خاص بالمجموعات المهمشة التي يُبقيها اختلافها مُستبعدة من السلطة السياسية؛ مجموعات مثل المجانين والسجناء والمثليين. لقد التزمت ثقافة ما بعد عصر النهضة بتهميش الاختلاف، بل شيطنته، وذلك بإرساء معايير سلوكية. كتب فوكو سلسلة من الدراسات التي تتناول كيفية تطبيق هذه المعايير في أوروبا الغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مما أدى إلى ظهور مجموعة جديدة من المؤسسات المُنظَّمة (مصحات الأمراض العقلية، والسجون، والمستشفيات) للتعامل مع "المختلف". فعند لفوكو، تعد هذه المؤسسات تعبيرات عن السلطة السياسية، وعن الطريقة التي تستطيع بها مجموعة مهيمنة في المجتمع فرض إرادتها على الآخرين.
لتوضيح كيفية شيطنة الاختلاف الجنسي في المجتمع الحديث، عاد فوكو إلى العصور الكلاسيكية في دراسته المكونة من ثلاثة مجلدات بعنوان "تاريخ الجنسانية" (1976-1984) ليستقصي كيف كانت المثلية الجنسية في الثقافتين اليونانية والرومانية. كان المجتمع اليوناني أكثر تسامحًا مع الاختلاف الجنسي من مجتمعنا، وإن لم يكن أقل أخلاقية في نظرته. وبتعبير فوكو، كان للجنسانية "خطاب" مختلف، خطاب لم يُفرض فيه معيار سلوكي واحد، بل ازدهرت فيه المثلية الجنسية والمغايرة الجنسية جنبًا إلى جنب. وقد قارن فوكو هذا السلوك بالأزمنة الحديثة، عندما تحولت المغايرة الجنسية إلى قاعدة واعتُبرت جميع أشكال التعبير الجنسي الأخرى انحرافات عنها. وهذا الإصرار على القاعدة بدلًا من الاختلاف، جزء من النزعة التسلطية authoritarianism التي يربطها مفكرون مثل فوكو بالثقافة الحديثة.
كان كتاب جيل دولوز وفيليكس غواتاري "ضد أوديب" (1972) هجومًا ما بعد بنيوي على النزعة التسلطية authoritarianism؛ وفي هذه الحالة، فإن النزعة الاستبدادية مُضمّنة في نظرية التحليل النفسي التي تسعى إلى التحكم في التعبير الحر عن الرغبة الإنسانية من خلال نظريات مثل عقدة أوديب. فعند دولوز وغواتاري، فإن الأفراد "آلات راغبة"، ويفتقرون إلى الشعور بالوحدة الذي نربطه عادةً بالهوية الفردية، لكن فرصة التعبير عن رغبتهم مكبوتة من قبل السلطات الاجتماعية والسياسية (الفاشية هي المثال الأوضح على كيفية سير هذه العملية). فالتحليل النفسي، عند دولوز وغواتاري، رمز لكيفية قمع الرغبة، وفي مقابل ذلك، يقدمان "التحليل الفصامي"، استنادًا إلى تجربة المصاب بالفصام - الذي يُصبح، في مخططهما للأشياء، نموذجًا مثاليًا للسلوك البشري. ويبرز هنا البعد السياسي للفكر ما بعد البنيوي، والذي يختفي غالبًا تحت ستار المناقشات الميتافيزيقية الغائمة.
يمكن أيضًا إدراج النسوية ضمن إطار ما بعد البنيوية، إذ إنها تُشكك في صرامة تصنيفات الجندر المزعومة. وتقوم الحجة على أن الهوية الجندرية، ولاسيما الهوية الأنثوية، ليست أمرًا ثابتًا، ولكنها مسألة مائعة لا يمكن اختزالها في جوهر أو معيار سلوكي (في هذه الحالة، معيار سلوكي مستمد من النظام الأبوي). وقد استخدم منظرون مثل لوس إيريجاري Luce Irigaray هذا الشكل من الحجج للتشكيك في افتراضات النظام الأبوي، وخصوصًا افتراض وجود سمات جنسية ذكرية وأنثوية على وجه التحديد، والتي تقود إلى الصور النمطية الجنسانية التي مازال مجتمعنا متمسكًا بها إلى حد كبير، ويوظفها كأساس لقمع المرأة.
مازال ليوتار الصوت الأكثر تأثيرًا في فلسفة ما بعد الحداثة، وثمة خيط متصل من مناهضة النزعة التسلطية يمتد عبر مسيرته الفلسفية، ويمكننا الآن أن نعده جوهر ما بعد الحداثة. كان من الممكن وصف ليوتار في بداية مسيرته بأنه ماركسي؛ إذ كان عضوًا في جماعة "الاشتراكية أو البربرية"، التي كرّست نفسها لإخضاع النظرية الماركسية لنقد صارم من الداخل، فقد كان المتحدث الرسمي باسم صحيفة الجماعة بشأن الجزائر. تكشف كتابات ليوتار عن حرب التحرير الجزائرية في خمسينيات القرن الماضي وستينياته عن شخصٍ بعيد كل البعد عن الماركسية التقليدية، وأكثر استعدادًا للتشكيك بمبادئ الماركسية. الاعتراض الرئيسي الذي يطرحه ليوتار أن قيادة الحزب الشيوعي تعاملت مع الجزائر بوصفها ثورة بروليتارية كلاسيكية، بينما كانت الجزائر في الواقع مجتمعًا فلاحيًّا لم تكن للماركسية فيه قيمة عملية تُذكر.
بعد انهيار حركة "الاشتراكية أو البربرية" في ستينيات القرن الماضي، نأى ليوتار بنفسه عن ماضيه الماركسي. ومثل العديد من المثقفين الفرنسيين من أبناء جيله، شعر بخيبة أمل من الموقف المؤيد للمؤسسة الذي تبناه الحزب الشيوعي الفرنسي في مؤتمرات باريس عام 1968. وفي أعمال مثل "الاقتصاد الليبيدي" (1974)، عبّر عن إحباطه الذي شعر به آنذاك تجاه الماركسية الرسمية. يذهب كتاب "الاقتصاد الليبيدي" إلى أن الماركسية عاجزة عن استيعاب مختلف الدوافع الليبيدية التي يختبرها الأفراد؛ لأن هذه الدوافع غير المتوقعة تقع خارج سيطرة أي نظرية (الحجة مشابهة لتلك الواردة في كتاب "ضد أوديب"). ما كان خطأ الماركسية تحديدًا هو محاولتها قمع هذه الطاقات، كاشفةً بذلك عن نزعتها الاستبدادية الكامنة. يكمن وراء هجوم الكتاب اللاذع على الماركسية اعتقاد ليوتار أن الطبيعة البشرية والعملية التاريخية ليستا قابلتين للتنبؤ كما أصرت على ذلك النظرية الماركسية. طلب منا ليوتار أن نقبل أن الطاقة الليبيدية (التي تُشبه مُركّب الدوافع اللاواعية التي حددها فرويد) تُفنّد أي ادعاء بأن الماركسية بوسعها الحكم على الأحداث. يُمكن اعتبار الكتاب بداية نقد "السرد الكبير" الذي شكّل جوهر أنجح أعمال ليوتار وأكثرها تأثيرًا، "حالة ما بعد الحداثة".
يذهب كتاب "حالة ما بعد الحداثة" إلى أن المعرفة هي الآن أهم سلعة في العالم، وأنها قد تصبح مصدرًا للصراع بين الدول في المستقبل. يُصرّ ليوتار على أن من يُسيطر على المعرفة يُمارس الآن سيطرة سياسية، وهو حريص على ضمان نشر المعرفة بأكبر قدر ممكن من الانفتاح، وبديله للسيطرة السياسية المركزية على المعرفة هو جعل جميع بنوك البيانات متاحة لعامة الناس. يُنظر إلى المعرفة على أنها تُنقل عبر السرد، وينتقد ليوتار ما يسميه السرديات الكبرى؛ أي تلك النظريات التي تدّعي قدرتها على تفسير كل شيء، ومقاومة أي محاولة لتغيير شكلها (أو "سردها"). فالماركسية، على سبيل المثال، لها سردها الخاص للتاريخ العالمي، الذي تعده صحيحًا، وفوق أي نقد أو حاجة إلى مراجعة. إنها ليست سردًا يُعاد تفسيره باستمرار في ضوء الأحداث الثقافية المتغيرة، بل هي نظرية منيعة صامدة على مر الزمن، ولا ينبغي التشكيك في سلطتها أبدًا. ويرى ليوتار أن هذا الموقف ذو نزوع استبدادي، ولذلك نراه يحتفي بقضية "السرد الصغير" (petit recit) بدلًا منه.
تُصاغ السرديات الصغرى على أساس تكتيكي من قِبل مجموعات صغيرة من الأفراد لتحقيق هدف محدد (مثل مزيج "السردية الصغرى" للطلاب والعمال في أحداث عام 1968الداعي إلى إصلاحات حكومية)، ولا تدّعي السردية الصغرى امتلاكها حلولاً لجميع مشاكل المجتمع، فهي لا تدوم إلا بما يلزم لتحقيق أهدافها. يرى ليوتار أن السرديات الصغرى هي الوسيلة الأكثر ابتكارًا لنشر المعرفة وتكوينها، وأنها تُسهم في كسر احتكار السرديات الكبرى. ففي مجال العلوم، على سبيل المثال، تُعد السرديات الصغرى الآن الوسيلة الأساسية للبحث والاستقصاء. ويُضيف ليوتار أن علم ما بعد الحداثة هو بحث عن المفارقات وعدم الاستقرار والمجهول، وليس محاولة لبناء سردية كبرى أخرى تُطبق على المجتمع العلمي بأكمله.
إحدى المشكلات التي نواجهها عند الاستغناء عن السرديات الكبرى، أو السلطات المركزية من أي نوع، هي كيفية بناء أحكام قيمة يقبلها الآخرون على أنها أحكام عادلة ومقبولة. يواجه ليوتار هذه المشكلة في كتابه "اللعب فقط" (1979)، حيث يعتقد أنه مازال من الممكن إصدار أحكام قيمة، حتى لو لم يكن لدينا سردية شاملة تدعمنا، على أساس "كل حالة على حدة" (وهو شكل من أشكال البراجماتية يزعم ليوتار أنه يُوظف في كتابات أرسطو السياسية والأخلاقية). إن العمل على أساس كل حالة على حدة، حيث نعترف بغياب أي معايير مطلقة، هو الحالة التي يشير إليها ليوتار بـ "الوثنية"، وهو مثال للطريقة التي ينبغي لنا أن نعمل بها في عالم ما بعد الحداثة. لا وجود أبدًا لمثل هذه المعايير المطلقة، أو لأسس الإيمان، كي ترشدنا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة، كما يُصرّ ليوتار، السقوط في الفوضى الاجتماعية، كما يُشير إلى ذلك النقاد المدافعون عن السرديات الكبرى. فما يُنادي به ليوتار هنا هو مناهضة التأسيسية، أي: رفض فكرة وجود أسس لنظامنا الفكري، أو معتقداتنا، لا تقبل الشك، والإصرار على ضرورتها لإصدار أحكام القيمة. فقد أثبتت فلسفة ما بعد الحداثة أنها مناهضة للأسس على نحو قاطع، وهي لا تقبل أن يجعلها هذا الرفض غير فعالة كفلسفة.
انصبّت اهتمامات ليوتار الفلسفية اللاحقة على ما يُسميه "الحدث"، وعلى مفهوم "الانعطاف" أيضًا. والحدث عند ليوتار يُغيّر نظرتنا للعالم جذريًّا، ويُشكّك في جميع افتراضاتنا الأيديولوجية. أوشفيتز أحد هذه الأحداث، واحتجاجات عام 1968 حدث آخر. فالأول تحديدًا ليس أمرًا يُمكن تفسيره بتطبيق مقولات "السردية الكبرى"؛ ولكنه يُمثل النقطة التي تنهار عندها هذه النظرية. أما الثاني، فهو نوع من انفجار الطاقة الليبيدية التي لا يستطيع النظام التعامل معها. فالإقرار بوجود أحداث لا يمكن التنبؤ بها أو حصرها ضمن أي نظرية عالمية واضحة، لا يعني إقرارًا بحدود السردية الكبرى فحسب، بل يعني أيضًا الإقرار بانفتاح المستقبل. ويُعد هذا الانفتاح ركنًا أساسيًا من أركان المذهب لدى ما بعد الحداثيين؛ أي: لا ينبغي اعتبار المستقبل مُحددًا مسبقًا بحيث يُفقد هذا التحديد كل جهد بشري من معناه.
الاختلافات هي تضارب مصالح بين أطراف لا يمكن حلها، ولكن يجب الاعتراف بها ووضعها في الحسبان دائمًا (انظر تحديدًا كتاب "الاختلاف" (1983)). كل طرف يسكن فيما يسميه ليوتار "نظامًا لفظيًا" phrase regime مختلفًا، أهدافه غير متناسبة مع أهداف الطرف الآخر، ولا يملك أي من الطرفين أي حق أخلاقي في إجبار الآخر على الامتثال لرغباته. ما يحدث عادةً في الممارسة العملية، ولاسيما الممارسة السياسية، أن أحد طرفي النزاع يفرض وجهة نظره على الطرف الآخر، أي: يفض النزاع لمصلحته الخاصة. وبتعبير ليوتار، يُسيطر نظامٌ لفظيٌّ على آخر - وهو مثالٌ كلاسيكيٌّ على النزعة التسلطية في أثناء الممارسة. يستشهد ليوتار، كمثال على ذلك في الحياة اليومية، بقضية موظفة مُستغَلّة لا تستطيع الحصول على أي تعويض عن استغلالها إذا رفعت دعوى قضائية ضد رب عملها؛ لأن المحكمة التي تنظر في دعواها قائمة على مبدأ قانونية الاستغلال. إن النظام اللفظي الذي يعتمده رب العمل يستبعد الآخر من التعبير عن رأيه. أما واجب الفلاسفة، فهو مساعدة الأنظمة اللفظية المكبوتة على إيجاد صوتها، وهذا ما يصفه ليوتار بـ"السياسة الفلسفية". يمكن عدُّ السياسة الفلسفية، والبحث عن أنظمة تعبيرية جديدة مضادة للثقافة، أفضل تعبير عن فلسفة ما بعد الحداثة.
وما يُثير قلق ليوتار هو الطريقة التي تُحاول بها قوى "العلم التقني" (والذي يُمكن أن نستنتج أنه الشركات متعددة الجنسيات) اختطاف مسار التاريخ البشري، من خلال التحضير لنهاية الحياة على الأرض. يجادل ليوتار بأن علماء التقنية يزيلون الجنس البشري تدريجيًا من المشهد، من خلال تطوير تكنولوجيا حاسوبية قادرة على إعادة إنتاج نفسها والاستمرار في الوجود في مكان آخر من الكون عند فناء الأرض (وهو حدث سيقع بعد حوالي 4.5 مليار سنة). يُحذّرنا ليوتار في كتابه "اللاإنساني" (1988) من أن الهدف النهائي للعلم التقني هو جعل التفكير ممكنًا دون جسد بشري، وهذا يُمثّل تهديدًا للإنسانية وقيمها التي يجب مقاومتها بشدة، لكونها "لاإنسانية" في جوهرها. ما يريده علماء التقنية هو اختزال البشرية إلى جوهرها المفترض؛ أي الفكر، وجعله قابلاً للتنبؤ به عبر برامج حاسوبية. وفي ظل فكر بلا جسد بشري، لا وجود لأحداث أو اختلافات كي نقلق بشأنها، ولا حتى انفتاح للمستقبل الذي يُقدّره فلاسفة ما بعد الحداثة. إنها حالة أخرى من استبعاد المختلف وغير المتوقع بهدف السيطرة. فالمُستبعد من المعادلة هو الفرد، وكذلك السردية الصغرى؛ إذ لا مكان لأيٍّ منهما في النظام الاستبدادي. فالرغبة في تجريد البشرية من إنسانيتها باختزالها في عملية فكرية فحسب، هي في نظر ليوتار نزعة استبدادية في نهاية المطاف. إن المقاومة على عبر السردية الصغرى تغدو فعلاً أخلاقيًّا من أجل قضية الاختلاف؛ لأنه هو الذي تجب حمايته بأي ثمن في عالم ما بعد الحداثة.
تُعدّ كتابات جان بودريار تعبيرًا مهمًّا آخر عن فلسفة ما بعد الحداثة، فقد انتقد هو الآخر الماركسية والبنيوية، ورفض فكرة وجود بنى خفية وراء جميع الظواهر التي يقع على عاتق المحلل تحديدها وتفسيرها. وعند بودريار، فإن عالم ما بعد الحداثة عالم من المحاكيات، حيث لم نعد نستطيع التمييز بين الواقع والمحاكاة، فالمحاكيات لا تُمثل إلا نفسها، فلا واقع آخر تُشير إليه. ونتيجةً لذلك، يدّعي بودريار أن ديزني لاند والتلفزيون يُشكلان الآن واقع أمريكا، والأكثر إثارةً للاهتمام، أن حرب الخليج لم تحدث، بل كانت مجرد محاكاة (شيء يُشبه لعبة فيديو، على ما يبدو). وليس من المُستغرب أن تُثير هذه النظرة انتقاداتٍ واسعةً لسخريتها الواضحة وافتقارها إلى الحساسية للبعد الإنساني المُتضمن فيها.
من حجج بودريار الأخرى التي أثارت جدلًا واسعًا، أن الأنظمة لم تعد بحاجة إلى معارضة، بل يمكن "إغواؤها" - أي إخضاعها (انظر تحديداً كتاب "الإغواء" (1979)). وقد انتقدت النسويات بشدة ما اعتبرنه تمييزًا جنسيًّا ضمنيًا في مفهوم الإغواء، واتهمن بودريار بتعزيز الصور النمطية الجنسية من خلال استخدامه. ومع الإقرار بقوة الحجة النسوية، فإن المرء قد يرى في الإغواء محاولةً ما بعد حداثية أخرى، هدفها تقويض الأنظمة من خلال تحديد نقاط ضعفها. لا ترى فلسفة ما بعد الحداثة عمومًا أي حاجة لمواجهة صريحة مع أنظمة السلطة، بل تهتم أكثر بتوضيح طريقة انهيار هذه الأنظمة (والماركسية والشيوعية مثالان بارزان).
يمكن النظر إلى رد الفعل ضد الماركسية العقائدية في أعمال مفكرين مثل ليوتار وبودريار جزءًا من اتجاه ثقافي آخر يُعرف الآن باسم ما بعد الماركسية. غدت ما بعد الماركسية حالة نظرية مهمة، لا تشمل الشخصيات التي ترغب في رفض معتقداتها الماركسية (ليوتار وبودريار، على سبيل المثال) فحسب، بل تضم أيضًا أولئك الذين يرغبون في تنقيح الماركسية وفقًا للتطورات النظرية والثقافية الجديدة. عبر إرنستو لاكلو Ernesto Laclau وشانتال موفت Chantal Moufteعن المجموعة الأخيرة عندما نشرا كتابهما المثير للجدل "الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية راديكالية" عام 1985. في هذه الدراسة، جادلا بأن الماركسية بحاجة إلى مواءمة نفسها مع مختلف الحركات الاجتماعية الجديدة الناشئة (النسوية، والخضر، والأقليات العرقية والجنسية، على سبيل المثال)؛ أي أن تتبنى الماركسية التعددية السياسية وتتخلى عن ادعاءاتها بأنها مجموعة من الحقائق المسلم بها. كما احتاجت الماركسية إلى مراعاة مختلف النظريات الجديدة التي كانت آخذة في البروز - نظريات مثل التفكيكية أو ما بعد الحداثة. ومرة أخرى، يمكننا أن نلاحظ بروز عدم ثقة ما بعد الحداثة بالسرديات الكبرى ودوغمائيتها. ما يُنظر إليه على أنه خطأ في الماركسية هو أنها أخفقت في مواكبة العصر، وفي إدراك مدى تنوع المجتمع (أو "التعددية"، كما يُقال). وبدلاً من ذلك، اكتفت الماركسية بمحاولة فرض نظرياتها على الآخرين، بدعوى أنها وحدها تملك الحقيقة. ومن هذا المنظور، تُعدّ الماركسية نظريةً استبدادية. ويُطالب لاكلو وموفت بماركسية أكثر "انفتاحًا"، قادرة على التكيف مع الظروف الثقافية المتغيرة، وجذب جماهير جديدة في سياقها. وكما هو متوقع، رفضت المؤسسة الماركسية ادعاءات لاكلو وموفت بأن الماركسية بحاجة إلى مراجعة جذرية، أو أنها ينبغي أن تسعى لتصبح تعددية، وتمسكت بدلًا من ذلك بحقيقة الماركسية المزعومة وعالمية تطبيقها.
إن هذا الارتياب في النظرية الكبرى، وادعاءاتها الاستبدادية، هو ما يُمكن عده السمة المميزة لفلسفة ما بعد الحداثة، التي تتبنى موقفًا ليبراليًّا في مختلف تجلياتها. يتبنى هذه الآراء في العالم الفلسفي الأنجلو أمريكي الفيلسوف البراغماتي الأمريكي ريتشارد رورتي Richard Rorty، وهو من أبرز رواد التقليد الفلسفي القاري الحديث. لا يُولي رورتي أيضًا اهتمامًا بالنظرية الكبرى، وبأسلوبه البراغماتي النموذجي، لا يُولي اهتمامًا لصدق أو كذب النظريات بقدر ما يُولي اهتمامًا لمدى فائدتها وإثارة اهتمامها. فالفلسفة، عند رورتي، ليست إلا شكلًا من أشكال الحوار، ويُفضل رورتي مواضيع أخرى مثل الأدب، وذلك عندما يتعلق الأمر بإيجاد مصدر للأفكار يُرشد سلوكنا. إن عودة رورتي إلى "ما بعد الفلسفة" هي أيضًا ما بعد حداثية؛ وذلك برفضها للسردية التقليدية المرتبطة بالتراث الفلسفي الغربي. ثمة مرجعية أخرى تُلقى بلا مراسم في سلة المهملات التاريخية.
ليس من المستغرب ألا يرضى الجميع بلجوء ما بعد الحداثة المتكرر إلى مزبلة التاريخ. فقد وصف الناقد الأمريكي فريدريك جيمسون نظرية ما بعد الحداثة بأنها "المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة"، معتبرًا إياها، بقصد أو بغير قصد، متواطئة مع أصحاب السلطة في المساعدة على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن. لطالما انتقد ما بعد الحداثيون إيمان اليسار بفعالية المواجهة الأيديولوجية، وفيما يخص ماركسيًّا مثل جيمسون، فإن هذا الاعتقاد يخدم قضية اليمين، فهذا الأخير لديه مصلحة راسخة في رؤية تزايد اللامبالاة تجاه العملية السياسية. اتخذ تيري إيغلتون وجهة نظر مماثلة لجيمسون، وسلط الضوء باستمرار على التداعيات الأيديولوجية لتبني خط ما بعد الحداثة، الذي يراه معاديًا لقضية الاشتراكية. انتقد كريستوفر نوريس Christopher Norris أعمال بودريار بشدة، لا سيما موقفه المتهور تجاه حرب الخليج. ويرى نوريس أن إنكار بودريار لواقع تلك الحرب يرمز إلى فراغ ما بعد الحداثة كنظرية ثقافية، ولا يمكنه قبول عدم اكتراث بودريار الواضح بالاضطرابات السياسية والمعاناة الإنسانية. ويرى يورجن هابرماس أيضًا أن ما بعد الحداثة موضع شك أيديولوجي، وقد عارض فلسفة ليوتار على هذا الأساس.
بشكل عام، يُمكن تعريف فلسفة ما بعد الحداثة بأنها نسخة مُحدثة من الشك، تُعنى بزعزعة استقرار النظريات الأخرى وادعاءاتها بامتلاك الحقيقة أكثر من اهتمامها ببناء نظرية إيجابية خاصة بها؛ مع أن التشكيك في ادعاءات الآخرين النظرية يعني، بطبيعة الحال، امتلاك برنامج خاص، ولو افتراضيًّا. لذلك، يُمكن عدُّ فلسفة ما بعد الحداثة توظيفًا للفلسفة لتقويض الضرورات الاستبدادية في ثقافتنا، على المستويين النظري والسياسي.
من الصعب الجزم ما إذا كان هذا الاتجاه سيحظى بالاهتمام لفترة أطول. إلى حدّ ما، أصبح لما بعد الحداثة سرديتها الكبرى الخاصة بها (هناك "خط" ما بعد حداثي محدد لمعظم القضايا الفلسفية)، ومن ثم فهي عرضة للهجوم في المقابل. من الممكن أيضًا القول إن فلاسفة ما بعد الحداثة قد بالغوا في تقدير تراجع السرديات الكبرى، ومن الاعتراضات المهمة على رفض ليوتار لأهميتها المستمرة أن الأصولية الدينية (وهي سردية كبرى إن وُجدت أصلًا) تزايدت بشكل واضح في العقود الأخيرة من القرن العشرين. ويبدو أن نمو الأصولية الإسلامية تحديدًا يُشكك في صحة حكم ليوتار في هذا الشأن، نظرًا إلى أنها لا تُسيطر على الحياة السياسية لعدد متزايد من دول الشرق الأوسط وآسيا. مما يجعلها ذات تأثير كبير على المشهد السياسي العالمي.
يتبنى ليوتار نفسه رؤيةً دوريةً للتاريخ الثقافي، حيث تتعاقب ما بعد الحداثة والحداثة على مر الزمن في تسلسلٍ لا ينتهي. وهكذا، وُجدت حركات ما بعد الحداثة في الماضي (شخصيات مثل رابليه أو لورانس ستيرن تُعد من أنصار ما بعد الحداثة عند ليوتار). وستظهر حركات حداثية وما بعد حداثية مجددًا في المستقبل. من الممكن القول إننا دخلنا بالفعل في عالم ما بعد ما بعد الحداثة، حيث تُبرز الانشغالات الثقافية المختلفة (مثل إعادة بناء السرديات الكبرى) حضورها. من المؤكد أن الشك ظهر وزال على مدار التاريخ الفلسفي. وربما تكون الجولة الحالية قد حققت غرضها المعتاد في لفت الانتباه إلى نقاط ضعف بعض المواقف الفلسفية، ويمكن أن يحل محلها برنامج فلسفي أقل سلبية في المستقبل القريب.