ثورات قلقة: مقاربات سوسيو/استراتيجية للحراك العربي
فئة : قراءات في كتب
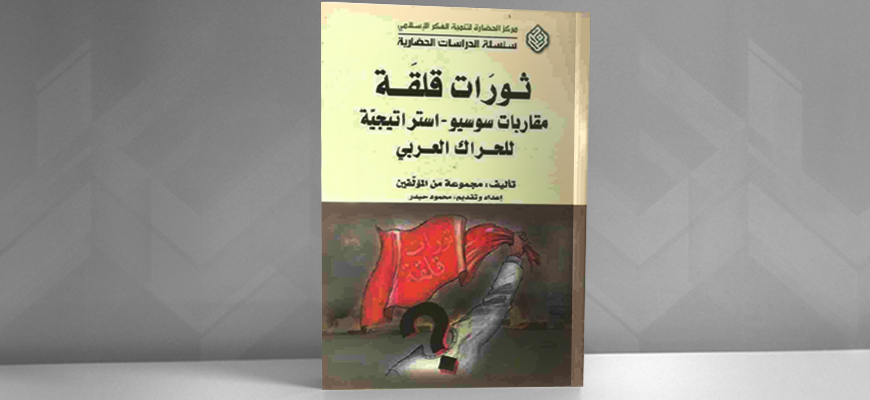
ثورات قلقة: مقاربات سوسيو/استراتيجية للحراك العربي
مجموعة مؤلفين (تنسيق محمود حيدر)، منشورات مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2012، 394 ص.
بمقدمة هذا الكتاب المرجعي الهام، نقرأ التالي على لسان المنسق: إنّه "حتى لو اتفقنا على التعامل بإيجابية مع العناوين الشائعة في الخطب الإعلامية والسياسية والفكرية، لجهة تعريف التحولات بأنها ثورات فتحت باب التغيير الديموقراطي، فليس لنا أن نغفو عن تلك الشبكة الهائلة من التعقيدات والتداخلات، التي تدفع بالحادث الثوري نحو فوضى الاحتراب الأهلي والتفتيت الوطني. لذا، فإنّ الرؤية الأكثر اقتراباً من الواقع تشير إلى أنّ الحادث العربي، في مجمل أقطاره وساحاته، هو حادث يحوطه ضباب كثيف، لكنه مفتوح على احتمالات ووعود لا حصر لها".
ويتابع بالقول إنّ وضع عبارة "الثورات القلقة" عنواناً لهذا الكتاب، إنما يعبر عن اليقين "من أنّ ما يحدث هو أشبه بجيولوجيا مجتمعية تتعدد أسبابها ومحركاتها، مثلما تتنوع المؤثرات والعوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى انفجارها وديمومتها".
ينقسم كتاب "ثورات قلقة" إلى مجموعة من الفصول الكبرى، يتضمن كل واحد منها أكثر من بحث ودراسة، وفق زاوية المقاربة المحبذة لدى هذا الباحث أو ذاك. ولذلك، وفي تعذر التعرض لها مجتمعة، فإننا سنتجاوز عن التقسيم الإجرائي المعتمد، لنقف عند "النصوص" الكبرى، أي عند تلك التي تبدو لنا دامجة للإشكالية المطروحة بهذا الفصل من الكتاب أو ذاك.
ـ ففي دراسته الموسومة "بواعث الثورات القلقة: مسعى تنظيري لفهم طبائعها وأسئلتها وتحيزاتها الإيديولوجية"، يلاحظ محمود حيدر أنه "لم يكن لحادث تاريخي أن يحظى بتلك الوفرة من الجدل حول ماهيته وهويته ومآلاته المنتظرة، كالحادث المتمادي على مساحة العالم العربي منذ بداية العام 2011".
ولذلك، فالباحث يرى أننا، في ظل هذا الجدل، بإزاء "جيولوجيا سياسية"، وليس تعريفاً واحداً مانعاً وجامعاً. إذ الذين "ذهبوا إلى توصيفها بثورات الربيع العربي سيكون لهم من الأسباب والتقديرات ما يحملهم على ذلك. والذين مضوا إلى قراءة معاكسة نظروا إلى تلك الجيولوجيا بما هي امتداد جيو/استراتيجي لهيمنة خارجية، تتغيا تفكيك وإعادة تركيب الإقليم العربي تبعاً لمصالحها... وثمة آخرون انبروا إلى ما يتعدى التفسير المألوف للثورات والمنعطفات الكبرى، فنظروا إليها على أنها مصادفة تاريخية نبتت على أرض الضرورة، لكنها فاجأت الكل وأنتجت لنفسها حيزاً خارج التوقع".
بالتالي، فنحن هنا بإزاء مشكلة فهم حقيقية، بين من يرى أنها ناتجة عن تعدد الفاعلين، ومن يرى أنها حصيلة واقع مضطرب، ومن يذهب لحد اعتبارها متأتية من طبيعة التصدعات المجتمعية، التي "افترضتها حقبة انتقالية دولية شديدة التعقيد، وممتلئة بعوامل متناقضة من الفوضى والاستقرار وعدم اليقين".
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الكاتب يسلّم بأنه مهما يكن من تباين في الفهم والمقاربة، أو من تضاربهما في العديد من الأحيان، فإنّ "زمناً عربياً مستحدثاً راح يشق مجراه، وهو محمّل باحتمالات ووعود وآمال شتى"، بل وبمفارقات كبرى من قبيل التوحد "العصبي" لمواجهة الاستبداد، مقابل تفرق الرؤى والتصورات المتعلقة بهويّة النظام الذي تتطلع إليه ثورة الشارع.
ولذلك، يلاحظ الكاتب أنّ وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة بمصر، هو ترجمة حقيقية لإحدى هذه المفارقات: مفارقة جماعة تواجه الاستبداد مع الجماهير بالميادين (وإن بتأن وترتيب مسبقين)، وفي الآن ذاته، تصل إلى سدة الحكم (بالمصادفة الماكرة ربما) وتبدأ في إعادة صياغة هويّة النظام، في سياق لم يكن أحد يتصور "مشهد النهاية الذي سوف ترسو عليه حركة الشارع، لا شباب الثورة ولا الجهاز الإيديولوجي لتيار الإخوان".
إنه سياق تحكمه تجاذبات السياسة والإيديولوجيا بامتياز، يقول الكاتب: إنّ "ما تحوزه الأجهزة الإيديولوجية من قدرات في احتواء الجماهير وتوظيف انفعالاتها تمتد إلى النقطة التي يصبح فيها العقل عبداً لمقتضيات السياسة، أي للغاية الفعلية التي يسعى إليها المتحيز في نضاله السياسي، وهي الحضور الفعال في خارطة التوازنات، وصولاً إلى المشاركة في السلطة أو السيطرة عليها".
كلّ هذا ليبرهن الكاتب على مدى قدرة الفعاليات المحصنة بالفكر الإيديولوجي على "الإحاطة بالشروط الداخلية للحراك، ومن ثمة احتواءه بالكامل على نحو متدرج"... لا بل والتهام كل ما هو أدنى وأقل قوة وتنظيماً منه.
ولذلك، يرى الكاتب أنّ شباب الثورة في مصر قد أنجز في ميدان التحرير "ما كان ينبغي على الجهاز الإيديولوجي والتنظيمي للإخوان أن ينجزه، حتى يتسنى له إدارة الانتقال المعقد من الشارع الملتهب إلى القصر الرئاسي". بالتالي، فإنّ الذين تحيزوا للجانب الإيديولوجي هم من كان في ضفة الصواب، استيعاباً للمقولة التي مفادها: "أنت متحيز، فهذا معناه أنك حاضر في الزمان، وأنك قابض على ناصية أمرك، مهما انقلبت الموازين أو اختلت شروط المواجهة".
ـ وفي دراسته عن "الخطاب الإعلامي ودوره في تحويل الثورات إلى فتن"، يقول جورج قرم: إنه "مع تكاثر التحليلات المركزة على عنصر تفسيري واحد، ديني أو مذهبي أو لغوي أو قبلي/عشائري/عائلي، لما يحدث في بعض الساحات العربية من ظواهر عنف متواصلة، يرسخ عند الناس أكثر فأكثر جو الفتنة والعنف، الذي تولده كثافة مثل هذه التحليلات، خاصة من خلال وسائل الإعلام البصرية".
ويتابع الكاتب، وهكذا أصبحت "قضية الثورة في البحرين قضية شيعة يناهضون سُنّة، وفي اليمن، زج بالقاعدة وأخواتها، وبالقبلية والاختلافات بين الشمال والجنوب، وقبل ذلك قضية الحوثيين كفرقة دينية افترض أنها تحت النفوذ الإيراني المعادي للعرب السنّة. وفي ليبيا، يحلل الصراع على أنه صراع مزمن للقبيلة وللإقليمية بين غربها وشرقها، وفي السعودية تفسر الاحتجاجات الشعبية في شرق البلاد على أنها قضية أقلية شيعية، وفي سوريا قضية أقلية علوية مقابل أغلبية سنية مغلوبة على أمرها، وأقلية مسيحية خائفة..."، وهكذا.
كل هذه التحاليل الاختزالية المبسطة لأوضاع جد معقدة، تحول، بنظر الكاتب، دون النظر إلى القضايا الجوهرية، وتحجب الرؤية عن القوى المختلفة المعادية للتغيير محلياً وخارجياً، "العاملة لتخريب مسار الثورات العربية، وسلاحها الوحيد والفتاك هو إثارة النعرات القبلية والطائفية".
ويبدو للكاتب هنا كما لو أننا بتنا "نحول بأيدينا الثورات الشعبية الجديدة، التي اندلعت منذ سنة 2011، إلى فتن بين أبناء الشعب الواحد، وذلك بتأثرنا بالتقاليد الاستشراقية التي لم تنظر إلى المنطقة العربية إلا عبر قبائلها وأديانها ومذاهبها ومجموعاتها العرقية أو اللغوية".
إنّ القضية الرئيسة، بنظر الكاتب، ليست قضية مسيحيين أو سنة أو دروز أو شيعة أو علويين، بل هي قضية "الحفاظ على التعددية الدينية والمذهبية العظيمة التي امتازت بها على مر العصور المجتمعات العربية وبعض المجتمعات الإسلامية الأخرى".
لذلك، يرى أنّ "امتلاء الجو الإعلامي والتحاليل السياسية باختزال ما أصبح يعتري الأوضاع الثورية العربية من ظواهر العنف ومن الخوف على أنها قبلية وعرقية وطائفية ومذهبية، هو بالفعل امتداد لما يحصل في منطقتنا العربية والشرق أوسطية، من فتن فتاكة بين أبناء المجتمعات العربية المختلفة، لصالح قوى الهيمنة الخارجية والقوى المحلية المحافظة والمتحالفة مع الخارج".
ويطالب الكاتب في ختام ورقته بضرورة "وضع شرعة شرف في الإعلام العربي ولدى المثقفين، بألا تتوغل في منظور تحليلاتهم ونظام إدراكهم التقسيمات الاستشراقية، عنصرية الطابع للمجتمعات العربية، والإشكاليات الغربية حول الأقليات العرقية والدينية والتعدد الحضاري في المجتمع الواحد، بل من واجب المثقف والمحلل الإعلامي أن يركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية وعلى كبت الحريات"، وهي العوامل الرئيسة المولدة لظروف العنف في مجتمعاتنا العربية، والذي قد يترجم في بعض الأحيان وبعض المناطق الجغرافية إلى أعمال شغب وقتل، تظهر في لباس طائفي أو مذهبي أو ديني أو عرقي.
ـ وفي دراسته الموسومة "الإسلاميون بعد الثورات: النموذج المؤجل"، يقول طلال عتريسي: "لم تكد صناديق الاقتراع في تونس ومصر تفرز، بعد الإطاحة بالرؤساء، غلبة إسلامية إخوانية وسلفية واضحة، حتى انهالت الأسئلة على الإسلاميين كافة، خصوصاً ما يتصل بطبيعة الحكم، وبمدى تقبل الإسلاميين للآخر، أو بالمخاوف من تطبيق الشريعة التي رفع لواءها بعض قادة السلفية في مصر. هكذا تحولت النقاشات ما بعد الثورة إلى أولويات ما سيفعله الإسلاميون بالبلاد والعباد".
إنّ أولويات الإسلاميين (حسب ما يؤكدون) هي أولويات داخلية، "لا فرق في ذلك بين الاتجاه الإخواني، الذي يريد البحث أولاً عن حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس الدولة والمؤسسات، وبين الاتجاه السلفي الذي يريد أولاً تطبيق الشريعة".
لكن هؤلاء لن يستطيعوا ذلك بسهولة، يقول الكاتب، ليس فقط لعدم تمرسهم في الحكم، ولكن أيضاً لأنّ بقايا النظامين السابقين، في مصر وتونس تحديداً، ستكون حجر عثرة أمامهم، لن يتسنى لهم اقتلاعها نهائياً في المدى المنظور.
إنّ التشكيك الذي يقابل به الإسلاميون بجهة طبيعة السياسات التي سيعتمدونها، لا يوازيه إلا تأكيدهم على أنهم يريدون تطبيق الشريعة التي تخشاها بعض الاتجاهات السياسية والاجتماعية والدينية، وأنهم سيعملون ضمن حكومات ائتلافية، و"أنهم لن يفرضوا الحجاب ولن يمنعوا الخمور ولا ارتياد الناس أو السياح المسابح أو الملاهي، وأنهم سيعملون على قاعدة المواطنة مع الأقليات الدينية".
إنه "النموذج" الذي ما فتئ الإسلاميون يقدمونه ويؤكدون عليه، لكن بين الذي جرى منذ كتابة هذه الدراسة (قبل إزاحة الإخوان بمصر وتراجع قوة حركة النهضة بتونس) قد أطاح به، ليبقى بالتالي "نموذجاً مؤجلاً" ولو إلى حين.
ـ أمّا في دراسته "الثورات العربية ورهانات المستقبل"، فينطلق حسن جابر من المقولة التي تتردد دائماً، والتي مفادها أنّ "منطق التاريخ يفترض انهيار الاستبداد، وقيام بدائل عنه تتمتع الشعوب فيه بجرعة أكبر من الحرية". وقد تم البناء على هذه المقولة للخلوص إلى معطى أنّ "الأنظمة العربية التي تشهد حراكاً شعبياً آيلة حتماً إلى السقوط".
إلا أنّ الكاتب يرى أنّ هذه المقولة ليست دقيقة ولا هي بالثابتة، إذ تختزن حركة التاريخ في نظره "الكثير من العناصر الغامضة والمستترة التي قد تحدث المفاجأة وتحرف المسار".
ويتابع الكاتب أنّ مطلب الحرية يتماشى ومنطق التاريخ، على الرغم من المشاق التي تتكبدها الشعوب لإدراك ذلك. لكن الخطر في رأيه هو "أن تنتشر الجماعات التي لا تقرّ بالحريات العامة إلا بمقدار ما تؤمن به، وأن تتمكن من الوصول إلى السلطة في الأقطار العربية التي شهدت مؤخراً تحولات سياسية".
ومردّ التخوف هنا، برأيه، متأت من أنّ "هذه الجماعات الدينية لا تحمل مشروعاً إسلامياً مفتوح الأفق على الاجتهاد المعاصر. فهي إلى اليوم، ما تزال أسيرة تصورات فقهية وكلامية تنتمي إلى قرون الانحطاط وعصور التأزم السياسي".
هذا الجمود لا يطال التيارات السلفية/التكفيرية فحسب، بل يمتد حتى إلى الحركات الإسلامية المعتدلة، التي "وإن كانت تختلف اجتهادياً مع الجماعات المتشددة، إلا أنها تشترك معها في عدم زخرفة مقولات السلف الفقهية وتبجيلها".
صحيح أنّ خطاب التيارات الإسلامية لم يعد يتحامل على الحرية وعلى الديموقراطية، بل جعل من حرية التعبير والتداول على السلطة إحدى شعاراته، لكن الكاتب لا يرى في ذلك سوى كونه نوعاً من البراغماتية، إذ لم تخضع التيارات إياها مراجعة شاملة لأدبياتها وطبيعة مرجعياتها.
ومع أنّ هذه الدراسة قد صيغت قبل الانقلاب على الإخوان بمصر وتقهقر حركة النهضة بتونس، فإنّ الكاتب كان يدرك جيداً أنّ "الكباش على المنطقة قوي وقاس، وقد يزداد حدة في المدى المنظور، قبل أن تنجلي المعركة وتتبين الخسائر والأرباح".
وهو استشراف لا يخلو من دقة، بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع المنطقة العربية، التي طالها "الربيع العربي" أو التي لم يطلها.






