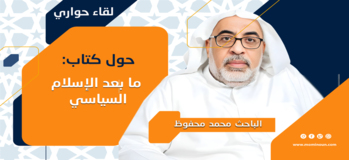حوار مع الدكتور ساري حنفي
فئة : حوارات

حوار مع الدكتور ساري حنفي
"هناك قيمٌ كونية ناقشها البشر وأقرّوها. وحين نقول "ناقشها البشر"، لا يعني أنها لم تكن مستوحاة من القيم الدينية أو من العقائد الكبرى، بل يعني أنها أُخذت في الحسبان من مختلف الثقافات"
د. حسام الدين درويش:
مساء الخير للجميع، مساء الخير دكتور ساري حنفي، ومرحبًا بكم في لقاء جديد ضمن سلسلة لقاءات مؤسسة "مؤمنون بلا حدود".
الدكتور ساري حنفي، غنيٌّ عن التعريف، بل من أغنى الأغنياء عن التعريف، وسيكون التعرف عليه من خلال مضامين كتاباته وفكره.
هو أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومدير مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، ورئيس برنامج الدراسات الإسلامية. له مناصب عديدة؛ رئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع، وكان رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، وقد حصل على جوائز وتكريمات كثيرة، وكرّمت الجوائزُ والتكريماتُ نفسها بحصوله عليها. فمرحبًا بك دكتور ساري، وشكرًا جزيلًا على تجاوبك مع الاستضافة.
دعني أبدأ بملاحظة شخصيّة، لكنها في الحقيقة ملاحظة عامة: كلّ من يعرفك، حتى من بعيد أو ممن اطلع على نشاطك، يشعر بالذهول من "فرط نشاطك". ما شاء الله، لك حضور عالمي، وعربي، وفلسطيني، وسوري أيضًا. فما الذي يمكن أن نقوله عن الحافز أو البعد المعرفي أو الأسباب الفكرية التي دفعتك إلى كل هذا النشاط، وإلى هذه التوجهات العالمية، والمحلية، والعربية، سواء من ناحية أكاديمية أو في المجال العام أو في التدريس، إلى غير ذلك؟ تفضل.
د. ساري حنفي:
شكرًا جزيلًا، أولًا على الدعوة، وشكرًا لك حسام. دعونا نضع الأسماء بلا ألقاب. في الحقيقة، علم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية كان همًّا قبل أن يكون مهنة؛ بمعنى أنني بدأت بدراسة الهندسة المدنية، وفي الحقيقة أنهيت دراسة الهندسة. نشأتُ في عائلة تحت خط الوسط، لاجئة فلسطينية في دمشق، في مخيم اليرموك. ودخولي إلى الفضاء الفكري والعلوم الاجتماعية لم يكن بحثًا عن مهنة، بل كان بحثًا عن حلّ لإشكاليات شعرتُ بها في داخلي. في بداية الثمانينيات، كانت سوريا مشتعلة. كان هناك مجتمع مدني تحت الأرض، وكان هناك العديد من الأحزاب غير الشرعية، وفي المقابل، قمع واستبداد. صديقنا ياسين الحاج صالح يسميه "التوحش"، وأنا أعدّه فعلًا "التوحش الاستبدادي". وبتقديري، فإن الحالة العراقية والسورية تمثل استثناءً بين الاستبدادات العربية الأخرى. نشأت في أسرة متديّنة، وانفتحت على فضاءات نضالية فلسطينية أو سورية معارضة، ما أغنى تفكيري بشدة، حيث كنت أستمع إلى الرأي والرأي الآخر، وشعرت أنه عليّ أن أنجز "الأطروحة" بطريقة هيجلية؛ أي أن أصل إلى التركيب. وفي الحقيقة، أنا أحبّ مهنتي، حتى إذا ذهبت إلى نزهة، أتشوق متى أعود كي أقبض على كتاب، أو أبدأ بالقراءة أو العمل، كما نقول بالإنجليزي out of love؛ فهذه هي مهنتي التي أحبّها، ولديّ شعور بالواجب تجاهها. وأودّ أن أقول شيئًا بسيطًا هنا: أستغرب من بعض أصدقائي الذين ينشرون فقط من أجل الترقية.
وبما أني ذكرت أنني رئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع، فقد كنت أتلقى مقالات لأصحابها يريدون الترقية، أنا شخصيًّا لم أشعر يومًا أنني أنشر من أجل الترقية. قال زميل لي، زميل في الجامعة الأمريكية ذات مرة: "أنت لا تنشر فقط، بل تفضحنا، تنشر أكثر منا بكثير."
د. حسام الدين درويش:
يرتبط هذا بمسألة بحثت فيها سابقًا، في كتابك "البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة". ففي سوريا، مثلًا، الحصول على الدكتوراه غالبًا ما يُعد نهاية البحث العلمي، وليس بدايته. حتى الترقية تبدو مسألة شكلية، وكذلك هو حال النشر للحصول عليها. فإلى أي حدّ نحتاج، لكي يكون لدينا بحث علمي عربي، وإنتاج معرفي حقيقي، إلى هذا "الشغف" الذي تحدثت عنه؟ أم إن للمسألة أسبابًا بنيوية ومؤسساتية تتجاوز هذه المسألة؟
د. ساري حنفي:
أتذكر حتى الآن الدكتور محمد صفوح الأخرس، رحمه الله، والذي عملت معه قبل أن أنهي دراستي في علم الاجتماع. كان يفتخر بأنه لم يقرأ شيئًا بعد الدكتوراه، وكأنه يقول لنا إن علمه لدنّي، نازل من السماء مباشرة! وكان يرى أن كل النظريات الجديدة أشياء معروفة، ولا ضرورة لقراءتها. وهذا أمر مذهل في الحقيقة. واليوم، مثلك يا حسام، نزلت إلى سوريا بعد "التحرير"، ورأيت وضع العلوم الاجتماعية، وخاصة علم الاجتماع، فوجدت أنه يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ؛ لأن الاحتكاك بالإنتاجات الأكاديمية الحديثة ضعيف جدًّا.
ربما كلمة عن كتاب "البحث العربي ومجتمع المعرفة"، الذي ألّفته مع صديقي الفرنسي ريغاس أرفانيتيس: تضمّن الاشتغال عليه لأول مرة، دراسات ببليومترية؛ أي تحليلات لوضع الإنتاج المعرفي العربي، مع حفر في بعض البراديغمات في العلوم الاجتماعية تحديدًا، ثم انتقلنا من خطاب ما أسمّيه "خطابات حائط المبكى"؛ أي ذلك الخطاب الذي يردد: "لا نملك إمكانيات، لا نملك جامعة، لا نملك مكتبة، لا نملك... لا نملك"، لكن أقول: لا، هناك شيء يمكن للفرد أن يفعله حتى في سياق مؤسساتي صعب. مثلاً في سوريا، رغم الاستبداد، ورغم أن كل أساتذتنا قبل أن يصبحوا أساتذة كانت الموافقة عليهم تمرّ عبر تقارير أمنية. تمكّنت جامعة دمشق من أن تُخرج حسام الدين درويش، واستطاع صادق جلال العظم، رحمه الله، أن يقوم بالمناورات يمينًا وشمالًا، وكذلك أسماء أخرى كثيرة، غانم هنا، رغم أنهم ليسوا كثيرين في الحقيقة. حتى الدكتور خضر زكريا، وكنت قد أجريت معه "بودكاست" ضمن سلسلة "أثر"، قال لي صراحة إن الوضع كان صعبًا جدًّا، وإنهم كانوا يقدمون تنازلات، واعترف بذلك.
أفتح قوسين كذلك هنا، لأقول: عندما كنت مسؤولًا عن المنطقة العربية في "نشرة حوار كوني"، وهي نشرة للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، حاولت أن أتواصل مع مصطفى التير، وهو أستاذ مرموق في ليبيا، أستاذ في علم الاجتماع، وسألته: كيف يمكن إنتاج المعرفة في ظلّ نظام القذافي ومخابراته وعملائه والمندسّين يمينًا وشمالًا إلى آخره؟
وفي الحقيقة، أتذكر أن هناك أكثر من عشرين رسالة إلكترونية تبادلناها، قبل أن يتحرر من الخوف، ويقول شيئًا في العلن. كيف يتحول علم الاجتماع مثلًا إلى علم اجتماع يوازي دراسات "البزنس" أو الاستهلاك؟ يعني، ماذا تفضل في لون المحارم مثلًا؟ كيف تنتج معرفة من هذا النوع من دون اقتصاد سياسي؟ من دون علم اجتماع سياسي؟ وفي الحقيقة، أحيانًا ينتج شيئًا يبدو كاريكاتوريًّا. وعند غياب الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع السياسي، يتحول الطرح إلى "ثقافوي". لذا، فهذه الموجة الثقافوية التي عاشها العالم العربي، سواء الذين يقولون إن الحل هو في التراث، أو الذين يقولون إن المشكلة هي التراث، ويجب التخلص منه. وأنت يا حسام كتبت كثيرًا في هذا الموضوع بصراحة، وفي هذه النقطة نحن متقاربان جدًّا في حساسيتنا ضد "الثقافوية"، بلا شك.
د. حسام الدين درويش:
من أهم الثنائيات في العلوم الاجتماعية، وفي علم الاجتماع تحديدًا، مسألة البنية وفاعلية الذات Structure and Agency، فأنت في حديثك عن مجتمع المعرفة والمجتمع العربي والإنتاج المعرفي العربي، تعترف بوجود إشكالية مؤسساتية بنيوية: قانونية، سياسية، مؤسساتية... إلخ، ومع ذلك، تشدّد على أهمية "الفاعلية الذاتية"؛ أي إنه لا يجوز إلغاء دور الفرد. فكي لا يتذرّع الناس بأنهم ضحايا فقط، ويتم إلغاء الذات، والمسؤولية، والفاعلية، برأيك: هل هناك حقًّا إمكانية لذلك؟ المقارنة صعبة مثلًا بين وضع سوريا ووضع المغرب، أو بين مختلف البلدان العربية. إلى أي حد ترى أنه، بالفعل، إذا أراد الأفراد، استطاعوا أن يفعلوا شيئًا ويحققوا نتائج؟
د. ساري حنفي:
طبعًا، في رأيي، ما معنى الاستبداد وما تأثيره على ما ندرسه؟ وكيف ندرّسه؟ والمناهج التي نستخدمها؟ وهل يمكننا إجراء فحص للرأي العام؟ كل هذا، في رأيي لأمد طويل، جعل من دراسات الرأي العام، أو ما يُسمى "الشارع"، في العالم العربي، دراسات تحليلية ضعيفة جدًّا؛ لأننا، في الحقيقة، لسنا متأكدين من ثبوتية المنهجية ومصداقيتها. ما معنى أن يجيب الناس عن الأسئلة؛ هل لأنهم أحرار في الإجابة أم لأنهم يخافون من الإجابة؟ لذلك، فإن تأثير البنية تأثير مهم جدًّا. والباحث الجيد، في رأيي، هو الذي يستطيع أن يوازن بين البنية والمشيئة الذاتية أوما أسميته بـ"الفاعلية الذاتية". والتوازن هنا لا يعني بالضرورة أن يكون بنسبة 50% و50%، بل أحيانًا، في ظروف معينة، قد تتحول البنية إلى 90% والفاعلية الذاتية 10%، أو العكس. خصوصًا عندما يُكسر حاجز الخوف، كما رأينا في الربيع العربي، حيث تحوّلت إرادات الأفراد، خاصة الشباب الذين كانوا يقرؤون بصمت في بيوتهم، إلى شيء فعّال ومؤثر. وفي الحقيقة، إذا سألتني عن رأيي في سوريا، فأنا مذهول كيف أن سوريا خرّجت منها، خلال عشر أو أربع عشرة سنة، طاقات فكرية وفنية. لقد كان الاستبداد، في بعض الحالات، حافزًا أكثر منه مثبّطًا. وهذه مسألة مهمة، وتستحق دراسة بعيدة عن النمطيّات، التي تقول مثلًا، إن الاستبداد لا ينتج سوى إنسان خانع.
د. حسام الدين درويش:
فكرك كلّه دائمًا يبدو لي جدليًّا؛ بمعنى أنه يتناول قطبين، ويعمل إما على تجنبهما أو على الجمع الجدلي بينهما. وفي السياق ذاته، أتذكّر في إحدى النشرات أو الرسائل الشهرية - لا أذكر بالضبط - التي كنتَ تكتبها، بصفتك رئيس الجمعية العالمية لـ "حوار"، كان لك فيها خطاب تحدثت فيه عن التدخّل الخارجي والإمبريالية والكولونيالية، ووجهتَ نقدًا شديدًا لها، لكنك لم تهمل العوامل المحلية؛ أي الاستبداد المحلي. فأحيانًا لا نعرف كيف ننقد الخارج دون أن نبرّئ الداخل.
د. ساري حنفي:
هذه، في رأيي، نقطة شديدة الأهمية، وهي التي تشكل جوهرًا نقديًّا لخطاب ما بعد الكولونيالية، وحتى الخطاب الديكولونيالي، الذي لا يرى الكولونيالية إلا من خلال منظرين من أمريكا اللاتينية، والكولونيالتي يمكن أن تكون من الداخل وليس من الخارج. في لحظة من اللحظات، تحوّل جزء كبير من اليسار العربي، وغير اليسار أيضًا، وحتى بعض الإسلاميين، إلى رؤية لا ترى سوى التأثير الإمبريالي الخارجي. وبالتالي، صاروا يضعون معادلات تبسيطية، من نوع: حافظ الأسد أو بشار الأسد ضد أمريكا وإسرائيل، إذن هما في معسكر الخير، والثورة ضدهما إذن هي معسكر الشر أو الإمبريالية، وهكذا. وهذا منتهى الصفاقة. أتذكّر، مثلًا، هنا في لبنان، كلّما التقيت بأحد "الممانعين"، يذكر لي مثالًا عن البنّي - الذي تحدّث مع الإسرائيليين أو دعا إلى التطبيع. لكن كم يمثّل هذا الشخص من الحالة الثورية السورية؟ ربما 1% فقط. بالعكس، هذا يُعدّ شرفًا للثورة السورية، أنها تتضمّن هذا القدر من التنوّع، وتحتوي أصواتًا شديدة التطرّف، دون أن تُقصيها، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، فهي نزعة "ماويّة" في خطاب ما بعد الكولونيالية، التي تتطلب التفريق بين التناقض الرئيس والتناقضات الثانوية.
- ماو تسي تونغ كان محقًّا، عندما طبّق هذه النظرية لفترة محددة - سبع سنوات تقريبًا، خلال مرحلة تحرير الصين، حين تحالف مع البرجوازية الصينية ضد الاستعمار الياباني وغيره. لكن لا يمكننا أن نبقى أسرى هذا التحليل سبعين عامًا، فنقول مثلًا إن حقوق المرأة هي تناقض ثانوي؛ لأن هناك تناقضًا قوميًّا أساسيًّا. ومن ثم، فالتحليل الزمني له وجاهته ضمن فترات قصيرة. أما على المدى الطويل، فلا معنى له. الأمر نفسه، كتبته في دراساتي حول الهجرة القسرية واللاجئين الفلسطينيين.
لا يمكن أن نتعامل مع اللاجئ في فترة قصيرة. في دراسات الهجرة القسرية، يتحدثون عن عشر سنوات، لكن ماذا عن لبنان، حيث هناك أربعة أجيال فلسطينية تعيش من دون حق في العمل أو التملّك؟ ما معنى أن يُحرَم الفلسطينيون في لبنان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؟ بكلّ جرأة وصراحة، كما للمواطن اللبناني. أحيانًا نلوم الحكومة الألمانية مثلًا على تشديدها في ملف طالبي اللجوء، بينما نحن لدينا أربعة أجيال في لبنان تعيش من دون حقوق أساسية! أنا أعتبر حق العمل مثل الهواء تمامًا. وأحيانًا أجادل زملائي اللبنانيين في هذا الأمر، فيقولون إن الفلسطينيين شاركوا في الحرب الأهلية. أقول لهم: نعم، شاركوا، نصفهم ضد النصف الآخر، ولكن هذا لا يُبرّر أن يُمنع عنهم الهواء والماء والغذاء!
د. حسام الدين درويش:
الغريب أن هناك من لا يزال يجادل في هذه المسألة. وفي السياق نفسه، وهي مسألة الجمع بين الثنائيات، فإن من يعرفك، ومن يقرأ كتاباتك، يلاحظ دائمًا هذا الجمع بين طرفين، ما يُظهر انقسامًا أيديولوجيًّا، وهي مسألة الكونية والعالمية من ناحية، والخصوصيات من ناحية ثانية. لكنها أيضًا هي إشكالية نظرية في العلوم الاجتماعية؛ أي كيف يمكن للكوني أن يكون محلّيًا؟ وكيف يمكن أن يكون كونيًّا دون أن يكون مركزيًّا أو تعبيرًا عن مركزية ما؟ بصراحة، كيف واجهتَ هذه الإشكالية بطرائق مختلفة، سواء نظريًّا وعمليًّا؟ وكيف ترى إمكانية التوفيق بين هذه القيم الكونية التي تدعو إليها وتمارسها وتُنظّر لها، من جهة، ومن جهة أخرى الخصوصية التي قد تكون أحيانًا مخيفة أو تهدّد بابتلاع الكوني؟
د. ساري حنفي:
تمامًا. أول شيء في الحقيقة، لا أرى إمكانية لوجود علم من دون مفاهيم كونية. يوجد شيء اسمه "سوريولوجيا"؛ (علم لسوريا(، أو "لبنانولوجيا" أو "فرنسولوجيا"، لكي يكون هناك شيء علمي، لا بد من وجود تفكّر يتجاوز الحالة المدروسة. ولذلك، فإن أهمية المفاهيم في العلوم الاجتماعية، مثل الطبقة الاجتماعية، ما معنى الأسرة، وغيرها من المفاهيم المهمة، حيث نبدأ بتعريف الكوني، ثم ننزله على واقع ما. المشكل الأعقد يكون في موضوع القيم، مثل حقوق الإنسان. القيم مهمة جدًّا. علينا أن نعتبر أن هناك قيمًا كونية ناقشها البشر وأقرّوها. وحين نقول "ناقشها البشر"، لا يعني أنها لم تكن مستوحاة من القيم الدينية أو من العقائد الكبرى، بل يعني أنها أُخذت في الاعتبار من مختلف الثقافات. يجب ألا ننسى أطروحة الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز حول "العصر المحوري "(Axial Age)، الذي التُقطت فيه قيَمٌ من أديان مختلفة، وشكّلت أساسًا لفهمنا لبعض المفاهيم، مثل الكرامة، والمساواة، والحرية، وغيرها. أنا شخصيًّا عندما أطلع على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"- وهو أحد تجليات الكونية- أصاب بدهشة: كيف تمكّنت الإنسانية من التوصل إليه في سنة 1948؛ أي بعد أربع سنوات فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية، حرب فيها الهولوكوست، وأبشع ما يمكن للإنسانية أن تراه من عنف. كيف استطاعت أن تجتمع مع بعضها، اجتمع الاتحاد السوفيتي، بحساسيته للمساواة الاقتصادية، مع الولايات المتحدة، مع الكوبيين، ومع شارل مالك من لبنان، وهو مقرر لجنة الصياغة، واتفقوا جميعًا على الإعلان على حقوق الإنسان، ووقّعت عليه كل الدول تقريبًا، مع بعض التحفظات، يمينًا ويسارًا، وهي تحفظات تكشف لك حجم المفارقات، منها ما هو مثير للسخرية. فمثلًا، كان الاتحاد السوفيتي ضد حرية التنقل؛ لأنه - كالنظام السوري في عهد الأسد - يشترط تأشيرة خروج للمواطن. وأنا من الأشخاص الذين كان حصولهم على تأشيرة خروج أمرًا معقدًا للغاية؛ لأن المملكة العربية السعودية في عام 1948 لم تكن مستعدّة لإنهاء العبودية، وإلى آخره؛ أي إن الاستثناءات تؤكّد أهمية كونية حقوق الإنسان. وفي الحقيقة، كيف لنا، - وأنا أتكلم هنا كفلسطيني - أن أطلب تضامن الآخرين معنا دون أن تكون هناك لغة كونية مشتركة بيننا وبينهم؟ وأود أن أذكر هذه الحادثة: قبل سنة ونصف كنت في زيارة للدوحة، وكنت أتصفح بريدي الإلكتروني، فوجدت دعوة لحضور ندوة للمفكر الفلسطيني الكبير وائل حلاق. ذهبت إلى المحاضرة، وكان في الحقيقة يتحدث عن العالم العربي بخطاب - دعني أقول - هو ذاته الخطاب الذي يطرحه في كتابه "الدولة المستحيلة"، من حيث نقده للغرب، واعتباره أن الدولة الغربية بلا أخلاق، وإلى آخره. واكتشفت أن أصدقاءً لي، كم أن وائل حلاق مهم بالنسبة إليهم؛ إذ يستمعون إليه كثيرًا، حيث أرسلوا لي لاحقا عبر "الواتساب"؛ لأنهم كانوا يتابعون المحاضرة على الإنترنت، وقالوا لي: كيف تجرأت أن تقول له كذا وكذا؟
قلت له بالحرف، ويمكن للمستمعين الرجوع إلى "يوتيوب"- كانت المحاضرة ضمن دائرة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن خليفة، قلت له: "أستاذ وائل، كيف تريدني أن أقتنع بأنني، كفلسطيني نشأت في سوريا، لا ينبغي أن أقول إن التعذيب أمر غير إنساني؟ كيف تحرمني من قدرتي على قول ذلك؟ بالنسبة لي، الكونية تعني ألا يكون هناك تعذيب. أنت تتحدث كيف يقشر العنب، وأنا أتحدث عن العنب ذاته، كجائع". لذلك، فإن أهمية الكونية، بالنسبة لي، أمر بالغ الأهمية.
في الوقت ذاته، في عملي الأخير، وخاصة في نقدي لكيفية خيانة الليبراليين اليوم لبعض القيم الليبرالية الأساسية - وخصوصًا الليبرالية السياسية - أقول نعم: القيم الإنسانية، حين تُطبّق على واقع ما، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار السياقات المعنية. يجب التفكير في كيفية تطبيقها، وكم من الوقت تحتاج للتطبيق، وربما ترتيب الأولويات. لكن ليس بمعنى أن نقول، كما في الخطاب الماوي، "انتظروا خمسين عامًا قبل تطبيقها". أنا وأنت يا حسام نؤمن أيضًا بتكاملية حقوق الإنسان؛ أي إنه لا ينبغي أن نضع الأولويات وكأننا نقول: انتظروا نصف قرن قبل المطالبة بحقوقكم. نعم، هناك كونية لحقوق الإنسان، لكن هناك أيضًا "نُظُم" لحقوق الإنسان (Human Rights Systems)، تختلف من بلد إلى آخر: في لبنان، في فرنسا، في ألمانيا، في أمريكا، إلخ. في هذه النظم، يُؤخذ بعين الاعتبار كيف يفهم المجتمع القيم، وكيف يُعرّف - بتفصيل - مفاهيم مثل الكرامة، أو حق الإنسان ألا يكون جائعًا، أو حق المرأة في المساواة، إلى آخره.
د. حسام الدين درويش:
دائمًا الخوف هو أن تتحول الكونية إلى وجه آخر أو غطاء جديد لمركزية ما، تتجاهل الآخرين وخصوصياتهم واختلافاتهم، أو أن تتحول "الخصوصية" إلى جسر لإنكار هذه الكونية. دعني أضرب مثالين واضحين؛ المثال الأول: في سوريا، صدر مؤخرًا قرار يمنع لباس السباحة المعيّن في بعض الأماكن، بحجة الخصوصية الحضارية، رغم أن التنوع في سوريا ليس مقتصرًا على وجود المسيحيين وغيرهم، بل حتى بين المسلمين أنفسهم هناك تنوّع كبير. ففرض رؤية واحدة باسم "الخصوصية" أمر إشكالي. ومشكل والمثال الثاني: في فرنسا، يُمنع ارتداء "البوركيني" على الشاطئ، أيضًا بحجة الخصوصية أو القيم الكونية. إذن، في سوريا يُفرض البوركيني، وفي فرنسا يُمنع البوركيني، والذريعة واحدة في الحالتين: الخصوصية أو القيم الكونية. وهذه ليست مجرد إشكاليات نظرية، بل مشكلات عملية حقيقية. كيف نوفّق في كلّ حالة، أو في إطار عام؟
د. ساري حنفي:
تمامًا، وأشكرك كثيرًا على ذكر هذا المثال، لماذا أنا أنطلق من اشتغال الفيلسوف الأمريكي جون رولز على الليبرالية السياسية؟ لأنه في رأيي عمل مهم، خاصة في تمييزه بين مفهوم "العدل"- الذي يجب أن يتفق عليه المجتمع- فالعدل، هو توازن بين الحريات والمساواة. فالحريات ليست مطلقة؛ يجب ألا تضرّ بالآخر، فإذا كنتَ مليارديرًا، لا يمكنك شراء حيّ بأكمله؛ لأن هذا يتعارض مع مفهوم المساواة.
أما "مفهوم الخير"، مثل: ماذا أريد أن ألبس؟ ماذا أريد أن أشرب؟ هل أريد أن أُصلّي؟ هل أريد الذهاب إلى البار؟ فهذا كله له علاقة بمفهوم الخير، ويجب على الدولة ألا تفرض مفهومًا معيّنًا للخير على الأفراد أو الجماعات. لهذا، النقد نفسه الذي نوجّهه إلى سوريا أو إلى إيران على فرض الحجاب في الشارع، يمكن أن نوجهه إلى فرنسا؛ لأنها تريد فرض مفهوم للخير على شريحة من مجتمعها. وأنا، بوصفي شخصًا عاش ربع قرن في سوريا، أعتقد أن أحد الرهانات الكبرى هناك هو ألّا تفرض الدولة "الأخلاق العمومية"؛ فهناك شيء يحدده مجتمع ما اسمه "الخير العام"، وهناك شيء اسمه "العقل العمومي" وهو مهم جدًّا؛ أي المحاججات العمومية؛ بمعنى أن الدولة أو القانون أو المجتمع يحاول أن يُقدّم مبرّرات أخلاقية تُرضي الجميع، أو الغالبية المطلقة، بشيء عام يمكن تسميته "خيرًا عامًّا". مثلًا، من المقبول القول إنه لا يجوز أن يكون الإنسان عاريًا تمامًا في الفضاء العام؛ لأن هذا شيء إنسانوي. لكن من الصعب، في المقابل، أن يُفرض مبدأ ديني على الجميع، بما في ذلك غير المتدينين أو المسيحيين أو غيرهم. لهذا، في الليبرالية السياسية، العملية الحِجاجية أهم من النتيجة. فبعض العمليات الحجاجية قد تؤدي إلى تضييق على حريات فئة معينة، لكن إذا كانت مبرّراتها معقولة. مثلا في الحريات الاقتصادية كثير من القوانين التي تُسنّ عبر البرلمان، تمثّل المجتمع، وتقيّد حريات بعض الفئات الاقتصادية. وهذا طبيعي؛ لأنه تم بناءً على محاججة أخلاقية.
د. حسام الدين درويش:
يعني تمثل الخير العام، لا خيرًا خاصًّا لمجموعة معينة. في هذا السياق، اسمح لي أن أنتقل إلى الثنائية بين "الإسلامية" و"الليبرالية"، وهي التي تعالجها في كتابك الأخير. أنت ليبرالي ناقد لليبرالية، ويمكن للمرء أن يقول أيضًا إنك "إسلامي" ناقد للإسلامية؛ بمعنى أنك لا تمثل لونًا واحدًا، ولا تتحزّب لطرف على حساب آخر. هذه كلها، كما نلاحظ، ثنائيات تتكرر في شخصك وكتاباتك: الكونية والمحلية، الدين، والقيم الليبرالية، إلخ. وربما يكون هذا مدخلًا مناسبًا للحديث عن النقد الأساسي الموجّه إلى الليبرالية من منظور ليبرالي؟
د. ساري حنفي:
شكرًا جزيلًا على هذا السؤال. أول شيء، حين كنت في فرنسا، كنت في الجامعة، وكان هناك العديد من المجموعات، وكانت مظاهرات، وكانت هناك ندوات تعرّفنا من خلالها على قضايا كثيرة، مثل المستعمرات الفرنسية، كجزر الكناري وغيرها. كنت متعاطفًا جدًّا معهم، وكنت متعاطفًا كذلك مع الأكراد، وما زلت، بوصفهم مجموعة تم قمعها ثقافيًّا وسياسيًّا، وغير ذلك وبالطريقة نفسها، أرى نفسي إنسانًا مسلمًا، وأحترم الدين الإسلامي وأمارس كثيرًا من شعائره. وفي الوقت ذاته، أتعاطف مع بعض الحركات الإسلامية، لا من منطلق مظلومياتها، وهي كلمة لا أحبذها.
كنت دائمًا أتناقش مع إخوتي، وأقول لهم: انظروا إلى النموذج التونسي، مثلًا؛ انظروا كيف تحالف الغنوشي مع أطراف مختلفة، ولم يُصرّ على خصوصيته، وانظروا إلى التونسيين كيف كانت هناك نسب تمثيل واضحة. حين جاء قيس سعيّد، قال لي أخي الكبير: حتى صاحبك الغنوشي، مع كل التنازلات التي قدمها، لم يُسمح له بالحكم! فثمة بالفعل إشكال حقيقي. ظهر هذا حين أصبحت هناك إمكانية لانتقال ديمقراطي: هل يُسمح لجماعات معيّنة بالمشاركة في هذا الانتقال أم لا؟
أنا، في هذا السياق، حساس لحقّ أي مجموعة فكرية بأن تمارس العمل السياسي. وفي الوقت ذاته، أرى أن الفكر الليبرالي في خطوطه العريضة؛ أي كنظرية نحيلة (thin theory)، هو فكر إنساني. حتى المحافظون في كثير من بلدان العالم هم ليبراليون. هناك طرف غير ليبرالي، ويمكن تحديده وتمييزه.
ولهذا، أرى في تنظيري للكوني، أن الليبرالية أخذت شكلًا كونيًّا ما. من المهم جدًّا أن نُدرك، خاصة في علم الاجتماع، ومع موقعي كرئيس سابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، أنني تدربت على الحديث بلغة يتفاعل معها الفلبيني، والياباني، والأمريكي، والفرنسي، والعربي، وغيرهم. من المهم أن تكون هناك لغة إنسانية، اختزلتها الليبرالية بشكل ما.
لهذا، أرى - ضمن ليبراليتي - أن الليبرالية أكدت حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومن ثمة، أرى أن أكبر نصير اليوم لأيّ حركة إسلامية تطمح لأن تكون مقبولة في مجتمعات متعددة. نحن لا نتحدث عن مجتمعات مغلقة، فمجتمعاتنا كلها متعددة. اليوم، يا حسام الدين درويش، الذي تربّى في حلب، وابنك - حفظه الله- الذي تربّى في ألمانيا، إن أردتَ العودة إلى سوريا، هل من يمكن للقيادة السورية الجديدة تطبيق المعايير نفسها على ابنك؟ مثل حسام الدين الذي نقول إن بيئته محافظة حلبيّة. وهنا فالاختبار الحقيقي للحركات الإسلامية هو الأخلاق العمومية.
د. حسام الدين درويش:
النقد الموجه إلى الليبرالية انطلاقًا من الليبرالية، فكتاب "ضد الليبرالية الرمزية" موجّه ضد نوع من الليبرالية.
د. ساري حنفي:
تمامًا، النقد الرئيس لليبراليين الرمزيين، كيف أصبح الليبراليون كلاسيكيين، يدافعون عن حق التعبير، وحق الدين، وما إلى ذلك، ولكنهم يفرضون مفهومهم الخاص للخير على المجتمع. وهنا أعطي أمثلة من دول مختلفة، لكنها تتجاوز حدود تلك الدول. مثلًا، في العلمانية الفرنسية، هناك وزراء داخلية يصيغون مسودات القوانين، من منطلق أمني، ينظرون إلى المسلمين الفرنسيين - وهم في الأغلب من الجيل الرابع أو الخامس – حيث تفرض العلمانية الفرنسية مفهومها للخير على بعض الفرنسيين. في السويد، يهمش الليبراليون سلطة الأسرة، ويحولون الخدمة الاجتماعية) Social service (أو المدرسة إلى سلاح ضد الأسرة؛ إذ ينظرون إلى الأسرة كبنية اجتماعية متخلفة. طبعا، الدولة تتدخل لحماية الأطفال، وأنا هنا أذكر أمثلة دقيقة. فمثلًا، في السويد تنتقل سنويًّا حوالي 4000 حالة حضانة من أسرة إلى أخرى. وفي النرويج، النسبة أعلى، وإن كان العدد أقل. رئيسة لجنة البحث عن الأسرة، وهي ألمانية، قالت لي: "شيل السويد، وضع ألمانيا بدلًا منها، الشيء نفسه".
أرى أن هناك انحيازًا ضد الأسرة التي لا تتماشى ثقافيًّا مع السائد. في ما يخص التنوع الجندري والجنساني، الذي أرى أن القبول به حدٌّ أدنى من العدالة، وأنت اشتغلت عليه حسام كثيرًا، التمييز السلبي والتمييز الإيجابي. لكنني لا أريد أن يُفرَض على الناس الاحتفاء بكل أشكال الجنسانيات. هناك فرق بين القبول والاحتفاء. للأسرة حق بأن تحتفي بشكل جنساني معيّن من العلاقات، كالعلاقة بين الرجل والمرأة، وأن تربي أولادها على ذلك، من دون ممارسة العنف عليهم، وتبقى ضمن المظلّة العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
د. حسام الدين درويش:
دعني أقول إن المسألة ترتبط بكتابك السابق، والمتعلق بتجاوز القطيعة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية. فهو يأتي ضمن إطار أوسع، يرتبط أيضًا بعلاقة العلمانية والإسلام، أو الديني واللا ديني، سواء على المستوى السياسي أو المعرفي. في كتابك، تركز على المستوى المعرفي. لكن إلى أي مدى ترى أن هناك، في العمق، إشكالية نظرية حقيقية بين الطرفين: بين الديني والعلماني أو اللاديني؟ أم إن هذه الإشكالية زائفة أو مصطنعة أو ربما مبالغ فيها، حيث تُعمي عن قضايا أخرى أكثر إلحاحًا وواقعية؟ في ضوء معالجتك المعرفية في هذا الكتاب، ما مدى واقعية هذه المشكلة برأيك؟
د. ساري حنفي:
العلاقة بين العلمانية والديانية هي إشكالية حقيقية. إذا فهمنا العلمانية كتمايز بين الديني والسياسي؛ أي الحيادية النسبية للدولة؛ إذ لا يوجد حياد كامل، فالدولة ملزمة بالدفاع عن الحد الأدنى لبعض القيم. وبهذا المعنى، هناك تعارض مع بعض المفاهيم لدى بعض الحركات الإسلامية التي ما زالت ترى في مخيالها أن الأخلاق العمومية يجب أن تُفرض على الشارع والفضاء العام.
في المقابل، ما أراه في العالم العربي هو تبنٍّ غير مُمَوْضَع (غير مُبَيَّأ) لعلمانوية فَرَنْسِيّة متشددة، تتحوّل إلى سياسات هوية. فيصبح العلماني مناهِضًا للدين، وهذا أمر أسمعه كثيرًا؛ إذ يسأل أحدهم الآخر: هل تصلّي؟ فيقول: "أنا علماني"، وكأنّ الذي يصلّي ليس علمانيًّا، أو العكس، كأنّ العلماني ملحد. هذا يشبه ما يُقال عن الليبرالي. وأنا ذكرت في مقدمة أحد فصول كتابي، عندما كنت أكتب عن الليبرالية، أنني كنت أستمع إلى درس ديني وضعه جارنا، وكان يشرح فيه أن الليبرالية هي الإلحاد، وغير ذلك. في الحقيقة، هناك سياسات هوية من الطرفين، لكنني أُلقي اللوم بدرجة أكبر على الطرف العلماني؛ لأنه، على الأقل، ليبراليته يجب أن تسمح باحتواء الآخر، وهذا لم يحصل. وفي الحقيقة، هذه الاستقطابات الحادّة في مجتمعاتنا العربية تحولت إلى سياسات هوية. وأكاد أدّعي أن أحد الأسباب الرئيسة التي أفشلت الربيع العربي هو كيف لجأت نخبة إلى العسكر ضد نخبة أخرى. كل هذا يعني أن هناك إشكالًا حقيقيًّا، لكنه ليس، ولا للحظة، أهم من إشكالات الخبز أو غيرها. أحيانا هناك إشكال مثل الصراع العربي- الإسرائيلي، الذي يظهر في لحظة من اللحظات كصراع يهودي- مسلم، وهذا موجود، أو مثل الطائفية في لبنان.
د. حسام الدين درويش:
أنت كما قلت بحثت عنها معرفيًّا بين علوم الشرع وغيرها، ومسألة جدل الانفصال والاتصال الذي تكلمت عنه. كيف يمكن أن تكون مشكلة زائفة أو على الأقل فيها اصطناع، أو دعني أقول إن الإيديولوجيا حين تكون علمانية أو إسلامية تكون فقيرة، فهي لا تقول لك إلى أي حد العلماني ديمقراطي أو غير ديمقراطي، يؤمن بالحريات والفردية والتعددية وحق الاختلاف، وما الأخلاق التي يتبناها. فكلمة علمانية لا تدلّك على شيء من كل ما سبق، فهي مهووسة بشيء واحد. فالاستقطاب كما في الحالة المصرية أو التونسية، يتم على حساب قيم يمكن للطرفين أن يؤمنا بها ويكون من مصلحتهما تبنيها. بهذا المعنى، تصبح المشكلة زائفة؛ لأن السؤال الأهم ليس: هل أنت علماني أم إسلامي؟ وإنما هل أنت ديمقراطي أم لا؟ هل تؤمن بالعدالة والحريات؟ من هنا، يمكن للعلماني أن يقول: "أنا لا أريد الإسلامي"، فيُقال له: "لكن إذا كنتما تؤمنان معًا بالديمقراطية، فلماذا لا تتشاركان؟"
د. ساري حنفي:
حسام، في الحقيقة، هناك باحثون مهمّون في تركيا، في علم الاجتماع والعلوم السياسية، أجروا استطلاعًا مهمًّا قبل سنتين أو ثلاث، ووجدوا أن الاختلاف في القيم بين المتديّن وغير المتديّن، أو بين اليساري وغير اليساري، اختلاف ضئيل. مثلًا، الفرق بين التركي اليساري والتركي المتدين فيما يتعلق بالإجهاض، فرق صغير، يُعدّ إحصائيًّا غير مهمّ. هذا أمر مهم جدًّا، وهذا ما أظهرته في دراسة لم تُنشر بعد، أسمّيها: "علمانية"- جزئية من تحت. بغض النظر عمّا إذا كانت دولنا ستتبنى العلمانية أم لا، فإن هناك علمانية من تحت. إحدى الدراسات المهمة التي أُجريت في أربع دول عربية (تونس، الأردن، لبنان، ومصر)، أظهرت أن ثلثي الناس ضد تعدد الزوجات. وعندما قيّمت تأثير التدين على هذا الموقف، وجدت أن الفئة شديدة التدين – التي نسبتها بالمناسبة 2% تقريبًا فقط – هي الوحيدة التي تختلف. أما البقية، سواء غير المتدينين، أو قليلي التدين، أو المتدينين العاديين، فلا فرق بينهم في هذا الموقف.
د. حسام الدين درويش:
أعتقد أن العلمانية موجودة أكثر بكثير مما يظن أعداؤها أو حتى مؤيدوها. ولكن نحن بحاجة إلى دراسات كهذه. وأتمنى أن أتمكن من الاطلاع على المزيد منها.
بقي لدينا سؤالان أخيران يتناولان مسألتين أساسيتين لا يمكن تجاوزهما؛ الأولى تتعلق بكتابك مع الدكتور رضوان السيد وبلال أورفلي حول تجديد الدراسات الإسلامية، هناك اتجاه أنت من أبرز أعلامه، وأنا متبنٍّ لهذا الاتجاه معكم. مسألة أولوية ومركزية الأخلاق في الدين، وحتى في الصلة بين العلوم الاجتماعية وعلوم الشرع، وخاصة حين نتحدث عن القيم الكونية. كيف يمكننا الربط بين هاتين المسألتين: تجديد الدراسات الإسلامية، مع أولوية ومركزية الأخلاق، مع تجاوز الاستقطابات التي تحدثنا عنها؟
د. ساري حنفي:
شكرًا جزيلًا، حسام. هذا يمنحني فرصة للحديث عن الكتاب الجماعي الذي حررته مع الصديقين رضوان السيد وبلال أورفلي. لكن اسمح لي أن أعود كذلك إلى كتابي "تجاوز القطيعة بين علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية." في الدراسات الشرعية، نجد قليلًا من القرآن الكريم والحديث الشريف، ثم ننتقل إلى التذرير الفقهي: فقه الزواج، فقه المعاملات، فقه الميراث، فقه الاقتصاد. لكن لا توجد مادة تدفعنا للتفكير في "روح" الإسلام، أو في القيم الأساسية التي يجب أن تنعكس على الأحكام الفقهية الأخرى. فتتحول كليات الشريعة – ببساطة- إلى مجرد تكرار لأحكام صَدرت بين القرنين الثاني والرابع الهجري، وتُحفَظ المتون كما هي.
مادة الأخلاق لا تُدرّس في كثير من الجامعات العربية، وإن دُرّست، فبأسلوب سطحي. الكليات مثلا، يُدرّسون "جنيفا كونفنشنز" "Geneva Conventions"؛ اتفاقية جنيف الرابعة، ثم يقولون: الإسلام سبقهم. لا يبينون أي تفاصيل؛ مثلًا مفهوم الكرامة، أنا أرى أنه مفهوم حديث، لا يعني بالضرورة أنه غريب عن الإسلام.
ننسى أن كثيرًا من الأحكام الفقهية نزلت بتدرج، حتى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يشتغل مع الناس فكريًّا، درجة تلو أخرى؛ فمثلًا، أوّلًا كان يُعتَق الرقبة، ثم جاء تنظيم العلاقة مع العبيد، وهكذا. في ظل نظام اقتصادي اجتماعي معين، لم يمنع الإسلام العبودية حتى فترة متأخرة. هذا كان طبيعيًّا بالمنطق التاريخي لذلك الوقت، بينما الآن فغير طبيعي.
فالتفكر الأخلاقي مهم جدًّا، "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"؛ يعني أن هناك مشتركًا إنسانيًّا مع الديانات الأخرى، ولكن أيضًا هناك خصوصية إسلامية. مثلًا، أهمية الزكاة: حروب قامت؛ لأن الناس لم يدفعوا الزكاة، وهناك مفاهيم اشتراكية في الإسلام. إذا لم تدرس هذه القيم بعمق، فكيف تنشئ اقتصادًا إسلاميًّا؟ الاقتصاد الإسلامي، كما يُطرح اليوم باختصار، يتحول إلى منتجات ليبرالية جديدة، مثل "حبوب الأسبرين" لعلاج بعض مشاكل الاقتصاد النيوليبرالي غير الإسلامي، دون تفكر أخلاقي.
وأعني بالتفكر الأخلاقي هنا ليس مجرد الحدس، بل النظرية. مثلًا، نظرية الأسس الأخلاقية تتحدث عن بديهيات، كما قال أرسطو عن الشجاعة. هناك شيء يُسمّى الأخلاق، وهناك فضائل. لكن الأخلاق اليوم ليست مجرّد تذكير بالفضائل. اليوم، الأخلاق تعني كيف تتعامل مع أبنائك، ليس فقط لتُذكّرهم بالفضائل، بل كيف تُجري محاكمات أخلاقية لا يمكن القيام بها من دون فلسفة أخلاقية. اليوم، لا يمكن أن يكون هناك تفكير أخلاقي إسلامي من دون التفاعل مع فلاسفة الأخلاق والسياسة. ولماذا أقول فلاسفة الأخلاق والسياسة؟ لأنّه لا يوجد تفكير أخلاقي من دون سياسة؛ بمعنى: في النهاية، كيف نعكس اختلافاتنا على قوانين ما؟ وهذا له علاقة بالسياسة. مثلًا: أين يمكننا أن نصوّت وأين لا يمكننا؟ لأنه حتى لو اتفقت الجماعة، فتصوّر أن يتم التصويت في ألمانيا لطرد مجموعة سكانية، كالسوريين مثلًا، هناك احتمال أن أكثر من 51% من الألمان يقولون: نعم، وهذا يمنعه الدستور الألماني.
كل التفكر الأخلاقي وربطه بالتراث وبثقافتنا، وحين أقول الثقافة، فإنني أُدرج الدين بالضرورة ضمنها. وفي الحقيقة، حتى في "الأسطورة" القائلة إن الدين لم يعُد يلعب دورًا في العصر العلماني، فهذا غير صحيح. كما في كتاب إيمانويل تود "من هو شارلي؟" الذي تحدث فيه بالتفصيل عن أن الإسلاموفوبيا مرتبطة بمسيحية محافظة معينة، كاثوليكية.
لذا، أختم هنا بأن أقول: الصرخة الكبيرة التي يطلقها أشخاص مثل الدكتور رضوان السيد أو بلال أورفلي أو أنا، هي لأهمية التفكير الأخلاقي. هذا أمر بالغ الأهمية. ويجب أن تُدرّب الكليات الشرعية طلابها عليه. وفي الحقيقة، لا أقصد طلاب الشريعة فقط، بل طلاب علم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرهم. اليوم، ما نسمّيه "الأخلاقيات"، أو ما نترجمه بالإنجليزية بـ ethics، هو شيء مهم جدًّا.
سأنهي هنا أيضًا بالإشارة إلى أن المشكلة الأكبر اليوم، كما يقول البعض، هي مشكلة "المهندسين" هي في الأخلاق. المهندس من خلال الشركات قد يكون فاسدًا. فالفساد الكبير اليوم في أوروبا سببه شركات الهندسة. قرأت قبل فترة أنهم أضافوا مادة الأخلاق إلى كل المدارس الهندسية؛ لأنهم اكتشفوا أن المليارات الأساسية التي تُسرق لا تكون من اللاجئ الفقير الذي سرق أربع موزات في فرنسا.
د. حسام الدين درويش:
أربط السؤال بمسألة الأخلاق، وسيكون مرتبطًا بالقضية الفلسطينية، وما جرى بعد 7 أكتوبر. كما ذكرت لك من قبل، فأنا من الأشخاص الذين تعرضوا، مع كثيرات وكثيرين غيري، لصدمة ثقافية حقيقية بعد 7 أكتوبر. والصدمة الثقافية كانت من رد الفعل الغربي – الأمريكي والألماني خصوصًا – على ما حدث في السابع من أكتوبر، وما بعده. فردود الفعل التي تلت ما حدث، خاصة في ظل الوحشية الفظيعة والمستمرة في غزة، دفعتنا إلى محاولة فهم ردود الفعل المذكورة؛ لأن ما يجري يكاد يعجز العقل عن استيعابه. وهنا، يبدو أن العامل الثقافي عاد إلى الواجهة بقوة. لم يعد الأمر قابلاً للتفسير فقط من خلال السياسة، أو الاقتصاد، أو الانتماء الحزبي، أو حتى الأيديولوجيا بالمفهوم التقليدي. لقد أصبح واضحًا أن هناك عاملًا ثقافيًّا حاضرًا ومؤثرًا. صحيح أننا ننتقد "الثقافوية"، لكننا لا ننكر دور الثقافة بوصفها أحد العوامل الحاسمة. وقد تحدثتَ سابقًا عن أن مقاربتك للواقع هي مقاربة سياسية-ثقافية-اقتصادية، أو اقتصادية-سياسية-ثقافية، بحسب السياق. فكيف يمكن أن نفهم هذا الوضع المركّب؟ وكيف نفسّر الصدمة الثقافية التي أصابت بعض الناس، وأنا منهم؟ ثم، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الصدمة معرفيًّا، وبأسلوب رصين ومنهجي؟
د. ساري حنفي:
شكرًا جزيلاً على هذا السؤال، حسام. في رأيي، هو سؤال مهم للغاية. في الحقيقة، أنا كنت قد رصدت استقطابات رهيبة في الديمقراطيات الليبرالية قبل 7 أكتوبر، بل إن الفصل الذي كتبته، كتبت أول مسودّة منه قبل 7 أكتوبر. وكان عندي مشكلة أن الفصل صغير جدًّا، والآن أصبح أكبر فصل في كتابي "ضد الليبرالية الرمزية". وقد نُشر الفصل في مجلة عمران، وسأكون محظوظًا إذا نُشر أيضًا في مجلة باللغة الإنجليزية ضمن ملف، سيتضمن سبع ردود عليه، وردّي على الردود. وقد رأى محررو المجلة أن هذا الموضوع خطير جدًّا، فعادة ما يُقدّم الموضوع لخمس أو ستة باحثين، لكن في هذه الحالة قُدِّم لتسعة. وهذا الموضوع بالغ الخطورة.
الليبرالية لديها زوايا عمياء (blind spots) منذ زمن طويل. رأيناها في الاستعمار. مثلًا: الفرنسيون كانوا نشيطين جدًّا في نيويورك في كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، ومن 1950 إلى 1960 كانوا يرتكبون مجازر في الجزائر. فالنظر إلى السلوك الفرنسي في فرنسا، والسلوك الفرنسي في الجزائر يُظهر هذا التناقض المنهجي. في رأيي، هناك نوع من الاستبداد عند الليبراليين. أصبح هناك نمط واضح جدًّا من انتهاك القيم الليبرالية، واستبداد في فرض مفاهيم معينة عن "الخير"، تحت تأثير سياسات الهوية. وعندما أقول: "سياسات الهوية"، أقصد: من هو "الأقوى" الذي يفرض قضيته على الطاولة. فنجد أن بعض القضايا تُعد مهمة، وأخرى غير مهمة. مثلًا، في الآونة الأخيرة، كانت قضية "الترانس" مهمة جدًّا، بينما قضية من لا مأوى لهم - الذين لا يملكون لا طعامًا ولا سكنًا - لا تحظى بالأهمية نفسها.
القضية الفلسطينية، ما حدث بعد 7 أكتوبر جاء ليُفجّر كل هذه التناقضات التي كنت ألمسها قبل ذلك، فطفت على السطح بشكل صارخ. ما ذكرته يا حسام، أشعر به تمامًا. أحيانًا، لا أستطيع أن أتخيّل أن بعض زملائي يقولون إن القانون الدولي يحق لإسرائيل أن ترد بهذه الطريقة. دعنا نتذكر مثلًا هابرماس، مؤسس نظرية العقل التواصلي. هذا الرجل، بعد أن أيّد "حق إسرائيل في الرد"، لم يكتب كلمة واحدة لانتقاد ما قامت به إسرائيل. نحن في الحقيقة مذهولون. وهذا في نظري نتيجة طبيعية، وفي رأيي، هذا ليس قطيعة، بل ما أحاول أن أجادلك فيه هو أنني لا أراه قطيعة، بل فجأة ظهر على السطح كمن كان عنيفا في داخله وعندما ظهر للعلن، رأينا عنفه، كان عنيفًا من قبل. ويدفعنا إلى القول: لا ينبغي أن نرمي الطفل مع ماء الحمّام القذر. فمشكلة تطبيق القيم لا يعني بالضرورة أن القيم نفسها خاطئة، قد تكون بعض القيم خاطئة، لكن التطبيق لا يُثبت ذلك دائمًا.
اليوم، هناك خطاب شعبوي، وأخشى منه كثيرًا. ولهذا، أرى أن هناك ثلاث نقاط مهمة علينا التفكير فيها في كيفية التعامل مع أي كاتب لديه موقف غير أخلاقي، أو موقف أخلاقي ضد الإنسانية؛ أحيانًا نجد أنفسنا أمام ما يمكن تسميته بـ"أخلاق شعبوية" أو "أخلاق جماعية ضيّقة"؛ فهي ليست غيابًا للأخلاق، بل شكل محدود منها، تنحصر في نطاق الجماعة الصغيرة أو الدائرة القريبة، كمن يُكرم أهل بيته ويغدق عليهم، لكنه لا يلتفت إلى جاره الذي أنهكه الجوع. فهنا لا يمكن القول إنه شخص غير أخلاقي بالمطلق، ولكن أخلاقه مقصورة على نطاق ضيّق، وتفتقر إلى الامتداد الإنساني الأوسع. أول نقطة:
علينا أن نفصل: هل الموقف الشائن أو غير الأخلاقي مرتبط بأجزاء من نظريته، إذا كان كذلك، فنلزم تلك الأجزاء من النظرية. مثلا، موقف هابرماس من إسرائيل لا يجعلني أتوقف عن دراسة نظريته في الفعل التواصلي.
1- توزيع الأدوار: مثلا حسام يكتب ضد موقف هابرماس من إسرائيل، وما علاقته بالعقل والسياق الألمانيين، وأنا أكتب عن نظرية الفعل التواصلي، دون أن نرمي الحجارة على بعضنا. لا أنت تقول لي لماذا تكتب، ولا أنا أقول لك لماذا تنتقد. والشيء نفسه ينطبق على هايدغر، وميشيل فوكو وعلاقته بالبيدوفيليا، هل علاقة بنظرية الجنسانية أم لا؟
2- الاعتراف بتطور العقل البشري: مثلا ديفيد هيوم حين كتب نصوصًا تبرر العبودية أو تسخر من العبيد في القرن الثامن عشر، لا يمكن أن نقطع رأس من يكتب ذلك الآن. لكن ما العمل ما تمثال هيوم في جامعة إدنبرة؟ هل يجب أن نزيله؟ أنا من الذين يعارضون ثقافة الإلغاء (cancel culture) لا نلغي، بل نوضح: كتب هيوم هذا، وهذا مخجل اليوم، دون أن نمحو وجوده.
في الحقيقة، الحساسية التي تمتلكها يا حسام مهمة جدًّا. وأنا أيضًا أمتلكها. لكن علينا أن نحرص على ألا تتحول إلى شعبوية معينة.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا. بالطبع، قائمة الأسئلة طويلة، لكن سنتوقف مؤقتًا هنا، ونأمل أن يكون لنا لقاءات قادمة. ودعني أختم، كما بدأت، بشيء شخصي: جزء من علاقاتك الواسعة في المجال الأكاديمي وغير الأكاديمي، العربي والعالمي، ناتج من انفتاحك الكبير على التعاون مع الآخرين، ومساعدتهم، وأحيانًا تبادر بذلك دون أن يُطلب منك. وأنا كنت من المحظوظين الذين نالوا هذا الكرم واللطف منك، فشكرًا كثيرًا لك باسمي وباسم كثيرات وكثيرين غيري. وشكرًا جزيلًا، أيضًا، باسم "مؤمنون بلا حدود" على قبولك الدعوة.