نظرية المبادئ في مواجهة نظرية القواعد: قراءة في كتاب أخذ الحقوق على محمل الجدّ
فئة : قراءات في كتب
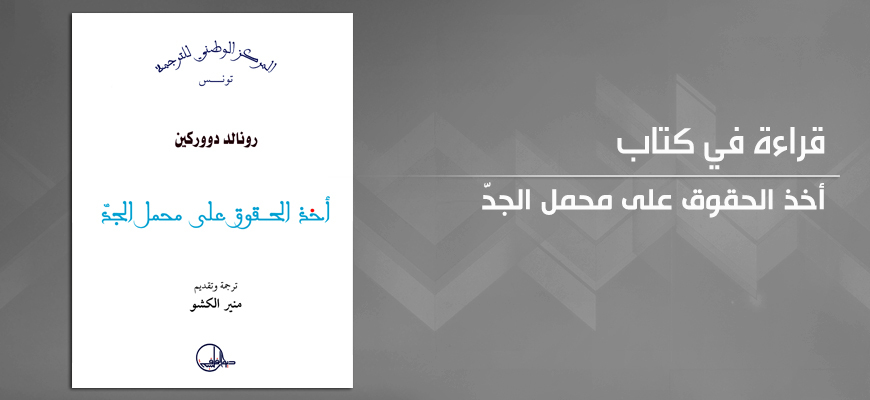
المؤلف: رونالد دووركين
ترجمة وتقديم: منير الكشو
الناشر: المركز الوطني للترجمة، تونس: 2015
عدد الصفحات: 540 ص. من القطع الكبير
يتألف كتاب دووركين أخذ الحقوق على محمل الجدّ، وهو من ترجمة أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية منير الكشو، من ثلاثة عشر فصلًا مع ملحق ضمّنه الناشر ردود المؤلف على ناقدي نظريته في القانون والحقوق وهم في معظمهم من أنصار اتجاه الوضعية القانونية. وتتعلق عمومًا الفصول الأولى من 1 إلى 6 بنقاش دووركين لهذا الاتجاه السائد في فقه القانون الأنجلو - أميركي، وتقديم نظريته التي يطرحها بديلًا عنه لقصوره، في رأيه، عن حماية الحقوق وأخذها على محمل الجدّ كما ينصص على ذلك عنوان الكتاب. أمّا الفصول من 6 إلى 13 فهي لا تتعرض حصرًا إلى المسائل ذات الصلة المباشرة بفلسفة القانون، وإنّما تتعداها إلى مسائل فلسفية وسياسية عامة، مثل العدل والحق، وجواز عصيان القوانين في دولة ديمقراطية، وحدود التسامح في مجتمع ديمقراطي مع المظاهر التي تعدّ من وجهة نظر شعبية مخلة بالآداب، وهل أن الليبرالية تتحدد كمذهب يعطي الأولوية للحرية أم للمساواة ومدى مشروعية التمييز الإيجابي في مجتمع يطمح إلى تحقيق شروط العدل بين مواطنيه. ويتطرق دووركين إلى هذه المسائل محاولا إبراز قوة واتساق الموقف الليبرالي لذي يتبناه ويدافع عنه حيالها.
وعند تفحّص الكتاب نتبين أن معظم فصوله قد صدرت في البداية في شكل مقالات منفصلة في مجلات مختصة في فقه القانون قبل أن يجمّعها الكاتب في هذا المؤلف. وقد حاول المؤلِف من خلالها أن يخطّ لنفسه طريقا ثالثة في نظرية القانون، أي نظرية في فقه القانون jurisprudence تقابل في السياق الفرنكوفوني المباحث الخاصة بفلسفة القانون، تطرح نفسها بديلًا عن المذهبين السائدين في الجدل حول معقولية الضوابط القانونية وحول مدى عدالتها وهما الوضعية القانونية من جهة والمنفعية الاقتصادية من جهة. ويدرج دووركين المذهبين الوضعي والمنفعي ضمن خانة ما يسميه النظرية السائدة في القانون التي يسعى إلى نقدها وإظهار قصورها في ضمان الحقوق وتحصينها، كما يبين ذلك منذ المقدمة. لكنه يبدو في نفس الوقت حريصا على ألا يقع في مطبّ آخر وهو الارتداد نحو نظرية الحق الطبيعي في صيغتها الحديثة والتي اعتمدها كما هو معروف فلاسفة الحق الطبيعي أمثال غريوثيوس وهوبس ولوك روسو وكانط لتسويغ الحقوق الفردية وانتقدتها الوضعية القانونية والفلسفة المنفعية كلاهما لأنها تقوم على تصور ميتافيزيقي للإنسان وللهوية الفردية بات محل ارتياب وتوجّس أكثر فأكثر في السياق المميز لفكرنا في العصر الراهن.
ورغم أنّ الكتاب قد صدر لأول مرّة بالإنكليزية عام 1977، وُيُعدّ باكورة كتب الفيلسوف دووركين، فقد أعيد نشره بعد ذلك التاريخ عديد المرّات مما يؤكد الصدى الواسع الذي لقيه وعمق الجدل الذي أثاره في السياق الأنغلو- سكسوني والأمريكي ولكن أيضا في ألمانيا وفرنسا حينما نقل إلى لغتيهما. ويعدّ نقله إلى العربية، من خلال طبعته الأخيرة مع ما تضمّنته من ردود على النقّاد جعلت أطروحة المؤلف الفيلسوف وفقيه القانون دووركين أكثر وضوحا للقارئ، في رأينا، أمرا هاما نرجو أن يفيد في تعميق الجدل بين المختصين في القانون في بلداننا العربية من قضاة ومحامين ومدرسين وباحثين في القانون حول معاني الضابط القانوني والحق والحكم القضائي والحماية القانونية والحقوق الفعلية والمجرّدة وغيرها من المسائل والقضايا الواردة في الكتاب. وسنؤكد في هذا التقديم على ما بدا لنا جوهريا في هذا الكتاب من ناحية فقه القضاء ونظرية القواعد في صلة بالسلطة التقديرية للقاضي من خلال نظره في النوازل. وتجدر الملاحظة، كما يتجلى ذلك من خلال فصول الكتاب وخاصة 3و4و5، أن النوازل لا حصر لها في حين إن القواعد تظل دوما محدودة العدد وأحيانا غير معلوم مدى انطباقها على الحالة المخصوصة موضوع التقاضي مما ينشأ عنه في كثير من الأحيان اضطرار القضاة إلى تحكيم رويّتهم الشخصية وبالتالي استخدام سلطة تقديرية غير محدودة من شأنها أن تؤدي إلى التعسف في استعمال القواعد أو في استنباطها على نحو من شأنه أن يمسّ، في نظر دووركين، من حقوق الفرد الأساسية. وباعتبار أن الدساتير والتشريعات الحديثة قد جعلت الهدف الأساسي لوظيفة القاضي حماية الحقوق والحريات من أي تعسّف ضدّها قد تمليه نوازع شخصية للقاضي ذاته أو خضوعه إلى ضغوطات سياسية أو ضعفه أمام رأي الجمهور، وغيرها من الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى الإخلال بالوظيفة الأساسية المناطة بعهدة القضاء، كان لزاما، في رأي دووركين، أن يقع ضبط السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وإخضاعها إلى معايير معقولة حتى لا يقع الزيغ بعمليات التقاضي وحتى لا يحدث استبداد باسم القانون نفسه.
وما يعيبه كاتب أخذ الحقوق على محمل الجدّ على الوضعية القانونية هو أنها بحكم مسلمات مذهبها لا يمكنها إلا أن تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة النطاق مما يترتب عنه خطر دائم يتهدّد الحقوق الفردية. وفعلا فالوضعية لا تعترف إلا بمنوال واحد في إقرار الحقوق وتسويغها وهو المنوال الذي يسميه دووركين، في الفصلين 3 و4 على وجه الخصوص، بمنوال القواعد. وفق هذا المنوال، والذي لا بُدّ من التنويه أنه يمثل وجهة نظر شائعة ونافذة بين رجال ونساء القانون في بلداننا من قضاة ومحامين وأكاديميين إلى حدّ جعل البعض يعتبر هذه الوجهة ضربا من الفلسفة الصامتة واللاواعية لديهم، ما من حق إلا ذلك الذي نصّت عليه قاعدة قانونية أو أمكن استنتاجه من حكم قضائي سابق وفق فقه السابقة القضائية. وبهذا تنتفي وفق هذا الرأي فكرة حق يفتقد إلى سند قانوني فالحقوق المجرّدة أو تلك التي يسميها دووركين بالحقوق الأخلاقية للفرد، التي يمتلكها بحكم أنه مواطن وكائن أخلاقي له الحق في المعاملة المتساوية مع غيره والحق في التقدير والاعتبار على قدم المساواة مع شركائه في المواطنة حتى لو لم تتجسد في قوانين ولم تنتقل إلى حقوق فعلية ومؤسساتية، تظل في رأي أنصار الوضعية القانونية مجرّد أوهام للفلاسفة والمفكرين الانسانويين. ويترتب على موقف الوضعية القانونية هذا مشكلان مستعصيان حاولت الوضعية القانونية كما يبيّن دووركين في الفصول 3و4و5 من كتابه التغلّب عليهما. أوّلهما أن قصر الحقّ في القواعد القانونية ينجم عنه ضرورة صعوبة تتمثل في الحالات التي لا تنضوي تحت قاعدة قانونية واضحة. ولحلّ هذا الإشكال عمدت الوضعية القانونية إلى تسويغ السلطات التقديرية الواسعة المحمولة على القضاة وخاصة في الحالات المستعصية التي لا يمكن بسهولة إدراجها ضمن مجال انطباق قاعدة ما. ويعترض دووركين على ذلك بشدّة لما يمثله، كما أسلفنا، من خطر في رأيه على الحقوق إذ من خلال الأمثلة للقرارات القضائية التي يوردها يتبيّن أن القضاة لم يكتفوا بتطبيق قواعد أو بالاستناد إلى فقه السابقة القضائية في ممارسة وظيفتهم الحُكمية وإنما استحدثوا قواعد قانونية جديدة طبّقوها على نحو رجعي على الحالات القضائية المطروحة على أنظارهم..
أما المشكل الثاني الذي واجهته الوضعية القانونية فيتعلق بتمييز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد. لقد اهتدت الوضعية القانونية مع أحد أقطابها وهو فقيه القانون الانكليزي والأستاذ في جامعة أكسفورد هربرت هارت (1907-1992)، صاحب كتاب مفهوم القانون الصادر عام 1963، حلاّ لهذا الإشكال من خلال التمييز بين القواعد الأولية، وهي التي تطبّق على الحالات الخاصّة والتي يمتثل لها الناس على نحو يومي في سلوكهم ويتعرضون لشتى أنواع العقاب المادي والأدبي لخرقها، ويُميّز بها داخل كل مجتمع بين المباح والممنوع وبين المأمور به والمنهي عنه وبين الحق والباطل، وبين قواعد ثانوية من درجة أعلى من تلك لا يكون موضوعها الوقائع والحالات وإنما القواعد ذاتها أي القواعد الأولية. وهذه القواعد الثانوية تحدّد كيف يمكن التعرّف على القانون وكيف يمكن نسخه وإبطاله وتطبيقه على الحالات وتضبط كذلك شروط واجرائيات التقاضي من خلاله. لذلك فالقاعدة القانونية تتميز عن القاعدة العرفية وعن القاعدة الأخلاقية وعن القواعد الخاصة بالانتماء إلى ناد أو جمعية ليس فقط لأنها أوامر تصدر عن سلطة صاحبة سيادة كما يقول فقيه القانون الانكليزي جون أوستين (1790-1859) أو لأنها عامة وشاملة وتنطبق على الجميع كما يؤكد لون فولر (1902-1978) وإنما أيضا وخاصة لأنها تستجيب إلى قاعدة ثانوية تحكم شروط صحتها وكيف يمكن التعرّف عليها وتمييزها عما سواها. فالقاعدة التي تنص مثلا على أن كل أمر يصدر عن برلمان الملك هو قانون أو أن القواعد العرفية لا تصبح لها صفة القانون إلا متى صادقت عليها محاكم صاحب السيادة كما نجد ذلك لدى الفقيه أوستين يعتبر قاعدة ثانوية تمكن من التعرف على القانون في ذلك المجتمع. وما يميز في رأي هارت مجتمعا قانونيا عن مجتمع ما قبل قانوني هو وجود القواعد الثانوية الضابطة لصحة القواعد القانونية المحددة للسلوك. فالقواعد القانونية صحيحة، في نظر هارت، لأن سلطة مؤهلة لوضعها قد صاغتها وأعطتها صفة القانون النافذ. في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية هذه القوانين قد صيغ بعضها من قبل المشرّع وفق الشروط التي ضبطها الدستور في حين صدر بعضها عن قضاة وضعوها، وفق الإجراءات المعمول بها، للبتّ في حالات معينة وأصبحت بعد ذلك سوابق قانونية للحالات اللاحقة([1])
ما هي الحاجة إلى فقه القانون؟
إن هذه الحاجة تنبع في رأي دووركين من الأمر التالي: وهو أن رجال القانون حينما يبتون في قضية أو عندما ينصح المحامون حرفاءهم أو عندما يسنّ المشرّع قوانين لأغراض اجتماعية محدّدة يواجهون غالبا مشاكل تكون من طبيعة تقنية لوجود اتفاق عموما على نوع الحجج المقدمة أو الوقائع التي تعدّ وجيهة وقادرة على حسم الخلاف كلما ظهر نزاع بين أطراف متقاضية. غير أن القانونيين، كما يشير دووركين، كثيرا ما يواجهون مشاكل تتجاوز الجانب التقني وتطرح قضايا ليست بالضرورة ذات طابع قانوني خالص بل هي سياسية بالأساس. يمكن إن نأخذ مثالا على ذلك تساؤل رجال القانون ليس حول ما إذا كان النص القانوني ساري المفعول أم لا وإنما إن كان عادلا. فعادة ما يدرج القانونيون هذه المسائل ذات الطبيعة المختلطة والملتبسة ضمن ما يسميه دووركين بالمسائل الصعبة أو المستعصية على الحلّ لكنهم لا يجمعون على ضرورة مواجهتها وحلّها إذ لا يرون جدوى من الناحية القانونية في ذلك ويفضّلون عموما أن ينأوا بأنفسهم عن المسائل ذات الطابع السياسي وعن تلك التي تكون ذات خلفيات سياسية وأخلاقية مختلف فيها. غير هذا المنحى الذي ساد فترة عنفوان المذهب الوضعي القانوني أخذ في التغيّر. فالاتجاه الذي بدأ في التبلور في النصف الثاني من القرن العشرين بحسب ما يقرره دووركين هو إعطاء قيمة اكبر في تدريس فقه القضاء وفي تحليل اتجاهات المحاكم وفي صياغة قراراتها لا لدراسة فنية فقط للأحكام والقرارات القضائية وإنما الاتجاه نحو طرح قضايا أكثر تشعّبا تقع في الحيز المختلط ما بين مجالات القانون والسياسة والاخلاق.([2]) فالسؤال المرتبط بالواجب الأخلاقي الذي يفرض على المرء الامتثال إلى القاعدة القانونية أصبح يطرح نفسه بحدّة ولم يعد يمكن للقانون أن يستند فقط إلى شروط الصحّة validité الشكلية التي تشدّد عليها الوضعية القانونية حتى يحظى بقبول الناس وإذعانهم له. إذ يمكن أن تتوفر في ضابط قانوني ما شروط الصحّة الشكلية، كأن يكون منسجما مع القواعد الثانوية التي وضعها هارت وأن تتوفر فيه شروط التراتبية hiérarchie والاتساق cohérence التي أكد عليها فقيه آخر في القانون هو النمساوي كلسن Kelsen (1881-1973) وأن يشعر المرء، مع ذلك، بالضيم والحيف كلما أطاعه. وكثيرا ما يطغى على رجال القانون سواء في التجربة الأنغلوسكسونية أو غيرها مقاربة ضيقة حِرَفيّة لا تعترف عموما بالقضايا الأخلاقية وبالجوانب القيمية المتضمنة في صناعة القانون وهي مقاربة لم تؤد في الحقيقة إلا إلى إشاعة وهم الصرامة التقنية والفكرية المحايدة تجاه القيم فضلا عما تتضمنه من ضيق أفق وإغراق في الجوانب الإجرائية والتفاصيل الفنيّة. وكثيرا ما تترك هذه المقاربة جانبا المسائل المتعلقة بمبادئ القانون لتتعلق فقط بالنواحي الإجرائية والتقنية.
وكمثال على ذلك يذكر دووركين الاتجاه الذي ساد الدراسات القانونية إلى حدود منتصف القرن العشرين. فبشكل عام يوجد في هذه الدراسات تأكيد على وجوب المقاربة التحليلية للقانون بوصفه نصوصا وتشريعات قائمة لتبيين معناها القانوني المميّز كما يظهر من خلال النصوص القانونية والصياغة الدقيقة لدلالات المفردات فيها([3]) إلا أن رجال القانون لم يقوموا عموما بالجهد الكافي لربط تلك القوانين بمسائل تتجاوز القانون لتمسّ قضايا أخلاقية فالقاضي في المادة الجزائية يعالج باستمرار مسالة الخطأ أو الذنب ويصدر أحكاما تتوافق عموما مع النصوص إذ يشترط لوجود كل جريمة نصّا محدثا لها ويقتضي عقابا لمرتكبها فلا جريمة ولا عقاب ولا ذنب إلا بنص سابق الوضع إذ أن مصدر التجريم باعتباره جوهر المادة الجزائية ينحصر في النص التشريعي وتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم وبيان أركانها وتحديد الجزاءات المقرّرة لها من حيث نوعها أو مقدارها كل ذلك يجب أن يرد في نصّ قانوني مكتوب يضعه مشرّع معترف له بسلطة إصدار القوانين وهو المبدأ الذي ساد النظرية القانونية عموما في كل التجارب المقارنة. بيد انه نادرا ما يطرح رجل القانون على نفسه مهمة تعريف الذنب أو التفكير في مفهومه وفق المدوّنة القانونية ووفق استعمال عامة الناس في لغة التخاطب اليومي. ويرى دووركين بشكل عام إن رجال القانون يواجهون في الواقع على الدوام هذا المشكل ولكنهم يختلفون دائما أيضا في معالجته. إنهم يختلفون لأنهم ببساطة لا يستخدمون مفهوما للذنب من طبيعة قانونية بل من طبيعية غير قانونية لتسويغ القانون أو لتفنيده. فرجل القانون يرى إن معاقبة رجل من غير ذنب مخالف بلا شك للمبدأ القانوني لكن رجل القانون يتجنب طرح أسئلة من شأنها أن تضع المبدأ ذاته محلّ شك وارتياب: فهل يمكن مثلا أن نعتبر مذنبا إنسانا يرتكب واقعة بحكم ظروف لم يكن بإمكانه توقع حصولها؟([4]) إن سؤالا من هذا القبيل يقتضي، في رأي المؤلّف، تحليلا للمعنى الأخلاقي للذنب وليس تحليلا قانونيا تقنيا فحسب. لذلك يرى دووركين أن مسعى الوضعية القانونية في عزل مجال التفكير في القانون عن المجالات المجاورة له والمتداخلة معه مثل مجال الأخلاق والسياسة والثقافة العامة للمجتمع وما تحمله من مواقف وتصورات تؤثر في صوغ الأحكام وفي المداولات والمرافعات يواجه صعوبات كبيرة أدّت به إلى الفشل. فلغة القانون لا يمكن أن تكون مجردة وموضوعية إلى الحدّ الذي تكون عليه لغة علوم الطبيعة.
ويعتبر الكاتب أن هذا الاستبعاد للمسائل السياسية من دائرة اهتمام القانون لم يعمّر طويلا إذ خاض القضاء الأمريكي لأسباب اقتصادية وسياسية يربطها المؤلف بحاجات التصنيع والتنمية الاقتصادية في مسائل اعتبرها القانون الانكلوسكوني قضايا سياسية لا أكثر ولا أقل. فقد عرف القرن العشرين فكرا جديدا من أولى ميزاته هدم مزاعم المذهب الفقهي التقليدي بحدوده الحِرفية الضيّقة. وكانت النتيجة الأولى التي أفضى إليها هذا المذهب الذي يسميه الكاتب بالتشكيكي إلى أمر لم يكن مقبولا في الماضي وربما لا زال هناك حدّ اليوم من يعارضه يتمثل في قلب رجال القانون سلّم الأوليات التقليدي. إذ أصبحت الأولية في عمل المحاكم تُعطى إلى الانشغالات السياسية والأخلاقية عند نظر القضاة في القضايا المطروحة على أنظارهم وأصبحوا يختارون قاعدة حكمهم المناسبة على ضوء تلك الانشغالات. وقد قبل الاتجاه الغالب على فقه القانون الأمريكي بهذه الدعوة الواقعية وكان من نتائج ذلك وضع القانون في مجال أوسع من مجاله التقليدي المتعارف عليه إذ اعتبر وسيلة تمكن المجتمع من التقدم صوب أهداف كبرى فأصبحت معالجة المسائل المتعلقة بالعملية القضائية تتمّ في اتجاه البحث عن حلول قانونية تكون أكثر ملاءمة لما يعدّ أهداف كبرى للمجتمع.
غير أن التركيز على الأهداف بمنظور استراتيجيا المستقبل أفضى هو نفسه إلى ذات المشكل وهو تشويه نظرية القانون إذ انه أقصى المسائل الأخلاقية عند صياغة الأحكام القضائية وأعار الاهتمام فقط إلى الجوانب السياسية المتعلقة بالأهداف الكبرى للمجتمع. فعندما يتعلق الأمر بمقاضاة شخص لمصنع تركيب السيارات لأنه اقتنى منه سيارة تبيّن أنها لا تستجيب تماما لشروط السلامة المرورية، هل ينبغي على القاضي أخذ المصلحة العامة للمجتمع في أن تظل صناعة السيارات مزدهرة وفي أن لا يثقل كاهل مصنعي السيارات بدفع غرامات مرتفعة أم أن يلتزم بالدفاع عن حق المستهلك للبضاعة في أن لا يتعرض إلى غشّ وفي أن لا تتعرض حياته وسلامته إلى خطر جرّاء عيب في التصنيع؟ لذلك تبدو المقاربة التي تسمّي نفسها واقعية وتأخذ بوجهة نظر منفعية واقتصادية قاصرة هي الأخرى، في رأي دووركين، على أخذ الحقوق على محمل الجدّ.
في هذا السياق الملتبس يرى دووركين ان أكثر رجال القانون لا يدركون المعنى العميق لإتباع القواعد ولما يقتضيه من المحاكم تصريف القاعدة والتعامل معها دون المساس من جوهرها ذاته من مرونة. فالمحكمة العليا حين تخالف القواعد وتحكم بعدم الميز بين الناس في المدارس فإنها لا تستشهد بقوانين أو قواعد بالمعنى الحرفي بل تستند إلى مبادئ غير منصوص عليها على نحو بيّن في المدوّنات القانونية. لكن من أين تأتي هذه المبادئ المجرّدة مثل المساواة في المعاملة والاعتبار وما الذي يجعلها صحيحة؟ هنا يطرح السؤال الجوهري والأكثر إلحاحا وهو أي تفويض يُعطى للقاضي ليبتّ في الحالات المستعصية وفق قواعد لا تكون دوما بيّنة؟ ما هي حدود التفويض الذي يُعطى له؟
نظرية المبادئ في مواجهة نظرية القواعد
يعيب دووركين على منوال القواعد الذي تدافع عنه الوضعية اقتصاره على تبيين القواعد القانونية من اجل التمييز بين القاعدة الصحيحة وغير الصحيحة. إن هذا المنوال يجعل صحة القواعد متوقفة على الاعتراف بها بوصفها ضوابط قانونية يتعين على الجميع الالتزام بها لا لأنها عادلة في ذاتها بل لأنها صادرة عن جهة عامة مخولة لإصدارها. غير إن واقع عمل القضاء والمحاكم يشهد بحقيقة أكثر تعقيدا. لذلك يدخل دووركين إلى جانب القواعد مفهوما كثيرا ما وقع الاختلاف حول طبيعته القانونية وهو مفهوم المبدأ. فهناك في نظره ضوابط من نوع آخر وهي التي يسميها بالمبادئ يستشف القارئ للأحكام القضائية حضورها وللتدليل على وجود مثل هذه الضوابط التي لا تكون في شكل قواعد يقدم المثال التالي "ففي قضية ريغز، التي يتوسع دووركين في تحليلها، نسخ قانون الميراث في قضية جرت أحداثها سنة 1889 وهي من الأمثلة التي يمكن ان نعتبرها مدرسية إذ لا يخلو منها أي كتاب للتدريس. اعتمدت المحكمة في قرارها على المبدأ التالي "لا يمكن لشخص ما إن يستفيد من ضرر كان سببا فيه" في سياق ورود اسم شخص في وصية جده وهو المتسبب في قتله. كان على المحكمة أن تطبق القاعدة المتعلقة بالوصية فلا يمكن من حيث المبدأ عدم الأخذ بالوصية نظرا لطابعها الإلزامي غير أن المحكمة ارتأت في سابقة مشهودة أن قانون الميراث مثل غيره من القوانين يخضع إلى أحكام عامة قد لا تكون لها صلة مباشرة بالواقعة، وهي تشتغل كمبادئ أساسية وليس كقواعد([5]). فالمبدأ الذي استعملته المحكمة ليس له صفة القاعدة بالشروط التي يتقيد بها الوضعيون إذ لا يرد في أية صيغة قانونية وليس من سلالة القوانين كما انه لا يمكن أن يقع التعرف عليه من خلال قاعدة ثانوية مثل تلك التي وضعها هارت ومع ذلك لا مجال لأي قاض سواء في الحالات المستعصية أو حتى اليسيرة أن يستغني عنه. وفضلا عن أنها في مرتبة أعلي من القواعد تشتغل المبادئ على نحو يختلف جوهريا عن القواعد فإذا كانت القاعدة تشتغل وفق مبدأ الكل أو اللا شيء أي الصحّة أو الخطأ فان المبدأ يتحرّك في مجال أوسع لأنه ثمرة اجتهاد القاضي وسعيه للملاءمة بين المبدأ والسياق الذي يقضي فيه. فليس كل مبدأ كافيا لتبرير نسخ القاعدة وإلا لما سلمت أية قاعدة وهو أمر لا يطلبه دووركين فهو في آخر الأمر رجل قانون قبل أن يكون فيلسوفا. فلا بدّ إذن أن تكون هناك مبادئ تأخذ بعين الاعتبار وأخرى لا تأخذ بعين الاعتبار بحسب النازلة وتفاصيلها. إن التمييز بين المبادئ القانونية والقواعد تمييز منطقي ولذلك تملي المجموعتان قرارات قضائية مخصوصة فالقواعد كما ذكرنا قابلة للتطبيق وفق أسلوب الصحة أو الخطا، الذي يعتمده الوضعيون ويلحّون عليه، في حين أن المبادئ تقبل الصحة والخطأ في نفس الوقت فهي أحيانا صحيحة وأحيانا خاطئة. وإذا عدنا إلى المثال السابق نتبيّن أن عدم استفادة شخص من جرم ارتكبه عن قصد لا يعني صحة المبدأ على نحو مطلق إذ كثيرا ما يقرّ القانون جواز ذلك في حالة التقادم الذي ينشا عنه حقّ والحالة الكلاسيكية التي يذكرها دووركين كمثال هي: إذا مررت بطريقة غير شرعية من سبيل على ملك الغير قد ينشأ عن التقادم حق لي في المرور الدائم عبره. إن هذه المبادئ قد تبدو لأغلب رجال القانون عبارات غير محدّدة المفهوم بل لعلّها عند بعضهم خطيرة لأنها تمسّ من استقرار الأحكام سواء في المادتين الجزائية أو المدنية([6]) إلا أن دووركين يرفض أن يرتبط هذا الغموض، الذي يقرّ به هو نفسه، بأي رؤية ميتافيزيقية حول الإنسان وحول الطبيعة البشرية. فهذه المبادئ ليست في نظره سوى تعبير عن فكرة مشتركة بين أفراد مجتمع تتعلق بحقوقهم الأساسية فهي في الأصل تعبّر عن تطلع الإنسان إلى عدالة مثالية مؤسسة على مبادئ عامة ليست بالضرورة قواعد شكلية تستمدّ شرعيتها فقط من السلطة المخولة بإصدارها. فالمبادئ هي من جنس البديهيات في زمن معين وتعلو فوق عمل القاضي والمشرع وتبدو ملزمة لهما ويمكن بالاستناد إليها نقد عملهما والطعن في مدى عدالة الشرائع الصادرة عنهما والأحكام المقرّرة والمعلنة. فهل يمكن أن ينازع أحد الآن في علوية مبدأ الحُرمة البدنية([7]) والمعنوية للإنسان أو في مبدإ المساواة في الاعتبار والتقدير بين أفراد الوطن الواحد أو في المبادئ التي تتأسس عليها حقوق مثل الحق في حرية التعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية؟ وهل يمكن لأحد أن يشكّك في سداد المبدإ الأخلاقي الذي يقضي بأن لا يجوز أن يستفيد المذنب من الجرم الذي ارتكبه؟
على صعيد آخر لا بُدّ من التنويه بطرافة العديد من الأفكار التي يقدّمها دووركين في كتابه هذا وثرائها من الناحية الفلسفية. ولعلّ أهم تلك الفكر التي استرعت انتباهنا تلك التي تؤكد على ضرورة أن ننظر إلى مختلف الحقوق والحريات، مثل تلك عددنا الآن، لا بوصفها أصلية وإنّما بوصفها حقوقًا فرعية متأتّية من حقّ أخلاقي أساسي يمتلكه الفرد، بوصفه شخصيّة أخلاقية، وهو الحقّ في الاعتبار المتساوي مع غيره. لذلك، لا تكون مختلف الحريات كحريّة التعبير وحريّة الضمير وحريّة المبادرة الاقتصادية وتعاطي التجارة غايات في حدّ ذاتها، لا يجوز المس بها أو التضييق منها، وإنّما بوصفها وسائل لخدمة هذا الحق الأساسي وهو الاعتبار المتساوي. فلو حُرم الشخص من حقه في التعبير عن رأيه ومن حقه في أن يدين بدين ما أو أن لا يؤمن بأي معتقد مهما كان أو من أن يعيش كما يشاء وأن يمارس المهنة التي يرغبها فسيؤثّر ذلك سلبيًّا في نظرته إلى نفسه. وسيكون في ذلك تعدّيًا على حقه في الاعتبار على قدم المساواة مع غيره من أقرانه وشركائه في الوطن. فحقه في الاعتبار المتساوي يملي على السلط العمومية وعلى نظام المجتمع الاعتراف له بحق السيادة على نفسه وفي الحرية لكن في نفس الوقت إذا اقتضى حق الفرد في الاعتبار المتساوي التضييق من حريته الاقتصادية من خلال وضع ضوابط وقيود على السوق الحرة وتوظيف ضرائب على أرباح الشركات فسيكون ذلك مبرّرا أيضا.
وعلى هذا النحو يعيد دووركين ربط الصلة بين الأخلاق والقانون والسياسة على قاعدة أولوية الحقوق وعدم جواز مقايضتها بأهداف سياسية عامة حتى ولو كان فيها خير للمجموعة ككل. إن أفضل ما يوجد في هذا الكتاب القيّم جدّا والمترجم ببراعة مع احترام المعجم المتداول بين أهل الاختصاص القانوني هو أن دووركين يلحّ على ما يسميه بالمبادئ وعلى طابعها المتحرّر من صرامة القاعدة وإلا فقدت هذه المبادئ طابعها المتراوح على الدوام بين الصحّة والخطأ. لا شك أن "الوضعية" التي ينتقدها دووركين تؤمن بلا شك بالسلطة التقديرية للقاضي غير إن هذه السلطة ليست مطلقة، كما يصوّرها الكاتب في كثير من الأحيان، وإنما هي مقيدة في الوضعية بالنصوص القانونية. إذ يتمثل عمل القاضي في الاجتهاد في اكتشاف القاعدة المناسبة للحالة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبتّ في الحالات المستعصية خاصة. غير إن دووركين له تصوّر أخر لمهمة القاضي وأصالة عمله فهو لا يطلب قاضيا واثقا من نفسه وثوق القاعدة التي يستند إليها بل يطلب قضاة "لا يقضون إلا وأياديهم مرتعشة كما يقول الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الفرنسية"([8]). لا شك أن قضاتنا في البلاد العربية يحتاجون إلى أياد مرتعشة كما يحتاجون أيضا إلى دراية بالمبادئ العامة لمعقولية القانون وأيضا إلى قواعد جيّدة للحكم في النوازل. هذا إذا كانوا يستندون إلى قواعد حقا في ظل أنظمة قضائية تابعة لسلط سياسية لا تعترف بمبدإ دولة القانون ولا تزال تتلمس طريقها إلى الاستقلالية. لذلك لا يزال أمام مجتمعاتنا عمل كبير يتوجب القيام به حتى يتحوّل المثل الأعلى للقاضي إلى واقع وحتى يكون القاضي فعلا حاميا للحقوق والحريات.
[1] المصدر ص 97
[2] مسالة إن كان من العدل تحديد الأجر الأدنى بقانون كانت تعدّ في انقلترا وفي الاتجاه التقليدي عموما مسالة سياسية في حين غدت في الولايات المتحدة مسالة قانونية فالقانونيون الأمريكيون بدؤوا يشعرون بأكثر حاجة إلى توصيف دقيق لما تقوم به المحاكم وتعليله لان المحاكم بدت وكأنها تستحدث قوانين جديدة مختلف حولها سياسيا بدل الاكتفاء بانفاذ القانون كما تقتضي النظرية التقليدية وهو ما جعل الجدل أحيانا يدخل إلى مناطق خارج حيز القانون وداخل منطقة السياسة والأخلاق انظر المصدر ص 48
[3] تعني المقاربة التحليلية أو الفقه التحليلي للقانون الصياغة الدقيقة لدلالة المفردات مثل "الذنب" و"الحوز" و"الملكية" و"الاهمال" ويطرح هذا الاتجاه في نظر دوركين مشكلا لان رجال القانون كثيرا ما يستعملون هذه المفاهيم دون إدراك منهم لدلالاتها. المصدر ص 47
[4] هل يتحمل شخص ما مسؤولية الضرر الذي حدث إن كان مقترفه من منظوريه او ان كان قد تسبب فيه هو بحكم ظروف لم يكن بإمكانه توقع حصولها؟ إن أسئلة كهذه تقتضي تحليلا للمعنى الأخلاقي للذنب وليس تحليلا قانونيا كما يفهمه عادة الفقيه القانوني ص ص 47 و48
[5] المبدا الذي يقول انه لا يجوز لأحد جني فوائد من ذنب اقترفه لا يدعّي في نظر دووركين "ضبط الشروط التي تجعل تطبيقه امرأ ممكنا وإنما يشير فقط إلى سبب يجعلنا نسير صوب وجهة ما ولا يوصي بالضرورة باتخاذ قرار محدد" المصدر ص 79
[6] يعض هذه المبادئ التي ينادي بها دووركين تظل دائما محل جدل كبير فالاتجاه السائد يرى ان القاضي مطالب بتطبيق القانون فاجتهاده مرتبط بما جاءت به النصوص من أحكام وتخويله إدخال اعتبارات أخلاقية من قبيل مبدأ العدل والإنصاف مثلا عند فصله في النزاعات أمر خطير قد يمس من استقرار المعاملات انظر القاضي عبد المنعم كيوة "حل النزاعات التجارية طبق مبدأ العدل والإنصاف" "القضاء والتشريع" (شهرية يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل التونسية) جانفي 1998 ويتضمن هذا المقال إحالات كثيرة مفيدة متصلة بالموضوع.
[7] مبدا الحرمة الجسدية للإنسان باعتباره مبدأ أخلاقيا وفلسفيا كثيرا ما يطرح مشاكل عويصة في محاكمنا في تونس بصدد عرض المثليين على الفحص الشرجي من اجل إثبات تهمة "اللواط" عليهم في غير حالات التلبس ومن ثم إصدار عقوبات قاسية ضدهم تصل إلى ثلاثة سنوات مع الإبعاد مثلما حصل أخيرا في قضية مجموعة شباب القيروان وتطالب منظمات حقوق الإنسان بنسخ الفصل 230 من المجلة الجنائية المجرم لواقعة "للواط" بحسب التوصيف القانوني باعتباره مخالفا لمبدأ الحرمة الجسدية. على إن هذا المبدأ يمكن عدم الأخذ به خارج الممارسة المثلية في حالات إثبات النسب في العلاقة الزوجية واثبات الأبوة خارج إطار الزواج حيث يفلت كثير من المتنفذين من الاختبار الجيني أو في واقعة الاغتصاب التي لا مناص فيها من الفحص الطبي او في حالات إثبات السكر في وضعية السياقة أو تناول المخدرات ويعتبر الامتناع عن الفحص قرينة إدانة في كثير من الأنظمة القانونية. مما يستدعي بلا شك موزانة القاضي بين الحقوق وتغليب ما يراه أجدر بالصيانة من الحقوق العامة أو الخاصة.
[8] "Qui peut juger sans frémir sur terre?" demande Verlaine. Il est vrai que nous ne rendons justice) que les mains tremblantes. Même arrimés et fidèles à la loi, nous ne sommes pas délivrés de notre entière responsabilité. Plus la marge d’interprétation du droit, plus la latitude d’appréciation des faits sont larges, plus le juge est libre et, de ce fait, en sa personne, pleinement responsable des sentences qu’il prononce Audience solennelle de début d’année judiciaire, Le 6 janvier 2006, Discours de M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation






