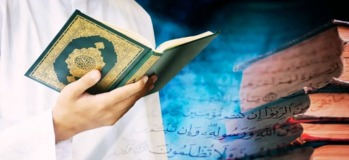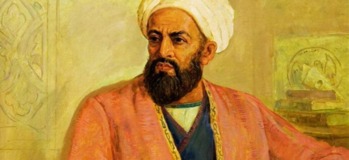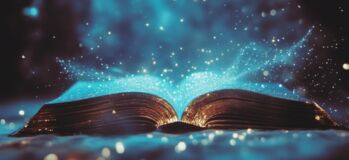منزلة المنطق عند ابن ميمون
فئة : أبحاث محكمة

منزلة المنطق عند ابن ميمون
الملخص:
تُشكِّل رسالةُ موسى بن ميمون القرطبي (1135-1204م) في صناعة المنطق، التي ألَّفَها عام 1158م، لحظةً فارقةً في التاريخ الفكري اليهودي، بوصفها الأثر المنطقي الأول الذي يُنسَب إلى فيلسوفٍ ينتمي إلى هذا التقليد. وقد مثَّلت هذه الرسالة محاولةً منهجيةً لاستيعاب المنطق الأرسطي، وإعادة إنتاجه ضمن النسق الديني الفلسفي اليهودي، مما يُجسِّد سعيًا جادًّا نحو تأسيس توافقٍ بين العقل والوحي.
غير أن الإحاطةَ بدلالة هذا العمل الإبستمولوجية، وفحص مُستوى الجِدَّة الفلسفية التي يَحملها، وتقييم أدواره التأسيسية في تطوير المنطق بين: ثنائية التلقي النقدي والإبداع الذاتي، تستدعي بالضرورة تفكيكًا فلسفيًّا دقيقًا لنسيجه المفاهيمي وغاياته الكُليَّة، إلى جانب رصدِ المصادر الفكرية التي استند عليها وأعاد تشكيلها ضمن سياقه النظري؛ إذ يتطلَّب الكشفُ عن الأثر المفاهيمي لمشروع موسى بن ميمون، وتحليلُ تداعياته في السياقين الفلسفي والمنطقي - داخل النسيج الداخلي للعقلانية اليهودية أو في تفاعل الفلسفة مع الخطاب اللاهوتي - منهجيةً نقديةً جذريةً قادرةً على تفكيك البنى التحتية للخطاب، وإعادة تركيب طبقاته المضمرة، وكشف الآليات التأويلية التي شكَّلت بنيته المعرفية والاستدلالية. ولا يتحقق هذا إلا عبر مساءلةٍ منهجيةٍ تعيد قراءةَ المشروع في ضوء تشابُهاته الإبستيمية واستراتيجياته النصية الخفية، بوصفه نموذجًا للتفاعل المعقَّد بين العقل والنقل في فضاءات الفكر الوسيط. من هذا المُنطلق، لا يُمكن اختزال هذه الرسالة في وظيفة جسرٍ تاريخيٍّ بين الموروثين اليوناني واليهودي فحسب، بل يتعيّن مقاربتُها بوصفها مشروعًا تأويليًّا مركبًا، يستوجب القراءةَ عبر مُستوياتها الإبستمولوجية والمنهجية المتداخلة، سعيًا لاستنطاق إشكالاتها المعرفية المُضمرة، وإعادة تحديد موقعها ضمن سياق تاريخ الأفكار، بما يتجاوز القراءات السطحية التي تُهمل تشابُكَ أبعادها النصية والفلسفية.
تنهضُ رسالةُ ابن ميمون المنطقية، المكوَّنَة من أربعةَ عشرَ فصلاً، نهوضاً يصل جوهريًّا بين ثلاثة أنساق معرفية: العلوم الشرعيّةِ واللغويّةِ والمنطقيّة، في تكاملٍ دالٍّ على الرؤية الفلسفية لمؤلفها. وقد انبثق اهتمامُ أبي عمران بالمنطق الأرسطي (الأورغانون) من مقاصد فلسفيةٍ كبرى، يمكن إجمالها فيما يأتي:
أولاً، تفكيكُ النصوص الدينية اليهودية وإعادةُ بنائها عبر الآليات المنطقية الأرسطية، مما أحدثَ تحولاً جذرياً في منهجية التعامل مع المقدس؛
ثانياً، تأسيسُ المنطق كمدخلٍ إبستمولوجيٍّ لا غنى عنه لفهم الفلسفة واللاهوت؛ حيث أصبحَ الشرطَ الأولَ لكلّ تأملٍ عقلانيٍّ منضبط؛
ثالثاً: تطويرُ البنية المصطلحية عبر استيعاب المفاهيم المنطقية الأرسطية، بدءاً من المقولات العشر ومروراً بأنماط القضايا والأقيسة، وصولاً إلى بناء معجمٍ فلسفيٍّ دقيقٍ يضمّ ما ينيف على مائةٍ وخمسةٍ وسبعين مصطلحاً منطقياً.
وإذا كان النصُّ يستند في مرجعيته الأساسية إلى المنطق الأرسطي، فإنه يحمل بصماتٍ واضحةً لتأثره بالمشروع المنطقي للفارابي، مما يجعله نموذجاً رفيعاً للحوار الحضاري بين التراث اليوناني والإسلامي واليهودي. وهكذا تتجاوز الرسالةُ حدود النقل السلبيّ إلى آفاق التأصيل والإبداع، حيث تمثل محاولةً جادّةً لإعادة إنتاج المنطق في سياقٍ فكريٍّ جديد.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا