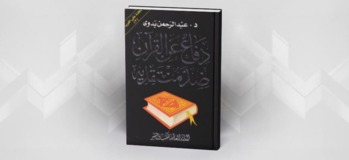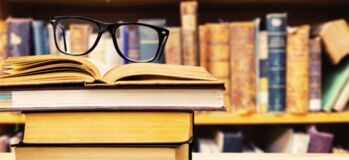في أصل العربيَّة القُرآنيَّة
فئة : ترجمات
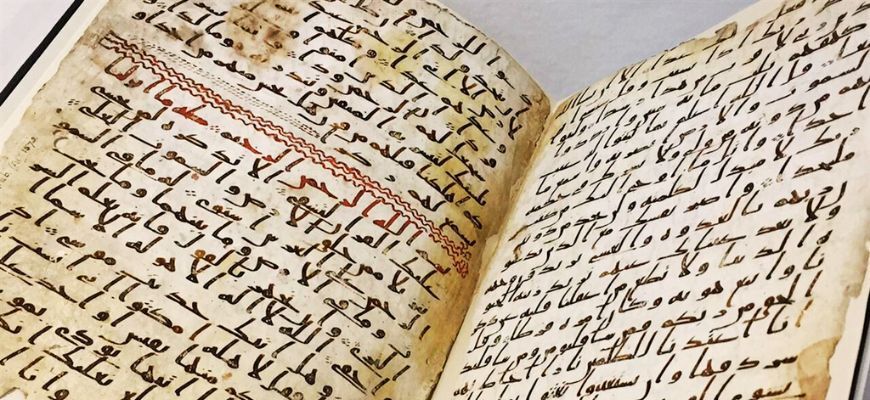
في أصل العربيَّة القُرآنيَّة
مقدمة المترجم
نُشرت هذه المقالة عام 2018م تحت عنوان "On the Origin of Qurʾānic Arabic"، في موقع أكاديميا على الرابط https://www.academia.edu/37743814/On_the_Origin_of_Qur%CA%BE%C4%81nic_Arabic.
يُواجه الباحث في تأريخ القُرآن لغزيْن: أولهما: سبب ندرة النقوش التي يُمكن أن تعكس سابقةً للغة العربيَّة القُرآنيَّة بين آلاف النقوش العربيَّة القديمة التي سبقت القُرآن، والمُنتشرة على منطقة شاسعة. أما الآخر: إن علماء اللغة المسلمين الذين بحثوا بجديّة عن اللهجة القُرآنيَّة، لم يتمكنوا من تحديد أيٍّ من اللهجات المعروفة لديهم تُعد مصدرًا للعربية القُرآنيَّة.
ربما يمتد هذا اللغزان إلى عصر الفتوحات الإسلاميَّة، وعلى نحوٍ خاص أيام الدولة الأمويَّة؛ إذ يتبادر تساؤل لماذا كانت أول المسكوكات الإسلاميَّة تحمل في طياتها لغاتٍ غير عربيَّة؟ ولماذا احتاج الخليفة الأمويّ، وبمشورة من الحَجاج بن يُوسف الثقفيّ، إلى سك الدينار الإسلاميّ وتعريب الدواوين؟
قد يُجيب البحث الذي بين يدي القارئ العربيّ الجواب عن اللغزيْن الأوليْن. أما جواب التساؤليْن الآخريْن، فسيجد تفصيلات جوابيهما في مؤلفات دان غيبسون عن مدينة الإسلام المُقدسة.
كاتب هذا المقال هو مارك دوري Mark Durie، والذي يعمل في مركز آرثر جيفري لدراسة الإسلام، كلية ملبورن اللاهوتيَّة Arthur Jeffery Centre for the Study of Islam Melbourne School of Theology.
إليك أيها القارئ العربيّ بصيصًا من النور عن إحدى الكتابات عن أصل اللغة العربيَّة القُرآنيَّة؛ حاول الكاتب فيها الاستفاضة في البحث عن أصل العربية القُرآنيَّة وخرج بهذا البحث البسيط والمركز، وكان أكثر ركيزته على كتاباتٍ لباحثين أخصائيين أمثال مايكل ماكدونالد، وأحمَد الجلاد، وحاييم رابين، والله الموفق.
ملخص
طُرحتْ الأبحاث السابقة في أصول اللهجة العربيَّة التي شكّلت معيار النص القُرآنيّ لُغزيْن: لغزٌ من أعلى، ولغزٌ من أسفل. يكمن اللغز من الأعلى في أن علماء اللغة المسلمين الذين بحثوا بجديَّةٍ عن اللهجة القُرآنيَّة لم يتمكنوا من تحديد أيٍّ من اللهجات المعروفة لديهم تُعد بمثابة مصدرٍ للعربيَّة القُرآنيَّة. اللغز من الأسفل هو: لماذا، من بين آلاف النقوش العربيَّة القديمة التي تعود إلى ما قبل القُرآن والمُنتشرة على مساحةٍ شاسعةٍ، هناك نُدرة في النقوش التي يُمكن أن تعكس ما يُمثل مقدمةً للعربيَّة القُرآنيَّة.
يُقال إن حلّ كلا اللغزيْن يكمن في أن العربيَّة القُرآنيَّة، كما ينعكس هيكلها الساكن، تطورت مباشرةً من عربيَّة الأنباط. حل اللغز من الأسفل هو أن الأنباط تركوا العديد من النقوش؛ لكن بلغتهم المكتوبة المُفضلة، الآراميَّة، وليس لغتهم الأم العربيَّة. حل اللغز من الأعلى هو أن علماء اللغة المسلمين كانوا يبحثون عن مصدرٍ بدويٍّ للنص القُرآنيّ؛ لكن الإرث اللغويّ للعربيَّة النبطيَّة كان موجودًا في اللهجات التي يتحدث بها المزارعون في جنوب بلاد الشام.
وثّقتْ الأبحاث الحديثة التي أجراها الجلّاد لهجات جنوب بلاد الشام العربيَّة قبل الفتح في منطقة النفوذ النبطيّ المُباشر. تُؤكد هذه النتائج فرضيَّة أن اللغة العربيَّة النبطيَّة وفرتْ التنوع اللغويّ للقُرآن.
اللغز من الأسفل: أدلة ما قبل الإسلام
على مدى ألف عام، وحتى القرن السادس الميلاديّ، شهدت عشرات الآلاف من النقوش والكتابات الجداريَّة بمجموعةٍ متنوعةٍ من النصوص العربيَّة الجنوبيَّة على وجود مجموعةٍ متنوعةٍ من اللهجات العربيَّة المُبكرة في جزيرة العرب. التساؤل الرئيس هو: أيٌّ من اللهجات العربيَّة القديمة الموثقة، إن وُجِدتْ، كانت سلف العربيَّة القُرآنيَّة؟ وإذا لم تكن هناك أسلافٌ مكتوبة؛ فكيف أمكن للهجةٍ ليس لها تأريخ مكتوب أن تُشكّل اللغة العربيَّة القُرآنيَّة؟
من السمات البارزة للهيكل الصوتيّ العربيّ القُرآنيّ استخدام أداة التعريف "أل". في المُقابل، فمعظم النقوش العربيَّة القديمة المُوثقة، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم "شمال جزيرة العرب القديمة"، تأتي بأشكالٍ مُتنوعةٍ من أدوات التعريف الأخرى، مثل "هن"، أو "ح"([1]). فقط عددٌ قليلٌ من النقوش تستخدم أداة التعريف "أل". تَظهر أدلةٌ على استخدام أداة التعريف "أل" في وقتٍ مُبكر جدًّا؛ إذ كتب هيرودوت Herodotus، حوالي عام 440ق.م؛ أي قبل نزول القُرآن بألف عام تقريبًا، أنه ورد أن معبود العرب كان يُعرف باسم Αλιλάτ، وهو ما يعكس على الأرجح كلمة "إلهة" في اللغة العربيَّة([2]).
اعتبر مايكل سي آي ماكدونالد M.C.A. Macdonald([3]) أن من ألغاز الدراسات العربيَّة القديمة أن نجد عشرات الآلاف من النقوش والكتابات على الجدران في معظم أنحاء جزيرة العرب وخارجها، في مجموعةٍ واسعةٍ من النصوص، من اللهجاتٍ التي نادرًا ما تَستخدم أداة التعريف "أل". في المُقابل، فإن عدد النقوش التي تَستخدم لهجةً متنوعةً لأداة التعريف "أل" ضئيلٌ للغاية؛ لدرجة أن ماكدونالد([4]) علّق قائلاً: "...من شبه المؤكد أن اللغة العربيَّة [يقصد ماكدونالد هنا اللهجة السابقة للعربيَّة القُرآنيَّة والفصحى] كانت لغةً منطوقةً بحتةً، وليست لغةً مكتوبةً بشكلٍ مُعتاد، في معظم تأريخها قبل الإسلام". لقد حيّره عدم وجود النقوش قائلاً:
"يبدو أنه لا يوجد سببٌ عمليٌّ لبقاء اللغة العربيَّة لغةً غير مكتوبةٍ لزمنٍ طويلٍ؛ لا سيما في المناطق التي شهدت نشاط كتابةٍ هائلاً للهجات ذات الصلة واللغات الأخرى"([5]).
يُقال هنا إن إجابة لغز ماكدونالد تكمن في أن العربيَّة النبطيَّة، التي أصبحت فيها أداة التعريف "أل" هي المعيار، كانت مقدمةً للعربيَّة القُرآنيَّة، وكان الأنباط مُعتادين على الكتابة بالآراميَّة؛ لدرجة أنهم استخدموا هذا الخط واللغة عندما تركوا وراءهم كتاباتٍ على الجدران بدلاً عن لغتهم العربيَّة العاميَّة المنطوقة. يتفق مع هذا التفسير أن الغالبيَّة العظمى من النقوش العربيَّة التي تستخدم أداة التعريف "أل" (باستثناء اليونانيَّة العربيَّة، التي ستُناقش لاحقًا) مكتوبةٌ بالخط النبطيّ([6]). لا يوجد إلا عددًا قليلًا من النقوش تتضمن أداة التعريف "أل" في نصوص العربيَّة الجنوبيَّة([7]).
الأنباط والنبطيَّة
وصف {سترابو Strabo} الأنباط بأنهم الشعب الذي كانت عاصمته البتراء (وتعني الصخرة باليونانيَّة)، والتي كانت تُعرف لدى الأنباط باسم "الرقيم"([8]). إن مصطلحي Ναβαταῑοi وNabataei مُستعاران من كلمة "نبطيّ" العربيَّة. يُشتق هذا اللقب القديم من الجذر العربيّ "ن- ب- ط"، الذي يُشير إلى جريان الماء أو تدفقه من الأرض، ومِن ثَم، إلى استخراج المياه الجوفيَّة عن طريق حفر بئر. بالتالي، فكلمة "نبطيّ" تعني في الأصل "حفار الآبار"([9]). عُثِرَ على نقوش، ليست بالآراميَّة النبطيَّة فحسب، بل أيضًا بالعربيَّة المُبكرة، في النصوص العربيَّة الجنوبيَّة، حيث يُعرَفُ الناسُ على أنهم "نبط" أو "نبطيّ" أو "نبطو"([10]). ليس من الواضح دائمًا ما إذا كان المقصود من هذا المصطلح هو تسميةٌ عرقيَّةٌ أم سياسيَّةٌ؛ أي "نبطيٌ"، أو وصفٌ لطريقة عيش شخصٍ ما مِن خلال الزراعة. أحد النقوش التي لا بد أنها تُشير إلى مملكة الأنباط هو النقوش الصفائيَّة التي تنص على: "وتوقف بسبب هطول الأمطار في العام الذي تُوفي فيه ملك الأنباط"([11]).
ذهب ماكدونالد إلى أن اللغة العربيَّة كانت موجودةً - بل وازدهرت - لقرونٍ بين الأنباط في البتراء في بيئةٍ ثنائيَّة اللغة مُستقرة، حيث استُخدمت الآراميَّة بادئ ذي بدءٍ ثم اليونانيَّة للتواصل الرسميّ المكتوب؛ بينما كانت اللغة العربيَّة هي اللغة الأم للمجتمع مع تقليدٍ شفهيٍ حيويّ، بما في ذلك النصوص الليتورجيَّة([12])، وهو تقليدٌ لم يكن مُلتِزمًا بالكتابة([13]). هناك مجموعةٌ متنوعةٌ من الأدلة الدعمة لهذا الاستنتاج. عدّ سترابو الأنباط عربًا([14])، وكذلك فعل ديودوروس الصقليّ Diodorus Siculus([15]). كما أطلق يوسيفوس Josephus على الأنباط اسم "أمة عربيَّة"([16])، والبتراء، عاصمة الأنباط، "المقر الملكيّ لملك جزيرة العرب"([17]). علاوةً على ذلك، أطلق يوسيفوس على المنطقة الواقعة جنوب يهودا اسم "العربيَّة"([18]) والتي شملت الأطراف الجنوبيَّة للبحر الميت، حيث تقع البتراء. أعاد تراجان Trajan تسمية النبطيَّة بـ "الولاية العربيَّة" عندما ضُمتْ عام 106م، وكان من عادة الرومان تسمية المقاطعات بأسماء الأعراق([19]). ومن الواضح من نقوشهم الآراميَّة أن الأنباط كانوا يحملون أسماء عربيَّةً([20]).
يُشير إبيفانوس Epiphanus، الذي كتب في القرن الرابع الميلاديّ، إلى أن البترائيين كانوا يُنشدون الترانيم باللغة العربيَّة لإلهتهم العذراء المسماة "كعبو"([21])، واقترح ماكدونالد([22]) أن سطريْن من الشِّعر العربيّ مُسجلان في نقشٍ في النقب، مُرفقيْن بنصٍّ بالآراميَّة النبطيَّة كانا مُقتطفيْن من قُداسٍ شفهيٍّ في مدح الملك المُؤلَّه عوداس. وهذا دليلٌ على الاستخدام الطقسيّ للشِّعر العربيّ في السياق النبطيّ.
من المعروف أيضًا وجود عددٍ كبيرٍ من الكلمات العربيَّة المُستعارة في الآراميَّة النبطيَّة([23])، علاوةً على أدلةٍ على التأثير النحويّ العربيّ على الآراميَّة النبطيَّة المكتوبة([24])، وهو دليلٌ أقوى من الاقتراض المعجميّ على وجود علاقةٍ ركيزةٍ بين العربيَّة والآراميَّة النبطيَّة. فأسماء الأماكن في برديات البتراء، فوق ذلك، التي تعود إلى القرن السادس الميلاديّ، والمكتوبة باليونانيَّة، هي في الغالب عربيَّةً([25])، ومن المعروف أيضًا وجود عددٍ كبيرٍ من الاستعارات الآراميَّة باللغة العربيَّة الفصحى([26]).
دليلٌ آخر على أن الأنباط كانوا يتحدثون العربيَّة هو وجود مجموعةٍ من البرديات المُعتمدة التي يعود تأريخها إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادييْن، والتي تتضمن فيها الوثائق الآراميَّة اليهوديَّة قوائمَ بمصطلحاتٍ آراميَّةٍ يهوديَّةٍ متبوعةً بمكافئاتها العبريَّة. في الوثائق الآراميَّة النبطيَّة الموجودة بجانبها، تتبع المصطلحات الآراميَّة مكافئاتها العربيَّة([27]).
ليس من المستغرب أن يلجأ العرب المُستقرين، الذين كانوا بحاجةٍ إلى تطوير بُنيَّةٍ تحتيَّةٍ إداريَّةٍ تتطلب نصوصًا مكتوبة، إلى الآراميَّة الإمبراطوريَّة بوصفها لغة كتابةٍ.
بيد أنه تُشير كافة الأدلة إلى أن أولئك الذين استخدموا الخط "النبطيّ" في الكتابة كانوا من الناطقين بالعربيَّة بوصفها لغتهم الأم:
"... لا ينبغي أن نفترض أن كل من كتب أو كُلّف بكتابة نصٍ بما نُسميه اللغة والخط "النبطيّ" اعتبر نفسه "نبطيًا" عِرقيًّا أو سياسيًّا، تمامًا كما هو الحال مع من يكتب باللغة "الإنجليزيَّة"؛ فهو ليس بضرورة الحال أن يكون ذا جنسيَّةٍ "إنجليزيَّة"([28]).
ما نعرفه أيضًا هو أن الكتابة العربيَّة تطورت عضويًا من شكلٍ مُتصلٍ من الخط الآراميّ النبطيّ([29])، وهو ما يحتاجه التجار لحفظ حساباتهم على المواد اللّيّنة مثل ورق البرديّ([30])، وهناك بعض النقوش العربيَّة المُبكرة المهمة بالخط الآراميّ: نقشٌ وثني من عين عفدات، ونقش نمارة، المؤرخ عام 328م([31]).
نستنتج أن ثقافة الركيزة العربيَّة النبطيَّة الشفهيَّة استمرت لقرونٍ جنبًا إلى جنبٍ مع الآراميَّة ثم اليونانيَّة. ثم انتقل متحدثو العربيَّة النبطيَّة إلى استخدام لغتهم الأم العربيَّة بوصفها وسيلةً مُفضّلةً للتواصل المكتوب؛ وقاموا بتكييف الخط الآراميّ النبطيّ لهذا الغرض. يُمكننا القول إن هذه العمليَّة كانت تدريجيَّةً من الطريقة التي يَظهر بها نصٌ عربيٌّ مكتوبٍ بخطٍ عربيٍّ متطورٍ على مر القرون. يذهب ماكدونالد:
"هذا يعني أنه يتعيّن علينا افتراض استخدامًا واسع النطاق، وربما مُتزايدًا، للكتابة على مواد لّيّنةٍ بالخط النبطيّ طوال القرنيْن الرابع والسابع الميلادييْن؛ لأن هذا وحده كان قادرًا على إنتاج أشكال الحروف الانتقاليَّة والأربطة التي نراها بادئ ذي بدءٍ في الكتابة على الجدران "النبطيَّة" أو "الانتقاليَّة" في القرن الخامس الميلاديّ... ثم في النقوش العربيَّة المُبكرة في القرنيْن السادس والسابع وأقدم البرديات العربيَّة في منتصف القرن السابع الميلاديّ"([32]).
بقدر ما كانت هذه العمليَّة تدريجيَّةً؛ فمن المُفترض أن ضرورة الإدارة باللغة العربيَّة بدلًا من الآراميَّة أو اليونانيَّة هي التي أدت إلى بروز الخط النبطيّ العربيّ في نصوص الإدارة الحكوميَّة، التي يقودها العرب، ونصوص الدين الإسلاميّ([33]).
اللغز من الأعلى: أدلة علماء اللغة المسلمين
في نقاشنا حتى هذه النقطة، تناولنا ظهور اللغة العربيَّة في ضوء الأدلة التي سبقت القُرآن، وعلى نحوٍ خاصٍ الندرة النسبيَّة في نقوش الأدلة على وجود لهجةٍ سابقةٍ للعربيَّة القُرآنيَّة. التفسير المُقترح هو أن سلف العربيَّة القُرآنيَّة كانت العربيَّة التي يتحدث بها الأنباط، والسبب في عدم انتشار العربيَّة النبطيَّة على نطاقٍ واسع مِن خلال النقوش هو أن الأنباط عادةً ما يتركون سجلاتٍ مكتوبةٍ باللغة الآراميَّة بدلًا من لغتهم الأم. سننظر الآن في الآثار المُترتبة على أدلة "النظر من الأعلى" من مصادر عربيَّةٍ لاحقةٍ لما بعد القُرآن، وتحديدًا عدم قدرة الباحثين اللاحقين على تحديد اللهجة التي كُتب بها القُرآن.
لخص سي. رابين C. Rabin([34]) الأدبيات المُخصَصة لمُشكلة أصل اللغة العربيَّة على أساس المصادر الإسلاميَّة اللاحقة. بذل علماء اللغة المسلمون في العصور الوسطى جهودًا حثيثة لدراسة اللغة العربيَّة وتدوينها؛ بما في ذلك البحث عن أدلةٍ من اللهجات العربيَّة، وقد قام العلماء بالتحقيق في أدلتهم بعنايةٍ في النصف الأول من القرن العشرين. اتخذ علماء اللغة المسلمون لغة القُرآن الكريم معيارًا ذهبيًا للغة العربيَّة. في الوقت نفسه، اعتقدوا أيضًا أن العربيَّة القُرآنيَّة هي تنوعُ العربيَّة ذاته في الشعر الجاهليّ([35]). اعتمد علماء المسلمين الأوائل على هذه المجموعة الشعريَّة للمساعدة في توحيد العربيَّة الفصحى، واستكملوها بمعلوماتٍ مُستمدةٍ من متحدثي اللهجات البدويَّة، الذين اعتبروهم مُتحدثين للغة العربيَّة "الخالصة"([36]). وعلّق رابين ساخرًا بأن البدوي "لا يستطيع التحدث بالعربيَّة بشكلٍ خاطئٍ، حتى لو أراد ذلك"([37]).
كان الشِّعر العربيّ قبل القُرآن يُلقى في مراكز البلاط، مثل بلاط اللخميين في الحيرة ببلاد الرافدين([38])، وبلاط الغساسنة في الجابية ببلاد الشام. نعلم أيضًا أن الشُّعراء قَدِموا من مناطق لهجاتٍ عربيَّةٍ متنوعةٍ، وأن أسلوبهم الشِّعريّ كان مُوحدًا. لهذا السبب، أطلق العلماء على التنوع الشعريّ اسم "اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة poetic koiné"([39]).
افترضَ علماء اللغة المسلمون في العصور الوسطى، بطبيعة الحال، أن لغة القُرآن هي لهجةُ قبيلة مُحَمَّدٍ، قُريش. بيد أن رابين([40]) أفاد أنه بحلول أربعينيات القرن العشرين، نشأ إجماعٌ بين العلماء في الغرب أنه على الرغم من قبول لغة القُرآن على أنها كانت مبنيَّةٌ على اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة؛ فإنه لا يُمكن أن تكون هذه هي اللهجة المكيَّة: "هناك اتفاقٌ كبيرٌ بين العلماء في أوروبا على أن العربيَّة الفصحى، بالنسبة لمعظم أو كل من استخدمها في كتابة الشِّعر، كانت إلى حدٍ ما لغةً أجنبيَّة يجب اكتسابها"([41]). استند هذا الاستنتاج إلى فحصٍ دقيقٍ للروايات الواسعة في المصادر الإسلاميَّة بشأن اللهجات البدويَّة([42]). كانت هذه التناقضات معروفةً جيدًا لعلماء المسلمين في العصور الوسطى. على سبيل المثال، أشار ابن عَبد البر (ت. 463هـ/1071م) إلى أن بعض السمات اللغويَّة للقُرآن الكريم، مثل الحفاظ على الوقف الحنجريّ، تتعارض مع لهجات الحجاز([43]).
ردًّا على ذلك، افترض علماء اللغة المسلمون أن القُرآن الكريم جَمَعَ سماتِ مجموعةٍ واسعةٍ من اللهجات البدويَّة. على سبيل المثال، علّق السيوطيّ بأن القُرآن الكريم يحتوي على كلمات من جميع لهجات العرب([44]). وبطبيعة الحال، هذا هو على وجه الدقة ما قد يتوقعه المرء لو لم يكن قد كُتب بأيٍّ من لهجات البدو. يُلاحظ رابين أنه "من الصعب أن نفهم أن العلماء لم يُدركوا قط" أن "لغة البدو المنطوقة كانت مُختلفةً عن اللهجة الكلاسيكيَّة"([45]).
ينبثق تساؤلان من هذه النتائج. يتعلق أحدهما بأصل اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة، والآخر باستخدام القُرآن للهجة الإقليميَّة وعلاقته بها. لاحظَ رابين أنه "يبدو أنه لم يُحرز أيّ تقدمٍ في السنوات الأخيرة في حل إشكاليَّة أصل اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة ومنشأها"([46]). هذا هو "اللغز من الأعلى". يتعلق التساؤل الآخر بمُحَمَّدٍ باعتباره قارئًا للقُرآن، ولماذا كان يُخاطب المكيين بلهجةٍ إقليميَّةٍ شعريَّةٍ كانت سائدةً في البلاط العربيّ. عبّر رابين عن الأمر بقوله:
ما الأسباب التي دفعت مُحَمَّدًا إلى مُخاطبة قومه بلغةٍ نشأت، وكانت تُستخدم آنذاك، لأغراضٍ مُحددةٍ للغاية في المجتمع البدويّ، وعلى نحوٍ خاص في المناطق البعيدة نسبيًا عن مكة([47])؟
بغض النظر عن مسألة ما إذا كان المكان الأصليّ لنزول القُرآن هو مكة؛ يُقترح هنا أن شبكة التجارة النبطيَّة واسعة النطاق، التي تأسست على مدى قرون، ربما وفرتْ السياق لتطوير لهجةٍ إقليميَّةٍ عربيَّةٍ على أساس اللهجة النبطيَّة. في سياق تنوع اللهجات العربيَّة، وبدعمٍ من هيبة القوة النبطيَّة، يُقترح أن اللغة العربيَّة النبطيَّة هي مقدمةٌ لتطوير معيارٍ شِّعريٍّ عابرٍ للحدود، والذي استمر الشعراء في استخدامه في البلاطات العربيَّة النائية لقرون بعد أن تضاءل نفوذ النبطيين([48]). كانت هذه اللهجة الإقليميَّة مُشابهةً جدًّا للتنوع العربيّ الذي استخدمه الرسول القُرآنيّ في التلاوات التي أصبحت القُرآن. وبما أن اللغة العربيَّة النبطيَّة كانت تُستخدم مِن قِبل التجار الذين جابوا مناطق واسعة في جميع أنحاء المنطقة الناطقة بالعربيَّة؛ فإن اللغة القُرآنيَّة كانت مفهومةً مِن قِبل المتحدثين بمجموعةٍ واسعةٍ من اللهجات.
يبدو من غير المحتمل أن يَعتبر العرب البدو اللهجةَ الإقليميَّة الشعريَّة لغةً مُختلفةً عن لهجاتهم الأصليَّة([49]). كانوا سيتعرفون عليها ببساطةٍ على أنها لغةٌ عربيَّةٌ. وهذا يُفسّر ذهاب القُرآن إلى القول إن الرسول كان )يُبلّغ بِلِسَانِ قَوْمِهِ( [سورة إبراهيم: 4]؛ و)بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ( [سورة النحل: 103؛ وسورة الشعراء: 195]. كان ذلك واضحًا؛ لأنه كان بلغةٍ عربيَّةٍ متنوعةٍ يفهمها الجميع، وليس بالضرورة أنه كان باللهجة المحليَّة لجمهوره الأول.
من المُثير للاهتمام للنظر في هذه المناقشة أن مصطلح "نبطيّ" جاء للإشارة إلى الشِّعر الشفهيّ الأصليّ للبدو([50])، وهو الاستخدام الذي لا يزال مُستمرًا حتى يومنا هذا. ربما يعود أصل هذا الاستخدام لكلمة "نبطي" إلى زمنٍ سابقٍ بكثيرٍ عندما حُددتْ "اللهجة الإقليميَّة" الشعريَّة على أنها نوعٌ "نبطيّ"، ومِن خلال المجاز؛ فإن التنوع اللغويّ الذي كان يُؤدَى به الشِّعر قد أعطى اسمه للفن الشِّعريّ نفسه. يذكر پي. جيه إيمري P. G. Emery([51]) أنه "على الرغم من الاختلافات اللغويَّة؛ فإن الشِّعر النبطيّ والعربيّ الكلاسيكيّ يشتركان في عدة أوجه تشابهٍ شِّعريَّة، وموضوعيَّة، ووظيفيَّة".
الأدلة اللغويَّة
تناولنا حتى الآن "اللغز من الأعلى" و"اللغز من الأسفل"، واقترحنا، بناءً على أدلةٍ ظرفيَّةٍ، أن أفضل مُرشحٍ ليكون لهجةً سابقةً للهجة الإقليميَّة الشعريَّة ولغة القُرآن العربيَّة هي العربيَّة النبطيَّة، والتي كانت من الممكن استخدامها في جميع أنحاء شبكات التجارة النبطيَّة. في هذا القسم، نُقارن السمات اللغويَّة للعربيَّة القُرآنيَّة والعربيَّة النبطيَّة.
هناك نوعان من الأدلة اللغويَّة التي تربط العربيَّة القُرآنيَّة بالخط النبطيّ. أولهما هو: حقيقة أن الخط العربيّ تطور من الخط النبطيّ. وهذا يعني أن ثنائيي اللغة الذين يعرفون الآراميَّة النبطيَّة والعربيَّة هم من الذين أسسوا قواعد الإملاء في العربيَّة. نوعٌ آخر من الأدلة وهو وجود سماتٍ لغويَّةٍ مُشتركةٍ مُحددةٍ تربط العربيَّة النبطيَّة بالعربيَّة في الرسم القُرآنيّ.
سبق أن لاحظنا أن استخدام أداة التعريف "أل" كان سمةً نبطيَّةً. استخدمتْ اللهجات العربيَّة القديمة، بما فيها الصفويَّة النقوشيَّة، مجموعةً متنوعةً من أشكال أداة التعريف، بما في ذلك "الهاء"، و"الهن"، و"أل"، أو استغنت عن أداة التعريف تمامًا (مثل الحسمائيَّة([52])).
على الرغم من أن بعض الباحثين السابقين قد حددوا شكل "أل" بوصفها سمةً مُميِّزةً للنوع السابق للغة العربيَّة الفصحى؛ إلا أن الجلّاد([53]) ذهب إلى أن أداة التعريف "أل" ليست ابتكارًا يُمكن استخدامه لتمييز مجموعةٍ وراثيَّةٍ مُنفصلةٍ ضمن الأنواع العربيَّة. بدلًا من ذلك، يرى الجلّاد بأن جميع الأشكال المتنوعة لأداة التعريف في العربيَّة القديمة كانت مُنتشرةً عبر اللهجات.
بيد أنه ورغم أن أداة التعريف "أل" قد لا تكون ذات دلالةٍ وراثيَّةٍ بوصفها علامةً تأريخيَّةً؛ فإن تكرار استخدامها يُعد سمةً مُميِّزة للغة العربيَّة النبطيَّة؛ إذ تُعتبر الشكل الوحيد لأداة التعريف الموثقة. من ناحيةٍ أخرى، في لهجات البدو العربيَّة القديمة، كانت أداة التعريف "أل" غير قياسيَّة([54]). لذا، في تواترها، تربط أداة التعريف "أل" لغة القُرآن، من حيث تكرارها، بالعربيَّة النبطيَّة، حتى لو لم تكن علامةً وراثيَّةً موثوقةً للتطور التأريخيّ في العربيَّة القديمة.
هناك سماتٌ أخرى تربط الرسم القُرآنيّ بالخط العربيّ اليونانيّ - وهو خطٌ عربيٌّ مكتوبٌ بأحرفٍ يونانيَّةٍ - بالعربيَّة البترائيَّة، معقل الأنباط في جنوب بلاد الشام. فبعد غزو الرومان لهم عام 106م، تحوّل الأنباط تدريجيًا إلى استخدام اليونانيَّة بوصفها لغةً للتواصل الكتابيّ الرسميّ([55]). هناك عددٌ كبيرٌ من النقوش والبرديات اليونانيَّة العربيَّة اللاحقة من مناطق الأنباط في جنوب بلاد الشام، وكما لاحظ الجلّاد([56])؛ فإن السمات اللغويَّة لهذه المواد "تتفق عادةً" مع البنيَّة العربيَّة للخط النبطيّ مُقابل النقوش "الشماليَّة العربيَّة القديمة"، وعلى نحوٍ خاص في استخدام أداة التعريف αλ، التي تعكس "أل"، والنهاية المؤنثة -α، التي تعكس "ـه" على عكس "ـة". يُمكن الإشارة إلى لهجات جنوب بلاد الشام على نحوٍ عام بالنبطيَّة.
أصبح التحليل في هذا القسم مُمكنًا بفضل المسح الرائع الذي أجراه الجلّاد للمنطقة اليونانيَّة العربيَّة في جنوب بلاد الشام. يُعرّف الجلاد([57]) هذه المنطقة بأنها تشمل: "جنوب سُوريَة (مناطق تشمل اللجاة، أي تراخونيتس، وأم الجِمال، وبُصرى، وحوران)، ووسط الأردن وجنوبه (بما في ذلك مناطق، مثل موآب، وأدوم، والبتراء، وحسمى)، وفلسطين (مناطق في النقب، مثل بئر السبع، والخلصة، وتل نيتسانا)." تتزامن هذه المنطقة مع المنطقة التي كانت تحت سيطرة الأنباط قبل الغزو الرومانيّ للبتراء عام 106م([58]، والتي أُعيدت تسميتها بالعربيَّة البترائيَّة بعد الفتح، وأُديرت من بصرى، عاصمة الأنباط الشماليَّة السابقة. نظرًا إلى الاستقرار السياسيّ في العربيَّة البترائيَّة بعد سقوط مملكة الأنباط عام 106م، واستمرار نفوذ بُصرى، التي كانت مدينةً نبطيَّةً رئيسة؛ فليس من المستغرب أن تُشير دراسة الجلّاد لعام 2017م للهجة العربيَّة اليونانيَّة في هذه المنطقة إلى الاتساق والتوحيد في سمات اللهجة التي تجعل مجموعةَ اللهجات العربيَّةٍ البترائيَّةٍ اليونانيَّة مُنسجمةً مع العربيَّة النبطيَّة.
السمات الخمس التي سنأخذها هنا في الاعتبار هو الإعراب الذي يأتي في نهاية الكلمة؛ والنهاية المؤنثة "ـة/ـه"؛ والألف المقصورة؛ والاحتفاظ بالوقف الحنجريّ، واستيعاب أداة التعريف "أل" في الحروف الشمسيَّة.
تعتمد الحُجج المُقدمة هنا على افتراضيْن: 1) إن تهجئة الرسم القُرآنيّ كانت صوتيًّا في الوقت الذي أصبح فيه النص العربيّ ثابتًا، و2) تعكس أنماط القافية في القُرآن علم الأصوات في اللهجة التي كُتب بها القُرآن وتُلي لأول مرة. سنرى أنه في كلٍّ من هذه النواحي، يتفق الرسم القُرآنيّ مع ما نعرفه عن العربيَّة البتراء اليونانيَّة-العربيَّة، وتحديدًا مع العربيَّة البتراء وحيثما تتوافر الأدلة. وقد أقرّ الجلّاد بهذا قائلًا: "يتفق الخط العربيّ اليونانيّ [في جنوب بلاد الشام] على نحوٍ عام مع قواعد الإملاء القُرآنيَّة"([59]). بيد أن الحُجج المُقدمة هنا أكثر شمولًا، وتأخذ في الاعتبار أيضًا الأدلة المُستمَدة من أنظمة القافية القُرآنيَّة لعلم الأصوات القُرآنيّ.
فُقدان الإعراب
في النص القُرآني، تُميَّز حروف العلة القصيرة غير المُشددة في نهاية الكلمة، بالإضافة إلى "التنوين"، بعلامات التشكيل: فهي غير مُمثلة في الرسم. تُعرف هذه النهايات باسم "الإعراب"؛ لأنها كانت من سمات لهجات البدو، في مُقابل اللهجات الحضاريَّة المُستقرة([60]). على الرغم من أن الشِّعر العربيّ الكلاسيكيّ ما قبل القُرآنيّ أدرج نهايات الإعراب في قافياته([61])؛ فإن القُرآن لا يفعل ذلك. يُمكن توضيح ذلك مِن خلال سورة الفاتحة التي تتضمن قافية فيها "ين/يم"؛ لكن النهايات التصريفيَّة المُضافة بعد هذا المقطع، والمُميَّزة بعلامات التشكيل، تتراوح بين "أ"، و"و"، و"ي".
إن عدم اكتراث القافية القُرآنيَّة بنهايات الكلمات يدل على أن النهايات قد فُقدتْ في اللهجة التي تُلي بها القُرآن لأول مرة. يتفق هذا مع ما نعرفه عن العربيَّة النبطيَّة، التي فقدت نهايات الكلمات بنهاية القرن الأول قبل الميلاد([62])، كما حدث مع العربيَّة الشاميَّة الجنوبيَّة بحلول القرن السادس الميلاديّ([63]). يُلخص الجلّاد([64]) أدلة اللهجة على النحو الآتي: "بحلول القرن السادس الميلاديّ، لم يعد هناك شكٌ في فقدان تصريف الكلمات، على الأقل في فلسطين الثالثة".
الهاء في آخر الكلمة والتاء المربوطة
تُرجمت النهاية المؤنثة "ـة" في العربيَّة البدائيَّة (والساميَّة البدائيَّة) إلى "ـه" في الصيغة القُرآنيَّة. في العربيَّة النبطيَّة، تغيّرت النهاية المؤنثة "ـة" إلى "ـه" في وضعيَّةٍ الوقوف (غير مبنيَّة) بحلول القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير([65])، عقب تغييرٍ موازٍ حَدَثَ سابقًا في العبريَّة([66]). بعض الاستعارات العربيَّة إلى النبطيَّة تسبق هذا التغيير؛ بينما تسبقه أخرى([67]). الدليل على وجود نهايةٍ سابقةٍ لهذا التغيير الصوتيّ هو الاسم النبطي "أريتاس" (Aretas) المذكور في سفر المكابيين الثاني: 5: 8 (حوالي 124ق.م)، والذي يعكس كلمة "حارثة" العربيَّة. استشهد أفنر Avner ونهمي Nehmé وروبن Robin([68]) بمثالٍ من أواخر القرن الخامس الميلادي لاسم "تعلبه"، الموجود في نقشٍ عربيٍّ نبطيٍّ انتقالي.
أصبح تغيير "ـه" إلى "ـة" سمةً إقليميَّةً للغة العربيَّة الشاميَّة الجنوبيَّة. يخلص الجلّاد، استنادًا إلى أدلة النقوش اليونانيَّة الرومانيَّة، إلى أنه بحلول القرن الرابع الميلاديّ، انتشر هذا الابتكار في جميع المستوطنات المُستقرة في جنوب بلاد الشام. في المُقابل، لا تُظهر نقوش الصحراء العربيَّة الشماليَّة القديمة هذا التغيير؛ حيث احتفظت بـ "ـة" في جميع المواضع([69]). وهكذا يصف الجلاد([70]) التغيير إلى "ـه" بأنه تطابقٌ لغويٌّ يفصل بين اللهجات العربيَّة المُستقرة واللهجات المكتوبة في النقوش الصخريَّة التي كتبها بدو الصحراء في منطقة الحرّة.
في رسم القُرآن الكريم، يُنتظم تغيير "ـة" إلى "ـه" في جميع المواضع؛ بما في ذلك السياقات غير المبنيَّة. بيد أنه استُعيد نطق "ـه" في المواضع غير المُتوقفة إلى "ـة" بإضافة نقطتيْن متراكبتين "نقطة التاء" فوق "الهاء" للحصول على "تاء مربوطة". هذا يعني أن تغيير "ـة" إلى "ـه" قد انتظم في جميع المواضع في اللهجة التي حَددت في الأصل قواعد كتابة الرسم القُرآنيّ.
إن حقيقة أن هذا لم يكن مجرد عٌرفٍ إملائيٍّ؛ بل طريقة تلاوة القُرآن الكريم في الأصل؛ واضحةٌ من أنماط القافية القُرآنيَّة، حيث تتناغم نهايات "التاء المربوطة" المفردة المؤنثة مع "الهاء" العادية دون تمييز. من الأمثلة على ذلك: الآيتان 12-13 من سورة عبس، حيث تتناغم كلمة )ذَكَرَهُ( مع كلمة )مُكَرَّمَةٍ(، والآيتان 18-19 من سورة الحاقة، حيث تتناغم كلمة )خَافِيَةٌ( مع كلمة )كِتَابِيَهْ(. بافتراض أن نهايات الكلمات والحروف المتحركة غير المُشددة في آخرها قد فُقدت؛ لكان من الممكن في الأصل تلاوة الزوج المقفيّ الأول على شكل قد قُرئ في الأصل "ذكره" و"مكرمه"، والزوج الآخر "خافيه" و"كتابيه"، مع تمييز المقاطع المُتناغمة (المقّفاة) بخطٍّ عريضٍ. الآيات القُرآنيَّة التي تتناغم فيها "التاء المربوطة" مع "الهاء" العادية هي: سورة الحاقة: 1-32؛ وسورة القيامة: 1-6، و14-25؛ وسورة عبس: 11-24، و33-42؛ وسورة العلق: 15-18؛ وسورة البيّنة: 1-8؛ وسورة القارعة: 1-11؛ وسورة الهُمزة: 1-9.
من ناحيةٍ أخرى، لا تتناغم "التاء المربوطة" مع "التاء" العادية أبدًا. تُوضح سورة الغاشية التباين، مع إبقاء "التاء المربوطة" مُنفصلةً عن "التاء": تتوافق الآيات 8-16 من سورة الغاشية مع "التاء المربوطة" باستمرار، ثم تنتقل الآيات 17-20 من سورة عبس إلى قافيةٍ مُتسقةٍ مع "التاء العادية. يَفصل نظام القافية بين الاثنيْن؛ مما يدل على أن "التاء" العادية لم تكن الصوت نفسه مثل "التاء المربوطة".
تُشير أدلة القوافي إلى أنه في الوقت الذي تُلي فيه القُرآن لأول مرة، كانت "التاء المربوطة" تُنطق في واقع الأمر "هاء" في كل المواضع، وهي الطريقة التي تُكتب بها في الرسم. من الواضح أن اللهجة التي تُليت بها القُرآن في الأصل قد نظّمت هذه السمة الشاميَّة الجنوبيَّة في كل أنحاء الأنموذج بأكمله، بما في ذلك المواضع غير الوقفيَّة. يُمثل هذا التنظيم مرحلةً مُتقدمةً في استبدال "ـة" بـ "ـه"، وعلى هذ النحو، فمن المرجح أنه حَدَثَ في جنوب بلاد الشام، حيث سُجِّل هذا التغيير الصوتيّ لأول مرةٍ في العربيَّة النبطيَّة.
يُميِّز هذا التغيير "ـة"، "ـه" العربيَّة النبطيَّة، ولغة المستوطنات التي خضعت لسيطرة النبط، عن النقوش العربيَّة لبدو الحرّة، التي احتفظت بـ "ـة"، وكذلك عن اللهجات البدويَّة، التي حددتْ لاحقًا القراءة الموحدة للقُرآن الكريم؛ إذ صُحِّحت الكتابة الإملائية لـ "الهاء" للرسم إلى "التاء"، ومُيّز إملائيًا بالإشارة إلى "التاء المربوطة"([71]).
الألف المقصورة
معنى الألف المقصورة هي استخدام حرف "ى" بدلًا عن "الياء" في نهاية الكلمة دون نقاطٍ تحتانيَّةٍ في العربيَّة الفصحى لتمثيل /آ/. على سبيل المثال، يُنطق حرف العلة في كلمة "على" إملائيًا /علا/. وهو ما يعكس نطق "ـي" في العربيَّة البدائيَّة. يذهب الجلّاد([72]) إلى أن النقش اليونانيّ النبطيّ يدعم نطق /æ: / لانعكاسات "ـي" في اللغة العربيَّة النبطيَّة. على سبيل المثال، في النقش، كُتبَ الإله النبطيّ ודשרא (ذو شرى): Δουσαρει، وليس على هيئة Δουσαρης([73]).
قبل ثمانين عامًا، لاحظ بيرغستاسر Bergstässer وبريتزل Pretzl([74]) أن قراءة /أ/ المكتوبة على هيئة ألفٍ مقصورةٍ لا تتناغم مع /أ/ المكتوبة على هيئة "ألف" في القُرآن الكريم، وتوصلا إلى نتيجة الجلّاد نفسها؛ استنادًا إلى الأدلة اليونانيَّة العربيَّة، وهي أن "الألف المقصورة" تعكس حرف علةٍ مُميَّزًا؛ نُسخ إلى "ألف". على سبيل المثال، قارن بين سورة الشمس ذات قافية الألف، وسورة الليل ذات قافية الألف المقصورة، وسورة النازعات التي تحتوي على مقاطع متناوبة ومتميِّزة من قافية الألف (النازعات: 27-32، 42-46) وقافية الألف المقصورة (سورة النازعات: 15-26، 34-41)، دون أيّ تداخلٍ بين القافيتيْن([75]).
لاحظَ الجلّاد([76]) أن الخط العربيّ اليونانيّ "يتفق عمومًا مع قواعد الإملاء القُرآنيَّة" في معالجته لحرف الياء. وهنا أيضًا تُظهر الأدلة إلى أن نُطق العربيَّة القُرآنيَّة وقت تلاوتها الأولى يتوافق مع العربيَّة النبطيَّة.
الاحتفاظ بالوقفة الحنجريَّة (أداة التعريف غير المحذوفة)
بينما تُحذف في التلاوة المعياريَّة للقُرآن الكريم الوقفة الحنجريَّة وحرف العلة في أداة التعريف واستبدالهما بحرف علةٍ مُضاف؛ يُبقي الرسم القُرآنيّ على الألف؛ مما يدل على عدم الحذف([77]). على سبيل المثال، يُقرأ تسلسل الحروف الساكنة "بسم الله" كـ /بسمِ اللهِ/. بيد أن الاحتفاظ بـ "الألف" في رسم القُرآن الكريم يُشير إلى أن الـ "أ" لم تُحذف في اللهجات العربيَّة، والتي على أساسها ثُبتتْ قواعد الرسم الإملائيَّة. وعلى نحوٍ مُماثل، لم يُحذف النطق الصوتيّ لأداة التعريف في اللغة اليونانيَّة العربيَّة في جنوب بلاد الشام، حتى بعد حروف العلة، كما هو موضحٌ، على سبيل المثال، Χαφφιαλογοµ/كافي العجوم/ من برديات البتراء([78]) ([79]). في هذا الصدد أيضًا يتوافق الرسم القُرآنيّ مع العربيَّة النبطيَّة.
أدوات التعريف غير المستوعبة
دليلنا الأخير يتعلق باستيعاب أداة التعريف "أل" لحرفٍ ساكنٍ شمسيٍّ يليها، وهو ما يُشار إليه في قواعد الإملاء العربيَّة بعلامة "الشدة". هنا أيضًا يتوافق عدم الاستيعاب في الرسم القُرآنيّ مع أدلة النقوش اليونانيَّة العربيَّة والنبطيَّة، وكذلك مع النقوش الصفويَّة والحسمائيَّة([80]). هناك أدلةٌ برديةٌ من البتراء تعود إلى القرن السادس الميلاديّ على عدم استيعاب "أل"([81]). على سبيل المثال، عُثر على كلمة ελδαργαθ، التي تعكس /الدرجات/، في مخطوطةٍ يرجع تأريخها إلى عامي 579-580م([82]). وهذا هو دليلنا الخامس الذي يربط العربيَّة القُرآنيَّة باللهجة النبطيَّة.
بالإمكان التمييز بين اللهجة العربيَّة التي ترسخت فيها قواعد الرسم الإملائيَّة، واللهجة التي تُلي بها القُرآن لأول مرة. ليس بالضرورة أن يكون الاثنان مُتماثليْن. ولن يكون مُفاجئًا أن تكون قواعد الإملاء المُبكرة للغة العربيَّة مبنيَّةٌ على العربيَّة النبطيَّة؛ إذ إنه من الثابت أن قواعد الإملاء العربيَّة تطورت من الخط الآراميّ النبطيّ. في واقع الأمر، فيما يتعلق بكلٍ من السمات الخمس التي فحصناها؛ فقواعد إملاء الرسم تتوافق مع ما نعرفه عن العربيَّة النبطيَّة. علاوةً على ذلك، فإن السمات الثلاث الأولى، المُنعكسة في أنظمة القافية القُرآنيَّة، تُشير أيضًا إلى أن العربيَّة النبطيَّة هي التنوع الذي تُلى به القُرآن لأول مرة.
في شأن كل سمةٍ من السمات اللغويَّة التي أخذناها في الاعتبار؛ يتوافق رسم القُرآن مع العربيَّة النبطيَّة. ويُؤكد هذا الدليل اللغويّ الدليلَ الظرفيّ على "اللغز من الأعلى" و"اللغز من الأسفل"، على أن اللهجة التي كُتب بها القُرآن هي العربيَّة النبطيَّة.
لسانٌ بدويٌّ أصيل؟
هناك تناقضٌ مُحتملٌ في مفهوم الهويَّة العربيَّة وأصل اللغة العربيَّة القُرآنيَّة المطروحة هنا. فمن جهة، جادلنا بأن العربيَّة النبطيَّة، التي ارتبطت بالتجارة والاستيطان الزراعيّ والثقافة البلاطيَّة، شكّلت المعيار العربيّ للإمبراطوريَّة العربيَّة الناشئة ودينها؛ بما في ذلك العربيَّة (سورة يُوسف: 2) التي كُتب بها القُرآن وتُحدِثَ بها. من جهةٍ أخرى، حظي البدو الرحل، أو الأعراب، بتقديرٍ كبيرٍ؛ كونهم النموذج الأوليّ للهويَّة العربيَّة.
يتجلى هذا التناقض إلى حدٍّ ما في القُرآن الكريم. من ناحية، يفخر القُرآن الكريم بأن يتحدث بلسانٍ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (سورة النحل: 103؛ وسورة الشعراء: 195)، بينما يُعبّر من ناحيةٍ أخرى عن موقف ازدرائيّ تجاه من يُطلَق عليهم لقب "الأعراب" (سورة التوبة: 90؛ 97-98؛ 101؛ وسورة الفتح: 11، 16؛ وسورة الُحجرات: 14). هؤلاء هم البدو القاطنين في الصحراء (سورة الأحزاب: 33)، مُقارنة بسكان المدن المُستقرين (سورة التوبة: 120)، الذين يُشكّلون الجمهور الرئيس للرسول القُرآنيّ. تعاطف الرسول الكريم مع سكان المدن، ويبدو من الثابت أن اللغة العربيَّة المُستخدمة في الرسم القُرآني كانت لهجةً قياسيَّةً مُستقرةً، بل حضريَّةً، أنموذجيَّةً للمدن والقرى النبطيَّة؛ وليست لهجةً بدويَّةً. من المفهوم أيضًا أن العلماء المسلمين اللاحقين - وكثيرٌ منهم ليسوا عربًا([83])- قد انبهروا بفكرة الصورة النمطيَّة العربيَّة البدويَّة الصرفة، والتي تنعكس في المقولة "أفصح العربيّ أبرهم"([84]). بناءً على هذا الافتراض؛ حاول العلماء المسلمون في العصور الوسطى إزالة الطابع الحضريّ عن أصول العربيَّة القُرآنيَّة مِن خلال الحصول عليها من مكانٍ ما في الصحراء العربيَّة. أدى هذا إلى دمج فكرتيْن: الضرورة العقائديَّة بأن لغة القُرآن نقيَّةً، والصورة النمطيَّة بأن لغة (وثقافة) البدو نقيَّةً. اجتمعتْ هاتان الفكرتان في فكرةٍ واحدة: إن لسان القُرآن بدويٌ نقيٌّ. دفع هذا العلماء المسلمين إلى بذل جهودٍ كبيرةٍ لتحديد اللهجة (أو اللهجات) البدويَّة التي يُمكن أن تُشكِّل التنوع اللغويّ للقُرآن. يبدو أنه لم يخطر ببالهم أن هذا التنوع يُمكن العثور عليه بين مستوطنات جنوب بلاد الشام التي اعتنقت المسيحيَّة بحلول عصر الفتوحات العربيَّة.
الآثار المُترتبة على تأريخ القُرآن
هذا السرد عن أصل اللغة العربيَّة وظهوره له آثارٌ على تأريخ القُرآن. فعندما ينص القُرآن على أن الله لا يُرسل رسولًا إلا بلسان قومه (سورة إبراهيم: 4)؛ فهذا يعني – نظرًا لأن هيكل الحروف الساكنة مكتوبةٌ بالعربيَّة النبطيَّة - أن "قوم" الرسول القُرآنيّ كانوا ناطقين أصليين للغة النبطيَّة الإقليميَّة. ولا بد أن لقب )أُمَّ الْقُرَى( [سورة إبراهيم: 7] ينطبق على مستوطنةٍ حضريَّةٍ في منطقة النفوذ النبطيّ. من الصعب تصور أن يكون هذا المكان مُنطبقًا على مكة. من ناحيةٍ أخرى، لو كان مُحَمَّدٌ يُناقش أهل مكة بلغتهم الأم، لكانت لهجةً بدويَّةً، وليست لهجة إقليميَّةً. في ضوء الأدلة التي تربط العربيَّة النبطيَّة بالقُرآن الكريم؛ يبدو من غير المعقول أنه بحلول أواخر القرن السابع الميلاديّ، كان أهل مكة البدو يتحدثون اللغة العربيَّة الفصحى (سورة النحل: 103؛ وسورة الشعراء: 195) الواردة في القُرآن الكريم بوصفها لغتهم الأم. في واقع الأمر، وكما رأينا، وجد النحويون المسلمون في العصور الوسطى أن اللهجة المكيَّة انحرفت عن المعيار القُرآنيّ.
الخاتمة
تُشير الأدلة المُقدَمة هنا إلى أن اللهجة العربيَّة التي تُلي بها القُرآن الكريم وكُتب بها كانت نبطيَّةً. يُقترح أن اللهجة النبطيَّة كانت مفهومةً على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء المنطقة الناطقة بالعربيَّة بفضل شبكات التجارة النبطيَّة. لم تُعتبر لغةً مُختلفةً عن اللهجات البدويَّة المحليَّة؛ بل شكلًا "بيّنًا" من اللغة العربيَّة. لقد تطوّر تقليدٌ شِّعر البلاط، الذي ربما استند على اللهجة النبطيَّة، في العصر الجاهليّ؛ متأثرًا بلا شك بمدينة بُصرى النبطيَّة السابقة، التي أصبحت عاصمة العربيَّة البترائيَّة([85]). هذا يُفسر سبب تحديد النحويين المسلمين للهجة الإقليميَّة الشعريَّة على أنها اللهجة العربيَّة القُرآنيَّة نفسها. في وقتٍ لاحقٍ، وفي سياق توحيد تلاوة القُرآن الكريم، أُضيفت سماتٌ لهجيَّةٌ أخرى إلى رسم القُرآن، وتميّزت بعلامات التشكيل، بما في ذلك نهايات الكلمات، واستيعاب أداة التعريف، وهي سماتٌ لم تكن من سمات اللهجة التي كُتب بها القُرآن في الأصل([86]).
يُفسر هذا الأنموذج لمصدر العربيَّة القُرآنيَّة أدلة النقوش التي سبقت الإسلام، بالإضافة إلى شهادة علماء اللغة المسلمين الذين وحدوا اللغة العربيَّة الفصحى. إنه يحل اللغز من الأسفل، وكذلك اللغز من الأعلى. كما أنه يتوافق مع الأدلة اللغويَّة التي تؤكِد أن العربيَّة النبطيَّة تتماشى مع التنوع اللغويّ الموثق في رسم القُرآن.
حل اللغز من الأسفل يتمثل في أن الأدلة المكتوبة على وجود سلفٍ للغة العربيَّة الفصحى نادرةُ الظهور في النقوش؛ لأن الأنباط الذين تحدثوا النوع السابق فضّلوا الكتابة بالآراميَّة (ولزمنٍ من الوقت، باليونانيَّة). حل اللغز من الأعلى هو أنه ثبت استحال على علماء اللغة المسلمين الأوائل تحديد اللهجة المصدريَّة للغة العربيَّة القُرآنيَّة بين القبائل البدويَّة المُختلفة التي بحثوا عنها؛ لأن العربيَّة النبطيَّة لم تكن تنوعًا بدويًّا. على أيَّة حال، لم تعد البتراء موجودةً، وتبددت الهويَّة النبطيَّة، ولم تعد العربيَّة النبطيَّة النوع المُميَّز لأيّ قبيلةٍ بعينها، بل أصبحت إرثًا لغويًا للمُزارعين في جنوب بلاد الشام، وفي اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة، الملكيَّة المشتركة للعرب([87]).
قائمة المصادر والمراجع
- Ammianus Marcellinus (1950) History. tr. J. C. Rolfe. 3 vols. Cambridge, MA: Loeb.
- Arjava, A., M. Buchholz, and T. Gagos, The Petra Papyri III (Amman: American Center of Oriental Research, 2007).
- Avner, Uzi, Laïla Nehmé, and Christian Julien Robin, ‘A Rock Inscription Mentioning Thaʿlaba, an Arab King from Ghassān’, Arabic Archaeology and Epigraphy 24: 2 (2013), pp. 237–256
- Avi-Yonah, Michael and Shimon Gibson (2007) ‘Petra’, in Fred Skolnik and Michael Berenbaum (eds.), Encyclopaedia Judaica. (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 16: 17-18).
- Bannister, Andrew G. (2014) An Oral-Formulaic Study of the Qur’an. Plymouth: Lexington Books.
- Blachère, Régis (1947) Introduction au Coran. Paris: G.-P. Maisonneuve.
- Blachère, Régis, Histoire de la littérature arabe: des origines à la fin du XVe siècle de J.C. 1 (Paris: Adrien Masionneuve, 1952).
- Bergsträsser, G., and O. Pretzl. 1938. Die Geschichte des Qorāntexts. Vol. 3. Leipzig: T. Weicher.
- Beyer, K., Die aramäischen Texte vom Toten Meer, Vol. 2. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004).
- Diem, Werner, ‘Die nabatäischen Inschriften und die Frage der Kasusflexion im Altarabishen’, Der Deutschen Morgenländishcen Gesellschaft 123: 2 (1973), pp. 227–237
- Emery, P. G. (1993) ‘Nabaṭī’, in C. E. Bosworth, et al. (eds.), The Encyclopaedia of Islam. New edn., Vol. 7. (Leiden: Brill, 7: 838).
- Fahd, T. (1993) ‘Nabaṭ al-ʿIrāḳ’, in C. E. Bosworth, et al. (eds.), The Encyclopaedia of Islam. New edn., Vol. 7. (Leiden: Brill, 7: 835-838).
- Fleish, Henri (1947) Introduction à l’étude des languages sémitiques: éléments de bibliographie. Paris: Adrien- Maisonneuve.
- Fraenkel, Siegmund (1886) Di Aramäischen Fremdwörter in Arabischen. Leiden: Brill. Greenfield, J., ‘Some Arabic Loanwords in the Aramaic and Nabataean Texts from Naḥal Ḥever’, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 15 (1992), pp. 10–21
- Gzella, H., Tempus, Aspekt Und Modalität in Reichsaramäisichen (Wiesbaden: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission 48, 2004).
- al-Hamad, M.F. (2014) ‘Nabataean in contact with Arabic: grammatical borrowing’,
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 44: 1-10
- Healey, J., The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada’in Salih (Oxford: Journal of Semitic Studies Supplement 1, 1993).
- Hoyland, Robert G. (1997) ‘The content and context of the early Arabic inscriptions’,
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 21: 77-102
- ———, (2001) Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam. London: Routledge.
- ———, (2008) ‘Epigraphy and the linguistic background to the Qurʾān’, in Gabriel Said Reynolds (ed.), The Qurʾān in its Historical Context. (London: Routledge, 51-69).
- al-Jallad, Ahmad, ‘On the Genetic Background of the Rbbl Bn Hfʿm Grave Inscription at Qaryat Al-Fāw’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies Available on CJO 2014 doi: 10.1017/S0041977X14000524, (2014), pp. 1–21
- ———, An Outline of the Grammar of the Safaitic Inscriptions (Leiden: Brill, 2015).
- ———, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’ in Ahmad Al-Jallad (ed.), Arabic in Context. (Louvain: Brill, 2017), pp. 99–186
- Jeffery, Arthur (1938) The Foreign Vocabulary of the Qurʾān. Baroda: Oriental Institute.
- Josephus, Flavius (n.d.) The Complete Works of Josephus: Antiquities of the Jews, the Wars of the Jews Against Apion, Etc., Etc. trans. Syvert Havercamp and William Whiston, New York: Bigelow, Brown & Co.
- Joukowsky, Martha Sharp (2007) ‘Nabateans’, in Fred Skolnik and Michael Berenbaum (eds.), Encyclopaedia Judaica. (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 14: 716-717).
- Knauf, Ernst Axel (2011) ‘From ancient Arabic to early standard Arabic’, in Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx (eds.), The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu. (Leiden: Brill, 197-254).
- Koenen, L., J.M. Kaimio, and R.W. Daniel, The Petra Papyri II (Amman: American Center of Oriental Research, 2013).
- al-Khraysheh, F. H., ‘New Safaitic Inscriptions from Jordan’, Syria 72 (1995), pp. 401–414
- Littmann, E., D. Magie, and D. R. Stuart, Publications of the Princeton University
Archaeological Expeditions to Syria in 1904–1905 and 1909, Division III. Greek and Latin Inscriptions in Syria, Section A. Southern Syria (Leiden: Brill, 1907-1921).
- Lane, E.W. (1863) Arabic-English Lexicon. London: Williams and Norgate.
- Macdonald, M.C.A. (1993) ‘Nomads and the Hawran in the late hellenistic and roman periods: a reassessment of the epigraphic evidence’, Syria 70: 303-413
- ———, (2000) ‘Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia’, Arabian archeology and epigraphy 11: 28-79
- ———, (2003) ‘Languages, scripts and uses of writing among the Nabataeans’, in Glenn Markoe (ed.), Petra Rediscovered: Lost City of the Nabataeans. (New York: Harry N. Adams, Inc, 36-56).
- ———, (2004) ‘Ancient North Arabian’, in Roger D. Woodard (ed.), The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. (Cambridge: CUP, 488-533).
- ———, (2006) ‘Literacy in an oral environment’, in Piotr Bienkowski, Christopher Mee, and Elizabeth Slater (eds.), Writing and Ancient Near Eastern Society. (London: Bloomsbury, 45-114).
- ———, (2008) ‘Old Arabic (epigraphic)’, in Kees Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. (Leiden: Brill, 3: 464-477).
- ———, (2009a) ‘Ancient Arabia and the written word’, in M.C.A. Macdonald (ed.), The Development of Arabic as a Written Language: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies Held on 24 July 2009. (Oxford: Archaeopress, 5-27).
- ———, (2009b) ‘Arabs, Arabias and Arabic before late antiquity’, Topoi 16: 277-332.
- ———, (2009c) Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia. Surrey: Farnham: Ashgate.
- ———, (2009d) ‘The decline of the “epigraphic habit” in late antique Arabia: some questions’, in Christian Julien Robin and Jérémie Schiettecatte (eds.), L’Arabie à la veilee de l’Islam. (Paris: De Boccard, 17-27).
- ———, (2009e) ‘On Saracens, the Rawwāfah inscription and the Roman Army’, Literacy and identity in pre-Islamic Arabia. (Farnham/Burlington, VT: Ashgate, 1-26).
- Mascitelli, D., L’arabo in epoca preislamica: formazione di una lingua (Rome: Arabia Antica 4, 2006).
- Morgenstern, M., ‘The History of the Aramaic Dialects in the Light of the Discoveries from the Judaean Desert. The Case of Nabataean’ in B. A. Levine, P.J. King, J. Naveh, and E. Stern (eds.), Eretz-Israel. Archaeological, Historical and Geographical Studies. (Jerusalem: Frank Moore Cross Vol. 26, 1999), pp. 134–142
- Nehmé, Laïla (2009) ‘A glimpse of the development of the Nabataean script into Arabic based on old and new epigraphic material’, in M.C.A. Macdonald (ed.), The Development of Arabic as a Written Language: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies Held on 24 July 2009. (Oxford: Archaeopress, 47-88).
- Nevo, Yehuda D. and Judith Koren (2003) Crossroads to Islam: The Origins of the Arab Religion and the Arab State. Amherst, NY: Prometheus Books.
- Nöldeke, Theodor and Friedrich Schwally (1919) Die Sammlung des Qorāns: mit einem literarhistorischen Anhang über die muhammedanishcen Quellen und die neurere christliche Forschung. Geschichte des Qorāns, 2. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung.
- O’Connor, M. (1986) ‘The Arabic loanwords in Nabataean Aramaic’, Journal of Near Eastern Studies 45(3): 213-229
- Rabin, Chaim (1951) Ancient West Arabian. London: Taylor’s Foreign Press.
- ———, (1955) ‘The beginnings of Classical Arabic’, Studia Islamica 4: 19-37
- Rabinovitch, I. (1956) ‘Aramaic inscriptions of the fifth century BCE from a North-Arab shrine in Egypt’, Journal of Near Eastern Studies 15(1): 1-9.
- Retsö, Jan (2011) ‘Petra and Qadesh’, Svensk Exegetisk Årsbok 76: 115-136
- ———, (2013) ‘What is Arabic?’, in J. Owens (ed.), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics. (Oxford: OUP, 433-540).
- Versteegh, Kees (1984) Pidginization and Creolization: The Case of Arabic. Amsterdam:
([1]) مايكل سي آي ماكدونالد، "لغة شمال جزيرة العرب القديمة"، Macdonald, M.C.A, (2004) ‘Ancient North Arabian’, in Roger D. Woodard (ed.), The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. (Cambridge: CUP, 488-533).
وضع الجلاد (أحمَد الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, Ahmad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’ in Ahmad Al-Jallad (ed.), Arabic in Context. (Louvain: Brill, 2017), pp. 99–186) تعريفًا للغة العربيَّة القديمة مِن خلال تحديد سماتٍ مُميِّزة مُشتركة. باستخدام هذه السمات المُميِّزة؛ خلص إلى أن الصفائيَّة والحسمائيَّة، وهما نوعان من اللهجات المعروفة سابقًا باسم "الشمال العربيّ القديم"، يُمكن اعتبارهما نوعيْن من اللهجات العربيَّة القديمة؛ لكنه استبعد أنواعًا أخرى من "الشمال العربيّ القديم"، مثل التيمانيَّة والثموديَّة، من مجموعة اللهجات العربيَّة القديمة. اعترض كناوف، إرنست أكسل (2011). "من العربيَّة القديمة إلى العربيَّة الفصحى المُبكرة"، Knauf, Ernst Axel (2011) ‘From ancient Arabic to early standard Arabic’, in Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx (eds.), The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu. (Leiden: Brill, 207)، سابقًا على "العربيّ القديم"، مُقترحًا أن "العربيَّة القديمة" هي التسميَّة الأفضل. كما أشار ريتسو، يان (2013) "ما اللغة العربية؟"، Retsö, Jan (2013) ‘What is Arabic?’, in J. Owens (ed.), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics. (Oxford: OUP, 438)، إلى أن بعض اللهجات العربيَّة الحديثة المحكيَّة في اليمن تحتوي على أداة تعريف "أن" و"م"، وعلى هذا الأساس؛ خلص إلى أن أداة التعريف "أل" "ليست سمةً عربيَّةً عامةً".
([2]) عُثِر على نقوِش من زمن هيرودوت نفسه في شمال شرق مصر؛ تشهد على اسم الإلهة "هن - إلت"، بالمعنى نفسه، وربما تُشير إلى الإلهة نفسها؛ لكن باستخدام أداة التعريف "هن" بدلًا عن أداة التعريف "أل" (ماكدونالد، "لغة شمال جزيرة العرب القديمة"، Macdonald, ‘Ancient North Arabian’, 517).
([3]) مايكل سي آي ماكدونالد، معرفة القراءة والكتابة والهويَّة في جزيرة العرب قبل الإسلام، Macdonald, M.C.A, (2009c) Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia. Surrey: Farnham: Ashgate, 179.
([4]) ماكدونالد، "العربيَّة القديمة (الكتابة)"، Macdonald ‘Old Arabic (epigraphic)’, 3: 464)..
([5]) مايكل سي آي ماكدونالد، "تراجع "عادة الكتابة" في جزيرة العرب القديمة المتأخرة: بعض التساؤلات"، Macdonald, M.C.A, (2009d) ‘The decline of the “epigraphic habit” in late antique Arabia: some questions’, in Christian Julien Robin and Jérémie Schiettecatte (eds.), L’Arabie à la veilee de l’Islam. (Paris: De Boccard, 21).
([6]) مايكل سي آي ماكدونالد، "العربيَّة القديمة (الكتابة)"، Macdonald, M.C.A, (2008) ‘Old Arabic (epigraphic)’, in Kees Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. (Leiden: Brill, 3: 464-477).
([7]) المرجع نفسه؛ وأحمَد الجلاد، مُلخّص في قواعد النقوش الصفائيَّة، al-Jallad, Ahmad, An Outline of the Grammar of the Safaitic Inscriptions (Leiden: Brill, 2015).
([8]) آفي يونا، مايكل وشمعون غيبسون (2007)، "البتراء"، Avi-Yonah, Michael and Shimon Gibson (2007) ‘Petra’, in Fred Skolnik and Michael Berenbaum (eds.), Encyclopaedia Judaica. (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 16: 17-18)؛ وريتسو، يان (2011) “البتراء وقادش”، Retsö, Jan (2011) ‘Petra and Qadesh’, Svensk Exegetisk Årsbok 76: 115-136 .
3. راجع جغرافيَّة سترابو، الكتاب 16، الفصل 4، Strabo’s Geography, Book 16, Chapter 4.
([9]) يبدو أن معنىً ذا صلةٍ قد استمر لزمنٍ طويلٍ بعد نزول القُرآن. أفاد لين، إي. دبليو. (1863) معجم عربيّ-إنجليزيّ، Lane, E.W. (1863) Arabic-English Lexicon. London: Williams and Norgate, 2759-2760، أن المعجميين العرب في العصور الوسطى وصفوا كلمة "النبطيّة" بأنها مُصطلح ازدرائيّ؛ يُشير إلى شعبٍ "مختلط" أو "حقير"؛ يكسب عيشه من الزراعة، أيّ الشعوب المُستقرة، في مُقابل البدو، وهو ما يتوافق مع اشتقاقها (جوكوفسكي، مارثا شارب (2007)، "الأنباط"، Joukowsky, Martha Sharp (2007) ‘Nabateans’, in Fred Skolnik and Michael Berenbaum (eds.), Encyclopaedia Judaica. (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 14: 716)). يذكر أميانوس مارسيلينوس، الذي كتب في القرن الرابع الميلاديّ، بكلمات العرب أنفسهم نفورهم من الزراعة: "أسوأ شر يُمكن أن يصيب شعبًا، ولا يأتي بعده خير، هو أن تُثنى أعناقهم" (التأريخ، Ammianus Marcellinus (1950) History. tr. J. C. Rolfe. 3 vols. Cambridge, MA: Loeb. Arjava, A., M. Buchholz, and T. Gagos, The Petra Papyri III (Amman: American Center of Oriental Research, 2007): §14.4). لاحظ آرثر جيفري (1938) معجم الألفاظ الغريبة في القُرآن، Jeffery, Arthur (1938) The Foreign Vocabulary of the Qurʾān. Baroda: Oriental Institute, 27، أن مصطلح "نبطيّ" كان يُستخدم بين العرب أيضًا للإشارة إلى "العديد من المجتمعات في سُوريَة والعراق"؛ أي أولئك الذين يعيشون على الزراعة، كما استخدم المعجميون العرب، بالإضافة إلى مصطلح "السريانيّ" المُستخدم للناطقين بالسريانيَّة في الشمال، مصطلح "نبطيّ" للإشارة إلى الأنواع الجنوبيَّة من الآراميَّة. ميّز ابن العبريّ Bar Hebraeus، الذي كتب في القرن الثالث عشر الميلاديّ، ثلاثة أنواعٍ من الآراميَّة. كانت الآراميَّة التي يتحدث بها سكان جبال آشور وجنوب العراق هي التي حُدِدتْ باسم "النبطيَّة". روبرت هويلاند (2008) "النقوش والخلفيَّة اللغويَّة للقُرآن"، Hoyland, Robert G. (2008) ‘Epigraphy and the linguistic background to the Qurʾān’, in Gabriel Said Reynolds (ed.), The Qurʾān in its Historical Context. (London: Routledge, 52. وأفاد ت. فهد، "نبط العراق"، Fahd, T. (1993) ‘Nabaṭ al-ʿIrāḳ’, in C. E. Bosworth, et al. (eds.), The Encyclopaedia of Islam. New edn., Vol. 7. (Leiden: Brill, 7: 836)، أن مصطلح "النبطيّ" (istanbaṭū) يعني الاستقرار وممارسة الزراعة؛ بينما مصطلح "المستعرب" (isatʿrabū) يعني تبني نمط حياةٍ رعويٍّ بدويٍّ. يعكس هذا تمييزًا مهمًا بين النوعيْن الرئيسين من المجتمعات الناطقة بالعربيَّة: سكان الصحراء أو العرب "الأصيلون"، والعرب المستقرون الذين استقروا ومارسوا الزراعة.
([10]) مايكل سي آي ماكدونالد، "البدو والحورانيون في أواخر العصر الهلنستيّ والرومانيّ: إعادة تقييم الأدلة المكتوبة"، Macdonald, M.C.A, (1993) ‘Nomads and the Hawran in the late hellenistic and roman periods: a reassessment of the epigraphic evidence’, Syria 70: 307, fn.28.
في النقوش العربيَّة القديمة، غالبًا ما يُستخدم حرفي "الواو" و"الياء" بالتبادل.
([11]) ورد هذا النقش في الخريشة، ف. ح.، "نقوش صفويَّة جديدة من الأردن"، al-Khraysheh, F. H., ‘New Safaitic Inscriptions From Jordan’, Syria 72 (1995), pp. 401–14. Littmann, E., D. Magie, and D. R. Stuart, Publications of the Princeton University، وقام الجلاد بترجمته للإنجليزية (الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 103).
([12]) كلمة "الليتورجيا" مُشتقةُ من الكلمة اليونانيَّة "leiton العامة" و"ergon الوظيفة"؛ وبالتالي فهي تعبيرٌ عن العبادة العامة التي تُمارس باسم الكنيسة الكاثوليكيَّة مِن قِبل أشخاصٍ مُعيّنين لهذا المنصب. في أيامنا هذه، غالبًا ما تظهر الليتورجيا الكاثوليكيَّة بمثابة نوع من الشعائر التي تُساعد على أداء الاحتفالات الدينيَّة المُتاحة للجميع. (المترجم).
([13]) بوصوله إلى هذا الرأي؛ تراجع ماكدونالد عن رفضه السابق (ماكدونالد، "اللغات والنصوص واستخدامات الكتابة عند الأنباط"، Macdonald, M.C.A, (2003) ‘Languages, scripts and uses of writing among the Nabataeans’, in Glenn Markoe (ed.), Petra Rediscovered: Lost City of the Nabataeans. (New York: Harry N. Adams, Inc, 36-56)) للافتراض القائل بأن الأنباط كانوا يتحدثون العربيَّة القديمة. إن ملاحظة أن الأنباط كانوا يتحدثون العربيَّة باعتبارها لغتهم الأم لا تتعارض بطبيعة الحال مع وجود مُتحدثين بلغاتٍ أخرى، مثل اليونانيَّة أو العبريَّة، في المناطق النبطيَّة.
([14]) جغرافيَّة سترابو، Strabo’s Geography, Book 16, Chapter 4..
([15]) مكتبة ديودوروس للتأريخ العالميّ، Diodorus’ Library of World History, 19: 94-95.
([16]) جوزيفوس، فلافيوس (بدون تأريخ) الأعمال الكاملة ليوسيفوس: آثار اليهود، حروب اليهود ضد أبيون، إلخ، إلخ.، Josephus, Flavius (n.d.) The Complete Works of Josephus: Antiquities of the Jews, the Wars of the Jews Against Apion, Etc., Etc. trans. Syvert Havercamp and William Whiston, New York: Bigelow, Brown & Co: 1.43.
([18]) أفاد يوسيفوس أنه يُمكن للمرء رؤية "جزيرة العرب" من أبراج القدس (المصدر نفسه: 4/202)، وأن جبل الفريديس Herodium يقع "قريبًا جدًا من جزيرة العرب"، المصدر نفسه، 4/367
([19]) ماكدونالد، "العرب وجزيرة العرب واللغة العربيَّة قبل أواخر العصور القديمة"، Macdonald, M.C.A, (2009b) ‘Arabs, Arabias and Arabic before late antiquity’, Topoi 16: 298
([20]) قد يكون من المهم أيضًا أن البتراء، عاصمة الأنباط، كانت تقع في وادي عربة، وهو مَعلمٌ جُغرافيٌ؛ يمتد - بدلالته القديمة - من بحر الجليل (بحيرة طبريا) في الشمال إلى خليج العقبة جنوبًا. يعود تأريخ اسم عربة إلى أسفار موسى الخمسة (سفر التثنية: 2: 8). وهو مُشتقٌ من جذر "ع-ر-ب" والذي تُشتق منه كلمة "عرب"، والفرق الصوتيّ الوحيد هو النهاية المؤنثة "ـه"، وهي شائعةٌ في أسماء الأماكن.
([21]) هويلاند، "النقوش والخلفيَّة اللغويَّة للقُرآن"، Hoyland, ‘Epigraphy and the linguistic background to the Qurʾān’, 54
([22]) مايكل سي آي ماكدونالد، "محو الأميَّة في بيئةٍ شفويَّةٍ"، Macdonald, M.C.A, (2006) ‘Literacy in an oral environment’, in Piotr Bienkowski, Christopher Mee, and Elizabeth Slater (eds.), Writing and Ancient Near Eastern Society. (London: Bloomsbury, 94.
([23]) مايكل سي آي ماكدونالد، "العرب وجزيرة العرب واللغة العربيَّة"، Macdonald, Arabias and Arabic’, 16: 397؛ وأوكونور م. (1986) "الكلمات العربيَّة المُستعارة في الآراميَّة النبطيَّة"، O’Connor, M. (1986) ‘The Arabic loanwords in Nabataean Aramaic’, Journal of Near Eastern Studies 45(3): 213-229؛ وغرينفيلد، ج.، "بعض الكلمات العربيَّة المُستعارة في النصوص الآراميَّة والنبطيَّة من وادي حبير"، Greenfield, J., ‘Some Arabic Loanwords in the Aramaic and Nabataean Texts From Naḥal Ḥever’, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 15 (1992), pp. 10–21؛ ومورغنسترن، م.، "تأريخ اللهجات الآراميَّة في ضوء الاكتشافات من صحراء يهودا: حالة النبطيَّة"، Morgenstern, M., ‘The History of the Aramaic Dialects in the Light of the Discoveries From the Judaean Desert. The Case of Nabataean’ in B. A. Levine, P.J. King, J. Naveh, and E. Stern (eds.), Eretz-Israel. Archaeological, Historical and Geographical Studies. (Jerusalem: Frank Moore Cross Vol. 26, 1999), pp. 134–42.؛ وباير، ك.، النصوص الآراميَّة من البحر الميت، Beyer, K., Die aramäischen Texte vom Toten Meer, Vol. 2. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004).
([24]) هيلي، ج.، نقوش المقابر النبطيَّة في مدائن صالح، Healey, J., The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada’in Salih (Oxford: Journal of Semitic Studies Supplement 1, 1993)؛ والحمد، م. ف. (2014) "النبطيَّة في اتصال مع العربيَّة: الاقتراض النحويّ"، al-Hamad, M.F. (2014) ‘Nabataean in contact with Arabic: grammatical borrowing’, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 44: 1-10؛ وغزيلا، هـ.، الزمن والمظهر والصيغة في الآراميَّة الإمبراطوريَّة، Gzella, H., Tempus, Aspekt Und Modalität in Reichsaramäisichen (Wiesbaden: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission 48, 2004).
([25]) هويلاند، "النقوش والخلفيَّة اللغويَّة للقُرآن"، Hoyland, ‘Epigraphy and the linguistic background to the Qurʾān’, 57
([26]) فرانكل، سيغموند (1886) الكلمات الأجنبيَّة الآراميَّة في اللغة العربيَّة، Fraenkel, Siegmund (1886) Di Aramäischen Fremdwörter in Arabischen. Leiden: Brill.
([27]) مايكل سي آي ماكدونالد، (a2009) "جزيرة العرب القديمة والكلمة المكتوبة"، Macdonald, M.C.A, (2009a) ‘Ancient Arabia and the written word’, in M.C.A. Macdonald (ed.), The Development of Arabic as a Written Language: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies Held on 24 July 2009. (Oxford: Archaeopress, 18.
([28]) ماكدونالد، "اللغات والنصوص"، Macdonald, ‘Languages, scripts’, 39.
([29]) ليلى نعمة (2009). "نظرة سريعة على تطور الخط النبطيّ إلى اللغة العربية استنادًا إلى المواد المكتوبة قديمها وحديثها"، Nehmé, Laïla (2009) ‘A glimpse of the development of the Nabataean script into Arabic based on old and new epigraphic material’, in M.C.A. Macdonald (ed.), The Development of Arabic as a Written Language: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies Held on 24 July 2009. (Oxford: Archaeopress, 47-88)؛ وماكدونالد، "جزيرة العرب القديمة والكلمة المكتوبة"، Macdonald, ‘Ancient Arabia and the written word’, 21
([30]) كناوف، إرنست أكسل (2011). "من العربيَّة القديمة إلى العربيَّة الفصحى المُبكرة"، Knauf, Ernst Axel (2011) ‘From ancient Arabic to early standard Arabic’, in Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx (eds.), The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu. (Leiden: Brill, 231).
([31]) للاطلاع على المزيد من المراجع الكثيرة حول هذه النقوش؛ انظر: ماسيتيلي، د.، اللغة العربيَّة في عصور ما قبل الإسلام: تشكل لغة، Mascitelli, D., L’arabo in epoca preislamica: formazione di una lingua (Rome: Arabia Antica 4, 2006), 121-129, 152
([32]) ماكدونالد، "جزيرة العرب القديمة والكلمة المكتوبة"، Macdonald, ‘Ancient Arabia and the written word’, 21؛ وانظر: نعمة، "نظرة سريعة على تطور الخط النبطيّ"، Nehmé, ‘A glimpse of the development of the Nabataean script.
([33]) هناك حاشية سفليَّة لافتةٌ للنظر في هذه الرواية عن صعود اللغة العربيَّة. عندما أشار بطليموس الشهير إلى "الساراسين" (المسلمين) في شمال غرب جزيرة العرب، فمن المُرجح أن هذا المصطلح مُشتقٌ من الجذر "ش-ر-ق"، والذي يعني في العربيَّة الفصحى "شرقًا" أو "اذهب شرقًا" (مايكل سي آي ماكدونالد، "حول المسلمين، نقش الروافة والجيش الرومانيّ"، Macdonald, M.C.A, (2009e) ‘On Saracens, the Rawwāfah inscription and the Roman Army’, Literacy and identity in pre-Islamic Arabia. (Farnham/Burlington, VT: Ashgate, 1-26)). في اللغة العربية الشماليَّة القديمة (وفي بعض اللهجات البدويَّة التي لا تزال قائمة حتى اليوم)، كانت الكلمة المشابهة "ش-ر-ق" تعني "الهجرة إلى الصحراء الداخليَّة"، بغض النظر عن اتجاه البوصلة (ماكدونالد، 2004: 529). فُسِّرت تقليديًا بمعنى "الشرق"، وفي واقع الأمر، من المُرجح أن يكون "الشرق" هو معناها الأصليّ "الصحراء الداخليَّة". لم يكن المسلمون أناسًا من الشرق؛ أناسًا من أهل البادية. يتناسب التغيير الدلاليّ من "الهجرة" إلى "الصحراء الداخليَّة" إلى "التوجه شرقًا" مع سياق الأنباط في البتراء؛ لأن الصحراء العربيَّة الكبرى تقع إلى الشرق من البتراء. كان من الضروريّ وجود حالةٍ مُستقرةٍ إلى الغرب من الصحراء لتحقيق مثل هذا التغيير الدلاليّ؛ لأنه بالنسبة للبدو، فإن الحركة إلى الصحراء الداخليَّة لم يكن مرتبطًا بنقطة بوصلةٍ واحدةٍ.
([34]) رابين، حاييم (1955) "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, Chaim (1955) ‘The beginnings of Classical Arabic’, Studia Islamica 4: 19-37.
([35]) رابين، "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, ‘The beginnings of Classical Arabic’, 21-22,
لا يُعرفُ الشِّعر الإسلاميّ إلا من مصادر المخطوطات التي تعود إلى ما بعد ولادة الإسلام، ويُظهر الشكل الذي نراه فيه علامات تنقيحٍ مُكثفٍ، المرجع نفسه، ص21.
([36]) رابين، حاييم (1951) غرب جزيرة العرب القديم، Rabin, Chaim (1951) Ancient West Arabian. London: Taylor’s Foreign Press, 12.
([38]) رابين، "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, ‘The beginnings of Classical Arabic’, 31.
([39]) ريغيس بلاشير، تأريخ الأدب العربيّ: من الأصول إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلاديّ، Blachère, Régis, Histoire de la littérature arabe: des origines à la fin du XVe siècle de J.C. 1 (Paris: Adrien Masionneuve, 1952), 66-82؛ ورابين، "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, ‘The beginnings of Classical Arabic’, 24؛ وفيرستيغ، كيس (1984) التبسيط والكريوليَّة: حالة اللغة العربيَّة، Versteegh, Kees (1984) Pidginization and Creolization: The Case of Arabic. Amsterdam: John Benjamins, 1.
ليس هذا هو المثال الوحيد المُوثَّق على استخدام اللهجة الإقليميَّة الشعريَّة؛ انظر: بلاشير، تأريخ الأدب العربيّ، Blachère, Histoire de la littérature arabe, 80-91، الذي يُعطي عدة أمثلةٍ أخرى.
([41]) المرجع نفسه، ص17؛ وانظر فليش، 1947: 97-101؛ وريغيس بلاشير (1947) مقدمة للقُرآن، Blachère, Régis (1947) Introduction au Coran. Paris: G.-P. Maisonneuve, 156-169؛ ونولدكه، ثيودور وفريدريش شوالي (1919). مجموعة القُرآن الكريم: مع ملحق أدبي تأريخيّ حول المصادر الإسلاميَّة والبحوث المسيحيَّة الحديثة: تأريخ القُرآن الكريم، Nöldeke, Theodor and Friedrich Schwally (1919) Die Sammlung des Qorāns: mit einem literarhistorischen Anhang über die muhammedanishcen Quellen und die neurere christliche Forschung. Geschichte des Qorāns, 2. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 57-58.
([42]) رابين، غرب جزيرة العرب القديم، Rabin, Ancient West Arabian, 24-26.
حتى أن رابين اقترح أنه "لا بد أن لهجة قُريش كانت أكثر اختلافًا عن اللهجة الكلاسيكيَّة منها عن اللهجات العاميَّة المعاصرة" (رابين، "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, ‘The beginnings of Classical Arabic’, 21-26).
([48]) نستذكر الأدلة المذكورة آنفًا على وجود تقليدٍ شِّعريٍّ طقسيٍّ عربيٍّ نبطيٍّ، هويلاند، "النقوش والخلفيَّة اللغويَّة للقُرآن"، Hoyland, ‘Epigraphy and the linguistic background to the Qurʾān’, 54؛ وماكدونالد، "محو الأميَّة في بيئةٍ شفويَّةٍ"، Macdonald, ‘Literacy in an oral environment’, 94)).
([49]) على سبيل المثال، خذ في الاعتبار أنه منذ أكثر من ألف عام، كان متحدثو اللهجات الجرمانيَّة يُشيرون إلى لهجاتهم المحليَّة والأنواع المعياريَّة المختلفة - التي تغيرت على مر القرون – بالاسم نفسه: في الألمانيَّة العليا القديمة diutisc، وفي الألمانيَّة العليا الوسطى diutsch. (كما استُخدمت الكلمة المشابهة þeodisc للإشارة إلى الإنجليزيَّة القديمة).
([50]) بانيستر، أندرو ج. (2014) دراسة شفويَّة صيغيَّة للقُرآن الكريم، Bannister, Andrew G. (2014) An Oral-Formulaic Study of the Qur’an. Plymouth: Lexington Books, 117-121.
([51]) إيمري، ب. ج. (1993) "النبطيّ"، Emery, P. G. (1993) ‘Nabaṭī’, in C. E. Bosworth, et al. (eds.), The Encyclopaedia of Islam. New edn., Vol. 7. (Leiden: Brill, 7: 838).
([52]) الحسمائيَّة هي: أبجديَّة ولهجة عربيَّة شماليَّة قديمة؛ سُميت بهذا الاسم بسبب انتشار النقوش الحسمائيَّة في منطقة صحراء حسمى؛ لكن تُوجد نقوش حسمائيَّة في مناطق أخرى من شمال شبه جزيرة العرب. (المترجم).
([53]) أحمَد الجلاد، "حول الخلفيَّة الجينيَّة لنقش قبر ربل بن هفعم في قرية الفاو"، al-Jallad, Ahmad, ‘On the Genetic Background of the Rbbl Bn Hfʿm Grave Inscription at Qaryat Al-Fāw’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies Available on CJO 2014 doi: 10.1017/S0041977X14000524, (2014) 5-6, 13-15.
([55]) كما اعتُمدتْ اللغة اليونانيَّة بمثابة لغةِ إداريَّةٍ مِن قِبل العرب الغساسنة الذين استقروا في بلاد الشام (ماكدونالد، "تراجع "عادة الكتابة""، Macdonald, ‘The decline of the “epigraphic habit”, 24)).
([56]) الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 105.
([58]) جرى التعرف على بقايا نبطيَّة في أكثر من ألف موقعٍ على طول طرق التجارة النبطيَّة التي ربطت البتراء بدمشق شمالاً والحجاز إلى الجنوب، وفي جميع أنحاء النقب المُمتد حتى ميناء غزة (جوكوفسكي، "الأنباط"، Joukowsky, ‘Nabateans’, 716).
([59]) الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 153.
([60]) فلايش، هنري (1947) مقدمة في دراسة اللغات الساميَّة: عناصر الببليوغرافيا، Fleish, Henri (1947) Introduction à l’étude des languages sémitiques: éléments de bibliographie. Paris: Adrien- Maisonneuve, 1250.
([61]) (زويتلر، Zwettler 1978, 147).
([62]) ديم، فيرنر، “النقوش النبطيَّة ومسألة تصريف الحالة في اللغة العربيَّة القديمة”، Diem, Werner, ‘Die nabatäischen Inschriften und die Frage der Kasusflexion im Altarabishen’, Der Deutschen Morgenländishcen Gesellschaft 123: 2 (1973), pp. 227–237.
([63]) الجلاد، Al-Jallad 2017a, 165.
كما أفاد الجلاد (الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 159) أنه "لا يوجد دليلٌ على تصريف الكلمات في العبارات العربيَّة المنقولة في البرديات غير الأدبيَّة من البتراء وتل نيسانا"، وعلى الرغم من وجود أدلةٍ على نهايات الكلمات الصوتيَّة في اللغة اليونانيَّة العربيَّة، في "و" الوسطى من مُركبات الأسماء المضافة إليها بعد فُقدانها في موضع نهاية الكلمة، بحلول القرن السادس الميلاديّ؛ فقدت برديات البتراء علاماتها حتى في المركبات (الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 156).
([64]) الجلاد، Al-Jallad 2017a, 165.
([65]) المرجع نفسه، ص ص158-159
([66]) يُعد تغيير نهاية المفرد المؤنث "ـة" إلى "ـه" سمةً مُميِّزة للغة العبريَّة الجنوبيَّة؛ لكنه ليس سمة مُميِّزة للغات الكنعانيَّة الأخرى. وقد انعكس هذا التغيير العبريّ في نص التناخ. ربما انتشر هذا التغيير من العبريَّة إلى العربيَّة النبطيَّة؛ حيث كان يُتحدث بها في المناطق المُجاورة. (انتهى كلام المؤلف). والتناخ هو اختصار للأحرف "ت"، و"ن"، و"خ"، والتي تُشير إلى أكثر أسماء أسفار الكتاب المُقدس العبريّ "العهد القديم). فـ "التاء" ترمز لأسفار التوراة، و"النون" ترمز لأسفار الأنبياء، و"الخاء" (أو الكاف) ترمز لبعض الكتاب الأخرى. (المترجم).
([67]) الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 157.
([68]) أفنير، عوزي، وليلى نعمة، وكريستيان جوليان روبن، "نقش صخري يذكر ثعلبة، ملك عربي من غسان"، Avner, Uzi, Laïla Nehmé, and Christian Julien Robin, ‘A Rock Inscription Mentioning Thaʿlaba, an Arab King From Ghassān’, Arabic Archaeology and Epigraphy 24: 2 (2013), 243.
([69]) ماكدونالد، "لغة شمال جزيرة العرب القديمة"، Macdonald, ‘Ancient North Arabian’, 498.
([70]) الجلاد، Al-Jallad 2017a, 158.
([71]) التصحيح المُطبّق في تلاوة القُرآن الكريم جرى أيضًا على كلمة "التوراه" (تُنطق "التوراة")، حيث لم تكن الـ "الهاء" نهايةً مؤنثةً، بل كانت أصليَّةً، مُستعارةً من الكلمة العبريَّة "tōrāh" (الشريعة).
([72]) الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 154-155.
([73])ليتمان، إي.، ود. ماغي، ود. ر. ستيوارت، منشورات بعثات جامعة برينستون الأثريَّة إلى سُوريَة في عامي ١٩٠٤-١٩٠٥ و١٩٠٩، القسم الثالث. النقوش اليونانيَّة واللاتينيَّة في سُوريَة، القسم أ. جنوب سُوريَة، Littmann, E., D. Magie, and D. R. Stuart, Publications of the Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904–1905 and 1909, Division III. Greek and Latin Inscriptions in Syria, Section A. Southern Syria (Leiden: Brill, 1907-1921), 234.
بشأن حرف الألف النبطي (א)، انظر المناقشة في الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 154-155.
([74]) بيرغستراسر ج. وأو .بريتزل (1938) تأريخ النص القُرآنيّ، Bergsträsser, G., and O. Pretzl. 1938. Die Geschichte des Qorāntexts. Vol. 3. Leipzig: T. Weicher, 37.
([75]) هناك عددٌ قليل من الكلمات التي ينتهي رسمها حرفها المشتق بـ "ياء-الألف" تتناغم قافيتها مع "الألف المقصورة"، مثل "دنيا (راجع: سورة النجم: 29؛ وسورة النازعات: 38؛ وسورة الأعلى: 16)، و"أحيا" (راجع: سورة النجم: 44)؛ مما يُشير إلى أن /ي/ تسببت في ظهور حرف /آ/ الذي يليها. هناك أيضًا كلمة "شيئًا" (راجع: سورة النجم: 28)؛ لكن قد يكون هذا تطابقًا غير كاملٍ؛ لأنه تُوجد أيضًا قوافي لكلمة "شيئًا" بشكل "شيئًا" (راجع: سورة مريم: 9، 42). فيما يتعلق بكلمة "أحيا"؛ انظر أيضًا مناقشة "الياء" في تصرف الفعل الثالث في الجلاد، Al-Jallad 2017a, 156: تُشير الأدلة اليونانيَّة العربيَّة إلى أن نطق /-ē/ كان سمةً مميزة لنطق الحرف "الياء" في تصرف الفعل الثالث لحرف "الياء" في جنوب بلاد الشام.
([76]) الجلاد، Al-Jallad 2017a, 153.
([77]) يذهب الجلاد (الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 158) إلى أن "التوقف الحنجري" كان يُنطق في الأصل، على الأقل في الصفائيَّة؛ استنادًا إلى نقشٍ ثنائيّ اللغة، صفويّ-نبطيّ؛ ظهر فيه الاسم النبطيّ מאתאלעזא بصيغة "ʾmtʾlʿz": يُشير حذف "التوقف الحنجري" في الصفويَّة إلى أن إدراجها في سياقات أخرى كان تناقضيًّا.
([78]) كوينين، إل.، جيه إم كايميو، وآر. دبليو. دانييل، البرديات البترائيَّة الثانية، Koenen, L., J.M. Kaimio, and R.W. Daniel, The Petra Papyri II (Amman: American Center of Oriental Research, 2013), 17.1, 180؛ وانظر المناقشة في الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 169.
([79]) أطلق ماكدونالد (مايكل سي آي ماكدونالد، "تأملات في الخارطة اللغويَّة لجزيرة العرب قبل الإسلام"، Macdonald, M.C.A, (2000) ‘Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia’, Arabian archeology and epigraphy 11: 51) على هذه السمة "الخط المتساوي اللسانيّ العربيّ القديم الشماليّ"، (الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 166).
([80]) (الجلاد، Al-Jallad 2017a, 166-167؛ وماكدونالد، "تأملات في الخارطة اللغويَّة"، Macdonald, ‘Reflections on the linguistic map, 11: 51.
([81]) الجلّاد، "اليونانيَّة العربيَّة: الجزء الأول: بلاد الشام الجنوبيَّة"، al-Jallad, ‘Graeco-Arabica I: The Southern Levant’, 169.
([82]) أرجافا، أ.، وم. بوخهولز، وت. غاغوس، برديات البتراء: الجزء الثالث، Arjava, A., M. Buchholz, and T. Gagos, The Petra Papyri III (Amman: American Center of Oriental Research, 2007), 30. 48. بيد أنه بحلول القرن الإسلاميّ الأول، استُوعبت الـ "أل" في اللغة اليونانيَّة العربيَّة بوصفها حرفًا ساكنًا شمسيًا يليه (الجلاد، Al-Jallad 2017b, 428).
([83]) روبرت هويلاند (2001). جزيرة العرب والعرب: من العصر البرونزيّ إلى بروز الإسلام، Hoyland, Robert G. (2001) Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam. London: Routledge, 247.
([84]) رابين، غرب جزيرة العرب القديم، Rabin, Ancient West Arabian, 18؛ وراجع: هويلاند، جزيرة العرب والعرب، Hoyland, Arabia and the Arabs, 245-246.
([85]) أحد الفروق المهمة بين العربيَّة النبطيَّة والشعريَّة هو أن الأخيرة استخدمت الإعراب بوصفه جزءًا من قافية. من المُفترض أن هذا كان نتيجة الرغبة في إضفاء الطابع البدويّ على لغة الشِّعر.
([86]) يُورد رابين (رابين، "بدايات اللغة العربيَّة الفصحى"، Rabin, ‘The beginnings of Classical Arabic’, 25) أدلةً على أن القُرآن كان يُتلى عادةً دون إعراب حتى أواخر القرن الثاني الهجريّ.
([87]) لا يمكن التوفيق بين الرواية المُقدمة هنا والرأي السائد لدى علماء اللغة المسلمين في العصور الوسطى بأن القُرآن قد كُتب بلهجة قريش (رابين، غرب جزيرة العرب القديم، Rabin, Ancient West Arabian, 22). لكن علماء اللغة المسلمين أنفسهم قد قدموا أدلةً تَدحض هذا الرأي.