حوار مع د. محمد المعزوز حول مجمل أعماله الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع
فئة : حوارات
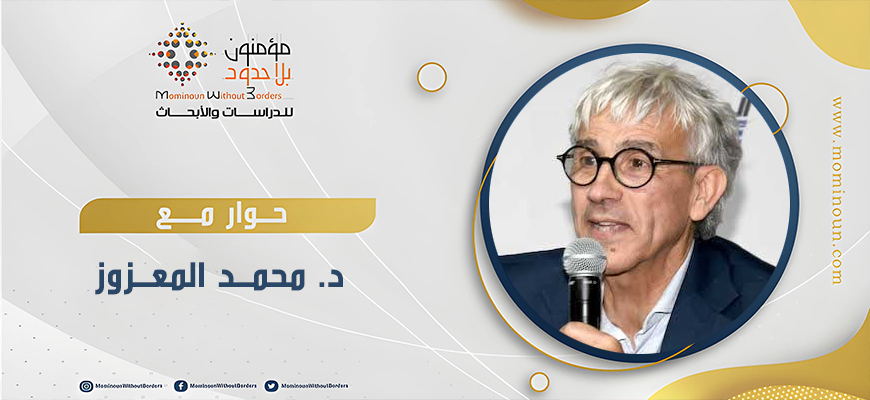
حوار مع د. محمد المعزوز
حول مجمل أعماله الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع
"إن تجربة «مؤمنون بلا حدود» تجربة فريدة ومميزة بكل صدق ومن دون مجاملة، وهي مميزة في تاريخ المؤسسات الثقافية العربية في العصر الحديث والمعاصر"
د. حسام الدين درويش:
مساء الورد للجميع، وأهلًا بكم في هذا اللقاء الجديد من سلسلة لقاءات "مؤمنون بلا حدود"، ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرباط. أرحّب بكم جميعًا، وأرحب بالدكتور محمد المعزوز. شكرًا جزيلًا لك دكتور على قبول الدعوة والحضور معنا.
د. محمد المعزوز:
أنا بدوري أشكركم على هذه الاستضافة، وليس ذلك بغريب على مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"؛ المؤسسة التي قدّمت خدمات عميقة جدًّا للفكر والتنوير العربيين.
د. حسام الدين درويش:
على الرغم من أن «المعروف لا يُعرّف»، فمن المناسب أن نبدأ بتقديمٍ بسيطٍ عنك. اهتماماتك، ما شاء الله، متنوّعة، تجمع بين الفكر والأدب، بين اللغتين العربية والفرنسية. لو أردنا أن نُلقي نظرة عامة على اهتماماتك الفكرية، كيف يمكن أن نُقدّمها؟ وما أبرز النتاجات التي قدّمتها في هذا المجال؟
د. محمد المعزوز:
فعلاً، هناك اهتمامات لا أقول إنها متعددة، ولكنها متداخلة. هناك تداخل لحقول فكرية، ومن ثم لا يمكن أن نقدم فهمًا قريبًا من الصواب ومن الحقيقة، من دون أن نقاربه بمناهج متقاطعة ومتداخلة. ومن هذا المنطلق، أحاول أن أُقارب موضوعات متشابكة، كالأنثروبولوجيا، والتحليل النفسي، والتاريخ، وعلوم السياسة.
كانت أعمالي الأولى منصبّة على علم الجمال في الفكر العربي القديم. وكان السؤال الأساس هو: هل عرف العرب نظرية في علم الجمال؟ فحاولت أن أقتحم هذا الحقل من خلال استنطاق النصوص الفلسفية، والكلامية، والفقهية العربية، لمعرفة مدى بلوغ الفكر العربي هذا الأفق الجمالي الشامل. بعد ذلك، حاولت أن أشتغل على "عيون السياسة"، لأرى علاقة السياسة بالجمال، وعلاقة السياسة بالأخلاق؛ لأنه، في اعتقادي، لا يمكن فصل الفلسفة عن السياسة، ولا عن الأخلاق، ولا عن الفكر عمومًا.
ومن هذا المنظور، كانت اشتغالاتي محاولةً لمقاربة معاني الدولة والمجتمع، والتمييز بينهما. كيف ننظر إلى الدولة من خلال هذا التقاطع الفكري الذي حدثتك عنه؟ وقد كتبت في هذا الإطار كتابًا باللغة الفرنسية: "الدولة من الإرث إلى الاستعمال L'État : de l'héritage à l'usage"، ثم صدر لي كتاب آخر في باريس حول الدولة في البلاد العربية: كيف يتشكل مفهومها، وكيف تتحرك وتشتغل الدولة في هذه البلاد، ثم انتقلت إلى ثلاثية أخرى، وهي: الدولة في المغرب. ومن خلال هذا التقاطع، أحاول أن أقدّم مقاربة شاملة وعامة للمغرب.
أما المسألة الأخرى التي أشتغل عليها الآن، فهي: الأنثروبولوجيا العربية. سيصدر لي قريبًا كتاب حول الأنثروبولوجيا العربية، لا بوصفها إسقاطًا لإطار نظري ومفاهيمي غربي على التراث العربي، وإنما هي إنصاف للفكر العربي. فهناك، مثلاً، ابن خلدون، والبيروني، والمسعودي صاحب "مروج الذهب"؛ هؤلاء قدّموا أفكارًا قوية ومؤسِّسة، حتى لعلم الأنثروبولوجيا الحديثة. في مقاربتهم للإنسان كمفهوم ثقافي شامل، يتعلّق بالكونية والإنسان في عمومه، وبالإنثوغرافيا؛ أي بدراسة الثقافات المحلية لشعب أو منطقة. وهذا الحضور موجود عند العرب، مثلاً في علم الأنساب، الذي اراه علمًا مهمًّا جدًّا، رغم قلة الكتابات التي تؤصّل له ضمن منظور أنثروبولوجي متكامل.
إذن، الكتاب الذي أعمل عليه حاليًّا، هو محاولة للإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف يمكن تقسيم الأنثروبولوجيا العربية؟ وكيف يمكن تقديم بدائل؟ في هذا الكتاب، أشتغل على الأنثروبولوجيا التأويلية، لفهم ما يقع، لفهم ما هو موجود وما هو كائن على المستوى الفكري الكوني عمومًا، والفكر العربي خصوصًا.
طبعًا، لا يمكن لهذا الجهد أن يتجاهل التحولات العميقة والسريعة التي يشهدها العالم، خصوصًا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة؛ فنحن اليوم أمام مجتمع غير الذي عهدناه، وإنسان بطبيعة قراءة مختلفة. والسؤال المطروح هو: هل سيموت الكتاب، أم سيبقى صامدًا؟ هل ستتغيّر طرائق القراءة، والكتابة، والفهم، جذريًّا؟ خصوصًا في ظل صعود أدوات مثل "ChatGPT"، وما يُثار حول «أنسنة الذكاء الاصطناعي»؛ أي تحوّله إلى كاتب أو فاعل معرفي. ولا أعتقد أننا سنُسلّم له المرحلة، مهما بلغ الذكاء، ومهما تطوّر الدماغ.
د. حسام الدين درويش:
هناك من يعترض على تسميته بالذكاء؟
د. محمد المعزوز:
نعم، لن يصل أبدًا إلى ذكاء الإنسان؛ لأن ذكاء الإنسان مبدع ومتجدِّد، أما ذكاء الآلة، فقد يكون مُبدعًا إلى حدٍّ ما إذا أُمدَّ بالمعطيات، ولكن إذا سُحبت منه هذه المعطيات، فلن يكون قادرًا على إنتاج معطى جديد، كما لا يمكنه أن يُنتج روحًا أو وجدانًا. وهذا هو السياق العام الذي أتحرك فيه.
د. حسام الدين درويش:
تفتح البداية الشهية لأسئلة كثيرة، وسأحاول قدر المستطاع الاغتناء والاستفادة، واستثمار هذه الجلسة في طرح بعض من أهم الأسئلة المرتبطة بالنقاط التي أثرتها. أولًا، في كتابك "الجمال: المدخل إلى الطبيعيات"، المقدمة مكثفة، وتتحدث فيها، بمعنى من المعاني، عن محاولة تأسيس علم جمال عربي. لكنك تتحدث، منذ البداية، عن مشكلة مزدوجة، ويمكن بعد ذلك إضافة مشكلة ثالثة. من ناحية أولى، لدينا مشكلة في العلاقة مع التراث عمومًا، ومع التراث الجمالي خصوصًا. وهي مشكلة تتعلق بجمع هذا التراث، وتصنيفه، وترتيبه. والمشكلة الثانية هي مشكلة القراءة والتأويل وفهم هذا التراث. أما المشكلة الثالثة، التي تتحدث عنها أيضًا في المقدمة، فهي مشكلة الاعتراف بوجود علم جمال عربي؟ فهل يمكنك توضيح ثالوث المشاكل هذا؟
د. محمد المعزوز:
نعم، يأتي هذا الكتاب، وعنوانه "مدخل إلى الجمال: مدخل إلى الإلهيات والطبيعيات"، بعد كتاب سابق هو "علم جمال الفكر العربي القديم"؛ فهو ثاني كتاب تناولت فيه هذا الموضوع. والإشكالية المطروحة هي: هل العرب لم يعرفوا نظرية في علم الجمال؟ وهل أول من قعّد لهذه النظرية، الاستيطيقا، هو "ألكسندر غوتليب باومغارتن Alexander Gottlieb Baumgarten"؟
ودون أيّ حكم قيمة في الموضوع ودون أي إسقاطات، لا بد أن ننصت بشكل جيد إلى التراث العربي، خصوصا النص الفلسفي. فعلى سبيل المثال، حين نقرأ للكندي في رسائله الموسيقية، أو نقرأ عمل الفارابي في كتابه "الموسيقى الكبير"- وهو كتاب ضخم يقع في نحو ألف صفحة- نلاحظ وجود تأصيل واضح لرؤية فلسفية حول الموسيقى، من حيث بناؤها وإدراكها. كما نجد عند ابن سينا، يقدم في كتابيه "النجاة" و"الشفاء"، تعريفًا لعلم الجمال، من منظور رياضي، قائم على التناسب والهارمونية. والهارمونية قد ذكرها الفارابي حين أدرج الموسيقى ضمن الرياضيات في كتابه "إحصاء العلوم"، وهو بذلك يؤسس للمفهوم. لاحظ معي: هناك تأسيس للمفهوم، وهناك تأسيس للإطار الفكري في الموسيقى، ونظرة العرب إلى الموسيقى أو التنظير العربي للموسيقى، وإلى إشكالية التقبّل أو الإدراك، التي تظهر من خلال ابن سينا في كتابه "الإشارات والتنبيهات"، وهو معروف في أربعة أجزاء. فهو يتحدث عن الدماغ، ويقول: ما المناطق المسؤولة عن تقبّل ما هو جمالي وفني في الدماغ، وما هي المنطقة في الدماغ، طبعًا، المسؤولة عن استقبال كل ما هو رياضي وفكري وعلمي.
وعلى مستوى الأدب، نلاحظ أن قدامة بن جعفر في كتابه "نقد الشعر"، وابن طباطبا العلوي في كتابه "عيار الشعر"، تأسيسًا لنظرية تضع معايير ومقاييس للشعر. وحين نعود إلى أبي حيّان التوحيدي، كذلك في مختلف كتبه: الصديق، الجليس، والإمتاع والمؤانسة، نلاحظ تأملات عميقة في الجمال والفن، تُضاف إليها إسهامات ابن مسكويه التي تبرز من خلال مفاهيم متشظية لكنها تناظرية، يجمعها سياقٌ فكريٌّ متكامل. لكننا، في تقديري، لم نبحث بعد عن هذا السياق الذي يمكن من خلاله لملمة هذه المفاهيم وتشكيل نظرية جمالية متكاملة في التراث العربي؛ فهذا عمل لم يُنجز بعد.
نقطة أخرى مهمّة: إذا سلّمنا بأن الفلسفة تقوم، في أحد أبعادها، على مفهوم الجمال، فإننا نلاحظ أن الفكر العربي الحديث والمعاصر غالبًا ما تناول الفلسفة بمعزل عن البُعد الجمالي. واللافت أنه أهمل هذا الجانب، رغم حضوره القوي في التراث. وربما لهذا التغييب جذوره وسياقاته الفكرية أو الفقهية، لا أجزم، ولكن يبقى السؤال قائمًا: لماذا اشتغل العرب في مختلف الدوائر الفكرية المرتبطة بالتراث، ولكنهم لم يشتغلوا بشكل ممنهج على علم الجمال؟
د. حسام الدين درويش:
ربما أحد الأسباب هو البعد السياسي؛ إذ إن الفكر العربي يغلب عليه الطابع السياسوي.
د. محمد المعزوز:
أنا لا أعتقد أن الفكر السياسي في حدّ ذاته يُشكّل إشكالًا، بل أرى أنه من الضروري أن يُلامس ويُقارب. غير أن المسألة الأساسية، في اعتقادي، هي أن الفكر العربي لم يقترب من علم الجمال، ولم يُسائل هذا الحقل كما بُني أو نُظر إليه كمفهوم وكمصطلح وكرؤية في تراثنا العربي.
د. حسام الدين درويش:
لديك ربط وثيق بين مسألة الاهتمام بالفلسفة والاهتمام بالجماليات وبالجمال، ليس فقط في إطار التنظير الجمالي داخل الفلسفة؛ أي إن الجمال لا يظهر عندك كإضافة ثانوية أو أمر يمكن الاستغناء عنه، بل هناك ترابط وثيق بين القيم الفلسفية الأساسية؛ أي ثالوث: الحق، والخير، والجمال. فهناك أحيانًا محاولات لربط الحق والخير في فكر سقراط وأفلاطون، أو الحق، والحقيقة، والجمال في الابستمولوجيا المعاصرة. حيث يُنظر أحيانًا إلى الحقيقة بوصفها شيئًا ينبغي أن يكون جميلًا. ويتصل الترابط القائم لديك بين الفلسفة والجماليات بالسؤال التالي: إلى أيّ حد توجد علاقة وثيقة بين هذه القيم؟
د. محمد المعزوز:
نعم، هناك علاقة، فليس الجمال غريبًا عن الفلسفة، ولا الفلسفة غريبة عن الجمال. انظر معي: جميع الفلاسفة الكبار الألمان – وأنا لا أتحدث هنا عن اليونان – كتبوا في الجمال، وأقصد أولئك الذين أسسوا للفلسفة الحديثة والمعاصرة. في الفلسفة الألمانية، لا تجد فيلسوفًا لم يتناول النظرية الجمالية؛ ديكارت، هيغل، هايدغر، بول ريكور، وحتى هوسرل، كل هؤلاء الفلاسفة الذين أسّسوا لفلسفة العقل الألماني لم يُغفلوا مقاربتهم لعلم الجمال. أما نحن، كما قلت لك سابقًا، فأنا شخصيًّا لا أدري ما السبب، ولا أريد أن أفصل بين الموضوعين، ولا أن أصدر حكمًا قيميًا. لكن ما كان في هذا السياق يفرض علينا، بالضرورة، العودة إلى التراث، من أجل تقويمه، أو على الأقل لفهم الفكر العربي المعاصر.
د. حسام الدين درويش:
اسمح لي بملاحظة توضيحية، بقَدر ما تتسم لغتك بالرصانة والجمال والدقة، فإنها تتطلّب يقظة تامة. تحتاج قراءة نصوصك إلى تركيز ويقظة ذهنية. وعند حديثك عن المقاربة الجمالية؛ تتحدث، تارةً، عن "علم الجمال"، وتارة عن "الرؤية الفلسفية"، أو "المقاربة الفلسفية للجمال". فهل ترى أن هذه المفاهيم متطابقة؟ فمفهوم العلم - وأنت أصلًا تشرح معنى العلم – يحمل دلالات مختلفة؛ فهناك مفهوم العلم في المعنى العربي القديم، وهناك أيضًا مفهومه في السياق الفلسفي والعلمي الحديث. أرجو فلو أمكن توضيح هذين المفهومين، والتمييز بينهما إن كان هناك فعلاً تمايز بينهما؟
د. محمد المعزوز:
لماذا حدّدتَ معنى العلم؟ أعني مفهوم العلم، نعم، في السياق التداولي العربي القديم؛ ذلك لأن بعضهم يقول إن العرب لم يعرفوا النظرية في ما يُسمّى ﺑ "علم الجمال"، فهم ينظرون إلى العلم من خلال المفهوم الحديث، الذي هو أضيق وأخصّ. لكن العلم، كما حدّده العرب القدماء، أشمل وأوسع وأكثر شمولًا ودقّة. فعندما نرجع إلى الشاطبي في كتاب "الموافقات"، أو إلى الباقلاني، وغيرهما، نلاحظ أن العلم في التراث لم يكن محصورًا في بعد واحد، بل وُجد بمفهومه الفقهي، والكلامي، والأدبي، والفلسفي. فهذا المفهوم، في الحقيقة، واسع وعميق ودقيق للغاية.
نحن - في العموم - لم ننتبه جيّدًا إلى الطريقة التي حدّد بها العرب القدماء مفاهيمهم، ولم نُعِر اهتمامًا كافيًا لهذا الجانب. ولهذا، حاولتُ أن أردّ على أولئك الذين يعتقدون أو يقولون: "عليك ألا تخلط بين مفهوم العلم الحديث ومفهوم العلم القديم". وأنا أقول: كلّا، علينا أن ندقّق المفاهيم ضمن سياقاتها التاريخية، وأن نكون منصفين. ليس دفاعًا عن العرب، ولا عن الإسلام، ولا عن أي دين من الأديان، أو مذهب من المذاهب الفلسفية، بل دفاعًا عن الحقيقة، عن الحقيقة العلمية تحديدًا.
د. حسام الدين درويش:
يمكن التمييز بين إطارين أو مرجعين أو سياقين مختلفين لمفهوم العلم: السياق الأنجلوسكسوني من جهة، والسياق الألماني من جهة أخرى. ففي السياق الأنجلوسكسوني، يُفهم العلم (Science) على نحو أقرب إلى التجريب، والمراقبة، والملاحظة، والبعد المادي؛ أي إن للعلم، بهذا المعنى، شروطًا تجريبية صارمة، تجعله أقرب إلى العلم الوضعي. أما المفهوم الألماني لكلمة العلم، فهو أقرب إلى معنى المعرفة الدقيقة، المنضبطة، والمنهجية.
د. محمد المعزوز:
حتى المعرفة الإنسانية تُعد علمًا، بدليل وجود فرع يُعرف بـ العلوم الإنسانية، وهي تختلف عن العلوم الدقيقة.
د. حسام الدين درويش:
حتى وإن لم تكن هناك تجربة أو ما شابه، هناك معرفة منضبطة ومنهجية دقيقة، بمعنى ما، لكنها دقيقة بمعنى أنها ليست جازمة؛ فلنقل إنها علوم منهجية أو منضبطة تمامًا. كيف، وإلى أي حدٍّ، يتقاطع مفهوم العلم العربي مع مفهومي العلم المذكورين؟
د. محمد المعزوز:
هذا سؤال مهم، فمفهوم العلم عند العرب ينطلق أولًا من التخصص، مثل علم الكلام، علم النحو، علم البلاغة، علم العروض، وفي الوقت نفسه يشمل علوم الفلك، والفيزياء، والرياضيات. فمفهوم العلم عند العرب مفهوم شمولي، وهو المفهوم الذي تبنّاه الغرب فيما بعد من خلال العلوم الإنسانية؛ لأن أهم كتب العرب قد تُرجمت إلى اللاتينية، وبعضها تُرجِم بشكل مشوّه، مثل ترجمة ابن رشد وابن سينا. وقد سيطر هذا المفهوم العلمي على الجامعة الأوروبية والفكر الأوروبي لمدة أربعة قرون. ولقد أخذ الغرب هذا المفهوم الشمولي من العرب عبر الترجمة، وهذا ما أكده توما الأكويني الذي حارب ابن رشد وابن سينا بذريعة أن الفكر العربي الإسلامي يجب أن يُنهى داخل الجامعة الأوروبية، ويتخلص منه الفكر الغربي بوصفه تهديدًا للمسيحية، حسب تعبيره. إذن، مفهوم العلم عند العرب مفهوم شامل جامع، رغم أنه يتضمن تقسيمات داخلية فرعية.
د. حسام الدين درويش:
أنا أدرّس الترجمة في جامعة ألمانية، بين العربية والإنجليزية والألمانية وغيرها. منذ الأسبوع الماضي، سألتني طالبة عن الفرق بين قول: "أنا أعلم" و"أنا أعرف"، فقلت لها: إننا غالبًا ما نستخدمهما بصورة متبادلة، لكن "أنا أعلم" قد تعبّر عن ثقة أكبر ويقين أشد.
د. محمد المعزوز:
هناك فرق بين العلم والمعرفة، أو بين قول: أنا أعرف وأنا أعلم. فعبارة "'أنا أعرف" تحمل دائمًا نوعًا من الشك. أما عبارة "أنا أعلم"، فلا يشوبها شك، بل هي قائمة على الثقة واليقين.
د. حسام الدين درويش:
أنا حاليًا أُحضّر بحثًا عن مفهوم التراث، وعلاقة العرب بتراثهم، وستكون هناك مقارنة مع علاقة الألمان بتراثهم وماضيهم. ويبدو أنه، في كلتا الحالتين، لدينا خصوصيات، ولا نواجه إشكاليات أو شجونًا متماثلة؛ فكل حالة لها فرادتها الخاصة بمعنى ما. مبدئيًّا، كيف ترى مفهوم التراث وعلاقة العرب به؟ لنبسط الأمر، هناك مقاربتان متناقضتان: إحداهما تقول إن الحل لا يكون إلا بالتراث، والأخرى تقول إن الحل لا يكون إلا بالتخلص من التراث. فالمقاربة الأولى ترى أن التراث هو الحل والثانية ترى أنه المشكلة. وأنت تعرف جيّدًا الحضور القوي لإشكالية الأصالة والمعاصرة. فكيف ترى علاقة العرب بتراثهم، سواء من الناحية العملية أو من الناحية النظرية؟ وهل هناك خصوصية في ذلك؟
د. محمد المعزوز:
نعم، هناك من يرى، استنادًا إلى قول الإمام مالك: 'لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها' - أن لا حلّ لنا إلا بالعودة الكاملة إلى التراث. وهناك من يرى على العكس، أن تقدّم العرب لا يتحقق إلا بالقطع التام مع التراث. أما أنا، فلا أتفق لا مع الرأي الأول ولا مع الثاني. والرأي الثالث، في نظري، هو: كيف نحسن استثمار التراث؟ فالتراث لا يخلو من عناصر إيجابية، وليس كل التراث سلبيًّا؛ فجميع تراثات العالم تحوي جوانب إيجابية وأخرى سلبية. والسؤال هو: كيف نُطوّع ما هو إيجابي في تراثنا العربي الإسلامي ليخدم العصر، بكل ما فيه من تعقيد وانفتاح، ونبني من خلاله خصوصيتنا الثقافية. هذه الخصوصية لا تُبنى إلا من مزج ما هو محلّي؛ وأعني به التراث، أو ما هو مضيء فيه، بما هو إنساني كوني عالمي. فالتراث العربي الإسلامي تراث منفتح بطبيعته، لم يكن في يوم من الأيام منغلقًا، ولا كان الإسلام منغلقًا، ولا كانت الكتابات العربية المتقدمة منغلقة.
إذن، لا أتفق مع القول إن "التراث هو الحل" بشكل مطلق، كما أرفض القول بضرورة القطيعة مع التراث؛ لأن ذلك يُعدّ نبذًا للهوية وتخلّيًا عن الخصوصية. ومن لا هوية له، لا تاريخ له، ومن ثم لا وجود حقيقي له. انظر، مثلًا، إلى اليابان، أو إلى الصين، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية- على الرغم من أنها دولة حديثة النشأة ومكوّنة من خليط من الشعوب - لم تتخلَّ عن تراثها الرمزي والثقافي، بل استثمرته ضمن مشروعها الحضاري.
د. حسام الدين درويش:
عندما سافرت إلى أوروبا، للمرة الأولى، لم أتعرض إلى صدمات ثقافية كثيرة، لكن ما فاجأني حقًّا هو أن علاقة أوروبا بتراثها علاقة صحية وإيجابية جدًّا. فعلى عكس ما يُعتقد أحيانًا، لم تقم الحداثة الأوروبية قطيعة مع تراثها، بل على العكس، ثمة علاقة حضور وتواصل مستمر مع هذا التراث.
د. محمد المعزوز:
هذا ما لم يفهمه كثير من إخواننا في البلاد العربية؛ إذ يظنون أن ما يُسمى بثورة القرن السادس عشر أو الثورة الفرنسية، كان يعني بالضرورة القطيعة مع التراث. لكن الواقع أن الثورة الفرنسية لم تكن قطيعة مع التراث، بل جاءت استجابة لحاجة سياسية، كفصل الدين عن الدولة، ولتأسيس نظام ديمقراطي يحقق شيئًا من العدالة، إلى غير ذلك من الأهداف. ومع ذلك، لم تُقدِم هذه الثورة على قطع صلتها بتراثها، بل لا تزال المسيحية حاضرة بشكلها الثقافي، إلى درجة أن كبار الفلاسفة في الغرب اليوم - ممن يُعتقد أنهم مؤسسو الفلسفة الحديثة، ومتقدّمون فكريًّا - لا يزالون يتحيّزون للثنائية اليونانية وللديانتين اليهودية والمسيحية. وحتى ما يُسمى بالمركزية الأوروبية، في عمقها، هي مركزية تراثية. وهنا، ينبغي الانتباه إلى أن الغرب يقوم على هذه الثنائية، في حين أن الفكر العربي الإسلامي حين يتناول مسألة النهوض، كثيرًا ما يقع في فخّ التقليد، فيقول البعض إن الحل هو أن نقلّد أوروبا، أو أن نتقدّم بالوسائل التي تقدّمت بها أوروبا، وهذا خطأ؛ بمعنى آخر: لم نبذل الجهد الكافي في الاجتهاد، فهناك حالة من الجمود الفكري، وعُطالة في الاجتهاد لدى العرب.
د. حسام الدين درويش:
إذا انقلنا إلى مسألة الدولة، وتعامل الفكر العربي معها، يمكن الحديث عن وجود رأيين متباينين تمامًا: أحدهما يرى أن هناك اهتمامًا مفرطًا في الفكر العربي من قِبَل الدولة، والآخر يرى، على العكس، أن الدولة لا تحظى بالاهتمام الكافي، في أو من هذا الفكر. ونجد عند برهان غليون، على سبيل المثال، في كتابه "المحنة العربية"، وصفًا للدولة بأنها دولة ضد الأمة، أو دولة بلا أمة. وكما تعلم، هناك حديث دائم عن أن العرب لا يفهمون معنى الدولة، باعتبار أن مفهوم الدولة يحيل في التراث العربي على التغير وعدم الاستقرار على حالة واحدةٍ، بينما يتضمن مفهوم الدولة الحديثة معنى الثبات والاستقرار؛ من أيّ منظور، إذن، ترى أنه ينبغي لنا أن نهتم بمفهوم الدولة أو بواقع الدولة؟
د. محمد المعزوز:
نعم، أولاً لا بد من التأكيد على مسألة مهمة، وهي أن الدولة مسألة أساسية. فنحن حين نتحدث عن الدولة، فإننا نقصد "الدولة الوطنية"، وليس الدولة بمعناها القديم، القمعي أو الديكتاتوري. فما معنى الدولة الوطنية؟
الدولة الوطنية هي الدولة الديمقراطية، التي تقوم على مبدأ فصل السلط، واحترام الفرد وكرامته، وتكريس التوزيع العادل للثروات، والاعتراف بالكفاءات. إنها دولة لا تقوم على حكم الجماعات، أو القبائل، أو الطوائف، بل على مبدأ المواطنة، حيث تُصان الحقوق وتُؤدى الواجبات. ونحن، في هذا السياق، في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع من الدولة؛ إذ لا يمكن تصور مجتمع من دون دولة. غير أن ما ينبغي التأكيد عليه اليوم هو أن الدولة، في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم والتكنولوجيا، مطالبة بتجديد أدوارها؛ إذ لم يعد كافيًا أن تقوم الدولة بالأدوار التقليدية فقط. وهذا ما تناولته في كتابي بالفرنسية بعنوان: "الدولة من الإرث إلى الاستعمال". فعدم فهمنا لهذه التحولات، سيبقي رؤيتنا للدولة حبيسة مفاهيم وسياقات تقليدية، تجعلنا نراها إما بلون أسود قاتم، أو بلون أبيض مثالي. لابد إذن من تبني نظرة نقدية تجاه الدولة، لا بمعنى الهدم أو التبخيس، بل بمعناها الإيجابي والبنّاء؛ فكل من يُبخّس من قيمة الدولة، يفتح المجال لتيارات أخرى كي تستغل هذا الفراغ، وتعيث فسادًا في المجتمع، أو تنتهك حريات الأفراد داخله.
د. حسام الدين درويش:
التعريف الذي قدمته هو تعريف للدولة كما يُفترض أن تكون؛ أي إنه رؤية معيارية. لكن ماذا عن الرؤية الوصفية؟ فنحن نمتلك رؤية معيارية لما ينبغي أن تكون عليه الدولة، لكن بوصفك باحثًا أو مفكرًا، قد لا يكون من المفيد دائمًا الاقتصار على البُعد المعياري. ربما من المفيد هنا الاستشهاد بقول وائل حلاق، الذي يرى أن الدولة الحديثة "لا أخلاق لها"؛ أي إنها تفتقر إلى أي بعد أخلاقي في بنيتها أو ممارستها.
د. محمد المعزوز:
حلاق يتحدث عن الدولة بالمفهوم الليبرالي؛ أي الدولة الحديثة.
د. حسام الدين درويش:
أقصد بالدولة هنا "دولة الأمة" أو "الدولة الوطنية"، لكن من وجهة نظري، ليست الدولة كما عرّفتَها أنت فحسب، بل هي في جوهرها مقومٌ من مقومات الأخلاق، بل يمكن القول إنها أساس الأخلاق؛ إذ لا أخلاق، في واقعنا المعاصر، من دون دولة. نعم، نحن نتحدث عن الدولة الوطنية، وهذا واضح. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت هذه هي رؤيتك المعيارية للدولة، فماذا عن واقع الدولة، سواء في العالم العربي أو خارجه؟
د. محمد المعزوز:
واقع الدولة في العالم، عمومًا، يُعدّ سيئًا. حتى مفهوم الديمقراطية بات، في كثير من الأحيان، بلا معنى، في ظل زحف الليبرالية المتوحشة، بمفاهيمها ومنطق السوق. لاحِظْ، على سبيل المثال، ما يحدث في أعرق الدول الديمقراطية: في الولايات المتحدة، هناك احتجاجات يُواجَه بعضها بالقمع، وفي فرنسا شهدنا حركة "السترات الصفراء" وما رافقها من قمع، وفي بريطانيا هناك مواقف ملتبسة.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة في سياق العدوان على غزة، فحدّث ولا حرج. خذ مثلاً ما حدث في فرنسا: أصدر وزير العدل بيانًا يُجرّم فيه التظاهر دعمًا لغزة. فأين هي الحريات والديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ هذا دليل على أن هناك إفسادًا لمفهوم الدولة حتى في الدول الغربية. أما في العالم العربي، فهناك تفاوتات كبيرة من دولة إلى أخرى. نعم، هناك دول عربية تُحترم، تُدار بعقلانية، وتحقق قدرًا من الاستقرار والتنمية، وإن كانت بدرجات متفاوتة. لكن، للأسف، هناك دول أخرى شملها التفتيت والتقسيم والتجزئة، وهي الآن في وضع مأساوي. انظر إلى ما حدث في السودان، وما يجري في سوريا، وما وقع في ليبيا، وكذلك في العراق. حين تفككت الدولة، تفكك معها النسيج الاجتماعي، وسادت الفوضى.
ومع ذلك، من الإنصاف أن نُقِرّ بأن بعض الدول العربية اليوم تُظهر قدرًا من الاستقرار، وتحقق تنمية ولو كانت نسبية، لكنها تنمية قائمة بالفعل. لذلك، لا ينبغي أن نعمّم الحكم على واقع الدولة في العالم عمومًا، أو في العالم العربي خصوصًا.
د. حسام الدين درويش:
من هذا المنطلق، يمكن القول إنك في طرحك الفكري قدمت رؤية مفهومية عامة لفكرة الدولة. لكن في الوقت نفسه، قدّمت أيضًا دراسة لحالة خاصة، مثل الدولة في المغرب.
د. محمد المعزوز:
نلاحظ في المغرب وجود انفتاح ديمقراطي، وسعيًا واضحًا من قِبَل الدولة نحو ترسيخ نموذج الدولة الوطنية، بل أكثر من ذلك، نحو بناء دولة عصرية حديثة. فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نقارن هذه التجربة بنماذج أخرى في العالم العربي، كالإمارات. لاحِظْ كيف هو نظام الحوكمة في الإمارات، وكيف تُدار شؤون الدولة هناك. لا بد من الإقرار بأن لكل دولة خصوصيتها، ولذلك لا يمكن إسقاط مفهوم "الدولة الوطنية" بصيغته الغربية على نموذج كالإمارات؛ فهناك خصوصيات ثقافية وسياسية وتاريخية يجب احترامها. ومع مراعاة هذا التعدد والخصوصيات، تبقى تجربة الدولة في المغرب، بكل موضوعية ومصداقية، تجربة نموذجية ضمن السياق العربي.
د. حسام الدين درويش:
يبدو أن مسألة العلاقة بين الأصالة والمعاصرة تُطرح بقوة، لا سيما في تناولنا لأيّ حالة أو مشكلة، سواء تعلق الأمر بالجماليات، أو السياسة، أو الثقافة، أو الاجتماع، أو غيرها. فإلى أي حدٍّ ترى أن هذه الإشكالية حقيقية؟ يبدو لي أنها كذلك بالفعل، خاصة في السياق الفكري العربي، حيث تُطرح بإلحاحٍ شديد. على العكس من ذلك، لا نجد مثل هذا الهوس أو هذا التوتر بين الأصالة والمعاصرة في الفكر الغربي.
د. محمد المعزوز:
أعتقد أن تسميتيْ "الأصالة والمعاصرة" غير دقيقة، ولا أتفق معها. ينبغي لنا أن نتحدث عن اللحظة المركبة أو الوجود المركب. ومعنى الوجود المركب هو أن الإنسان يعيش في القرن الحادي والعشرين، حاملًا ثقافات متعددة. فمثلاً، أنا كعربي وكَمغربي، أحمل في داخلي ثقافات متعددة: عربية، أمازيغية، وإسلامية، وكلها تشكل جزءًا من ثقافتي. وفي المشرق العربي، قد تجد فردًا كرديًّا، سوريًّا، عربيًّا، وربما مسيحيًّا أو مسلمًا، يمثل بدوره لحظة وجود مركبة. ولكن الحكم الأساسي هو: هل هذا الفرد يعيش بمعنى الكونية، أم إنه بحاجة إلى السكونية؟ هذا الفرد يعيش في لحظة بناء الدولة التي تخدم الإنسان، وهذا هو الأساس. يجب أن يكون الإنسان منفتحًا، لا أن يقوم على ثنائية "هذا أصيل وهذا معاصر"، فكما ذكرنا في البداية، التراث أساسي، فالإنسان كائن تراثي، لكنه، في الوقت نفسه، كائن لحظي، وهو إنسان وليد لحظته.
د. حسام الدين درويش:
من الناحية العملية، هل هناك شيء مميز يخص علاقة العرب بتراثهم؟ بمعنى آخر: هل هم مرتبطون بتراثهم أكثر من اللازم، أم أقلّ من اللازم، أم إن الوضع طبيعي؟ أم إن المشكلة في الأساس مسألة نظرية فحسب؟
د. محمد المعزوز:
أقول لك شيئًا، هناك اليوم ارتباك واضح حين نتحدث عن ارتباط العربي بتراثه. مثلاً، في المغرب، تجد أن الجملة العربية الدارجة تحوي مفردات فرنسية، وأحيانًا إسبانية، والآن باتت تحتوي على الإنجليزية أيضًا. أما في الخليج، وفي المشرق العربي، فتكاد الجملة العربية تختفي لصالح الإنجليزية. هذا التعلق، أو الانصهار بين الأصالة والمعاصرة، أحيانًا يصبح تعلقًا مرضيًّا، حيث يتحدث الإنسان في بيته بالإنجليزية أو الفرنسية. لكن المشكلة ليست في هذا الأمر بحد ذاته، بل في أن هذا الحديث عن الأصالة والمعاصرة يُستخدم أحيانًا لأغراض استهلاكية إعلامية، ولا يعبر عن قضية جوهرية أو صحيحة بالضرورة.
د. حسام الدين درويش:
دعنا ننتقل إلى سؤال آخر: كيف ولماذا حدث هذا الجمع لديك بين الجانب الفكري والإبداعي، أو بمعنى آخر بين الرواية والعمل الفكري؟ ولماذا تم هذا الدمج؟ هل يعود السبب إلى وجود وسائل مختلفة وضرورية لنقل الأفكار والقيم، أو لنقل أمور لا يمكن التعبير عنها بسهولة بالفكر؟
د. محمد المعزوز:
نعم، أنا دائمًا أقول إنك تستطيع أن تعبّر في الرواية عن أشياء لا تستطيع التعبير عنها في النصوص الفكرية. كما أن السرد هو أمر إنساني بامتياز؛ فالقدرة على الحكي، أو السرد، هي خاصية إنسانية. وللسرد خصوصية ومنطق لا يتوفران في النصوص الفكرية أو الكتابات النظرية. فمن خلال الرواية يمكن أن تكون فيلسوفًا أكثر مما تكون في كتاباتك، ويمكنك أن تكون مؤرّخًا، أو محللًا نفسيًا عبر الشخصيات، أكثر مما تستطيع أن تكون في النص النظري المعرفي. لذا، أقول إن للرواية عالمها المفتوح، وللمعرفة كمكتوب عالمها المفتوح، ولكل عالم خصوصيته. وعلينا أن نعبر في الرواية كما نعبر في الفكر، لكي نعبر عن عمق وجودنا وعمق إنسانيتنا. فلا يكتمل العمق الإنساني الوجودي إلا بالوجدان الذي تمثله الرواية، والشعر، والفنون، وبالعمق العقلي الذي تمثله المعرفة والعلوم بشكل عام. بهذا التكامل بين الجمالي الإبداعي والعقلي، يتأسس الإنسان اليوم.
د. حسام الدين درويش:
حسنًا، دعني أستخدم مصطلح "الأسلوب" بمعناه الدقيق. لكلّ كاتب أسلوبه الخاص، وهذا الأسلوب يمنحه فرادته وتميزه. لكن كيف يمكن لنا أن نكتب مرة بطريقة فكرية، وأخرى بطريقة أدبية؟ أكرر، نحن لا نكتب بلغة عادية؛ فاللغة في النص الفكري أو الفلسفي يجب أن تكون رصينة، مضبوطة، دقيقة، بلغة تقوم على الدقة والمفاهيم، ثم ننتقل إلى كتابة أدبية لها وسائل تعبير مختلفة، مثل الصور البلاغية والجماليات، مع أن الأفكار موجودة في كلا المجالين. على سبيل المثال، لديّ صديقة تعمل في الأنثروبولوجيا أو السوسيولوجيا، كتبت نصًّا أدبيًّا غلب عليه الفكر، حتى إنّها أحيانًا تناقش الفكرة وتغفل الجانب الأدبي. فهل ترى هنا وجود إشكاليات في المزج بين الفكر والأدب؟
د. محمد المعزوز:
أقول شخصيًّا، للتعبير عن تراثي وأصالتي، إنني أكتب بلغة، لا أقول لغة تراثية بالمعنى الضيق، ولكن أكتب بلغة تستطيع أن تعكس تلك الروح الفكرية أو الحمولة الفكرية العظيمة التي حملتها اللغة في مضامينها الكبرى. إن انتصاري للغة بصرامتها هو انتصار لهويتي وثقافتي. لهذا السبب، أحيانًا أكتب جملًا تقليدية للحفاظ على استمرارية هذه اللغة، دون الوقوع في تضييع القول. فلا بد أن أظل منغلقًا على اللغة؛ فاللغة متجددة ومتطورة بتطور المجتمعات، تستوعب وتحتضن كلمات ومصطلحات وتراكيب جديدة.
أنا من أنصار هذا التطوير، لكن حذاري من الانفتاح الأعمى أو الانفتاح غير المدروس، الذي قد يؤدي إلى تضييع اللغة كلغة تعبّر عنا. إذا أهملنا اللغة، سيأتي وقت لا يفهم فيه أبناؤنا أو أحفادنا اللغة العربية حين يقرؤونها، وسيظنونها مجرد طلاسم. وهذا يمنح الشرعية للغات أخرى مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وغيرها، لتظل حية ومستمرة في المستقبل. لاحظ معي أن اللغة الصينية اليوم أصبحت لغة العلم، لكنها حين تكتب تظل ضمن بنيتها التراثية، ولا تخرج عنها، والتراث يُفهم هنا بمعنى التقديم والتجديد، لا بمعنى الجمود. فهذه واحدة من الأمور التي يجب أن نعيها وننتبه إليها.
د. حسام الدين درويش:
معك حقّ، أصبح مبتذلًا القول إن المشكلة تكمن في أوضاع الناطقين باللغة، وليس في اللغة ذاتها. بالطبع لدينا مشكلة في اللغة، لكن لأن مشكلة الناطقين هي التي تحدد تطور اللغة؛ وذلك نتيجة التطور الحضاري للمتكلمين بها والمنتجين لنصوصها. ونحن مسؤولون عن تحديث اللغة وتطويرها واستخدامها واستثمار إمكانياتها. فليس هناك نقص في اللغة ذاتها بمعنى ما، وهذا مجرد توضيح لما قلت سابقًا.
دعنا ننتقل إلى مسألة أنك كنت عنصرًا مهمًّا في مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، هل يمكنك الحديث عن مسيرتك مع هذه المؤسسة؟
د. محمد المعزوز:
أقول إن تجربة «مؤمنون بلا حدود» تجربة فريدة ومميزة بكل صدق ودون مجاملة، وهي مميزة في تاريخ المؤسسات الثقافية العربية في العصر الحديث والمعاصر، أولًا نظرًا إلى ما أنتجته من كتب حداثية وتنويرية ومنصفة، وثانيًا لانفتاحها على مختلف الأطياف بدون تمييز أو تحيز أو انغلاق. أتمنى لهذه التجربة، بصدق، أن تُبعث من جديد، طبعًا بصيغة جديدة، ولكن بنفس الروح والنفس الذي أُسست من أجله.
د. حسام الدين درويش:
بلا شك، أشاركك التمنيات نفسها، وأنا مسرور جدًّا بحديثك عن المؤسسة؛ بمعنى أن تكون بالفعل تحتضن هذه الاختلافات بمختلف أنواعها، سواء في الفلسفة أو الدين أو العلوم الاجتماعية من منظورات متعددة، وهذا أمر يُحسب لها. وأنت كنت من المساهمين في أن تكون هذه المؤسسة على ما هي عليه.
بالنيابة عن المؤسسة وباسمي الشخصي، أشكرك جزيل الشكر.
د. محمد المعزوز:
أشكركم، وأشكر مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» التي أتاحَت لي الفرصة مجدّدًا لإجراء هذه الدردشة الجميلة، وهي دردشة فكرية نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم، وما أحوج بلادنا العربية إليها في ظل هذه الانزلاقات الفكرية، والانزلاقات على كل المستويات، حتى على مستوى شعورنا بذواتنا وبذات مجتمعاتنا.
شكرًا جزيلاً لك.
د. حسام الدين درويش:
العفو، ونبقى على تواصلٍ.






